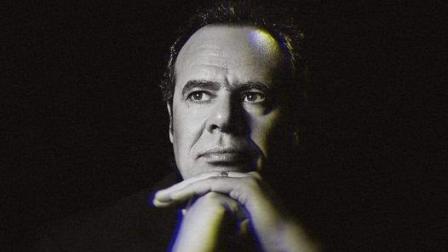أيها العالم نحن لسنا أرقاماً (عبد الرحمن الشيخ)
أثر الفراشة لا يُرى. أثر الفراشة لا يزول.. انطلق مشروع "أثر الفراشة" في سورية مبكراً مع بداية أحداث الثورة، وبجهود فردية لبضعة فنانين وأطباء نفسيين، لعلاج الأطفال النازحين من مناطق العنف، والمصابين بـ"تروما" الحرب، من خلال المسرح "سايكو دراما". ومع أن دائرة العنف في سورية اتسعت واشتدت، فقذفت بأطفالها خارج الحدود، إلا أن الآباء الأوائل للمشروع لحقوا بالأبناء أينما حلّوا، وفي أي أرض.
يقول المخرج والممثل جلال الطويل، لـ"العربي الجديد"، وهو أحد الآباء المؤسسين للمشروع: "تضم الورشة 25 طفلاً، يحكون أقاصيصهم مع الحرب، ذكرياتهم وما اختبروه فيها، القصد منها أن يتمكن الطفل من التغلب على العنصر الأكثر تأثيراً فيه، أمام نفسه، ومن ثم أن يتغلب عليه أمام الأشخاص الأقرب إليه، لا سيما عائلته وأصدقائه".
لكن الفكرة التي بدأت علاجاً، توجت في نهاية المطاف عروضاً فنية، وعلى مدار سنوات ثلاث، قدموا عروضهم في مصر، وتركيا، والأردن، ولبنان، ومخيم أطمة، وكان آخرها قبل أيام بعمان أيضاً، تحت عنوان: "طلعنا على الحرية".
ضم العرض 14 لوحة سردية، بدأت في زمن يسبق الثورة، ومن مقاعد الدراسة، الخلية الأولى لاستبداد "وحش" كان ساكناً مطمئناً، حيث القمع يرخي بظلاله في كل مكان، لننتقل في اللوحة الثانية إلى الشرارة الأولى للثورة، إذ يكتب أطفال المدرسة على جدرانها أولى عبارات الحرية، التي تخرج "الوحش" من قمقمه، لتبدأ معه رحلة الآلام.
من لوحة إلى أخرى يحكي لنا الأطفال تجاربهم الشخصية التي مروا بها، بلغة تخلو من الكلمات في إشارة إلى عجز اللغة عن التعبير عن واقع السوريين المرّ. وحدها أجسادهم وأرواحهم القلقة، برفقة ثماني مقطوعات للموسيقار مالك جندلي، تقبض على حواس الجمهور لتنقله من حيّز إلى حيّز أضيق، فتمارس عليه مرات أساليب الوحش المستبد، سارق الطفولة، وتزجّه مرات أخرى في معتقلاته البائسة، حيث يعلو جبين الأطفال عداد من الأرقام يتسارع متصاعداً، في إشارة للمعتقلين الذين يقتلون تحت التعذيب، برمزية تصرخ في وجه العالم: "أوقف هذا. فنحن لسنا أرقاماً".
يقول الفنان جلال الطويل، الذي يؤدي دور الوحش، (وقد سبق اعتقاله لموقفه المؤيد للثورة والمناهض للنظام): "الوحش هو من يسرق طفولة الأطفال، أياً كانت هويته وموقعه. ومن هنا لم نطلق عليه اسم النظام أو الشبيح أو داعش أو أو. هو كلهم مجتمعين، هو الجمهور أيضاً إذ يرانا ولا يتحرك".
وفي لوحة أخرى وعلى وقع موسيقى "يا الله ما لنا غيرك يا الله"، يذهب الأطفال إلى النوم ليلاً كعادتهم، وما إن تغط الجفون في نوم رقيق، حتى تتساقط عليهم الغازات السامة، فيتحول الأطفال على المسرح إلى ملائكة ذوي أجنحة، يرفرفون لا ليحلقوا إلى السماء استسلاماً لموت بات محكماً، وإنما ليدفعوا إلى الجمهور بأجنحتهم بعضاً من الغاز الذي يخنقهم، رغبة بإشراك الجمهور في تذوق ما تذوقه أطفال سورية ليلة الكيماوي، وتحميله المسؤولية الأخلاقية لما يجري لهم، إذ اكتفى ويكتفي بالفرجة فحسب.

يقول جلال: "هذا العرض عمّره الأطفال بحكاياتهم، كما عمّروا العروض التي سبقته، وبريع العرض السابق، (طلعنا على الضو)، تمكّنّا من كفالة أكثر من 200 يتيم سوري، أما "طلعنا على الحرية"، فسيذهب ريعه لأطفال مرضى السرطان من السوريين. وقد كانت بطلة العرض السابق رزان خوجة (المصابة بالسرطان) من حفّزنا لفعل ذلك".
من بين 25 طفلاً سوريّاً شردتهم الحرب عن وطنهم وبيوتهم، وحرمت بعضاً منهم من عائلاتهم وأصدقائهم، كان هناك 8 أطفال فقدوا أعضاءهم، إلا أنهم على ما يبدو عرفوا مبكراً وأدركوا أن لا خيار أمامهم للتخلّص من هذا القهر إلا بقهره، فجاءت لوحة الختام: "الحب" لتكلل ذلك، وعلى وقع أغنية "وطني أنا"، يقف عبد الله وإيمان (كلاهما مبتور الساق، ولم يتجاوز الخامسة عشرة) على عكازيهما، على شفا خط رسمه لهما الوحش، لا يجرؤان على تجاوزه.
تذهب محاولات عبد الله لإيصال وردة إلى إيمان أدراج الرياح، خوفاً من عين وحش لا تغفل، وانهاكاً من عجز أصاب جسديهما، حتى خطر له أن يستخدم عكازه (رمز عجزه)، كأداة يوصل بها وردته لمن يحب، وإذ يفلح، تزول الحدود ويزول معها الوحش وكأنهما لم يكونا يوماً. فيتشابك الجسدان في وضعية تحدٍ وأمل، جسدان تحملانهما ساقان فحسب، تكفيان لتستمر الحياة.
أطفال سورية تخلصوا من أوهامهم. من خوفهم من "الوحش"، من إيمانهم بـ"عالم عادل" يأبه لهم. أطفال سورية طلعوا على الضو. على الحرية. وسينتصرون على عجزهم.

من لوحة إلى أخرى يحكي لنا الأطفال تجاربهم الشخصية التي مروا بها، بلغة تخلو من الكلمات في إشارة إلى عجز اللغة عن التعبير عن واقع السوريين المرّ. وحدها أجسادهم وأرواحهم القلقة، برفقة ثماني مقطوعات للموسيقار مالك جندلي، تقبض على حواس الجمهور لتنقله من حيّز إلى حيّز أضيق، فتمارس عليه مرات أساليب الوحش المستبد، سارق الطفولة، وتزجّه مرات أخرى في معتقلاته البائسة، حيث يعلو جبين الأطفال عداد من الأرقام يتسارع متصاعداً، في إشارة للمعتقلين الذين يقتلون تحت التعذيب، برمزية تصرخ في وجه العالم: "أوقف هذا. فنحن لسنا أرقاماً".
يقول الفنان جلال الطويل، الذي يؤدي دور الوحش، (وقد سبق اعتقاله لموقفه المؤيد للثورة والمناهض للنظام): "الوحش هو من يسرق طفولة الأطفال، أياً كانت هويته وموقعه. ومن هنا لم نطلق عليه اسم النظام أو الشبيح أو داعش أو أو. هو كلهم مجتمعين، هو الجمهور أيضاً إذ يرانا ولا يتحرك".
وفي لوحة أخرى وعلى وقع موسيقى "يا الله ما لنا غيرك يا الله"، يذهب الأطفال إلى النوم ليلاً كعادتهم، وما إن تغط الجفون في نوم رقيق، حتى تتساقط عليهم الغازات السامة، فيتحول الأطفال على المسرح إلى ملائكة ذوي أجنحة، يرفرفون لا ليحلقوا إلى السماء استسلاماً لموت بات محكماً، وإنما ليدفعوا إلى الجمهور بأجنحتهم بعضاً من الغاز الذي يخنقهم، رغبة بإشراك الجمهور في تذوق ما تذوقه أطفال سورية ليلة الكيماوي، وتحميله المسؤولية الأخلاقية لما يجري لهم، إذ اكتفى ويكتفي بالفرجة فحسب.

يقول جلال: "هذا العرض عمّره الأطفال بحكاياتهم، كما عمّروا العروض التي سبقته، وبريع العرض السابق، (طلعنا على الضو)، تمكّنّا من كفالة أكثر من 200 يتيم سوري، أما "طلعنا على الحرية"، فسيذهب ريعه لأطفال مرضى السرطان من السوريين. وقد كانت بطلة العرض السابق رزان خوجة (المصابة بالسرطان) من حفّزنا لفعل ذلك".
من بين 25 طفلاً سوريّاً شردتهم الحرب عن وطنهم وبيوتهم، وحرمت بعضاً منهم من عائلاتهم وأصدقائهم، كان هناك 8 أطفال فقدوا أعضاءهم، إلا أنهم على ما يبدو عرفوا مبكراً وأدركوا أن لا خيار أمامهم للتخلّص من هذا القهر إلا بقهره، فجاءت لوحة الختام: "الحب" لتكلل ذلك، وعلى وقع أغنية "وطني أنا"، يقف عبد الله وإيمان (كلاهما مبتور الساق، ولم يتجاوز الخامسة عشرة) على عكازيهما، على شفا خط رسمه لهما الوحش، لا يجرؤان على تجاوزه.
تذهب محاولات عبد الله لإيصال وردة إلى إيمان أدراج الرياح، خوفاً من عين وحش لا تغفل، وانهاكاً من عجز أصاب جسديهما، حتى خطر له أن يستخدم عكازه (رمز عجزه)، كأداة يوصل بها وردته لمن يحب، وإذ يفلح، تزول الحدود ويزول معها الوحش وكأنهما لم يكونا يوماً. فيتشابك الجسدان في وضعية تحدٍ وأمل، جسدان تحملانهما ساقان فحسب، تكفيان لتستمر الحياة.
أطفال سورية تخلصوا من أوهامهم. من خوفهم من "الوحش"، من إيمانهم بـ"عالم عادل" يأبه لهم. أطفال سورية طلعوا على الضو. على الحرية. وسينتصرون على عجزهم.