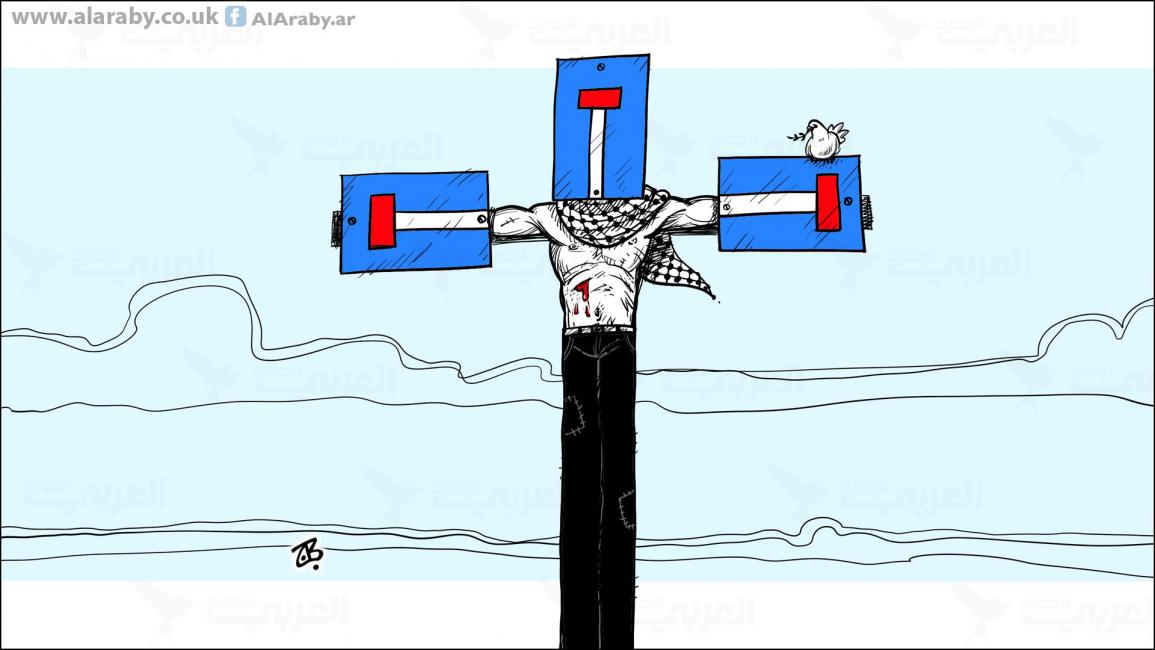"إن فيها قوماً جبّارين"

نهاية قواسمي
صحافيّة فلسطينية. شاركت في كتاب عن الصراع الفلسطينيّ الصهيونيّ للأميركيّة لوريل هوليداي. بكالوريوس دراسات نسويّة وعلم اجتماع. ناشطة نسوية وسياسيّة وإحدى مؤسّسي حركة حق "العودة إلى فلسطين" في الولايات المتّحدة
من لم يسمع هذا الجزء من الآية القرآنية الكريمة على لسان الراحل ياسر عرفات؟ اعتاد على ترديد الآية لشحذ همة الفلسطينيين، والتباهي بقدراتهم على الصمود والاستبسال في وجه المحتل الإسرائيلي. من منّا، نحن الفلسطينيين، لم يشعر بفخر عظيم حين كنا نسمعها منه؟ من منا لم يشعر أن في وسعه إزالة الجبال من طريقه ومهاجمة كتيبة عسكرية وحده؟
هل نحن حقا شعب الجبارين؟ وماذا فعلت بنا عبارات كهذه؟ أصبحنا أسطورة الشعب العربي وأبطالاً خارقين غير قابلين للكسر، ولا نهزم، مهما فعل بنا الاحتلال وجيشه. أصبحت صورتنا هي غسان كنفاني الوسيم الذي يجلس خلف مكتبه، وبيده لفافة تبغ وقلم بيده الأخرى، يفيض منه إبداعه الأدبي. وإن لم تكن كنفاني، فهي صورة الأكثر وسامةً، الأمير الأحمر، وقميصه المفتوح كاشفا عن صدره، وقصة بطولاته من هجوم ميونيخ إلى إفلاته من محاولات عدة من الموساد الصهيوني لاغتياله. وإن لم تكن هذا أو ذاك، فلنا ابن المخيم بنظراته المتقدة وغضبه الدائم.
أين هو الفلسطيني الطبيعي أو العادي من هذه الصور النمطية؟ أين الشاب الذي يرغب بالهجرة إلى أوروبا، ليكمل تعليمه أو ليجد عملا وزوجة شقراء ليبتعد عن ضجيج هذه الحرب التي لا تنتهي؟ أين هي الفتاة الحالمة التي تود أن تتعلم العزف على آلة موسيقية، بدلا من أن تخطف طائرة أو تطعن جنديا احتلاليا؟ أين نحن أغلب الفلسطينيين؟
نحن الذين نشبهكم برغبتنا بالعيش عيشةً كريمةً وتحقيق أحلامنا، والسفر إلى بلاد أخرى
للسياحة أو ربما للاستقرار. نحن من نتمنّى لو لنا القدرة على السهر في ملهىً ليلي، والرقص حتى الفجر من دون التفكير بكيفية العودة إلى المنزل، وتجنب حاجز عسكري احتلالي، ثابت أو متنقل. نحن من نرغب بالجلوس على رمال الشاطئ لنلهو مع أبنائنا، ونبني قلاعا من الرمل، من دون أن تأتينا قذيفة من البحر تحيلنا أشلاء. نحن من نشتهي حياةً طبيعيةً، مثل كثيرين من سكان هذا الكوكب.
تتعاملون مع هذه الأمنيات البسيطة على أنها مسلمات، لكنها بالنسبة لنا أمنيات وأحلام صعبة المنال في أغلب الأحيان. أهل الضفة الغربية لا يعرفون ما هو البحر، إلا إذا منحهم الاحتلال تصريحا يسمح لهم بزيارة فلسطين المحتلة منذ عام 1948. أبناء غزة لا يعلمون ما هو الجبل، فلا هم قادرون على زيارة عيبال أو جرزيم، وزيارة الكرمل لن تتحقق إلا بتحرير كامل التراب الفلسطيني. أما أبناء القدس، فأغلبهم لم ير قطاع غزة قط، وهم أيضا ينتظرون التحرير، ليروا كامل وطنهم.
في فلسطين، نحاول البقاء على قيد الحياة قدر المستطاع، ولا نأخذ مرور يوم، تجنبنا فيه الموت، من المسلمات. قد يبدو هذا، في نظركم، بطولة، لكنها غريزة البقاء. أنتم تخشون حوادث الطرق أو الحريق والغرق والقتل عن طريق لص أو الاغتصاب، ونحن نخشى هذا كله، بالإضافة إلى رصاصة أو قذيفة تنهي حياتنا. ولا مكان للهرب هنا، فلا حدود مفتوحة، ولا دول عربية أو أوروبية تفتح حدودها لنا وتستقبلنا. هنا، نهرب من موت إلى موت آخر.
قالت لي صديقة فيسبوكية يوما: أنتم أبطال... أجبتها: إننا لسنا كذلك، فنحن أناس عاديون، منّا الصالح والطالح والوطني والعميل والقوي والضعيف. لم يعجبها كلامي، وأصرّت على أننا أبطال. أنهيت صداقتي معها، لرفضها أن ترى الإنسانة في، وأصرّت على صورة نمطية لا تعني لي الكثير. لا تعلم ماذا يعني أن أفضّل البقاء في منزلي على أن أتوّجه إلى القدس، وأضطّر لأن أتعرّض للذل على حاجز عسكري احتلالي. لا تعلم كم أرغب بالرحيل، كي لا أتعرّض لهذه الإهانة اليومية. هي تتصور بقائي في فلسطين بطولة وصمودا، وأنا أراه نوعا من قتل الذات بشكل بطيء.
كنا، ولم نعد خط دفاعكم الأول. قاومنا الاحتلال، وقدّمنا كثيرا من الموت، كي نبعده عنكم.
ماذا فعلتم أنتم؟ أشبعتمونا الشعارات الفارغة والقليل من الدعم. أرسلتم بضع صواريخ عادت إلينا دمارا لم نره من قبل، وجثثا تتراكم حولنا وأحبة عديدين فقدناهم. قطعتم أموال الصمود عنّا وأفسحتم المجال للإمبراطورية الأميركية لتتحكم بقوتنا وتركعنا متى شاءت. لم تحموا ظهورنا، وأمضيتم وقتكم بشعوذة الدين وإطاعة أولي الأمر الفاسدين. لم تستطيعوا حماية حدودكم من الموت الذي حاولنا عبثا صدّه عنكم. ارتميتم بأحضان من قتلنا من أجل مناصب فارغة، وها هو الموت يحصدكم كما حصدنا. لم كنا نموت ولأجل من؟ سميتمونا جبّارين، وتحلقتم مع عائلاتكم تشاهدون موتنا على شاشات التلفاز، ولم تفعلوا شيئا سوى التحسّب على من قتلنا. ربما تخرجون في مظاهرة، وتلتحفون خلالها بكوفية فلسطينية مصنوعة في الصين، وتهتفون، "تحيا فلسطين".
فلسطين لم تعد تلك الدولة المسخ، تربعت في ثناياها ودخلت في مساماتها ولم تعد فلسطين. تصرون على أنها موجودة كي تستمروا في رمي عبء النضال على كاهلنا، بينما تسهبون في التشجيع من خلف حاسوباتكم وبهاشتاغاتكم وقلادات حنظلة معلقة من رقابكم، واقتباسات من غسان كنفاني أو محمود درويش في منشوراتكم. تخونوننا حين نضطر للتعامل مع مؤسسات الاحتلال المفروضة علينا. لكن لا ضير أن تشتروا بضاعةً من شركة أميركية تدعم الاحتلال. تغضبون لأنه لا وجود لعملة فلسطينية، ولأننا نستخدم الشيكل، عملة العدو! وفي الوقت نفسه، تغضبون حين يمنع عرض فيلم لمخرج أميركي يساند العدو ماليا. تطالبوننا بالصمود، بينما أنتم تفرون من بلادكم. تطالبوننا بمقارعة الاحتلال والموت في سبيل الوطن، في حين أنكم تفرّون من وجه الموت في بلادكم، وحتى من قنبلة غاز. حين أحرق المستوطنون الطفل علي الدوابشة، صرخت صديقة لبنانية، "كل الفلسطينية بكرا ع الموت". طلبت منا أن نتوجه إلى الموت بأرجلنا، في حين هي لم تصمد أكثر من ثلاثة أيام في الضاحية الجنوبية لبيروت خلال حرب 2006.
يا لازدواجية معاييركم. هذا هو صمودي، أقدمه لكم، فخذوه. لست ملاكا، ولا جبارة، ولست آلهة، كي أحتمل كل هذا العذاب من أجلكم. فعلنا الكثير لنحميكم، ولكن أنتم من أدخل المحتل إلى أرضكم ومن ثم فررتم، فلم لا أفعل مثلكم؟ هل أرواحكم أعلى قيمة من أرواحنا؟ هل أنتم تستحقون الحياة، ونحن لا؟
هل نحن حقا شعب الجبارين؟ وماذا فعلت بنا عبارات كهذه؟ أصبحنا أسطورة الشعب العربي وأبطالاً خارقين غير قابلين للكسر، ولا نهزم، مهما فعل بنا الاحتلال وجيشه. أصبحت صورتنا هي غسان كنفاني الوسيم الذي يجلس خلف مكتبه، وبيده لفافة تبغ وقلم بيده الأخرى، يفيض منه إبداعه الأدبي. وإن لم تكن كنفاني، فهي صورة الأكثر وسامةً، الأمير الأحمر، وقميصه المفتوح كاشفا عن صدره، وقصة بطولاته من هجوم ميونيخ إلى إفلاته من محاولات عدة من الموساد الصهيوني لاغتياله. وإن لم تكن هذا أو ذاك، فلنا ابن المخيم بنظراته المتقدة وغضبه الدائم.
أين هو الفلسطيني الطبيعي أو العادي من هذه الصور النمطية؟ أين الشاب الذي يرغب بالهجرة إلى أوروبا، ليكمل تعليمه أو ليجد عملا وزوجة شقراء ليبتعد عن ضجيج هذه الحرب التي لا تنتهي؟ أين هي الفتاة الحالمة التي تود أن تتعلم العزف على آلة موسيقية، بدلا من أن تخطف طائرة أو تطعن جنديا احتلاليا؟ أين نحن أغلب الفلسطينيين؟
نحن الذين نشبهكم برغبتنا بالعيش عيشةً كريمةً وتحقيق أحلامنا، والسفر إلى بلاد أخرى
تتعاملون مع هذه الأمنيات البسيطة على أنها مسلمات، لكنها بالنسبة لنا أمنيات وأحلام صعبة المنال في أغلب الأحيان. أهل الضفة الغربية لا يعرفون ما هو البحر، إلا إذا منحهم الاحتلال تصريحا يسمح لهم بزيارة فلسطين المحتلة منذ عام 1948. أبناء غزة لا يعلمون ما هو الجبل، فلا هم قادرون على زيارة عيبال أو جرزيم، وزيارة الكرمل لن تتحقق إلا بتحرير كامل التراب الفلسطيني. أما أبناء القدس، فأغلبهم لم ير قطاع غزة قط، وهم أيضا ينتظرون التحرير، ليروا كامل وطنهم.
في فلسطين، نحاول البقاء على قيد الحياة قدر المستطاع، ولا نأخذ مرور يوم، تجنبنا فيه الموت، من المسلمات. قد يبدو هذا، في نظركم، بطولة، لكنها غريزة البقاء. أنتم تخشون حوادث الطرق أو الحريق والغرق والقتل عن طريق لص أو الاغتصاب، ونحن نخشى هذا كله، بالإضافة إلى رصاصة أو قذيفة تنهي حياتنا. ولا مكان للهرب هنا، فلا حدود مفتوحة، ولا دول عربية أو أوروبية تفتح حدودها لنا وتستقبلنا. هنا، نهرب من موت إلى موت آخر.
قالت لي صديقة فيسبوكية يوما: أنتم أبطال... أجبتها: إننا لسنا كذلك، فنحن أناس عاديون، منّا الصالح والطالح والوطني والعميل والقوي والضعيف. لم يعجبها كلامي، وأصرّت على أننا أبطال. أنهيت صداقتي معها، لرفضها أن ترى الإنسانة في، وأصرّت على صورة نمطية لا تعني لي الكثير. لا تعلم ماذا يعني أن أفضّل البقاء في منزلي على أن أتوّجه إلى القدس، وأضطّر لأن أتعرّض للذل على حاجز عسكري احتلالي. لا تعلم كم أرغب بالرحيل، كي لا أتعرّض لهذه الإهانة اليومية. هي تتصور بقائي في فلسطين بطولة وصمودا، وأنا أراه نوعا من قتل الذات بشكل بطيء.
كنا، ولم نعد خط دفاعكم الأول. قاومنا الاحتلال، وقدّمنا كثيرا من الموت، كي نبعده عنكم.
فلسطين لم تعد تلك الدولة المسخ، تربعت في ثناياها ودخلت في مساماتها ولم تعد فلسطين. تصرون على أنها موجودة كي تستمروا في رمي عبء النضال على كاهلنا، بينما تسهبون في التشجيع من خلف حاسوباتكم وبهاشتاغاتكم وقلادات حنظلة معلقة من رقابكم، واقتباسات من غسان كنفاني أو محمود درويش في منشوراتكم. تخونوننا حين نضطر للتعامل مع مؤسسات الاحتلال المفروضة علينا. لكن لا ضير أن تشتروا بضاعةً من شركة أميركية تدعم الاحتلال. تغضبون لأنه لا وجود لعملة فلسطينية، ولأننا نستخدم الشيكل، عملة العدو! وفي الوقت نفسه، تغضبون حين يمنع عرض فيلم لمخرج أميركي يساند العدو ماليا. تطالبوننا بالصمود، بينما أنتم تفرون من بلادكم. تطالبوننا بمقارعة الاحتلال والموت في سبيل الوطن، في حين أنكم تفرّون من وجه الموت في بلادكم، وحتى من قنبلة غاز. حين أحرق المستوطنون الطفل علي الدوابشة، صرخت صديقة لبنانية، "كل الفلسطينية بكرا ع الموت". طلبت منا أن نتوجه إلى الموت بأرجلنا، في حين هي لم تصمد أكثر من ثلاثة أيام في الضاحية الجنوبية لبيروت خلال حرب 2006.
يا لازدواجية معاييركم. هذا هو صمودي، أقدمه لكم، فخذوه. لست ملاكا، ولا جبارة، ولست آلهة، كي أحتمل كل هذا العذاب من أجلكم. فعلنا الكثير لنحميكم، ولكن أنتم من أدخل المحتل إلى أرضكم ومن ثم فررتم، فلم لا أفعل مثلكم؟ هل أرواحكم أعلى قيمة من أرواحنا؟ هل أنتم تستحقون الحياة، ونحن لا؟
دلالات


نهاية قواسمي
صحافيّة فلسطينية. شاركت في كتاب عن الصراع الفلسطينيّ الصهيونيّ للأميركيّة لوريل هوليداي. بكالوريوس دراسات نسويّة وعلم اجتماع. ناشطة نسوية وسياسيّة وإحدى مؤسّسي حركة حق "العودة إلى فلسطين" في الولايات المتّحدة
نهاية قواسمي