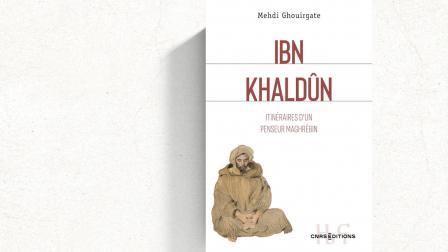في الغزوات القديمة، لم يكن القراصنة يسحبون وراءهم تماثيل آلهة المغلوبين عبثاً، ولم يكونوا يُطلقون اسم "البرابرة" على المغلوبين تسليةً، ولا كانوا يغدقون الهدايا على الدواسيس من أجل سواد عيونهم.
كانوا في الحقيقة يقتلعون ذاكرة الشعوب المغلوبة، ويورثونها بدل ذاكرتها ألغازاً تتقاتل لحلّها، ألغازاً من نوع: ما هو جنس الملائكة؟ وكم ملاكاً يمكن أن يقف على رأس إبرة؟ وها نحن اليوم نستعيد ألغازاً مماثلة، فنسأل عن أرض يأجوج ومأجوج، وهل آن أوان خروج الدجّال أم لا زال سجين جزيرة نائية؟
ثقافتنا الآن، أي ثقافة هذا العالم الافتراضي المصطنع، لا صلة لها بواقع عالمنا الغائب، ولا عالم الآخرين الحاضر بكل أثقاله. ثقافتنا كما هي ماثلة في منتجات التقانة الحديثة، ثقافة تسلية وصخب في أنفاق متخيّلة. وخارجها، أي في العالم الواقعي، تشرق شمس لم نتعرّف عليها، وكواكب لا نعرف إلا أسماءها، وكائنات ما زلنا حائرين في فكّ رموز حركاتها وسكناتها وكلماتها.
نحن المحرومون حتى من تسمية أنفسنا، ناهيك عن تسمية أشيائنا، نحن العاجزون عن استرداد أسماء جبالنا وأنهارنا وطيور بساتيننا، نحن الأكثر ضآلة من عشب صيف ناشف، لابد لنا أن نسترد الكثير؛ هويتنا الضائعة في أرخبيل الهويات المذهبية والطائفية والعرقية والدينية الذي قذفونا في خضمه، اسم فلسطيننا وجزيرتنا على الأقل، أسماء آبائنا الذين لم نعد نتعرّف عليهم ولم يعودوا قادرين على التعرّف علينا. ثروات أرضنا التي لا نملك إلا أن نتطلّع إليها وسفن القراصنة ترحل بها.
ما الذي نفعله الآن سوى ما كان يفعله الأفارقة البؤساء قبل قرنين على الشواطئ؟ يقذف لنا القراصنة بالخرز الزجاجي الملوّن والأساور النحاسية وببعض التبغ والمشروبات، ونراقب عمائرهم تنهض وسفنهم تجول ووفودهم تتوافد، فلا نملك إلا أن نرقص امتناناً بأثوابنا الزاهية وسيوفنا الخشبية المصقولة، ونؤلّف الأغاني المناسبة للمقام والحال.
اقرأ أيضاً: عن صناع الإيكولوجيا الثقافية: أين تسكّ المعايير؟