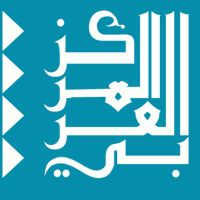18 نوفمبر 2024
الانتخابات التشريعية الجزائرية.. برلمان جديد وتحديات كبيرة
تصويت في الجزائرالعاصمة مع رفض 63% عملية الافتراع (4/5/2017/Getty)
شهدت الجزائر يوم 4 مايو/ أيار 2017 أول انتخابات تشريعية بعد التعديلات الدستورية التي أقرّت عام 2016، وشارك فيها أكثر من 12 ألف مرشح، يمثلون 57 حزبًا وقائمة. وانتخب نوابٌ جدد في الغرفة الدنيا للبرلمان (المجلس الشعبي الوطني)، إثر انتهاء الفترة القانونية (خمس سنوات) للعهدة النيابية. وقد كرّست نتائج الانتخابات هيمنة أحزاب السلطة على أغلبية المقاعد البالغة 462 مقعدًا، إذ حصلت أحزاب الموالاة، وهي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية والتحالف الوطني الجمهوري، على 305 مقاعد بنسبة 66.017%. وحصلت الأحزاب المنضوية داخل هيئة التشاور التابعة للمعارضة مجتمعةً، والتي دخلت المعترك الانتخابي، على 59 مقعدًا بنسبة 12.77%، في حين توزّعت بقية المقاعد على أحزاب متوسطة وصغيرة جدًا؛ فحصل أقدم حزب معارض، وهو جبهة القوى الاشتراكية، على 14 مقعدًا، وحزب العمال الذي تقوده المرشحة الرئاسية السابقة، لويزة حنون، على 11 مقعدًا، وانتزع حزب جبهة المستقبل، بقيادة عبد العزيز بلعيد، والحاصل على المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية السابقة، 14 مقعدًا، وحصلت أحزابٌ صغيرة أخرى على ما بين مقعد واحد إلى ثلاثة مقاعد لكل منها.
ونتيجة بقاء الأغلبية المطلقة بيد أحزاب السلطة، وتراجع مكاسب المعارضة عن تلك التي حازتها في الانتخابات السابقة، أعلنت المعارضة رفضها النتائج، وقدمت طعونًا تشكو فيها التزوير.
ظروف العملية الانتخابية
جرت هذه الانتخابات في ظروفٍ صعبة يمر بها الاقتصاد الجزائري، إثر أزمة تدّني أسعار النفط؛ المصدر الأساسي لمدخولات الدولة. وانعكس ذلك على الواقع المعيشي للمواطن؛ ما جعل الجهاز التنفيذي، بقيادة الوزير الأول عبد المالك سلال، يعمد إلى انتهاج سياسةٍ وصفها بـ "ترشيد النفقات"، بينما عدّها الشارع سياسة تقشف. وبدأ تطبيقها بعد التصديق على قانون المالية لسنة 2016، وبإجراءات أكثر صرامةً في قانون المالية لسنة 2017، فاكتسبت المناقشات البرلمانية طابعًا مشحونًا، بما في ذلك تبادل الاتهامات بين الموالاة والمعارضة.
وعلى الرغم من ذلك، مرّ القانونان بأغلبيةٍ مريحةٍ من نواب الموالاة، ما جعل المواطن الجزائري يحمّل البرلمان مسؤولية ما وصلت إليه ظروفه المعيشية، ودفعت به إلى التعبير عن ذلك في الصورة العامة للانتخابات أخيرا، إذ بلغت نسبة العزوف والمقاطعة أرقامًا كبيرة. وقد أكدت السلطات الجزائرية أن نحو ثمانية ملايين فقط من أصل أكثر من 23 مليونًا مسجلين في القوائم الانتخابية شاركوا في الانتخابات، بنسبة مشاركة بلغت 38.25%. في حين بلغت نسبة المشاركة 43% في العام 2012.
وتميزت هذه الانتخابات أيضًا بحالةٍ من الهدوء في خطابات قادة الأحزاب السياسية، وغياب التشاحن الإعلامي الذي عرفته الانتخابات الرئاسية في ربيع 2014، وأصدرت وزارة الإعلام بيانًا ذكّرت فيه الوسائل الإعلامية، خصوصا التلفزيونية، بضرورة الحياد وعدم اتباع نهج تعبوي، مع التأكيد على عدم استضافة دعاة المقاطعة. وكان الاستثناء في بعض المشاحنات العابرة التي جرت بين مسؤولي حزبي الموالاة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، حول شرعية الولاء والانتماء لمعسكر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. أما خطابات قادة الأحزاب وحملاتهم، فقد كانت خاليةً من أي أجنداتٍ أو برامج حقيقية.
عزوف ومقاطعة
كانت الرسالة الأبرز التي أوضحتها عملية الاقتراع هي تحوّل العزوف الشعبي عن الانتخابات إلى مقاطعةٍ حقيقية، ما يعد بمنزلة عقابٍ غير معلن لمؤسسة البرلمان؛ المتهم الأول بتزكية مشاريع حكومية أقرّت إجراءاتٍ اقتصاديةً قاسيةً ومؤثرةً في الوضع المعيشي لأغلب المواطنين الذين يعيشون وضعًا متوسطًا، أو دون المتوسط. فقد صوتت نسبة 10% من الناخبين بأوراق ملغاة قانونيًا، ورفض نحو 63% المشاركة في العملية الانتخابية من أساسها. وقد توزّع المقاطعون للانتخابات التشريعية في تركيبتهم بين أحزاب سياسية وناشطي مجتمع مدني وعازفين غير مهتمين من بين جموع المواطنين.
أما حزبيًا، فقد تبنّت هيئة التشاور والمتابعة، المعارِضة، مطلبَ إحداث اللجنة العليا المستقلة للانتخابات، لكنها لم تصدر موقفًا موحدًا بشأن المشاركة من عدمها، وتركت القرار للأحزاب المنضوية تحتها؛ ما جعل أغلبها يقرّر المشاركة، فيما قرّر حزب طلائع الحريات المقاطعة، وأصدر حزب جيل جديد، مع بعض الناشطين المنتمين للهيئة، إعلان "أوفياء مزفران" الذي دعا إلى اعتماد خيار المقاطعة.
وكان "جيل جديد" أول من أعلن مقاطعته الانتخابات؛ بسبب صدور قانون الانتخابات من دون أن يتضمّن استحداث هيئة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات؛ ما اعتبره سببًا كافيًا للدعوة إلى مقاطعة العملية الانتخابية، وعدم إضفاء الشرعية عليها. أما "طلائع الحريات"، بقيادة رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، فقرّر عدم المشاركة، تبعًا لقرار أغلبية أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بعد عملية تقييم لجدوى المشاركة من عدمها؛ فاحتجاج الحزب على قانون الانتخابات، وعلى بقاء صلاحية تنظيم الانتخابات بيد السلطة التنفيذية، وعدم فتح المجال لتأسيس الهيئة العليا المستقلة لتنظيم الانتخابات، كان السبب الأول للمقاطعة. أما السبب الثاني الذي عرضته اللجنة المركزية، فهو "انعدام الجدوى من التنافس على الوصول إلى برلمانٍ فاقد للصلاحيات، وخاضع كليةً لهيمنة السلطة التنفيذية".
الخارطة السياسية والحزبية
تشهد الخارطة السياسية والحزبية الجزائرية تغيراتٍ مهمةً على ملمحها العام، إذ برزت تشكيلاتٌ حزبيةٌ جديدة موالية للسلطة، وهي تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية والتحالف الوطني الجمهوري؛ وهي أحزابٌ متوسطة الحجم، أعلنت انخراطها مع الحزبين التقليديين، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، في مسعى موالاة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
في المقابل، تشكّلت قوى معارضة جديدة، إثر الانتخابات الرئاسية التي جرت في ربيع 2014، والتي اجتمعت لأول مرة في مؤتمر مزفران الأول، ونتج منها تكتل هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة الوطنية، جمع شخصياتٍ سياسيةً بارزة، وأحزاباً قاطعت الرئاسيات، مثل تنسيقية الانتقال الديمقراطي التي تجمع حركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة وحزب جيل جديد والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، كما جمع مشاركين في الرئاسيات، مثل علي بن فليس.
وظلت أحزابٌ، مثل حزب العمال، محافظةً على خطابها العام المهتم بالقضايا الاقتصادية، ولم تعلن ولاءها أو معارضتها السلطة القائمة، واختار حزب جبهة القوى الاشتراكية أسلوب الحوار والخطاب التوافقي بين السلطة والمعارضة، من خلال مشروعه السياسي الحالي الداعي إلى الإجماع الوطني. وبقي حزب جبهة المستقبل، بقيادة عبد العزيز بلعيد، والحاصل على المرتبة الثالثة في الرئاسيات الأخيرة، على نهج خطاب التهدئة وتفادي الصدام بين السلطة والمعارضة. اجتمعت هذه الأحزاب على خطابٍ ينطلق من ضرورة تفادي الوصول إلى ما وصلت إليه سورية وليبيا.
مستوى المشاركة الحزبية
بسبب تطبيق قانون الانتخابات (الصادر في 25 أغسطس/ آب 2016 ) بأثرٍ رجعي، لم يعد ممكنًا لأي حزبٍ المشاركة في الانتخابات، من دون حصوله على نسبة 4% من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات التشريعية السابقة (وهو الشرط الذي يتوفر لدى حزبي الموالاة الرئيسين فقط: جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي)، وإلا فإن على الراغبين في الترشّح جمع 250 توقيعًا مقابل كل مقعدٍ متاح للتنافس في الدائرة الانتخابية محل إقامة المعنيين؛ ما عقّد مهمة الأحزاب الصغيرة، ومنعها من تقديم ترشيحاتها في دوائر انتخابية كثيرة. ولذلك، لم تستطع هذه الأحزاب أن تنافس على جميع المقاعد، إلى أن قرّرت الحكومة منح التحالفات المستحدثة مجموع الأصوات المعبّر عنها التي حصل عليها مجموع أطراف كل تحالف؛ وهو ما مكّنها من المنافسة على أغلبية المقاعد (تحالف حركة مجتمع السلم وتحالف الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء).
سعت الحكومة من هذا القرار إلى جذب أكبر مشاركةٍ حزبيةٍ ممكنةٍ لإنجاح الانتخابات وإعطائها شرعيةً شعبيةً لحاجتها الماسة إلى غطاء دستوري، يضمن لها تمرير خططها الاقتصادية، في ظل ظروفٍ ماديةٍ صعبة، تميّزت بشحّ الموارد والمداخيل، بعد انهيار أسعار النفط في السوق الدولية؛ ما قد يجبرها على التوجه نحو حلولٍ سريعةٍ وغير شعبية، تتمثل أساسًا في رفع أسعار المواد الاستهلاكية وزيادة الضرائب وتوسيع نطاقها. ومع استمرار تدني الوضع الاقتصادي، تجد السلطة السياسية نفسها مجبرةً على التوجه نحو خياراتٍ أكثر قسوةً على الواقع المعيشي للمواطن. وهو ما يتطلب برلمانًا يوافق بأغلبيةٍ مريحةٍ على قانون المالية للعام المقبل 2018، بما قد يفيد ضمان حالة من الهدوء الاجتماعي، حتى نهاية العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
خاتمة
على الرغم من أن نتائج الانتخابات مثلت خيبة أمل للطامحين في تحوّل ديمقراطي حقيقي في الجزائر، بعد إقرار التعديلات الدستورية المهمة عام 2016، حيث كرّست حكم أحزاب السلطة، وأعادت إنتاج التوليفة الحاكمة، فإنّ كثيرين نظروا إليها باعتبارها محطةً في الطريق نحو تسمية خليفة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ومع كثرة الطامحين في الوصول إلى سدة الرئاسة، زادت الانتخابات من حدّة التكهنات. فقد قدّم أحمد أويحيى، مدير ديوان رئيس الجمهورية المُنحّى من منصبه والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي خلال قيادته الحملة الانتخابية البرلمانية، برنامجًا وخطابًا ذا طابعٍ رئاسي. والواضح أنه مرشّح لهذا المنصب. كما قدّم مولود حمروش، رئيس الحكومة الأسبق والمشرف على عملية الإصلاح السياسي في بداية التعدّدية السياسية في الجزائر، خطابًا مطمئنًا للدولة وللجيش، حتى تقبل به لتولي رئاسة الجمهورية فترة انتقالية بتزكيةٍ من المؤسسة العسكرية. ويبقى طموح علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق، والذي انتقل إلى معارضة الرئيس، ونافسه في انتخابات عامي 2004 و2014، كبيرًا للمنافسة على هذا المنصب، خصوصًا مع تحضيراته المستمرة لأي منافسةٍ رئاسيةٍ مقبلة. وتطرح بعض الدوائر في الظل إمكانية تقدّم مستشار الرئيس وشقيقه، السعيد بوتفليقة، لتأدية دورٍ مهمٍ في خلافة شقيقه، بدعم من محيط الرئيس من سياسيين ورجال أعمال بارزين. بهذا المعنى، لم تساعد الانتخابات التشريعية على توضيح الصورة وإظهار الخليفة المحتمل، لكن البرلمان الجديد سيكون له دور مهم في ترجيح كفة الطامحين لخلافة الرئيس؛ أنهى فترته الرئاسية أم لا.
ونتيجة بقاء الأغلبية المطلقة بيد أحزاب السلطة، وتراجع مكاسب المعارضة عن تلك التي حازتها في الانتخابات السابقة، أعلنت المعارضة رفضها النتائج، وقدمت طعونًا تشكو فيها التزوير.
ظروف العملية الانتخابية
جرت هذه الانتخابات في ظروفٍ صعبة يمر بها الاقتصاد الجزائري، إثر أزمة تدّني أسعار النفط؛ المصدر الأساسي لمدخولات الدولة. وانعكس ذلك على الواقع المعيشي للمواطن؛ ما جعل الجهاز التنفيذي، بقيادة الوزير الأول عبد المالك سلال، يعمد إلى انتهاج سياسةٍ وصفها بـ "ترشيد النفقات"، بينما عدّها الشارع سياسة تقشف. وبدأ تطبيقها بعد التصديق على قانون المالية لسنة 2016، وبإجراءات أكثر صرامةً في قانون المالية لسنة 2017، فاكتسبت المناقشات البرلمانية طابعًا مشحونًا، بما في ذلك تبادل الاتهامات بين الموالاة والمعارضة.
وتميزت هذه الانتخابات أيضًا بحالةٍ من الهدوء في خطابات قادة الأحزاب السياسية، وغياب التشاحن الإعلامي الذي عرفته الانتخابات الرئاسية في ربيع 2014، وأصدرت وزارة الإعلام بيانًا ذكّرت فيه الوسائل الإعلامية، خصوصا التلفزيونية، بضرورة الحياد وعدم اتباع نهج تعبوي، مع التأكيد على عدم استضافة دعاة المقاطعة. وكان الاستثناء في بعض المشاحنات العابرة التي جرت بين مسؤولي حزبي الموالاة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، حول شرعية الولاء والانتماء لمعسكر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. أما خطابات قادة الأحزاب وحملاتهم، فقد كانت خاليةً من أي أجنداتٍ أو برامج حقيقية.
عزوف ومقاطعة
كانت الرسالة الأبرز التي أوضحتها عملية الاقتراع هي تحوّل العزوف الشعبي عن الانتخابات إلى مقاطعةٍ حقيقية، ما يعد بمنزلة عقابٍ غير معلن لمؤسسة البرلمان؛ المتهم الأول بتزكية مشاريع حكومية أقرّت إجراءاتٍ اقتصاديةً قاسيةً ومؤثرةً في الوضع المعيشي لأغلب المواطنين الذين يعيشون وضعًا متوسطًا، أو دون المتوسط. فقد صوتت نسبة 10% من الناخبين بأوراق ملغاة قانونيًا، ورفض نحو 63% المشاركة في العملية الانتخابية من أساسها. وقد توزّع المقاطعون للانتخابات التشريعية في تركيبتهم بين أحزاب سياسية وناشطي مجتمع مدني وعازفين غير مهتمين من بين جموع المواطنين.
أما حزبيًا، فقد تبنّت هيئة التشاور والمتابعة، المعارِضة، مطلبَ إحداث اللجنة العليا المستقلة للانتخابات، لكنها لم تصدر موقفًا موحدًا بشأن المشاركة من عدمها، وتركت القرار للأحزاب المنضوية تحتها؛ ما جعل أغلبها يقرّر المشاركة، فيما قرّر حزب طلائع الحريات المقاطعة، وأصدر حزب جيل جديد، مع بعض الناشطين المنتمين للهيئة، إعلان "أوفياء مزفران" الذي دعا إلى اعتماد خيار المقاطعة.
وكان "جيل جديد" أول من أعلن مقاطعته الانتخابات؛ بسبب صدور قانون الانتخابات من دون أن يتضمّن استحداث هيئة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات؛ ما اعتبره سببًا كافيًا للدعوة إلى مقاطعة العملية الانتخابية، وعدم إضفاء الشرعية عليها. أما "طلائع الحريات"، بقيادة رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، فقرّر عدم المشاركة، تبعًا لقرار أغلبية أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بعد عملية تقييم لجدوى المشاركة من عدمها؛ فاحتجاج الحزب على قانون الانتخابات، وعلى بقاء صلاحية تنظيم الانتخابات بيد السلطة التنفيذية، وعدم فتح المجال لتأسيس الهيئة العليا المستقلة لتنظيم الانتخابات، كان السبب الأول للمقاطعة. أما السبب الثاني الذي عرضته اللجنة المركزية، فهو "انعدام الجدوى من التنافس على الوصول إلى برلمانٍ فاقد للصلاحيات، وخاضع كليةً لهيمنة السلطة التنفيذية".
الخارطة السياسية والحزبية
تشهد الخارطة السياسية والحزبية الجزائرية تغيراتٍ مهمةً على ملمحها العام، إذ برزت تشكيلاتٌ حزبيةٌ جديدة موالية للسلطة، وهي تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية والتحالف الوطني الجمهوري؛ وهي أحزابٌ متوسطة الحجم، أعلنت انخراطها مع الحزبين التقليديين، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، في مسعى موالاة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
في المقابل، تشكّلت قوى معارضة جديدة، إثر الانتخابات الرئاسية التي جرت في ربيع 2014، والتي اجتمعت لأول مرة في مؤتمر مزفران الأول، ونتج منها تكتل هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة الوطنية، جمع شخصياتٍ سياسيةً بارزة، وأحزاباً قاطعت الرئاسيات، مثل تنسيقية الانتقال الديمقراطي التي تجمع حركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة وحزب جيل جديد والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، كما جمع مشاركين في الرئاسيات، مثل علي بن فليس.
وظلت أحزابٌ، مثل حزب العمال، محافظةً على خطابها العام المهتم بالقضايا الاقتصادية، ولم تعلن ولاءها أو معارضتها السلطة القائمة، واختار حزب جبهة القوى الاشتراكية أسلوب الحوار والخطاب التوافقي بين السلطة والمعارضة، من خلال مشروعه السياسي الحالي الداعي إلى الإجماع الوطني. وبقي حزب جبهة المستقبل، بقيادة عبد العزيز بلعيد، والحاصل على المرتبة الثالثة في الرئاسيات الأخيرة، على نهج خطاب التهدئة وتفادي الصدام بين السلطة والمعارضة. اجتمعت هذه الأحزاب على خطابٍ ينطلق من ضرورة تفادي الوصول إلى ما وصلت إليه سورية وليبيا.
مستوى المشاركة الحزبية
بسبب تطبيق قانون الانتخابات (الصادر في 25 أغسطس/ آب 2016 ) بأثرٍ رجعي، لم يعد ممكنًا لأي حزبٍ المشاركة في الانتخابات، من دون حصوله على نسبة 4% من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات التشريعية السابقة (وهو الشرط الذي يتوفر لدى حزبي الموالاة الرئيسين فقط: جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي)، وإلا فإن على الراغبين في الترشّح جمع 250 توقيعًا مقابل كل مقعدٍ متاح للتنافس في الدائرة الانتخابية محل إقامة المعنيين؛ ما عقّد مهمة الأحزاب الصغيرة، ومنعها من تقديم ترشيحاتها في دوائر انتخابية كثيرة. ولذلك، لم تستطع هذه الأحزاب أن تنافس على جميع المقاعد، إلى أن قرّرت الحكومة منح التحالفات المستحدثة مجموع الأصوات المعبّر عنها التي حصل عليها مجموع أطراف كل تحالف؛ وهو ما مكّنها من المنافسة على أغلبية المقاعد (تحالف حركة مجتمع السلم وتحالف الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء).
سعت الحكومة من هذا القرار إلى جذب أكبر مشاركةٍ حزبيةٍ ممكنةٍ لإنجاح الانتخابات وإعطائها شرعيةً شعبيةً لحاجتها الماسة إلى غطاء دستوري، يضمن لها تمرير خططها الاقتصادية، في ظل ظروفٍ ماديةٍ صعبة، تميّزت بشحّ الموارد والمداخيل، بعد انهيار أسعار النفط في السوق الدولية؛ ما قد يجبرها على التوجه نحو حلولٍ سريعةٍ وغير شعبية، تتمثل أساسًا في رفع أسعار المواد الاستهلاكية وزيادة الضرائب وتوسيع نطاقها. ومع استمرار تدني الوضع الاقتصادي، تجد السلطة السياسية نفسها مجبرةً على التوجه نحو خياراتٍ أكثر قسوةً على الواقع المعيشي للمواطن. وهو ما يتطلب برلمانًا يوافق بأغلبيةٍ مريحةٍ على قانون المالية للعام المقبل 2018، بما قد يفيد ضمان حالة من الهدوء الاجتماعي، حتى نهاية العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
خاتمة
على الرغم من أن نتائج الانتخابات مثلت خيبة أمل للطامحين في تحوّل ديمقراطي حقيقي في الجزائر، بعد إقرار التعديلات الدستورية المهمة عام 2016، حيث كرّست حكم أحزاب السلطة، وأعادت إنتاج التوليفة الحاكمة، فإنّ كثيرين نظروا إليها باعتبارها محطةً في الطريق نحو تسمية خليفة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ومع كثرة الطامحين في الوصول إلى سدة الرئاسة، زادت الانتخابات من حدّة التكهنات. فقد قدّم أحمد أويحيى، مدير ديوان رئيس الجمهورية المُنحّى من منصبه والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي خلال قيادته الحملة الانتخابية البرلمانية، برنامجًا وخطابًا ذا طابعٍ رئاسي. والواضح أنه مرشّح لهذا المنصب. كما قدّم مولود حمروش، رئيس الحكومة الأسبق والمشرف على عملية الإصلاح السياسي في بداية التعدّدية السياسية في الجزائر، خطابًا مطمئنًا للدولة وللجيش، حتى تقبل به لتولي رئاسة الجمهورية فترة انتقالية بتزكيةٍ من المؤسسة العسكرية. ويبقى طموح علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق، والذي انتقل إلى معارضة الرئيس، ونافسه في انتخابات عامي 2004 و2014، كبيرًا للمنافسة على هذا المنصب، خصوصًا مع تحضيراته المستمرة لأي منافسةٍ رئاسيةٍ مقبلة. وتطرح بعض الدوائر في الظل إمكانية تقدّم مستشار الرئيس وشقيقه، السعيد بوتفليقة، لتأدية دورٍ مهمٍ في خلافة شقيقه، بدعم من محيط الرئيس من سياسيين ورجال أعمال بارزين. بهذا المعنى، لم تساعد الانتخابات التشريعية على توضيح الصورة وإظهار الخليفة المحتمل، لكن البرلمان الجديد سيكون له دور مهم في ترجيح كفة الطامحين لخلافة الرئيس؛ أنهى فترته الرئاسية أم لا.