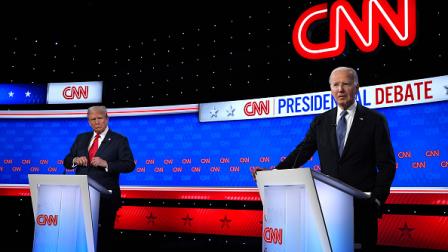لا يزال البيان الصادر عن الجيش السوداني، يوم الأحد الماضي، في خامس أيام الاحتجاجات الشعبية، والذي أعلن، بلا توضيح للدوافع، التفافه حول قيادته السياسية، والتأكيد كذلك على حرصه على الدفاع عن "مكتسبات الشعب، وأمن وسلامة المواطن"، يثير تساؤلات عديدة لدى عطفه على التعاطي الأمني المتفاوت في عنفه مع المتظاهرين والمحتجين، والذي أدى، بعد 6 أيام من انطلاق الحراك الشعبي الغاضب على الوضع الاقتصادي ــ الاجتماعي ــ السياسي، إلى مقتل 37 مدنياً على يد الشرطة، بحسب بيان صدر أمس الثلاثاء عن منظمة العفو الدولية، التي قالت إنها تملك "تقارير موثوقة" تؤكد هذا العدد من الضحايا.
ويبدو أن اجتماع قيادة الجيش والبيان الذي أعقبه جاء بصورة واضحة رداً على الأحاديث التي تناقلتها مجالس السياسة ووسائط تواصل اجتماعي عن دعم تجده الاحتجاجات الشعبية من قبل عدد من قادة الجيش، خصوصاً من الضباط الميدانيين الذي كانوا جزءاً من المنظومة الأمنية التي تتعاطى مع الاحتجاجات. ذلك أنه في أكثر من مشهد احتجاجي نُقل عن متظاهرين قولهم إنهم حصلوا على حماية مباشرة من قوات الجيش المنتشرة في المدن، لدى التعرض لهم بعنف من قبل قوات الشرطة والأمن. وقد حدث ذلك في عطبرة والقضارف مثلاً، حيث ظهر بعض أفراد الجيش يتجاوبون إيجابياً مع المتظاهرين الذين لم يترددوا بالهتاف لهم. وحتى في التظاهرات الليلية التي أعقبت مباراة الهلال والأفريقي التونسي ليل الأحد، ذكر متظاهرون أنهم لجأوا للسلاح الطبي، أحد أفرع الجيش في أم درمان، خوفاً من عناصر الشرطة التي كانت تطاردهم.
كما أن ثمة مداخلات عديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يتم التأكد من صحتها، نسبت إلى ضباط رفيعي المستوى، يعلنون فيها دعمهم للحراك الشعبي، بما فيها صفحات ظهرت باسم أعضاء في هيئة الأركان. وإضافة إلى ذلك، فقد يحرص المحتجون على استقطاب الجيش لدعمهم، وذلك من خلال الهتاف لصالحه، على شاكلة شعارات "جيش واحد شعب" و"الجيش معانا ما همّنا" و"الجيش... الجيش الكيزان (حزب المؤتمر الوطني الحاكم) سرقوا العيش". وفي ظل هذه الصورة التي رُسمت، أو التي حاول البعض رسمها حول الجيش وموقفه من الحراك الاحتجاجي، حرصت قيادة الجيش من خلال بيانها على حسم أمرين، تغيير تلك الصورة، والتأكيد أنها تقف خلف الرئيس عمر البشير، المعني تماماً بهذا البيان، إذ أصبح الشعار الأول للتظاهرات هو تنحيه عن الحكم، علماً أن البشير، بحكم منصبه، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية. كذلك حرص البيان على القول إنه يعمل "ضمن منظومة أمنية واحدة ومتجانسة، القوات المسلحة، وقوات الشرطة الموحدة، وقوات الدعم السريع (الجنجويد)، وقوات جهاز الأمن والاستخبارات الوطني". وجاء هذا التأكيد كما هو واضح، لنفي أي خلاف بين القوات النظامية في التعاطي مع الاحتجاجات الشعبية.
وطبقاً لمعلومات "العربي الجديد"، فإن الجيش السوداني ما زال يفضل خيار البقاء بعيداً عن الأحداث، على الأقل في الوقت الراهن، والاكتفاء بالدور الدفاعي كما حدده الدستور، مع الإبقاء على مهمة الأمن الداخلي في مكانها، في يد قوات الشرطة. وقد أنيط بالقوات المسلحة دور جديد، هو حراسة المؤسسات الحيوية، خشية تعرضها للأضرار كما حدث لبعضها في بعض مدن الحراك الشعبي. وليس بعيداً عن حصر مهمة التعاطي مع الاحتجاجات بالشرطة وحدها، ذهبت قوات الدعم السريع (الجنجويد) في ذات الاتجاه، وهي القوات التي بدأت كقوة غير نظامية (مليشيا) تساند الجيش السوداني في عملياته في دارفور، واتهمت بارتكاب جرائم حرب كبيرة، وتحولت لاحقاً لقوة نظامية وفق قانون خاص يلحقها بالجيش، على أن تكون تحت إمرة رئيس الجمهورية، مع توسع مهامها سواء بمكافحة الهجرة غير الشرعية أو المخدرات والإرهاب. وقد نسب إلى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان (حميدتي) قبل فترة أن قواته لن تعمل في مجال فض المحتجين حتى لو طلب منها ذلك، لأنها ليست مهمتها. واللافت أيضاً أنه، وفي ثاني أيام الاحتجاجات، أصدرت تلك القوات (الجنجويد) بياناً في ذات الاتجاه، أشار إلى أن "البعض" يسعى لأن "يجعل من قواتنا عدواً للمحتجين". وحتى جهاز الأمن نفسه حرص على التأكيد أن مسؤولية فض التظاهرات هي من مهام الشرطة.
وبعيداً عن أدوار القوات الأمنية المختلفة، فإن التعاطي الأمني مع الاحتجاجات يبدو أنه، طبقاً لمراقبين، يحاول الاستفادة من تجربة احتجاجات عام 2013، والتي سقط فيها أكثر من 200 قتيل، وهو رقم تصر عليه المعارضة ومنظمات حكومية وتنفيه الحكومة التي تقر بمقتل 80 شخصاً. وأولى تلك العبر، التي تعمل بموجبها الحكومة، فسح المجال للشرطة، وإلى حد ما للأمن وقوات الدعم السريع، للقيام بمهامها، وإبعاد أي تدخل من جهات غير نظامية مع الشعب للتقليل إلى أقصى حد من عدد الضحايا. أما ثاني العبر فهي عدم استخدام العنف المفرط، لأنه لن يقود إلا إلى مزيد من الاحتقان والغضب، وبالتالي زيادة احتمالات خروج الأمور عن السيطرة.
وبعيداً عن التعامل الأمني، فقد مضت الحكومة إلى تكتيكات أخرى للحد من الاحتجاجات، وأولاها وأهمها إغلاق المدارس الثانوية في كل أنحاء السودان ومعها الجامعات، والتي برزت كمحرك رئيسي لتلك الاحتجاجات. كما حجبت مواقع التواصل الاجتماعي، بنشاطها المعلوم، وفرضت رقابة قبلية بواسطة أفراد من جهاز الأمن على الصحف، وحظرت التجول الليلي في عدد من الولايات، ونشرت قوات كبيرة في المدن، فضلاً عن وضع رسالة سياسة وإعلامية واحدة تعترف بالأزمة الاقتصادية وتقر في الوقت ذاته بحق المواطنين في التعبير السلمي عن عدم رضاهم، مع محاولة تثبيت فكرة وجود "مخربين" بين المتظاهرين، تقف وراءهم "الحركات المتمردة والموساد الإسرائيلي" بحسب الرواية الرسمية التي تجد سخرية واسعة النطاق داخل السودان وخارجه.
ولم تكتف الحكومة بذلك، إذ قامت بحملة اعتقالات واسعة وسط قيادات أحزاب المعارضة، لأنها تدرك أن العفوية والمطلبية تطبع الاحتجاجات وأن المعارضة يمكنها تحويل كل ذلك لصالح أجندة سياسية سقفها إسقاط الحكومة. ورغم القول إن الحكومة تحاول الحد من حجم العنف في التعاطي مع الاحتجاجات، فإن ذلك لم يحدث في أماكن مهمة، خصوصاً في مدينة عطبرة شمال السودان، ذلك أن احتجاجات المدينة كانت بمثابة الشرارة الأولى الحقيقية، ولأن إخمادها في مهدها كان سيعني سد الطريق أمام المدن الأخرى، لكن النتيجة جاءت عكسية، رغم استجابة السلطات لبعض مطالب الأهالي وأهمها توفير الخبز، ما أغرى بقية المدن بالخروج إلى الشوارع، فوصل العدد إلى نحو 20 مدينة، وإن تفاوت حجم الاحتجاج من واحدة إلى أخرى.