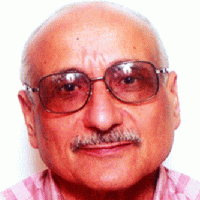06 نوفمبر 2024
الحق في اختيار الموت
عندما خاطب محمد الماغوط بدر شاكر السياب: "تشبث بموتك، أيها المغفل، دافع عنه بالحجارة والأسنان والمخالب، فما الذي تريد بعد أن تراه؟"، كنا يومها نلتصق بالحياة، نحسّ بعنفوانها في أعماقنا، تسكننا آمال التغيير، ونتجرأ على مواجهة خطايا العالم، كأننا موكلون بذلك. كنا ثواراً بالعقل والقلب والضمير، نقيس سوانا باقترابه أو بعده عنا. ولذلك، وجدنا في مقولة الماغوط مسحة تشاؤم واكتئاب، ولم نغفر له نبوءته المثقلة بالهم، حتى سقطنا نحن معه في الهوة نفسها التي صنعها القدر لجيلنا الذي سماه مطاع صفدي "جيل القدر"، في كنايةٍ عن قدرته على صنع التغيير، وإنْ بدت تلك التسمية لنا اليوم كأنها ضرب من السخرية اللاذعة.
ونعرف أن السياب كان يتشبث بالحياة، حتى وهو يعاني من مرضه الذي يجعله يموت في اليوم الواحد مرات، لكنه لم يفكر في الانتحار، أو نشدان الموت، لكي يتخلص من آلامه: "لك الحمد مهما استطال البلاء، ومهما استبد الألم، لك الحمد أن الرزايا عطاء، وأن المصيبات بعض الكرم". كان مثله الذي يتقمصه أيوب الذي مسّه الضر، ونجاه الله لصبره، "اختارت نفسي الموت على عظامي هذه، فقد ذبت، لا إلى الأبد أحيا".
في حينها، كنا ننظر إلى "الحق في الحياة الحرة الكريمة" حقاً غير مشروط ولا مقيد، فيما ننظر إلى "الحق في اختيار الموت" هروباً من مسؤولية صنع التغيير، وحماية الحقوق، وضمان الحرية، ولم يكن حب الموت الذي يجيء ذكره في مأثوراتنا الشعبية سوى تعبير عن إيماننا أن التضحية بالنفس لا يمكن أن تكون إلا دفاعاً عن الأرض والإنسان، ونبحث عبر الموت عن ضمان حياةٍ كريمةٍ لأجيال تأتي بعدنا، وحتى عندما أقدم محمد البوعزيزي في تونس على الانتحار، لأنه فقد الأمل في أن يعيش حراً كريماً، وجد بعضنا في اختياره الموت خروجاً على ما ألفناه، وآمنا به، لكننا عشنا، حتى وجدنا من نسائنا من يطالبننا بكفالة حق اختيار الموت لهن، ليقدمن على الانتحار، لتوقي اغتصابهن من وحوشٍ صبغوا وجوههم الكالحة بدم ضحاياهم. وقبل ذلك، سمعنا صرخة امرأةٍ تلقي بنفسها، وهي تحمل وليدها الغضّ في "الفرات"، بعدما امتنع مليشياويون عن السماح لها بدخول عاصمة بلادها.
نذكر أيضاً "ممرّضة حلب" التي قيل إنها اختارت الانتحار عن سابق إصرار لكي تتفادى الاغتصاب، وظهرت رسالتها على مواقع تواصل، واستفزّت كتاباً ومعلقين عديدين بين ساخطٍ شاجب، وبين مفند ومكذّب. وبين الاثنين برز من يبرّر اغتصاب فتاةٍ أو فتياتٍ على أنه خطيئة فردية، لا تنسحب على الجهة التي ينتسب إليها الفاعل، وآخر قال، إن معظم الجيوش ترتكب مثلها (!)، وإن الحروب "النظيفة" قد لا تخلو من ممارساتٍ كهذه، مطلقاً صفة "النظافة" على حربٍ اندفع إلى تأجيجها نظام دكتاتوري، حكم شعبه بالحديد والنار عقوداً، أودت بحياة الآلاف من الأبرياء، وأعاقت أضعافهم، وهجّرت الملايين، وأوجدت جيشاً من المرضى والجوعى والمقعدين.
هنا، لا نبرّر للانتفاضة الشعبية ضد نظام دمشق أخطاءها القاتلة، من قبيل "عسكرتها"، أو القبول بوصاية أطرافٍ خارجية عليها، أو الصمت عن اختراقها من عناصر متطرفة، أو شرذمتها في أكثر من مائة فصيل وفصيل، ما أعطى الديكتاتور فرصة الانقضاض عليها، وتجريدها حتى من بعض مقومات وجودها وقدراتها وقاعدتها الشعبية. هنا أيضاً ندعوها إلى أن تراجع نفسها، وتمارس نقداً ذاتياً لأخطائها، لكي تتعلم من تجربتها.
لا نجد ما نقوله أكثر من ذلك، لكن فظاعة ما يجري من حولنا يبقي سؤال الحق في اختيار الموت عندنا مفتوحاً، والسجال لم ينته بعد، وإذا كانت المراجع الطبية قد وضعت شروطاً للموت الرحيم. وإذا كان بعض فلاسفة ومفكرين، في أزمان سابقة، قد طرحوا فكرة الإباحة، ومنهم أفلاطون الذي قال "هناك أناس يجب أن يُتركوا للموت"، وبيكون الذي نظّر لما سماه "الموت الهادئ"، فإن حروبنا الماثلة وشناعاتها تعيد طرح السؤال الكبير نفسه: هل يمكن أن نقر الحق في اختيار الموت، في ظل ما نقاسيه من مظالم وشرور، مع أن كل الرسالات تعلمنا أن "الحق في اختيار الموت إلهي محض، لأن الله سبحانه هو واهب الحياة، وهو الذي يسترجعها متى شاء"؟
ونعرف أن السياب كان يتشبث بالحياة، حتى وهو يعاني من مرضه الذي يجعله يموت في اليوم الواحد مرات، لكنه لم يفكر في الانتحار، أو نشدان الموت، لكي يتخلص من آلامه: "لك الحمد مهما استطال البلاء، ومهما استبد الألم، لك الحمد أن الرزايا عطاء، وأن المصيبات بعض الكرم". كان مثله الذي يتقمصه أيوب الذي مسّه الضر، ونجاه الله لصبره، "اختارت نفسي الموت على عظامي هذه، فقد ذبت، لا إلى الأبد أحيا".
في حينها، كنا ننظر إلى "الحق في الحياة الحرة الكريمة" حقاً غير مشروط ولا مقيد، فيما ننظر إلى "الحق في اختيار الموت" هروباً من مسؤولية صنع التغيير، وحماية الحقوق، وضمان الحرية، ولم يكن حب الموت الذي يجيء ذكره في مأثوراتنا الشعبية سوى تعبير عن إيماننا أن التضحية بالنفس لا يمكن أن تكون إلا دفاعاً عن الأرض والإنسان، ونبحث عبر الموت عن ضمان حياةٍ كريمةٍ لأجيال تأتي بعدنا، وحتى عندما أقدم محمد البوعزيزي في تونس على الانتحار، لأنه فقد الأمل في أن يعيش حراً كريماً، وجد بعضنا في اختياره الموت خروجاً على ما ألفناه، وآمنا به، لكننا عشنا، حتى وجدنا من نسائنا من يطالبننا بكفالة حق اختيار الموت لهن، ليقدمن على الانتحار، لتوقي اغتصابهن من وحوشٍ صبغوا وجوههم الكالحة بدم ضحاياهم. وقبل ذلك، سمعنا صرخة امرأةٍ تلقي بنفسها، وهي تحمل وليدها الغضّ في "الفرات"، بعدما امتنع مليشياويون عن السماح لها بدخول عاصمة بلادها.
نذكر أيضاً "ممرّضة حلب" التي قيل إنها اختارت الانتحار عن سابق إصرار لكي تتفادى الاغتصاب، وظهرت رسالتها على مواقع تواصل، واستفزّت كتاباً ومعلقين عديدين بين ساخطٍ شاجب، وبين مفند ومكذّب. وبين الاثنين برز من يبرّر اغتصاب فتاةٍ أو فتياتٍ على أنه خطيئة فردية، لا تنسحب على الجهة التي ينتسب إليها الفاعل، وآخر قال، إن معظم الجيوش ترتكب مثلها (!)، وإن الحروب "النظيفة" قد لا تخلو من ممارساتٍ كهذه، مطلقاً صفة "النظافة" على حربٍ اندفع إلى تأجيجها نظام دكتاتوري، حكم شعبه بالحديد والنار عقوداً، أودت بحياة الآلاف من الأبرياء، وأعاقت أضعافهم، وهجّرت الملايين، وأوجدت جيشاً من المرضى والجوعى والمقعدين.
هنا، لا نبرّر للانتفاضة الشعبية ضد نظام دمشق أخطاءها القاتلة، من قبيل "عسكرتها"، أو القبول بوصاية أطرافٍ خارجية عليها، أو الصمت عن اختراقها من عناصر متطرفة، أو شرذمتها في أكثر من مائة فصيل وفصيل، ما أعطى الديكتاتور فرصة الانقضاض عليها، وتجريدها حتى من بعض مقومات وجودها وقدراتها وقاعدتها الشعبية. هنا أيضاً ندعوها إلى أن تراجع نفسها، وتمارس نقداً ذاتياً لأخطائها، لكي تتعلم من تجربتها.
لا نجد ما نقوله أكثر من ذلك، لكن فظاعة ما يجري من حولنا يبقي سؤال الحق في اختيار الموت عندنا مفتوحاً، والسجال لم ينته بعد، وإذا كانت المراجع الطبية قد وضعت شروطاً للموت الرحيم. وإذا كان بعض فلاسفة ومفكرين، في أزمان سابقة، قد طرحوا فكرة الإباحة، ومنهم أفلاطون الذي قال "هناك أناس يجب أن يُتركوا للموت"، وبيكون الذي نظّر لما سماه "الموت الهادئ"، فإن حروبنا الماثلة وشناعاتها تعيد طرح السؤال الكبير نفسه: هل يمكن أن نقر الحق في اختيار الموت، في ظل ما نقاسيه من مظالم وشرور، مع أن كل الرسالات تعلمنا أن "الحق في اختيار الموت إلهي محض، لأن الله سبحانه هو واهب الحياة، وهو الذي يسترجعها متى شاء"؟