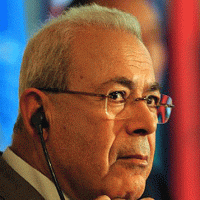الدمار ليس الخيار الوحيد لمستقبل الشرق الأوسط
وبرز بشكل واضح أيضا عندما دفنت هذه القوى نفسها حلم المملكة العربية الواحدة التي نادى بها العرب، أو بالأحرى الشريف حسين، ممثلا لتحالف الأرستقراطية القبلية والدينية الحجازية مع البرجوازية التجارية الجديدة الصاعدة في سورية الطبيعية، أو بلاد الشام، في بدايات القرن العشرين، ففرض على أصحاب هذا المشروع العربي الذي لم يكن له منافس في ذلك الوقت، مشروع سايكس بيكو الذي جزّأ سورية الطبيعية ذاتها إلى دويلاتٍ صغيرة، لا تملك وسائل تأسيس دول، ولا الارتقاء بدورها والوفاء بالتزاماتها.
وكان من المفترض أن تخضع المناطق الأخرى المشرقية للمصير ذاته، لو لم يسعفها الحظ بوجود موارد قوة مهمة وقيادة سياسية قوية، نجحت في وأد التدخل الغربي، كما حصل في تركيا التي تحول بمناسبتها كمال أتاتورك إلى أسطورة، ولقب أتاتورك (أبو الأتراك)، أو دعوة عصبية قبلية وثورة دينية عميقة الجذور في بقاع نجد الواسعة حسمت الأمر لصالحها، وفرضت على الغرب التعاون معها، كما حصل في الجزيرة العربية من خلال تحالف السعوديين والحركة الوهابية.
وهذا ما حصل أيضا لمشروع الوحدة العربية الذي قاده في الخمسينيات والستينيات من القرن ذاته الزعيم القومي جمال عبد الناصر الذي تمتع بشعبيةٍ لا تُجارى في كل بلدان المشرق، فقد نظر إليه الغرب بسبب نزعته التوحيدية أنه هتلر العصر، وعامله باعتباره عدواً له، ينبغي بكل الوسائل إسقاطه، ولم يهدأ باله، قبل أن يحقق هدفه بالفعل، وينهي حلم الاتحاد العربي الذي رمز إليه. كان هذا هدف العدوان الثلاثي الإسرائيلي البريطاني الفرنسي في 1956، ولم ينجح الرئيس المصري في تجاوز نتائجه العسكرية إلا بما تمتع به من قاعدة شعبية وقوة خطابية على مستوى البلاد العربية، بالإضافة إلى استفادته من موقف واشنطن المستقل، في ذلك الوقت، عن موقف القوى الأوروبية الاستعمارية الآفلة. واستمر الغرب بعد ذلك، بما فيه واشنطن، في تعقب أخطائه، في اليمن وفي إدارة الإقليم السوري، حتى نجح في تفكيك الوحدة السورية المصرية من جديد، مستخدماً نقمة القوى الاجتماعية المحافظة الانفصالية في المرحلة الأولى، ثم قوى اليسار البعثية والشيوعية المزاودة على الناصرية، والمدعومة غربياً، بهدف تقويض الدعوة القومية العربية الشعبية من الداخل، إلى أن أمكن إسقاطها سياسياً في حرب عام 1967 وهزيمة الناصرية وتفويض حكم سورية إلى سلطة عسكرية انفصالية طفولية، قبل
تكرّرت العملية ذاتها في مواجهة مشروع صدام حسين والبعث العراقي الذي حاول أن يوظف ثروات العراق الهائلة في مشروع إقامة مركز اقليمي للتقدم العلمي والتقني، يمكن أن يشكل، كما فعلت بروسيا بيسمارك في ألمانيا التاسع عشر، نقطة جذب للبلدان الأخرى. ولم تكتف الدول الغربية بسحق الجيوش العراقية، ولكنها قوّضت الدولة ذاتها، وحلت مؤسساتها جميعاً، بما فيها الثقافية، لتجعلها قاعاً صفصفاً، وتمزّقها أشلاء، كما يمزق الوحش المفترس فريسته. كما لم يخف قادة الحملة على العراق هدفهم من تحطيم العراق حتى لا يكون قطب جذب للدول العربية، وهو ما صرح به رئيس المفوضية الأوروبية، جاك دولور، في ذلك الوقت، ولا طمعهم في السطو على ثرواته المادية، مما لا يستحي من التذكير به الرئيس الأميركي الحالي، دونالد ترامب، بمناسبة ومن دون مناسبة، فكانت الحرب التي أعلنت على العراق مختلفةً عن
قد تعتقد القيادة الإيرانية التي تسمم نفسها بالأيديولوجيا الدينية أن الوضع مختلفٌ بالنسبة لها، وأن ما عجز عنه الأولون تستطيع هي أن تحققه بفضل ما تمثله من قوة استثنائية مادية وعسكرية وروحية، ووشائج القربى الثقافية والسياسية التي كانت تجمعها، كما تعتقد، مع الغربيين خلال زمن طويل، والدور الذي يمكن أن تلعبه في محاصرة بلدان المشرق العربي وتركيا والمشاركة في تنفيذ الخطط الغربية أيضا، وكذلك بسبب انعدام أسباب العداء القومي الذي يشعر به العرب تجاه إسرائيل، واستعدادها للتعامل معها، والتعاون لدرء مخاطر الهجومات العربية الراهنة المتجسّدة فيما يسمونه "الإرهاب السني"، والقادمة المحتملة بسبب تنامي قدرات الشعوب العربية. وقد نظر الغرب بالفعل إلى إيران، منذ القديم، بعيون إيجابية وميزها عن العرب، وقارن الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، في أثناء ولايته السياسية بين سلوك إيران واستراتيجيتها "العقلانية" التي يمكن المراهنة على التعامل معها في مقابل انعدام العقلانية والاتساق في ردود العرب وسياساتهم، وأمل بالفعل أن يجعل منها بتوقيعه الاتفاقية النووية شريكا في ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، في مواجهة الأزمة العميقة التي تعيشها دول المشرق العربي. وتراهن طهران أيضا على ما تملكه من قوة نفوذ وموارد
ولكن إذا كان من الصحيح أن الغرب حريصٌ على أن يستخدم الصراع العربي الفارسي لاستهلاك طاقة الشعوب المشرقية وإضعافها جميعا للاستمرار في السيطرة على مقدّراتها
2)
ولكن في الوقت نفسه، لن تستطيع الولايات المتحدة أن تقضي على نفوذ إيران، وتحرمها من وزنها الاستراتيجي، مهما فعلت أيضا. وإذا لم يكن من الصعب عليها سحقها من الناحية العسكرية فإن احتواء آثار هذا السحق ستكون وبالا على المنطقة، وسوف تتحمل، هي وحلفاؤها، جزءا من هذه النتائج، أيضا. وقد خسرت واشنطن جميع الحروب التي خاضتها، وكان لها السبق العسكري فيها، إنما من دون أي مشروع سياسي بديل، كما حصل في فيتنام وأفغانستان وفي العراق ليس من زمن بعيد. بل ليس من المبالغة القول إن إيران الاشكالية التي تسعى الولايات المتحدة اليوم إلى درء مخاطر توسعها وتطلعاتها العسكرية هي النتاج المباشر لسياسات العزل والحصار والاحتواء الأميركية التي اتبعتها واشنطن منذ الثورة الإيرانية، وفي المحصلة لسياسات ايران التوسعية التي تحاول أن تفكّ العزلة المفروضة عليها بتهديد المصالح الأميركية المتجسدة في ضمان الأمن والاستقرار في المشرق، حفاظا على تفوق إسرائيل والتحكم بسوق النفط وسياساتها، والحيلولة دون قيام أي تحالف سياسي، أو حتى تعاون اقتصادي يخرج بلدان المنطقة من الدوران في حلقة التخلف المفرغة.
ولذلك لن يكون هناك حل للمشكلة الإيرانية من دون حل شامل للمسألة المشرقية بأكملها، وهي
المشكلة التي نجمت عن تضافر ثلاثة إخفاقات تاريخية لمجتمعاتها، ليست هي ذاتها مستقلةً عن خيارات السياسة والاستراتيجية الغربية: حماية البلاد من الاعتداءات الأجنبية والحفاظ على الأمن والسلامة الوطنيين. بناء دولة القانون والمواطنة وتلبية تطلع الأفراد إلى المشاركة في الحياة السياسية وتحمل قسطهم من المسؤولية في إدارة بلدانهم ودولهم. التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاج إليها جميع المجتمعات لإيجاد فرص العمل، وإدماج الشباب في مجتمعاتهم، وبالتالي ضمان السلام الأهلي والحد من استخدام العنف، واللجوء إلى الحكومات العسكرية والأحكام العرفية. ونتيجة هذه الإخفاقات التاريخية الثلاث، أصبحت اليوم واضحة ومعروفة، وهي الحرب الدائمة الأهلية والإقليمية، والعجز عن بناء استراتيجية وطنية ناجعة اقتصادية، وأمنية، واستمرار الاعتماد على الغرب، والمراهنة على حمايته الخارجية بالنسبة لمعظم الدول القائمة، وانتشار نظم الاستبداد والحكم بالقوة والقهر والإرهاب، وتخليدها في بيئةٍ تزداد فقرا سياسيا باضطراد. وأخيرا سيطرة نمط من اقتصاد الريع والتوزيع والاستهلاك وتصدير الرساميل إلى الخارج، بدل بناء اقتصاد الإنتاج المولد لفرص العمل، وطبقة اجتماعية سائدة وحاكمة يحرّكها التنافس على جمع الثروة وتبذيرها، من دون أي اعتبار لحاجات السكان الاقتصادية والاجتماعية، وأحوالهم وحقوقهم السياسية والمدنية.
ليس من الممكن ترك إيران تتابع سياسة تفكيك المنطقة، وتدمير شروط وجودها السياسية والاقتصادية، لتحول شبابها إلى بيادق في مليشيات بدائية، تعيش على الكفاف في حروبٍ قرسطية وحشية، ولا نهاية لها، وتقويض الدولة وحكم القانون. ولكن الحل لا يأتي، ولن يأتي من التدمير المنظم لأي قوة صاعدة، وتكسير قوائم البلدان القائمة، واحدتها بعد الأخرى، وتحويل المشرق إلى مجتمعات معاقة وعاجزة وغير قادرة على القيام بأود أبنائها. والاستمرار في هذه الاستراتيجية سوف يجعل من منطقةٍ تحوي أكثر من نصف مليار من البشر مستنقعا آسنا صالحا لإنتاج جميع الوحوش والأفاعي والحشرات الضارّة لشعوب المنطقة، وشعوب العالم أجمع. وترك المنطقة لنفسها بعد أن دمرت جميع عناصر تفاهمها وثقتها المتبادلة، أو إدارتها بالحروب والنزاعات، لاستنفاذ طاقاتها وتحييدها على أمل الاحتفاظ بالسيطرة المباشرة عليها، سواء كان السبب السعي وراء مصالح استراتيجية أو الخوف من الارهاب أو عدم الثقة بالاسلام أو تثبيت اللاجئين المحتملين في أرضهم، او محاصرة الشعوب التي انحلت عقدتها وتفكّكت
وتشتت شملها، واحتواء غليانها بالطرق البدائية والنظم الارهابية، لن ينتج سوى المزيد من التدهور في شروط الحياة المدنية والاجتماعية، ومن ورائه المزيد من التطرف والعنف والإرهاب.
ما ينقذ المنطقة ويخرجها من هذا الانحدار نحو الهمجية هو وضع حد لاستراتيجية الفوضى المنظمة التي قامت عليها السياسات الغربية تجاه المنطقة منذ القرن التاسع عشر، والتي أرادت تحطيم كل تعاونٍ بين شعوب المنطقة، بل داخل هذه الشعوب ذاتها، وعزلها واحدتها عن الأخرى واستعداء هؤلاء ضد أولئك، والحيلولة دون أي تفاهم على أي صعيدٍ كان، في سبيل منع ظهور قوة استراتيجية مكان السلطنة العثمانية المتهاوية، تشارك الغرب في سيطرته على المتوسط، وتسمح للمنطقة التي لا تبعد سوى مئات الكيلومترات عن أوروبا أن تعيد توحيد نفسها، وبث الاتساق والانسجام فيما بين شعوبها، وإقامة علاقات تعاون وتبادل للخبرات والكوادر. والنتيجة ما نشهده اليوم: تعميم الحروب وتدهور الاقتصاد في كل مكان، واعتماد المجتمعات في وجودها وتأمين شروط معيشتها على الموارد الريعية النفطية وغيرها، والحرمان من ولوج الثورة الصناعية والتقنية، أي التخلف المركب والبنيوي الذي يهدّد بأوخم العواقب على شعوب المنطقة والعالم.
لم يكن هذا التطور أمرا عفويا ولا طبيعيا، ولا هو نبع من الثقافة أو الدين، ولا حتى من السياسات الفاشلة والفاسدة التي اتبعتها النخب الحاكمة، ولكنه كان بشكل رئيسي نتيجة استراتيجية قديمة ومستمرة منذ عقود طويلة، تبنّتها النخب الغربية وتداولتها، واحدتها بعد الأخرى، منذ انهيار السلطنة العثمانية، ونظرت من خلالها إلى منطقة المشرق وشمال أفريقيا باعتبارها منطقة مخاطر وعداوة تاريخية، ينبغي نزع سيادتها عنها، وإخضاعها لمعالجة طويلة المدى، تقوم على تفجير تناقضاتها والتلاعب بها وتقسيمها ونزع روح السيادة عنها، وإعدام أي نزعة حرية أو تحرّر عند الأفراد فيها، حتى يستسلموا لمصيرهم، ويقبلوا بأن يسلم قادتهم أيضا سيادتهم للقوى الحامية والوصية.
والترجمة الحقيقية لهذه الفوضى المنظمة هي إخراج المنطقة وشعوبها ودولها من دائرة الاتفاقات الدولية، وبناء علاقاتها فيما بينها على أساس القوة والتبعية والعصبية والقرابة أو العداوة، أي على أسسٍ لا علاقة لها بالأسس القانونية التي تضمنها الاتفاقات والمواثيق الدولية، والتي تحكم العلاقات بين الدول عموما على مستوى المعمورة. هنا في المشرق والشرق الأوسط، لا توجد قوانين ولا قواعد ولا برتوكولات ولا عهود ولا اتفقات تضبط سلوك الأطراف، أو تستند إليها لحسم خلافاتها وتنظيم معاملاتها الخاصة والعامة. إرادة الأشخاص والأسر والعشائر والنخب الحاكمة هي القانون، وأهواؤها هي المرجعية الحاكمة وسند القرار. لا توجد سياسة إقليمية تضبط سلوك الدول تجاه بعضها، على أساس مواثيق أو معاهدات، كما لا توجد سياسة وطنية تنظم شؤون الأفراد في علاقتهم بالسلطة وبمؤسساتها على أساس القانون، ولا توجد حتى سلطات محلية تملك الحد الأدنى من المشروعية والالتزام للقيام بواجبات تقديم الخدمات العمومية. هذه هي منطقة الفراغ القانوني والسياسي والأخلاقي التي
الذي يطمح فيها كل صاحب قوةٍ إلى تحقيق أهدافه وتطلعاته ب"ذراعه"، وحنكته وقدرته على الاحتيال والانتهاز للفرص، شخصا كان أو مجموعة أو حكومة. ولا مرجعية موحدة تنظم سلوك أحد، وتضمن الحد الأدنى من الاتساق في الحركة العامة للمجتمعات والدول والجماعات.
لن يخرج الشرق الأوسط من محنته تدمير بلدان المنطقة، واحدة بعد الأخرى، كما جرت عليه العادة، ولا تقويض قدراتها السياسية والعسكرية، وحرمان مجتمعاتها من أي تقدّم سياسي وتقني، وإعادة شعوبها إلى عصر ما قبل الثورة الصناعية. بالعكس، كلما تدهورت شروط حياة هذه المجتعات الاقتصادية والسياسية ضعفت نوابضها الأخلاقية والمدنية، وتفاقم نزوعها إلى إنتاج السلوكات العنيفة والشاذة. لن ينقذ المنطقة، ويحمي المجتمعات الغربية "المتمدنة" من انفجاراتها الداخلية سوى فتح آفاق التقدّم أمامها جميعا، حتى تتمكّن من إنجاز المهام المنوط بكل دولة حديثة مستقرّة، ومرضية لشعبها إنجازها، من تقدّم اقتصادي وتحرّر سياسي وتطور ثقافي وعلمي، أي كل ما حالت السياسات الاستعمارية دونه. ولن يكون ذلك ممكنا مع الاستمرار في إضعاف المنطقة وتفكيكها وتقسيمها، ورعاية نزاعاتها، وتعميق خلافاتها وقتل روح السيادة لدى شعوبها ودولها، وقدرتها بالتالي على عقد اتفاقاتٍ وبناء توافقاتٍ ومعاهدات، وعلى احترامها أيضا. ولا مع الاستمرار في توجيه بلدانها بعضها ضد بعض، واستنزاف طاقاتها في الحروب والنزاعات وحرمانها من أفضليات التعاون والاستفادة من تكامل أسواقها، وتوفير شروط أفضل لتبادل السلع والخدمات المقارنة، وتكوين سوق شرق أوسطية توفر للأجيال الجديدة الفرص التي لا تزال تفتقدها منذ عقود، لتثمير مواهبها وإظهار قدراتها وتحمل مسؤولياتها. وفي هذه الحالة، لن يكون الطلب الرئيس كما هو قائم اليوم في هذه المجتمعات على المليشيات والحشود وتجار الدين والحروب المقدّسة، وإنما على العلماء والتقنيين المتقدّمين والفنانين والمثقفين العضويين والمتنورين.
لا يمكن قلب اتجاه التاريخ، والتحول من بيئة مشرقية منتجة للنزاعات والحروب، ومنشغلة بإعداد المقاتلين والمبشرين الدينيين والمشعوذين، وإرساء حقبة من الاستقرار تفتح أبواب التعاون بين شعوب المنطقة، وتبسط السلام، وتعزّز روح الألفة بين الجميع، من خلال الاعتقاد بإمكانية الاستمرار في فرض الوصاية على الشعوب، أو تقييد حرياتها، أو ضبطها من الخارج عن طريق دعم طغاة دمويين يحكمونها بالحديد والنار، ولن يكون ذلك ممكنا إلى الأبد، ولا من خلال حشد الشباب المهمّشين والمحرومين من أي مستقبلٍ أو أمل أو رجاء وراء حلم استعادة "الامبرطورية" الإسلامية أو القومية، ودولتها القوية والتضحية بالشعوب الصغيرة والضعيفة واستملاك مواردها ونهبها وتهجير سكانها. ولن يكون لذلك سوى نتيجة واحدة، تعميم الدمار والخراب وتهجير القسم الأكثر ديناميكية من سكان المنطقة وشبابها، وفي مقدمتهم كوادرها وعلمائها ومثقفيها، كما هو واضح اليوم في سورية والعراق واليمن وليبيا.
ليس هناك سوى حل واحد، أن توضع تحت سقف المواثيق والاتفاقات الدولية، وتساعد على إحلال فكرة الخضوع للقانون محل الإرادات الشخصية والخاصة التي يسعى كل فردٍ أو طرفٍ إلى فرضها على الآخرين، بوسائل عنفية أو بحيل سياسية ودينية. والعمل على وضع عهد إقليمي يكون بدايةً للاعتراف المتبادل لجميع الدول بسيادتها على أراضيها، وتحريم التوسع بالقوة وعقد العزم على محاربته، وإيجاد الحلول للنزاعات القائمة من خلال مرجعية مواثيق الأمم المتحدة، ووفقا لقراراتها. أي إعادة المنطقة إلى دائرة الشرعية الدولية التي أخرجت منها، لتتحول إلى منطقة سائبة، لا تخضع علاقات الدول والشعوب فيها لأي قانون سوى قانون القوة، ولا تحترم فيها النظم والسلطات أي حقوق أو مواثيق إنسانية تجاه شعوبها. وهي الحالة التي تعكس استمرار السياسات الاستعمارية التقليدية بطرائق أخرى، والتي تستفيد منها القوى الدولية، من أجل العمل خارج إطار القانون الدولي، للاحتفاظ بمصالح خاصة استثنائية، أو لا تتفق مع القوانين الدولية، وكان الفعل الاستعماري نفسه المثال الأبرز لها.
وأعتقد أن البداية للخروج من حالة الهمجية الإقليمية التي دمرت بلدان المنطقة، ودمرت ثقة شعوبها ومستقبله، هو مبادرة حكماء المنطقة، وبعض ممثلي قواها الديمقراطية والمدنية في إقامة "منتدى الشرق الأوسط"، لتعميق الحوار وتداول الرأي والتفكير الجماعي والمشترك في قضايا الأمن والسلام والتعاون، وحل النزاعات بين شعوب المنطقة وجماعاتها القومية والدينية المختلفة. على أمل أن يقود ذلك، في مرحلةٍ تالية، إلى عقد مؤتمر شعوب المشرق للتعاون في إعادة إحياء معنى القانون الدولي والسياسي، وإخراج المنطقة من حالة التسيب القانوني والأخلاقي والسياسي التي تعيشها اليوم، والتي تشجع أي مغامرٍ على وضع وجود الشعوب ومستقبله على كف أهوائه العنيفة والمتضاربة. والهدف الرئيسي لهذا المؤتمر مساعدة الشعوب على التعرّف على بعضها، وإبراز الاعتراف المتبادل بحقوقها وسيادتها على أرضها، وحق كل منها بإدارة شؤونها بشكلٍ مستقل، وفي إطار الالتزام بمبادئ الديمقراطية والمساواة والانتخابات النزيهة العامة.
هذا هو الذي المناخ والإطار الجيوسياسي والسياسي والقانوني الذي يمكن أن يجلب الهدوء والاستقرار والأمان والازدهار والتعاون إلى الشرق الأوسط، ويخرجه من الحروب والنزاعات الداخلية والإقليمية المستمرة منذ عقود. وغير ذلك من الحلول يعني أننا مقبلون على كارثة بيئية وإنسانية، لا تستطيع أوروبا ولا الولايات المتحدة، ولا أي قوى أخرى، احتواء نتائجها عندما ستنفجر في الوقت نفسه القنبلة الاجتماعية والقنبلة القومية والقنبلة الدينية، سواء حصل ذلك في ثيابٍ دينيةٍ ومذهبية، أو في ثياب قومية عنصرية، حيث لا يبقى للجماعات خيار آخر لتأمين ما تعتقد أنه الحد الأدنى من حقها في الحياة سوى نهب الجماعات الأضعف، وافتراسها، أو تشتيت شملها وتدميرها لوراثة مصالحها وممتلكاتها. وفي هذه الحالة، سوف نكون قد دخلنا، إن لم نفعل بعد، في عصر الإبادات الجماعية، وفقدنا أي قدرة على الحفاظ على الحد الأدنى من قيم المدنية والإنسانية الجامعة.