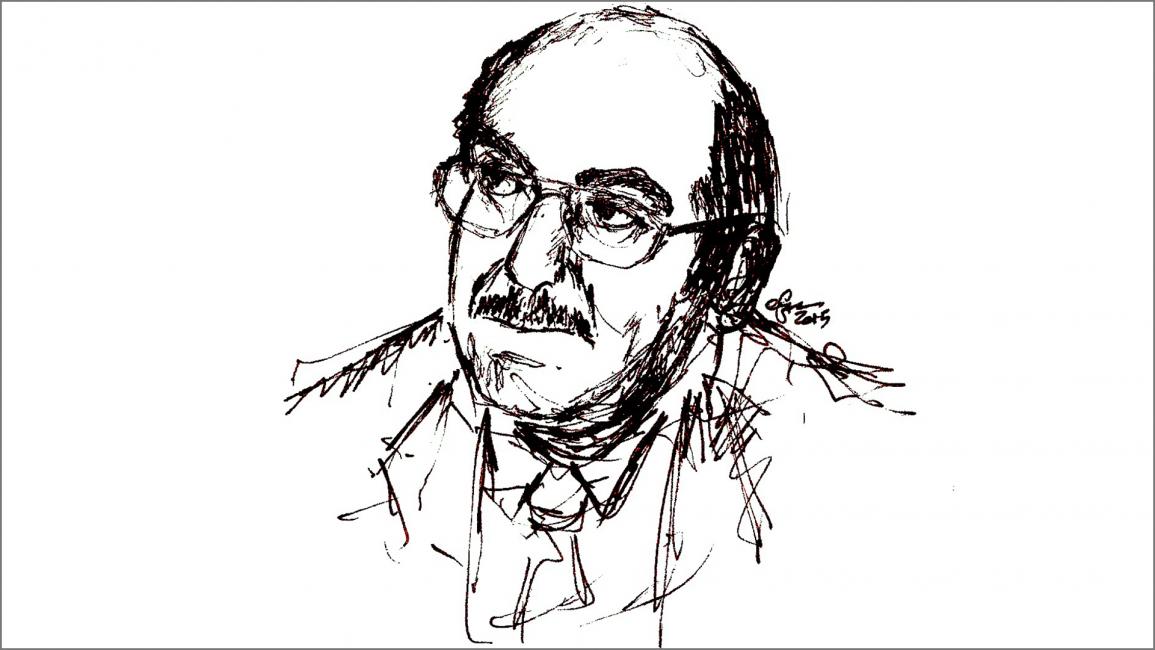23 اغسطس 2024
العرب والعلمانية الوظيفية
الجابري: الأدب والتراث الفارسي مصدر الطاعة السياسية
لم تشهد العلمانية كسياق سياسي انتكاسة كبيرة، كما شهدتها في واقعنا العربي، على مدى أزيد من نصف قرن. ولم تكن هذه الانتكاسة التي منيت بها العلمانية نتيجة قصورها، كمنظومة أفكار تحاول الإجابة على جملة تساؤلاتٍ دنيويةٍ في ما يتعلق بحقوق الناس، وواجباتهم الحياتية تجاه المجتمع، وتجاه السلطة الحاكمة له والعكس، وإنما لأن هذه العلمانية لم تكن استجابةً طبيعيةً لمشكلةٍ قائمة تعيق تقدم المجتمع ونهوضه، بقدر ما كانت استنساخا غير موضوعي لواقعٍ غير واقعها، ومشكلة غير مشكلتها التي نشأت من أجلها.
صحيح أن الفكرة العلمانية ليست صورة واحدة بقدر تعدّدها، وتعدّد أشكالها وصورها، بتعدّد المجتمعات، واختلاف مشكلاتها وثقافتها التي نشأت بها، فنلاحظ اختلافاً وفرقاً كبيراً بين العلمانية البريطانية والفرنسية على سبيل المثال، والعلمانية الغربية عموماً عن العلمانية الشرقية الآسيوية، إلا أن العلمانية في الحالة العربية كانت صورةً واحدةً، ونسخة متشابهةً مع بعضها بعضاً، علمانية تهدف إلى محاربة تدين المجتمع، وتصادم عاداته وتقاليده وثقافته التي ورثها قروناً، أي كانت أقرب إلى علمانية وظيفية، لا سياق ثقافي واجتماعي، فرضته المشكلات القائمة.
أما العلمانية في سياقها الغربي تحديدا فكانت استجابة موضوعية حقيقية لأزمة بنيوية، تعيق المجتمع ونهضته وتقدّمه، بفعل السلطة الدينية الكنسية المحتكرة كل شيء، وفي مقدمتها احتكارها للسلطة السياسية والاقتصاد في المجتمع الذي بقيت دُولة بين أباطرة الملك وسدنة الكنيسة، فيما بقى الشعب كله سخرةً لا حقوق له، في مقابل واجباتٍ كبيرة يؤديها.
ليس هناك مشكلة بنيوية في الحالة الإسلامية بين الدين والدولة، بين السلطة الحاكمة والسلطة الدينية التي تعتبر شبه مستقلة، في الحالة الإسلامية السنية تحديدا، لكن هذه الاستقلالية لم تستمر طويلا، مع تحوّلات المجتمع وتطورات السياسة، حيث سعى ربّان السياسة عبر التاريخ إلى تسخير السلطة الدينية، واستخدامها في معركة الحكم مع الخصوم، إلى درجةٍ أن أملت السلطة الحاكمة نصا مأزوما وافترائيا واضحا، في ما يتعلق بجواز المتغلب (أي "الانقلابي") وأحقيته بلغة هذه اللحظة السياسية، وأحقيته في الحكم والطاعة.
لم تكن هذه اللوثة الإفتائية موجودة في القرن الهجري الأول، في صلب الفكرة الإسلامية الأولى
التي كانت تعلي من قيمة المعارضة الفاعلة لتغولات الحاكم وسلطته، وظلمها الناس، وكان النص الديني للواقع التاريخي واضحاً في التعاطي مع إشكالية كهذه، والتي بلورت سلطة النص وسلطة الواقع، استجابة واضحة لمواجهة الخلل في واجبات الحاكم ووظائفه بالخروج عليه مبكّراً في التاريخ الإسلامي، كما مثلت فكرة الخروج على الخليفة الثالث عثمان أولى تطبيقات هذه الروح المعارضة لسطوة الحاكم، وتغولات سلطته.
بالعودة إلى قراءة دقيقة لمصادر هذه اللوثة الاستبدادية التي تدفقت على التراث الإسلامي، يقول المفكر محمد عابد الجابري إن لوثة الأحكام السلطانية والطاعة السياسية التي أصابت الفكر والثقافة الإسلامية كان مصدرها الأدب والتراث الفارسي الذي نقله حرفيا، وبطريقةٍ غاية في الذكاء، الأديب ذي الأصول الفارسية، عبد الله بن المقفع، والذي مثل جسر عبور لترسبات الاستبداد السياسي الفارسي إلى التراث الإسلامي.
كي لا نتوه بعيداً، عن مضمون هذا المقال بشأن السؤال عن أسباب فشل الفكرة العلمانية عربياً، ونجاحها في كل السياقات الثقافية الأخرى، وهو سؤالٌ يتطلب قراءة عميقة ودقيقة، حتى لا تتحول الانطباعات إلى حقائق غير قابلة للجدل، بالنظر إلى التجربة والمحاولة الطويلة للعلمانية في المشهد العربي على مدى أزيد من نصف قرن، لكنها كلها كانت تبوء بالفشل السريع، فالتجربة العلمانية، ومحاولاتها في السياق العربي، والتي باءت بالفشل الذريع، كانت تجربةً تستدعي مزيداً من البحث والدراسة والتقصّي، للأسباب التي وقفت أمام نجاح هذه التجربة التي كتب لها النجاح، في بلدانٍ كثيرة، إلا في العالم العربي الذي شهد عدة تجارب من تجربة القومية العربية "العلمانية"، بشقيها البعثي والناصري، وكل تجارب القمع الثقافي، كالتجربة اليسارية الاشتراكية وغيرها، والتي ارتكزت كلها حول مواجهة مع المجتمع ومصادمته بدرجة رئيسية.
ولمّا لم تكن العلمانية في السياق العربي استجابةً علميةً وثقافيةً، لعدم وجود ذلك الإشكال الذي يبحث عن حلٍّ له، وإنما كانت مطلباً خارجياً تحمله نخبةٌ ممن تعيش مرحلة قطيعةٍ مع مجتمعها أولا، وثقافتها ودينها ثانيا. وبالتالي، كانت العلمانية شيئاً خارج السياق كله، إذا ما رأينا كيف سعت السلطات الاستعمارية إلى فرض هذه الحالة فرضاً على المجتمع، ووظفت لذلك كتاباً ونشطاء وسياسيين ونخباً. وكانت مظاهرات نزع الحجاب في مصر وتونس في ثلاثينيات القرن الماضي خير مثالٍ على ذلك، تلك المظاهرات التي تزّعمتها هدى شعراوي في القاهرة وغيرها من ناشطات العلمانية "الوظيفية"، فالعلمانية، في كل السياقات الثقافية المختلفة، سواء في السياق الغربي أو الشرقي، كانت نتاجاً طبيعياً واستجابة لمشكلاتٍ قائمة، تطلبت وجود العلمانية نظاماً إدارياً حاكماً ينظم العلاقة بين مختلف الجماعات والتيارات والثقافات، وتتحدّد معالمها في دستور حاكمٍ يعلي من حقوق الإنسان وحرياته، وفقا لمفهوم المواطنة المتساوية، وقداسة حقوق الإنسان وحرياته.
هذا في السياق الغربي، أما بشأن السياق الشرقي، كشرق آسيا التي وصلت اليوم إلى مراتب
عالية في التقدم والتطور، فإن العلمانية هناك ليست أكثر من مجرّد مرحلةٍ ثقافيةٍ، مثلها مثل الليبرالية الاشتراكية والعولمة، بمعنى أن العلمانية الشرقية الآسيوية لم تمثل قيمةً إضافية لمجتمعاتٍ محافظة، لا تصادم فيها بين تطلعات الشعوب وأشواقها الروحية، بالنظر إلى أن الحالة الدينية في شرق آسيا هي أفكار وحكم تربوية، تعلي من قيم العمل والتقدم، سواء في الكونفوشية أو في التاوية، أو حتى في الشنتوية أيضاً.
أما العلمانية في السياق العربي فإنها تمثل إشكالية إضافية، ليس باعتبار تعارض العلمانية كسياق ثقافي مع السياق الثقافي الإسلامي، وإنما بسبب أن الدافع الوحيد لها، منذ لحظة التأسيس الأولى، لم يكن الاحتياج الموضوعي والإشكالي، وإنما رغبة جامحة من القوى الاستعمارية لإفراغ هذه الشعوب من طاقتها الروحية، والفصل التام بين المجتمع وتديّنه وثقافته، وليس الفصل بين الدين والدولة، لأن العلاقة بين الديني والدنيوي في السياق الإسلامي أكثر وضوحاً من أي سياق آخر، فالعلاقة القائمة بين الديني والدنيوي علاقة تمييز واضح بينهما بحسب رئيس الحكومة المغربية، والقيادي في حزب العدالة والتنمية (الإسلامي)، سعد الدين العثماني، ذلك التمييز كأساس العلاقة القائمة بين الدين طاقة روحية وقيماً أخلاقية للمجتمع المسلم والدولة باعتباره نظاماً قانونياً حاكماً ينظم العلاقة بين الطرفين، وبين كل المكونات الثقافية في المجتمع، بحيث لا تتحوّل الدولة أداة في يد طرفٍ يستقوي بها على الأطراف الأخرى، وإنما الدولة نظام قانوني حاكم، يقف الجميع متساوين أمام قانونها وسلطتها الحامية للجميع.
لكن ما حصل من العلمانيين العرب هو العكس تماماً، حيث تم تحويل الدولة وإمكاناتها إلى جهاز قمعي، بيد النخب العلمانية التي سعت إلى تحويل الفكرة العلمانية إلى ما هو أشبه بأداة وظيفية لقمع خصوم السياسة، ومصادمة ثقافة المجتمع وعاداته وأخلاقه وقيمه، وفرض نمط سلوكي أحادي للأخلاق والسلوك في المجتمع، لا يتفق مع سلوك المجتمع وأخلاقياته الثقافية والدينية، بمعنى أننا أصبحنا إزاء علمانية وظيفية، تبقي المجتمع في حالة صراع وتصادم مع السلطة الحاكمة، وهذا أسوأ ما يمكن توصيفه للسياق العلماني في المشهد العربي على مدى نصف قرن، وما زالت هذه الأفكار والتصورات الحاكمة هي ذاتها لماهية العلاقة وأطر التعريف القائم للسياق الوظيفي الذي وضعت في قوالبه العلمانية العربية.
صحيح أن الفكرة العلمانية ليست صورة واحدة بقدر تعدّدها، وتعدّد أشكالها وصورها، بتعدّد المجتمعات، واختلاف مشكلاتها وثقافتها التي نشأت بها، فنلاحظ اختلافاً وفرقاً كبيراً بين العلمانية البريطانية والفرنسية على سبيل المثال، والعلمانية الغربية عموماً عن العلمانية الشرقية الآسيوية، إلا أن العلمانية في الحالة العربية كانت صورةً واحدةً، ونسخة متشابهةً مع بعضها بعضاً، علمانية تهدف إلى محاربة تدين المجتمع، وتصادم عاداته وتقاليده وثقافته التي ورثها قروناً، أي كانت أقرب إلى علمانية وظيفية، لا سياق ثقافي واجتماعي، فرضته المشكلات القائمة.
أما العلمانية في سياقها الغربي تحديدا فكانت استجابة موضوعية حقيقية لأزمة بنيوية، تعيق المجتمع ونهضته وتقدّمه، بفعل السلطة الدينية الكنسية المحتكرة كل شيء، وفي مقدمتها احتكارها للسلطة السياسية والاقتصاد في المجتمع الذي بقيت دُولة بين أباطرة الملك وسدنة الكنيسة، فيما بقى الشعب كله سخرةً لا حقوق له، في مقابل واجباتٍ كبيرة يؤديها.
ليس هناك مشكلة بنيوية في الحالة الإسلامية بين الدين والدولة، بين السلطة الحاكمة والسلطة الدينية التي تعتبر شبه مستقلة، في الحالة الإسلامية السنية تحديدا، لكن هذه الاستقلالية لم تستمر طويلا، مع تحوّلات المجتمع وتطورات السياسة، حيث سعى ربّان السياسة عبر التاريخ إلى تسخير السلطة الدينية، واستخدامها في معركة الحكم مع الخصوم، إلى درجةٍ أن أملت السلطة الحاكمة نصا مأزوما وافترائيا واضحا، في ما يتعلق بجواز المتغلب (أي "الانقلابي") وأحقيته بلغة هذه اللحظة السياسية، وأحقيته في الحكم والطاعة.
لم تكن هذه اللوثة الإفتائية موجودة في القرن الهجري الأول، في صلب الفكرة الإسلامية الأولى
بالعودة إلى قراءة دقيقة لمصادر هذه اللوثة الاستبدادية التي تدفقت على التراث الإسلامي، يقول المفكر محمد عابد الجابري إن لوثة الأحكام السلطانية والطاعة السياسية التي أصابت الفكر والثقافة الإسلامية كان مصدرها الأدب والتراث الفارسي الذي نقله حرفيا، وبطريقةٍ غاية في الذكاء، الأديب ذي الأصول الفارسية، عبد الله بن المقفع، والذي مثل جسر عبور لترسبات الاستبداد السياسي الفارسي إلى التراث الإسلامي.
كي لا نتوه بعيداً، عن مضمون هذا المقال بشأن السؤال عن أسباب فشل الفكرة العلمانية عربياً، ونجاحها في كل السياقات الثقافية الأخرى، وهو سؤالٌ يتطلب قراءة عميقة ودقيقة، حتى لا تتحول الانطباعات إلى حقائق غير قابلة للجدل، بالنظر إلى التجربة والمحاولة الطويلة للعلمانية في المشهد العربي على مدى أزيد من نصف قرن، لكنها كلها كانت تبوء بالفشل السريع، فالتجربة العلمانية، ومحاولاتها في السياق العربي، والتي باءت بالفشل الذريع، كانت تجربةً تستدعي مزيداً من البحث والدراسة والتقصّي، للأسباب التي وقفت أمام نجاح هذه التجربة التي كتب لها النجاح، في بلدانٍ كثيرة، إلا في العالم العربي الذي شهد عدة تجارب من تجربة القومية العربية "العلمانية"، بشقيها البعثي والناصري، وكل تجارب القمع الثقافي، كالتجربة اليسارية الاشتراكية وغيرها، والتي ارتكزت كلها حول مواجهة مع المجتمع ومصادمته بدرجة رئيسية.
ولمّا لم تكن العلمانية في السياق العربي استجابةً علميةً وثقافيةً، لعدم وجود ذلك الإشكال الذي يبحث عن حلٍّ له، وإنما كانت مطلباً خارجياً تحمله نخبةٌ ممن تعيش مرحلة قطيعةٍ مع مجتمعها أولا، وثقافتها ودينها ثانيا. وبالتالي، كانت العلمانية شيئاً خارج السياق كله، إذا ما رأينا كيف سعت السلطات الاستعمارية إلى فرض هذه الحالة فرضاً على المجتمع، ووظفت لذلك كتاباً ونشطاء وسياسيين ونخباً. وكانت مظاهرات نزع الحجاب في مصر وتونس في ثلاثينيات القرن الماضي خير مثالٍ على ذلك، تلك المظاهرات التي تزّعمتها هدى شعراوي في القاهرة وغيرها من ناشطات العلمانية "الوظيفية"، فالعلمانية، في كل السياقات الثقافية المختلفة، سواء في السياق الغربي أو الشرقي، كانت نتاجاً طبيعياً واستجابة لمشكلاتٍ قائمة، تطلبت وجود العلمانية نظاماً إدارياً حاكماً ينظم العلاقة بين مختلف الجماعات والتيارات والثقافات، وتتحدّد معالمها في دستور حاكمٍ يعلي من حقوق الإنسان وحرياته، وفقا لمفهوم المواطنة المتساوية، وقداسة حقوق الإنسان وحرياته.
هذا في السياق الغربي، أما بشأن السياق الشرقي، كشرق آسيا التي وصلت اليوم إلى مراتب
أما العلمانية في السياق العربي فإنها تمثل إشكالية إضافية، ليس باعتبار تعارض العلمانية كسياق ثقافي مع السياق الثقافي الإسلامي، وإنما بسبب أن الدافع الوحيد لها، منذ لحظة التأسيس الأولى، لم يكن الاحتياج الموضوعي والإشكالي، وإنما رغبة جامحة من القوى الاستعمارية لإفراغ هذه الشعوب من طاقتها الروحية، والفصل التام بين المجتمع وتديّنه وثقافته، وليس الفصل بين الدين والدولة، لأن العلاقة بين الديني والدنيوي في السياق الإسلامي أكثر وضوحاً من أي سياق آخر، فالعلاقة القائمة بين الديني والدنيوي علاقة تمييز واضح بينهما بحسب رئيس الحكومة المغربية، والقيادي في حزب العدالة والتنمية (الإسلامي)، سعد الدين العثماني، ذلك التمييز كأساس العلاقة القائمة بين الدين طاقة روحية وقيماً أخلاقية للمجتمع المسلم والدولة باعتباره نظاماً قانونياً حاكماً ينظم العلاقة بين الطرفين، وبين كل المكونات الثقافية في المجتمع، بحيث لا تتحوّل الدولة أداة في يد طرفٍ يستقوي بها على الأطراف الأخرى، وإنما الدولة نظام قانوني حاكم، يقف الجميع متساوين أمام قانونها وسلطتها الحامية للجميع.
لكن ما حصل من العلمانيين العرب هو العكس تماماً، حيث تم تحويل الدولة وإمكاناتها إلى جهاز قمعي، بيد النخب العلمانية التي سعت إلى تحويل الفكرة العلمانية إلى ما هو أشبه بأداة وظيفية لقمع خصوم السياسة، ومصادمة ثقافة المجتمع وعاداته وأخلاقه وقيمه، وفرض نمط سلوكي أحادي للأخلاق والسلوك في المجتمع، لا يتفق مع سلوك المجتمع وأخلاقياته الثقافية والدينية، بمعنى أننا أصبحنا إزاء علمانية وظيفية، تبقي المجتمع في حالة صراع وتصادم مع السلطة الحاكمة، وهذا أسوأ ما يمكن توصيفه للسياق العلماني في المشهد العربي على مدى نصف قرن، وما زالت هذه الأفكار والتصورات الحاكمة هي ذاتها لماهية العلاقة وأطر التعريف القائم للسياق الوظيفي الذي وضعت في قوالبه العلمانية العربية.