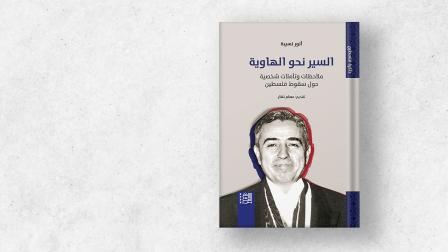تبدو سلسلة "أصوات من السماء" (الجزيرة الوثائقية)، التي تتناول عبر حلقات منفصلة أعلاماً من مقرئي وحافظي القرآن، عملاً مثيراً. فمن جهة، تفتح الباب على التذوق القرآني والبيئة الموسيقية الفريدة التي وعاها بعض المقرئين والحافظين واشتغلوا عليها. ومن جهة أخرى، تصلح لأن تكون مختبراً لدراسة وتأمل وجدانات الشعوب العربية والإسلامية، وخصائص "المزاج العام" لكل منها، عبر فحص الأساليب والطرق والأداءات الموسيقية التي فضلها وانتهجها المقرئون، كلٌّ في محيطه وبيئته.
وهذا المحور من التناول أو المعالجة لا يقع في اهتمام ووظيفة تلك الحلقات وصانعيها، الذين آثروا الاشتغال بدرجة أكبر على السير الذاتية للمقرئين والمنشدين وحفظة القرآن. إلا أن المُشاهد يستطيع بدون مشقة أن يدرك ذلك، من طريق جانبية لا تؤثر ولا تشوّش على الرسالة والمقولة العامة لتلك الحلقات.
وبين هذا وذاك، يجب الانتباه إلى/ والتعامل مع "القراءة القرآنية" كوثيقة صوتية وحيدة وفريدة في التاريخ الإنساني، حتى قبل ظهور المسجّلات الصوتية، فضلاً عن أنها، وهذا هو الأهم، وثيقة صوتية متحركة عابرة للتاريخ، تختزن تجارب إنسانية، فردية وجمعية، لم تنل حقها الكافي من الدراسة والتحليل.
فـ"علم التجويد" الذي يُعنى بكيفية نطق الحروف والكلمات كما نطقها النبي محمد (ص) عن الملَك جبريل عليه السلام، هو العلم الذي صان "اللسان من اللحن في ألفاظ القرآن الكريم عند الأداء"، وكانت قواعده قد كتبت في القرن الثالث الهجري، على خلفية اتساع رقعة الدولة الإسلامية واختلاط الشعوب والأمم الأخرى بالعرب، ما أدّى إلى شيوع اللحن والخطأ، سواء لجهة التصويت والكلام أو لجهة البناء والتركيب اللغوي (النحو والصرف)، وذلك توازياً مع كتابة قواعد اللغة العربية.
وبغضّ النظر عن من كان أول من كتب قواعد ذلك العلم (التجويد) ـ إذ تختلف الروايات التاريخية في هذا الخصوص، فتنسبه تارةً إلى أبي الأسود الدؤلي، وتارة إلى أبي القاسم بن سلام، وأخرى إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي ـ إلا أن الأهم هو أن علم التجويد حفظ لنا بطريقة تفوق دقتها دقة أجهزة التسجيل ـ التي تقوم فكرتها ومبدؤها أساساً على النسخ ـ أصواتَ الحروف مفردةً أو مجتمعة، في الكلمة وفي الجملة. وفي نظرة سريعة إلى هدف علم التجويد، يتبيّن لنا أنه إخراج كل حرف من حروف الأبجدية من مخرجه الصحيح، وإعطاؤه حقه من الصفات اللازمة التي لا تنفك عنه (كالهمس والجهر والقلقلة والشدة)، ومستحقه من الصفات العارضة (كالتفخيم والترقيق والإدغام والإقلاب).
أما "التوثيق الصوتي" فيأتي من كون أن كل مقرئ مجاز، في عصرنا أو في أي عصر آخر، فهو إنما يتلو القرآن الكريم بنفس الطريقة التي كان يقرأ بها القرآن في زمن النبي (ص)، في ظاهرة قد تكون الأولى والوحيدة من نوعها في تاريخ البشر والأديان.
ونزيد إن توثيق القراءة القرآنية لا يقتصر على حالة أو قراءة واحدة، بل يبلغ عددها العشر، وهي القراءات التي قرأ بها الرسول أو أجازها. وهذا أيضاً يفتح الباب على تأمل ودراسة "الحالات" اللغوية التي كانت منتشرة في ذلك الزمن، ويفضل بعض الباحثين والمؤرخين أن يسمّيها لهجات.
ما يعني أن توثيق النصوص القرآنية لم يقتصر على كتابتها ونسخها ورسم كلماتها، بل تجاوزه إلى "التوثيق الصوتي" الذي يعني أن كل قراءة قرآنية مضبوطة وفق قواعد التجويد؛ هي نوع من النسخ للقراءة الأساسية، مع فارق أنها تختلف في كل مرة عن غيرها حسب صوت المقرئ. وبغض النظر عن تفسير هذه الظاهرة، فيما إذا كان دينياً متصلاً بوعد الله بحفظ القرآن الكريم، أو كان ثقافياً يحيل إلى الجهد الكبير المبذول من قبل الأعلام الأوائل والعبقريات الفذة بهاجسها الجمعي، حيث انتبهت وعملت منذ وقت مبكر على ابتكار طرق وآليات لحفظ القرآن عبر الكتابة والصوت.
في سياق آخر، تقول الآية الكريمة: "وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا" (سورة الفرقان: 30)، وهي آية تصلح أيضاً لتوصيف موقف المؤسسات الرسمية من الدين ومن الثقافة الدينية عموماً، منذ نشوء وتشكل الكيانات الوطنية العربية الحديثة، بصيغها العلمانية غالباً، في بدايات القرن الماضي، والتي اتخذت في كثير من الأحيان موقفاً سلبياً من الدين، إعلاناً أو إضماراً، وفي أحيان ليست بالقليلة موقفاً إقصائياً، أو معادياً.
وقصة تأسيس "مدرسة قرآن نور العثمانية" التي ورد ذكرها في الحلقة التي تناولت سيرة الحافظ التركي حسن أكوش، ليست أكثر من مثال فاقع لما كان يحدث في العديد من الدول العربية. إذ أن بناء تلك المدرسة استوجب تصريحاً خطياً من مؤسس الدولة التركية الحديثة كمال أتاتورك نفسه.
ويروي أحد تلامذة الشيخ أكوش أنه "عندما بدأ الشيخ تعليم القرآن، لم يجد مكاناً مناسباً، فاضطر لاستخدام غرفة الإمام الخاصة، لأن المسجد كان بحالة رثة، فقد كان مهجوراً مهملاً، حتى قابل أول رئيس للشؤون الدينية رفعت البوركتشي وطلب منه أن يمنحه تصريحاً رسمياً لفتح مدرسة للقرآن الكريم. وحين ذهب بوركتشي إلى أنقرة نقل هذا الطلب لأتاتورك الذي أرسل التصريح الرسمي بتوقيعه، فأصبح الشيخ بعدها معلّما للقرآن بصفة رسمية لـ "مدرسة قرآن نور العثمانية".
وسلسلة "أصوات من السماء" لا تنشغل ولا تناقش الكثير من التصورات والخلفيات الثقافية، إلا أن أهميتها تبرز في تسليط الضوء على واحدة من أهم العبادات والشعائر الإسلامية، أي التعبّد من خلال قراءة القرآن، تلاوة أو إنصاتاً، ناهيك عن تدبّر معانيه.
فتلاوة القرآن بتنويعاتها الثلاثة: الترتيل (القراءة بأناة وتفّهم من غير عجلة)، والحدر (إدراج القراءة وسرعتها مع المحافظة على أحكام التجويد)، والتدوير (حالة متوسطة بين الترتيل والحدر)؛ توسّع مروحة الأداء الصوتي وتثري الإمكانيات الموسيقية والتلوينات النغمية لدى الشيوخ القراء، فيستخدمون منها ما يتلاءم مع المناسبة ويراعي مقتضى الحال.
وقد وعى بعض القارئين "وظيفتهم" بمعناها العميق من حيث أنها وظيفة لا تقوم على التأثير أو الإطراب فحسب، بل تتعداها إلى مساعدة المستمعين للوصول إلى المعاني التي تنطوي عليها الآيات والسور القرآنية. وهذا يعني بالضبط أن المقرئ هو فنان من الدرجة الأولى، من دون أن يتناقض ذلك أو يتصادم مع البعد الديني للمسألة.
وهذا ما يبرر وجود الكثير من الخبراء الفنيين والموسيقيين الذين أدلوا بشهاداتهم في معظم الحلقات التي بثتها "الجزيرة الوثائقية" حتى الآن. وخلافاً للحلقة التي تناولت سيرة الشيخ السعودي علي عبدالله جابر ـ وشهدت غياباً للمصطلحات والمفاهيم الموسيقية (لحساسيات وأوضاع ثقافية مفهومة) فاقتصرت شهادات المشاركين فيها على جمال الصوت وقوة تأثيره ومعرفة المقرئ العميقة بأحكام القرآن ـ فقد زخرت الحلقات الأخرى بشهادات تستخدم اللغة والمعجم الموسيقيين عند الحديث عن عبقرية المقرئين وميولاتهم الفنية من حيث تفضيلهم لمقامات موسيقية بعينها، أو انتقالات مبتكرة، عن سابق تصميم ومعرفة. وهو الأمر الذي تكرر كثيراً في الحلقات التي تناولت المقرئين المصريين مثل الشيخ خليل محمود الحصري والشيخ كمال يوسف البهتيمي والحافظ العراقي خليل ابراهيم والحافظ التركي حسن أكوش، والمغربي المقرئ عبد العزيز الكرعاني.
ثم إن الشيوخ المقرئين، وكلٌّ من حيث تجربته وشخصيته الفنية المميزة، يعكسون بقراءاتهم وخصائص أصواتهم وأداءاتهم، تباين واختلاف ثقافات الشعوب العربية والإسلامية وأمزجة أبنائها.
فمثلاً يعكس الحافظ خليل إسماعيل الأسى والشجن اللذين تتصف بهما الشخصية العراقية، فيما يعكس القرّاء المصريون المزاج الفرح والسعيد الذي يشي بخفة الدم لدى المصريين، كما يمكن تلمس ذلك الاختلاف في التذوّق والإحساس الفني لدى مختلف الشعوب، التي يفضل بعضها التجويد القرآني حسب رواية حفص عن عاصم، كما هو الحال لدى الشعوب المشرقية، بينما تفضل شعوب المغرب العربي التجويد حسب رواية ورش عن نافع؛ وكلاهما قراءتان متواترتان عن النبي (ص).
وفي النهاية، يبقى مصدر السعادة لدى متابعة هذا السلسلة الوثائقية، أنها من إنتاج وإنجاز وإبداع عربي، حيث تم الانتباه والاحتفال بحالات وأسماء تم التغاضي عنها لوقت طويل، ولأسباب غير مقنعة، متذكرين في هذا السياق كيف تم إهمال الإنشاد الديني (فناً ومنشدين)، والصوفي منه على وجه التحديد، في الكثير من البلدان العربية، قبل أن يعاد تقديمه في عواصم العالم الغربية، واكتشاف روحانياته وعوالمه الآسرة.
وفيما عدا بعض المقرئين الذين حققوا انتشاراً وشهرة كبيرة، يبقى الأهم أن السلسلة قدمت بعض الأسماء المعروفة محلياً إلى الجمهور العربي الكبير، إضافة إلى إعادة التذكير ببعض التجارب التي كاد أن يطويها الزمن.