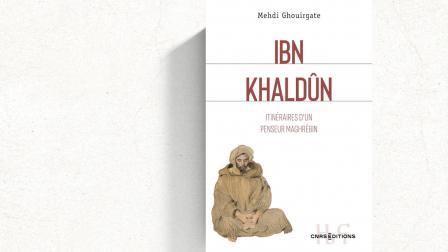يعرِّف البلاغيون القدامى المجاز العقلي بأنه صورة بيانية، يُسند فيها الفعلُ إلى غير فاعله الحقيقي، بسبب وجود قرينة عقليةٍ أو سياقية، تمنع من ذكر ذلك الفاعل الحقيقي. وظلوا يمثلون لهذا المجاز، ويسمّونه الإسنادي أيضاً لوقوعه في الجملة وليس في الكلمة، بأمثلة مكرورة ساذجة، منها: "بنى الخليفة قصراً" أو "ربحت تِجارته"، مع تأكيدهم أن الخليفة لا يبني، وإنما عمَلتُه، وأن التجارة لا تَربح، وإنَّما صاحبها.
وسُمّي هذا النوع من المجاز عقلياً، لأنَّ العقل يمنعُ -طبقاً لقوانين الطبيعة والمنطق والعرف- أن ينجزَ الفاعل المذكور ذلك الفعل، حسب المُتعارف عليه من الوقائع. ويبدو أنَّ هذا الضرب من الإسناد ظاهرة لسانية عفوية، ينتجها الخطاب بتلقائية ربطًا بين الظواهر المتباعدة، ونسبةً لبعضها البعض، وهذا واضحٌ في الأمثلة التي يذكرها التراث العربي.
وأما في الخطاب البلاغي الغربي الوسيط، فقد تحدث بيار فونتانيي (َ1765-1844)، وهو من أشهر لغوييهم في الطور السابق لنشأة الأسلوبية، عن هذه الصورة باعتبارها تشخيصاً "أيْ: جَعل كائن ما، غير عاقلٍ، ولا شعور له، أو كائنٍ مجردٍ، ذي طبيعة فكرية محضة، نوعاً من كائنٍ حقيقيٍّ ومادي، له شعور وحياة، أي ما نعتبره شخصاً (فاعلاً)".
والملاحظ أن التنظير الأسلوبي العربي والغربي، كليهما، لم يواكبا التطوّرات المفصلية لهذا المجاز، ولم يشيرا إلى استخدامه المكثف، بعد أن كان مهمشاً، نسبياً، في الإنجازات الشعرية التقليدية. ومن أمثلة ذلك، عديد العناوين والبيانات والتصريحات الرسمية التي تنسب المواقف الدولية إلى عواصم الدول ومؤسساتها الرسمية مثل: "صرّحت موسكو" و"رفضت واشنطن" و"ماطلت دمشق"، و"أوضحت الوزارة"... وفي كل هذه الأمثلة، فإنَّ المسؤولين -وليست العواصم- هم الذين ينجزون الأفعال.
وهكذا، صار هذا المجاز اليوم من أخطر وسائل التأثير في الخطاب السياسي والديبلوماسي والإعلامي الحديث حيث تستغل عفوية نظمِ المجاز العقلي وسهولته، إنتاجاً وتلقيّاً، من أجل تمرير رسائل ضمنية. فمن اليسير على الناطقين باسم سلطة سياسية أو دينية ما، نسبةُ أفعال الشر إلى أعدائها. وفي المقابل، نسبة الأعمال البطولية إلى القائمين عليها. كما يفضّل المتلقي إلصاق الشر بمن يعتبره، أو يطلب إليه أن يعتبره عدواً، ونسبة فضائل الأعمال إلى من يَراه بطلاً.
ويمكن الحديث هنا عن تواطؤ بين المرسل والمتلقي: يقدّم الأول الفعل كما لو كان صادراً عن "الزعيم"، وعلى الثاني أن يقبل بتلك النسبة ويصدّقها. وقد يعدُّ التشكيك فيها -مع أنها نسبة كِنائية صرفة- على أنها ضربٌ من انتقاد السلطة ومساسٌ من هيبتها. فهل كان يجرأ أحدٌ تحت الحكم البورقيبي في تونس (1956-1987) أن يُشكك في كون بورقيبة هو مَن "بَنَى البلد وحرَّرَ المرأة وثقّف الشعب"؟ وهل كان يأمل أحد في أن ينفي أنَّ صدام حسين "قد هزم الغزاةَ، وحدَّث العراق؟".
ولا شك أن السهولة والتسرّع، وأحياناً ضرورات البروتوكول الرسمية، هي التي تجرّ إلى هذه الاستخدامات بعد أن صارت جزءاً لا يتجزأ من العبارات الجاهزة، ودخلت الاستعمال بشكل مكثف. ولكنَّ النظر المتأني فيها يفضي بنا إلى ملاحظات عدّة.
قد يتحوّل المجاز العقي إما إلى ضرب من الاتهام العام، غير الدقيق، وحتى العاري من الصحة تماماً، أو على العكس من ذلك، إلى تمجيد فضفاض، غالباً ما يخصّ رأس الدولة، في حين أنَّ المقصود هم أفراد قلائل، ممّن أنجزوا ذلك الفعل، ويصبح هذا الإسناد مقصوداً إما لتعميم الاتهام وتشويه الصورة لدى الرأي العام مثل ما يقال: "ترعى الدولة الفلانية الإرهاب" و"شجعت العاصمة الفلانية كذا..."، وما يترتب قانوناً من إسناد مثل هذه التهم هو تحميل المسؤولية المدنية والجزائية. وشتان بين التوجيه القانوني لتهمةٍ ما باعتماد أدلة قطعية، وبين مجرّد التلاسن السياسي أو الإعلامي، الذي لا هدف من ورائه سوى التمجيد أو التشكيك، فَليست أهداف هذه الأفعال الإنجازيَّة واحدةً.
ومن جهة ثانية، تقع نسبة الأفعال الإيجابية إلى الملوك والرؤساء وحكوماتهم، كما لو كانوا المحركين الوحيدين للتاريخ، وصانعي أحداثه، مما يؤدي إلى تفسير أحادي للتاريخ، وحصر عوامل التغيير فيه لدى "شخص" واحدٍ مطلق: الزعيم الفذ. وتشيع هذه المجازات ضمن خطابات الإشادة والمديح التي تنسب كل فخر إلى القائد الملهم، سالبةً بذلك كل دورٍ للفئات الشعبية، وقوى المجتمع المدني والوسائل الإنتاجية وما تضطلع به من دورٍ في صنع التاريخ، ومن أمثلة ذلك ما يتواتر من أخبار "حَدَّث الرئيس البَلدَ" و"حرّر المرأة"، و"طوَّر المجتمع" و"قمع الأعداء"...
ولا بدّ أن نستذكر في هذا المجال التصوّر اللاهوتي- الأشعري الذي ينسب الأفعال جميعَها إلى الله، ويعتبر نسبتها إلى الإنسان مجرّد مجاز، بل وإسرافاً في اللغة، فالقول: "إنَّ الدواء يشفي" مجازٌ لأنَّ الشافي الحقيقي هو الله، ولكن نلاحظ أنَّ هذا الفاعل المطلق والغيبي (الله) استعيض بالمطلق السياسي والفاعل الأساسي، أي الزعيم الذي يُنسب إليه كل شرفٍ ضمن رؤيةٍ لا تربط الأسباب بمسببّاتها الحقيقية، بل بمن يُراد من أصحاب الرئاسة.
وللمجاز العقلي ارتباطٌ وثيق بالمسؤولية القانونية، وبالسببية الطبيعية والتتابع المنطقي. لذا، يجدر تفكيك هذه الصورة البيانية لما فيها من خطر يسلب الإرادة ويحجب الوعي عن رؤية الفاعل الحقيقي ونسبة الأعمال إليه، وليس إلى قوة مجردة، ومفاهيم مطلقة تعفيها من كل مسؤولية، أو بالعكس تحمّلها لها كاملة، وما يجر ذلك من تشويه في إدراك السلاسل السَّببية التي تفضي إلى نتائجها.
أبعد من صورةٍ بيانية، يخفي المجاز العقلي بنية عقلية وثقافية كاملة، تحدّد مجال الفكر العربي، بل هو أحد محاذيره، ولا بد من تفكيكه حتى يخلص الوعي من خطر العوائق المعرفية التي يساهم الخطاب الإعلامي في إشاعتها وترسيخها. ولعل أخطر ما فيه أنه من أسرع أفعال الكلام مساً بالعواطف البشرية، ومن أقوى أساليبه تأثيراً، بل وتلاعباً، بمستويات الوعي وتصوير العالم وأحداثه.
ويكفي النظر إلى عناوين الصحافة -كل يوم- للتأكد ليس فقط من شيوع هذا الشكل البلاغي، بل من خطورة الإستراتيجيات الخطابية التي توظفه لتغيير توجهات الرأي العام ولفت الأنظار إلى ظاهرةٍ ما أو بالعكس تحويلها عن فاعلها الحقيقي، الذي قد يتوارى في طياتِ الكلام. وكم أفلت بسبب المجاز العقلي من مجرم؟ وكم بفضله شُيِّدت من الزعامات الكاذبة؟
كل ذلك يحصل بعد أن جرى تناسي أرضية المجاز الأولى، ومراحُها الشعر وعالي الكلام، ففيهما كانت الجمالية تخيّلاً لعلل وهمية تُفسّر ظواهر الطبيعة والمجتمع. ومن أمثلته في الشعر الحديث، نكتفي بنموذج المدينة في شعر بدر شاكر السياب كقوله "تلتفّ حولي دروب المدينة/ حبالاً من الطين يمضغن قلبي". فإذا كان هذا المجاز رائقاً في الشعر، فإنه في أطر أخرى يصبح مدخلاً للتلاعب بالعقول وقصفها.