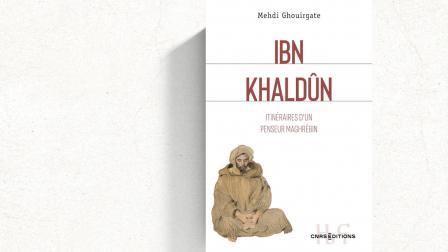من شأن حديث الدكتور رشيد الخالدي عن نشأة القضية الفلسطينية ونكبة 1948 ضمن هذا الحوار معه، أن يفتح الباب على الماضي غير البعيد لهذه القضية وحيثياتها، وخصوصًا إلى ناحية ملامسة لحظات التقاء ظروف دولية وإقليمية ملائمة لإقامة إسرائيل، وهو التقاء يمثل أحد المداخل المهمة لتقييم ما حدث وفهمه.
وما يجدر التنويه به في هذا الشأن تحديدًا، بحسب ما ورد في أكثر من مرجع تاريخيّ، بما في ذلك مراجع لمؤرخين إسرائيليين تحدّوا طبيعة إسرائيل الكولونيالية، أنَّ أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية (1945) كانت رازحة تحت وطأة "عقدة الذنب" من جراء الهولوكوست. وطوال عقدين من الزمان، في إثر تلك الحرب، لم يعرف الدعم الأوروبي لإسرائيل حدودًا: سياسية، دبلوماسية، عسكرية (بالإضافة إلى السلاح النووي)، اقتصادية، تكنولوجية، علمية.
كذلك كانت ما تُسمى "خطوط الهدنة"، من سنة 1949، تعتبر في معظم أوروبا وفي أميركا شيئًا مقدسًا يشبه التقسيم في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية إلى "شرق" و"غرب"، بين القوى الغربية وبين الاتحاد السوفييتي السابق.
يشير الخالدي أيضًا إلى أنه بعد قرار بريطانيا الانسحاب من فلسطين، وقف الفلسطينيون بدون أجهزة دولة أمام دول أوروبية حديثة بكل أجهزتها واستخباراتها، في حين كان الصهاينة أوروبيين ولديهم المعرفة والعلاقات والتعليم، ولهم جذورهم هناك وأموال هائلة، كما لديهم دعم أكبر قوتين عالميتين بعد الحرب العالمية الثانية وهما الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.
ونستطيع أن نضيف بخصوص دعم هذه القوة العالمية الأخيرة، وهو ما سبق أن أشرنا إليه مرارًا وتكرارًا في مقامات أخرى، أنه حتى زعيمها جوزيف ستالين، وخلال سنواته الأخيرة التي اعتبرها الصهيونيون وغيرهم موبوءة بـ "العداء للسامية"، لم يقترح انسحاب إسرائيل من "خطوط هدنة 1949" إلى ما أعطته خطة التقسيم الدولية الأصلية (الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1947) إلى اليهود في فلسطين.
كذلك فإنَّ خلفاء ستالين في الكرملين لم يطلبوا هذا، مع أنَّ حقبة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين الفائت اتسمت بكونها "عصر تفكّك الاستعمار"، وستالين والذين أتوا بعده امتدحوا كل حركة مضادة للاستعمار تقريبًا. غير أنَّ هؤلاء انتقدوا إسرائيل باعتبارها صنيعة الرأسمالية الأميركية، لا لكونها قوة استعمارية. والعديد من الدول التي استقلت حديثًا والشعوب التي كانت مستعمرة سابقًا فضلت إقامة علاقات وثيقة مع إسرائيل، على الرغم من إدانتها حكومات استعمارية أخرى، مثل تلك التي كانت موجودة في كينيا أو جنوب أفريقيا أو الجزائر. وحتى اليسار في فرنسا وإيطاليا كان يفتقد أي خطاب معاد لإسرائيل واستعمارها على غرار الخطاب الذي أصبح رائجًا بعد سنة 1967، في أعقاب حرب الخامس من حزيران/ يونيو في تلك السنة التي أوجدت ظروفًا لتطرّف عمليات الاستيطان الكولونيالية الصهيونية.
في المحصلة العامة، كانت إقامة إسرائيل فكرة يُنظر إليها عمومًا، في ذلك الوقت، على أنها نتيجة حتمية لحرب خاضها اليهود وانتصروا فيها، كما كان يُنظر إليها قبل أي شيء آخر على أنها بمنزلة ملاذ للناجين من الهولوكوست ولأسرى معسكرات الاعتقال النازية. أما مسألة إعادة توطين مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيّين ضحايا النكبة فقد نُظر إليها أساسًا باعتبارها مهمة إنسانية صرف، وليس استراتيجيا سياسية. وكان من المفترض، بموجب تلك النظرة، أنْ تتحمّل إسرائيل المسؤولية عن مستقبل هؤلاء اللاجئين ماديًا وماليًا فقط في حال إحلال السلام مع العرب. وبموازاة ذلك كان الغرب يتوقع من الدول العربية المجاورة أنْ تساند أعمال استيعاب اللاجئين الفلسطينيّين داخلها، فالكثيرون في الغرب اعتبروا هذه الدول مسؤولة، وإن جزئيًا، عن نتائج حرب شنتها سنة 1948 لإفشال قرار الأمم المتحدة القاضي بتقسيم فلسطين. وقد حثّ الأميركيون والأوروبيون، وحتى السوفيات، العرب على التوصل إلى سلام مع إسرائيل على أساس الواقع القائم على الأرض بعد وقائع نكبة 1948.
ولا بُدّ من تكرار أن التقاء هكذا ظروف دولية وإقليمية ملائمة لحدوث النكبة يمثل مدخلًا مهمًا لتقييم ما حدث. لكنه بالتأكيد ليس المدخل الوحيد في ما يتعلق بهذا الماضي غير البعيد للقضية الفلسطينية.
ثمة مداخل أخرى عديدة ومتنوعة.
ويبقى الأهم أنه يتوجب إخضاعها هي أيضًا إلى الفكرة الأساسية التي تطل من وراء دعوة ضيف العدد إلى اعتماد نظرة نقدية حيال الماضي، وهي السعي إلى معرفة أين نحن حاليًا، وإتاحة المجال أمام إمكان اجتياز العتبة نحو سائر أسئلة الوجود الحرّ ومحاسبة الذات.
اقــرأ أيضاً
وما يجدر التنويه به في هذا الشأن تحديدًا، بحسب ما ورد في أكثر من مرجع تاريخيّ، بما في ذلك مراجع لمؤرخين إسرائيليين تحدّوا طبيعة إسرائيل الكولونيالية، أنَّ أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية (1945) كانت رازحة تحت وطأة "عقدة الذنب" من جراء الهولوكوست. وطوال عقدين من الزمان، في إثر تلك الحرب، لم يعرف الدعم الأوروبي لإسرائيل حدودًا: سياسية، دبلوماسية، عسكرية (بالإضافة إلى السلاح النووي)، اقتصادية، تكنولوجية، علمية.
كذلك كانت ما تُسمى "خطوط الهدنة"، من سنة 1949، تعتبر في معظم أوروبا وفي أميركا شيئًا مقدسًا يشبه التقسيم في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية إلى "شرق" و"غرب"، بين القوى الغربية وبين الاتحاد السوفييتي السابق.
يشير الخالدي أيضًا إلى أنه بعد قرار بريطانيا الانسحاب من فلسطين، وقف الفلسطينيون بدون أجهزة دولة أمام دول أوروبية حديثة بكل أجهزتها واستخباراتها، في حين كان الصهاينة أوروبيين ولديهم المعرفة والعلاقات والتعليم، ولهم جذورهم هناك وأموال هائلة، كما لديهم دعم أكبر قوتين عالميتين بعد الحرب العالمية الثانية وهما الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.
ونستطيع أن نضيف بخصوص دعم هذه القوة العالمية الأخيرة، وهو ما سبق أن أشرنا إليه مرارًا وتكرارًا في مقامات أخرى، أنه حتى زعيمها جوزيف ستالين، وخلال سنواته الأخيرة التي اعتبرها الصهيونيون وغيرهم موبوءة بـ "العداء للسامية"، لم يقترح انسحاب إسرائيل من "خطوط هدنة 1949" إلى ما أعطته خطة التقسيم الدولية الأصلية (الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1947) إلى اليهود في فلسطين.
كذلك فإنَّ خلفاء ستالين في الكرملين لم يطلبوا هذا، مع أنَّ حقبة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين الفائت اتسمت بكونها "عصر تفكّك الاستعمار"، وستالين والذين أتوا بعده امتدحوا كل حركة مضادة للاستعمار تقريبًا. غير أنَّ هؤلاء انتقدوا إسرائيل باعتبارها صنيعة الرأسمالية الأميركية، لا لكونها قوة استعمارية. والعديد من الدول التي استقلت حديثًا والشعوب التي كانت مستعمرة سابقًا فضلت إقامة علاقات وثيقة مع إسرائيل، على الرغم من إدانتها حكومات استعمارية أخرى، مثل تلك التي كانت موجودة في كينيا أو جنوب أفريقيا أو الجزائر. وحتى اليسار في فرنسا وإيطاليا كان يفتقد أي خطاب معاد لإسرائيل واستعمارها على غرار الخطاب الذي أصبح رائجًا بعد سنة 1967، في أعقاب حرب الخامس من حزيران/ يونيو في تلك السنة التي أوجدت ظروفًا لتطرّف عمليات الاستيطان الكولونيالية الصهيونية.
في المحصلة العامة، كانت إقامة إسرائيل فكرة يُنظر إليها عمومًا، في ذلك الوقت، على أنها نتيجة حتمية لحرب خاضها اليهود وانتصروا فيها، كما كان يُنظر إليها قبل أي شيء آخر على أنها بمنزلة ملاذ للناجين من الهولوكوست ولأسرى معسكرات الاعتقال النازية. أما مسألة إعادة توطين مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيّين ضحايا النكبة فقد نُظر إليها أساسًا باعتبارها مهمة إنسانية صرف، وليس استراتيجيا سياسية. وكان من المفترض، بموجب تلك النظرة، أنْ تتحمّل إسرائيل المسؤولية عن مستقبل هؤلاء اللاجئين ماديًا وماليًا فقط في حال إحلال السلام مع العرب. وبموازاة ذلك كان الغرب يتوقع من الدول العربية المجاورة أنْ تساند أعمال استيعاب اللاجئين الفلسطينيّين داخلها، فالكثيرون في الغرب اعتبروا هذه الدول مسؤولة، وإن جزئيًا، عن نتائج حرب شنتها سنة 1948 لإفشال قرار الأمم المتحدة القاضي بتقسيم فلسطين. وقد حثّ الأميركيون والأوروبيون، وحتى السوفيات، العرب على التوصل إلى سلام مع إسرائيل على أساس الواقع القائم على الأرض بعد وقائع نكبة 1948.
ولا بُدّ من تكرار أن التقاء هكذا ظروف دولية وإقليمية ملائمة لحدوث النكبة يمثل مدخلًا مهمًا لتقييم ما حدث. لكنه بالتأكيد ليس المدخل الوحيد في ما يتعلق بهذا الماضي غير البعيد للقضية الفلسطينية.
ثمة مداخل أخرى عديدة ومتنوعة.
ويبقى الأهم أنه يتوجب إخضاعها هي أيضًا إلى الفكرة الأساسية التي تطل من وراء دعوة ضيف العدد إلى اعتماد نظرة نقدية حيال الماضي، وهي السعي إلى معرفة أين نحن حاليًا، وإتاحة المجال أمام إمكان اجتياز العتبة نحو سائر أسئلة الوجود الحرّ ومحاسبة الذات.