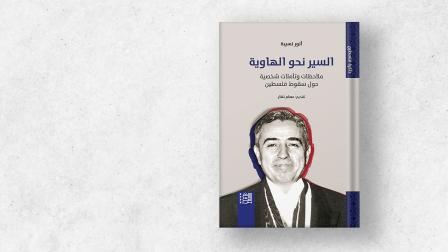في البدء كانت التاكسي والتاكسي كانت صفراء اللون، على الأقلّ في تونس. في الأصل، كانت التاكسي كومة من نفايات الحديد تحوّلت إلى ذهب بفضل القدرات السحرية لحجر الفلاسفة. لكن، بسبب لعنة ما، قُدّر على سيارات التاكسي أن تتجوّل تائهةً في الشوارع.
ليلاً ونهاراً، كانت السيارات المراودة تبحث عن الركّاب، جامعةً وصمات العار التي لا تجيب عليها إلّا بتزمير لا جدوى له. ما انفكّت مصائبها تزداد، خاصّة وأنّه فُرض عليها ألا تتجوّل إلّا في المدن. هكذا إذن جرى حرمانها من الذهاب من جهة إلى أخرى تحت طائلة غرامات نقدية باهظة.
مبدئياً، ليس أسهل من مناداة تاكسي ومن الطلب من السائق الذهاب إلى توزر. سيقبل السائقُ حتماً وربما يفرك يديه، لأنّ الزبائن الذين يستقلّون سيارات التاكسي باتجاه توزر ليسوا شائعين. في ما يخصّ السائق، سيسعد بالقيادة لفترة طويلة عبر الطريق السيارة، بعيداً عن ازدحام المدن. تدوم الرحلة حوالي ثلاث ساعات، لأنّ المسافة بين تونس العاصمة ومدينة توزر تقارب أربعمائة كيلومتر. عند الوصول، سيُظهر عدّاد سيارة التاكسي مبلغاً طائلاً، هذا ممّا سيزيد في سعادة السائق.
لحسن الحظّ، لن يكون أيّ شيء من هذا ممكناً: ليس بإمكان سيارات التاكسي التجوُّل بحرية بين مختلف الجهات. لكن، للذهاب إلى توزر، يمكنُ استقلال سيارة تاكسي جماعية، أو بما يُلقّب بوجه العموم في تونس بسيارة "لُواجْ". لا أحبّ سيارات التاكسي الجماعية، لا لأنّي سأكون بداخلها مع أناس آخرين، بل بسبب تهوّر السائقين في القيادة. طريقة سيرهم طائشة تماماً.
يكونون دائماً متعجّلين ويقودون بسرعة مُهلكة. كما توجد كذلك رائحة التدخين الباردة المقزّزة التي تحرقُ العيون وتسبّبُ التهاب الحنجرة، ممّا يجعلك تتخيّل بأنّ الموت هنا، حاضر، مستعدّ للعمل في أيّ وقت وفي أيّ مكان على الطريق السيارة. لا أرغب في أن أموت قبل أن أزور ولو لمرّة واحدة قبر أبي القاسم الشابي بتوزر. غنم الموت حياة هذا الشاعر المبكّر في سنّ الخامسة والعشرين. لا أريد أن يعاملني بالمثل: عمري لم يتجاوز الثانية والعشرين.
في يوم من شهر مارس، تحلّيتُ بالشجاعة وقرّرتُ ركوب سيارة تاكسي جماعية باتجاه توزر. دسستُ في جيبي الأيسر الديوان الوحيد للشابي "أغاني الحياة". قلتُ لنفسي أنه ما عدا القراءة يُمكنني استعماله كملجأ في حالة حاول أحدهم الحديث إليّ خلال الرحلة. كنتُ أنوي زيارة الضريح حيث يرقدُ الشاعر واكتشاف الأماكن التي ألهمته. لم أكن إطلاقا أثق في الصور السياحية ولا في البطاقات البريدية.
سيّدة في سنّ النضج تقريباً ركبت الآن بجانبي. يبدو أنّ لا أحد كان قد انتبه إلى حضورها. تبدو أجنبيّة الأصل، حسب هندامها، لكن كم دُهشتُ عندما تحدّثت إلى السائق في لغة عربية فصحى مع بعض الكلمات بالدارجة التونسية، كلّ ذلك في جملة طويلة ذات إيقاع موسيقي جميل. لاحَظت دهشتي لكنّها لم تُعلّق. حتّى عندما غُصْتُ في قراءة ديوان الشابي، اكتفت بالتعرّف على هوية الكاتب والكتاب.
أحسستُ بفضولها يزداد عندما أخرجتُ من جيبي الأيمن دفتري الصغير الذي كنت أدوّن فيه ملاحظات قراءتي. كانت الغريبة تحاول بجدّ فكّ رموز بعض الأبيات التي ترجمتُ. كانت عيناها مشدودتين إلى خربشتي وكأنّها كانت تريد أن تبعث للحياة حضرة مخفيّة، حضرة كانت تشعر بوجودها. فجأة، انحنت نحوي، طوّقت عنقي بيدها اليسرى، وضعت يدها اليمني على ركبتي وشرعت بصوتها الملائكي في تلاوة "صلوات في هيكل الحب": عذبةٌ أنتِ كالطفولة/ كالأحلام/ كاللحنِ كالصباحِ الجديدِ.
تلت هذه الأبيات بالإغريقية. لا أعرف الإغريقية، لكنّي تعرّفت عليها. كالسماء الضحوكِ/ كالليلةِ القمراءِ/ كالوردِ كابتسامِ الوليدِ.
هذه المرّة، تلت بطريقة جليّة بالفرنسية. وكانت أبيات ترجمتي الشخصية. كيف انتبهت إليها؟ كنتُ أمرُّ من دهشة إلى أخرى. عندما وصلنا إلى توزر، أخذتني الغريبة من يدي مُجبِرة إيّاي بلطف أن أتبعها. يبدو أنّ الرحلة لم تُتعبها وكانت تتمكّن بطريقة رائعة من فتح الطريق أمامنا عبر حشد المارّة. كانت تعرف المدينة جيّداً وحتى أماكنها المنعزلة.
وصلنا إلى مكان يُسمّى رأس العين حيث تمثال الشابي. عينا الشاعر البرّاقتان المحفورتان في الجبل كانتا قبالة نسر من حديد. أحسست فجأة بحرارة تتمكّن منّي، وبدأت قواي تنهار. كلّ شيء صار مختلطاً في عيوني ولم أعد أفرّقُ بين صور قصيدة "هكذا غنّى بروميثوس" وتلك التي كنت أراها أمامي منحوتة في الصخر.
تقدّمت الغريبة باتجاهي، حضنتني بين ذراعيها وضمّتني بقوّة شديدة. كانت مثل الوحي: رأيتُ السماء في حجاب أبيض، رأيتُ حولي وفي كلّ مكان ذهباً صافياً.
بعيداً، كانت سيارات التاكسي المراودة تواصل تجوالها.
* شاعر وكاتب تونسي