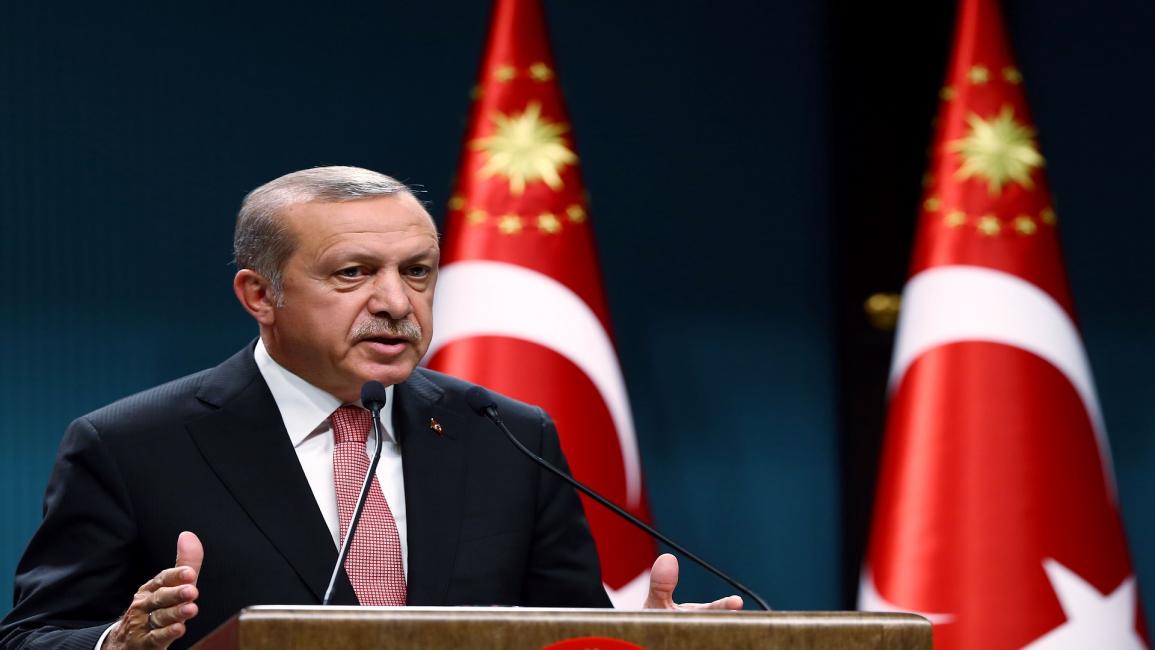09 نوفمبر 2024
تركيا... الحاجة إلى انفراج سياسي واجتماعي
أردوغان: المسارعة لترويج إعادة العمل بعقوبة الإعدام (21 يوليو/2016/Getty)
تحدّث، في غضون الأيام القليلة الماضية، مسؤولون أتراك هم: الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس الحكومة بنعلي يلدريم، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، أن خطرالمحاولة الانقلابية على الحكم ما زال قائماً. وهذه تصريحات بمثابة سلاح ذي حدّين، فهي، من جهة، تشدّد على عامل اليقظة، وأهمية التعامل مع ذيول الانقلاب وحلقاته، بيد أنها، من جهةٍ أخرى، تمنح الانقلابيين وزناً زائداً، وتكرّس حالة من التوتر، ما فتئت تطبق على بلاد الأناضول، منذ ما قبل منتصف ليلة الجمعة/ السبت 15 و16 يوليو/ تموز الجاري. كان إفشال الانقلاب عملاً باهراً، تشارك فيه أردوغان مع رئيس الاستخبارات، حقان فيدان، ورئيس الأركان، خلوصي أكار، غير أن من لعب الدور الحاسم، ونجح في تغيير المزاج السياسي هم حشود الأتراك الذين خرجوا إلى الشوارع، متحدّين إعلان حظر التجول الذي أصدره الانقلابيون. بينما لعبت أحزاب المعارضة الرئيسية: حزب الشعب الجمهوري والحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطي (الكردي) دوراً تاريخياً في نزع البساط من تحت أقدام الانقلابيين، الأمر الذي أدّى إلى خروج البرلمان بموقفٍ "يلعن الانقلاب" بالإجماع. والآن: هل من الحكمة تصوير الأمور على أن الانقلاب لم يفشل تماماً، وأنه متواصل ومستمر بصور مختلفة؟.
مع هذه النجاحات التي ُتحسب لتركيا ونظامها الديمقراطي، ولجموع الشعب وللمعارضة والنواب، فإن حال التوتر ظل قائما، وقد عزّزته التصريحات الرئاسية المتكرّرة التي طالبت بتسليم فتح الله غولن (75عاماً) المقيم في أميركا، وقبل أن يُباشر القضاء تحقيقاته، والتي تتوعّد من يدور في فلك الانقلاب، وهي تصريحاتٌ كان يمكن فهمها وتسويغها، لو أن رئيس الجمهورية وجّه تحيةً للشعب، ولقادة المعارضة وقواعدها، وللنواب ممثلي الشعب المختارين، ولو أن أردوغان تمسّك بالنظام الديمقراطي وآلياته، لكنه لم يفعل. ولعل أجواء الانقلاب، والذي كان ضالعاً فيه آلافٌ من منسوبي القوات المسلحة من رتبٍ عالية ومتوسطة، وشعوره بالصدمة الشديدة، لعل ذلك يفسّر المزاج المتوتّر الذي استبد بالرجل، ولم يفارقه، خصوصاً أنه قد اختار مواجهة الظرف الطارئ العصيب منفرداً، ومع حلقته الأمنية الضيقة فقط، بدلاً من مدّ الجسور نحو القوى السياسية المختلفة، ودعوتها إلى التشارك في حماية الدولة والنظام، وقطع الطريق نهائياً على المغامرات الانقلابية.
ظل هاجس السلطة هو المهيمن على الرجل، بدلاً من القلق على الدولة ونظامها، وعلى الوحدة الوطنية، وعلى ترسيخ حكم القانون. والملاحظات الخارجية، وخصوصاً الأوروبية، لم يجانبها الصواب، بصرف النظر عن النيات، وهي ملاحظاتٌ انصبّت على أهمية حماية العدالة، والاعتصام بها.
لم يفسّر أردوغان، ولا أحد من أركان الحكم، سبب إقصاء 2700 قاضٍ، وهو عدد مهول، في بلد يفترض فيه أن السلطة القضائية فيه مستقلة، وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات. وكذلك التسريحات الكبيرة في سلك التعليم والشرطة، وصولاً إلى إغلاق زهاء 600 مدرسة ومعهد، وهذا عدد خرافي. فحتى في الأنظمة الشمولية، فإنه يتم السيطرة على المدارس والمعاهد، لا إغلاقها. "أغلق مدرسة وافتح سجناً" هل هذا هو النموذج الصالح لحماية الاستقرار، هل بهذه الطريقة يواجَه الانقلاب وتداعياته؟
من حقّ الأتراك أن يقلقوا، فإذا كانت المدارس والمعاهد تتبع غولن وحركته "الخدمة"، فمن
الأوْلى أن لا يُحاسَب أحدٌ على معتقداته، وأن يخضع سلوكه فقط (بما في ذلك التحريض إذا حدث) للمساءلة، حين يقتضي المقتضى القانوني. كيف يمكن لتشريد عشرات الآلاف من الطلبة والمدرسين والإداريين أن يؤدي إلى استتباب السلم الاجتماعي؟. وكيف للجسم القضائي أن يتمتع باستقلاليته وحياديته، وأن ينهض بمسؤولياته، فيما القرارات السياسية تطاول آلاف القضاة، ألا يشكل ذلك تسييساً للقضاء في نظام ديمقراطي، وبما يقوّض ركناً رئيساً من أركان هذا النظام؟.
وأبعد من ذلك، فإن مشاهد إهانة الجنود لا ينطوي على رسالةٍ ضد الانقلاب، فالجنود ينفذون أوامر عسكرية، وليسوا أصحاب قرار، وليس من المصلحة إهانتهم، فذلك يفتك بمعنويات المؤسسة العسكرية، وقد يؤدي إلى حالة احتقان في هذه المؤسسة (صرح زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليشدار أوغلو، بأن قادة الانقلاب، لا الجنود، هم من يجب أن يخضعوا للمحاكمة)، وينطبق ذلك على قرار منع أداء الصلاة على قتلى الانقلاب من الجنود ورجال الشرطة.
تردّد أن الرئيس كان معرّضاً للاعتقال، وربما ما هو أسوأ، وهو في إجازته الصيفية. ولعل ذلك صحيح تماماً، غير أنه لا يبرّر ترويج إعادة العمل بعقوبة الإعدام، فقرارٌ كهذا يحتاج إلى مشاركة قانونيين وقضاة وسياسيين وحقوقيين وبرلمانيين، قبل المسارعة في التلويح به. كان الأجدر التشديد على حكم القانون والعدالة في هذه المرحلة، وعلى أن الانقلابيين لن يفلتوا من العقاب. ولكن، من دون المسارعة إلى إبداء الاستعداد لتغيير قانون العقوبات، بعيداً عن المؤسسات وآلية النظر في القوانين.
الخشية هي في تبديد اللحظة السياسية والوطنية الثمينة للتلاقي الذي حدث بين الحكم والمعارضة والبرلمانيين وحشود المنتفضين ضد الانقلاب. تبديد مناخ الوحدة الوطنية والمشاركة الجماعية في تحمّل مصير الوطن والجمهورية، إذ لا يظهر أحد في المشهد السياسي سوى خمسة من أركان الحكم، وليس من أحدٍ سواهم. تم تضييق الدائرة الواسعة، وبدا الحرص على الحكم والتمسّك بتلابيبه متقدّماً، وطاغياً على الدفاع عن الدولة، وحماية النظام الديمقراطي والسلم الاجتماعي. في هذا السياق، يشير خبراء إلى ما يحيق بالوضع الاقتصادي الذي كان مزدهراً، وتستند المخاوف إلى مخاطر الفوضى السياسية، وهبوط سعر الليرة التركية، وارتفاع العجز، وتراجع السياحة وكلفة نفقات استقبال اللاجئين، وهي مخاطر جدّية، لا يحتاج بعضها إلى رأي الخبراء، كالفوضى السياسية والأهلية المحتملة، والناجمة عن حالة الاحتقان والإقصاء، وانخفاض عدد السياح بصورة كبيرة.. فمن سيشدّ الرحال لزيارة بلد السلاطين، فيما مسؤولو هذا البلد يقولون، بالفم الملآن، إن الحالة الانقلابية لم تنته؟.
لمواجهة ذلك، لا بد من انفراج سياسي واجتماعي ملموسيْن، يستشعرهما المواطن في حياته اليومية، وبدون تراخٍ أمني بالطبع، وبما يمثل مكافأةً مستحقةً للشعب وللمعارضة والبرلمانيين، لدورهم المشهود في إنقاذ وطنهم ودولتهم من الانقلاب وشروره، ويضمن للدولة منعتها وتماسكها، وللنظام تفتحّه وحيويته، ويرسي حكم القانون مرة أخرى بغير افتئاتٍ ورؤوس حاميةٍ وأعصابٍ منفلتة، وبدون أن يفلت الانقلابيون، ومن ساندهم، وتواطأ معهم من المحاسبة والمساءلة، وفق مقتضيات العدالة، لا وفق نازع الانتقام.
مع هذه النجاحات التي ُتحسب لتركيا ونظامها الديمقراطي، ولجموع الشعب وللمعارضة والنواب، فإن حال التوتر ظل قائما، وقد عزّزته التصريحات الرئاسية المتكرّرة التي طالبت بتسليم فتح الله غولن (75عاماً) المقيم في أميركا، وقبل أن يُباشر القضاء تحقيقاته، والتي تتوعّد من يدور في فلك الانقلاب، وهي تصريحاتٌ كان يمكن فهمها وتسويغها، لو أن رئيس الجمهورية وجّه تحيةً للشعب، ولقادة المعارضة وقواعدها، وللنواب ممثلي الشعب المختارين، ولو أن أردوغان تمسّك بالنظام الديمقراطي وآلياته، لكنه لم يفعل. ولعل أجواء الانقلاب، والذي كان ضالعاً فيه آلافٌ من منسوبي القوات المسلحة من رتبٍ عالية ومتوسطة، وشعوره بالصدمة الشديدة، لعل ذلك يفسّر المزاج المتوتّر الذي استبد بالرجل، ولم يفارقه، خصوصاً أنه قد اختار مواجهة الظرف الطارئ العصيب منفرداً، ومع حلقته الأمنية الضيقة فقط، بدلاً من مدّ الجسور نحو القوى السياسية المختلفة، ودعوتها إلى التشارك في حماية الدولة والنظام، وقطع الطريق نهائياً على المغامرات الانقلابية.
ظل هاجس السلطة هو المهيمن على الرجل، بدلاً من القلق على الدولة ونظامها، وعلى الوحدة الوطنية، وعلى ترسيخ حكم القانون. والملاحظات الخارجية، وخصوصاً الأوروبية، لم يجانبها الصواب، بصرف النظر عن النيات، وهي ملاحظاتٌ انصبّت على أهمية حماية العدالة، والاعتصام بها.
لم يفسّر أردوغان، ولا أحد من أركان الحكم، سبب إقصاء 2700 قاضٍ، وهو عدد مهول، في بلد يفترض فيه أن السلطة القضائية فيه مستقلة، وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات. وكذلك التسريحات الكبيرة في سلك التعليم والشرطة، وصولاً إلى إغلاق زهاء 600 مدرسة ومعهد، وهذا عدد خرافي. فحتى في الأنظمة الشمولية، فإنه يتم السيطرة على المدارس والمعاهد، لا إغلاقها. "أغلق مدرسة وافتح سجناً" هل هذا هو النموذج الصالح لحماية الاستقرار، هل بهذه الطريقة يواجَه الانقلاب وتداعياته؟
من حقّ الأتراك أن يقلقوا، فإذا كانت المدارس والمعاهد تتبع غولن وحركته "الخدمة"، فمن
وأبعد من ذلك، فإن مشاهد إهانة الجنود لا ينطوي على رسالةٍ ضد الانقلاب، فالجنود ينفذون أوامر عسكرية، وليسوا أصحاب قرار، وليس من المصلحة إهانتهم، فذلك يفتك بمعنويات المؤسسة العسكرية، وقد يؤدي إلى حالة احتقان في هذه المؤسسة (صرح زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليشدار أوغلو، بأن قادة الانقلاب، لا الجنود، هم من يجب أن يخضعوا للمحاكمة)، وينطبق ذلك على قرار منع أداء الصلاة على قتلى الانقلاب من الجنود ورجال الشرطة.
تردّد أن الرئيس كان معرّضاً للاعتقال، وربما ما هو أسوأ، وهو في إجازته الصيفية. ولعل ذلك صحيح تماماً، غير أنه لا يبرّر ترويج إعادة العمل بعقوبة الإعدام، فقرارٌ كهذا يحتاج إلى مشاركة قانونيين وقضاة وسياسيين وحقوقيين وبرلمانيين، قبل المسارعة في التلويح به. كان الأجدر التشديد على حكم القانون والعدالة في هذه المرحلة، وعلى أن الانقلابيين لن يفلتوا من العقاب. ولكن، من دون المسارعة إلى إبداء الاستعداد لتغيير قانون العقوبات، بعيداً عن المؤسسات وآلية النظر في القوانين.
الخشية هي في تبديد اللحظة السياسية والوطنية الثمينة للتلاقي الذي حدث بين الحكم والمعارضة والبرلمانيين وحشود المنتفضين ضد الانقلاب. تبديد مناخ الوحدة الوطنية والمشاركة الجماعية في تحمّل مصير الوطن والجمهورية، إذ لا يظهر أحد في المشهد السياسي سوى خمسة من أركان الحكم، وليس من أحدٍ سواهم. تم تضييق الدائرة الواسعة، وبدا الحرص على الحكم والتمسّك بتلابيبه متقدّماً، وطاغياً على الدفاع عن الدولة، وحماية النظام الديمقراطي والسلم الاجتماعي. في هذا السياق، يشير خبراء إلى ما يحيق بالوضع الاقتصادي الذي كان مزدهراً، وتستند المخاوف إلى مخاطر الفوضى السياسية، وهبوط سعر الليرة التركية، وارتفاع العجز، وتراجع السياحة وكلفة نفقات استقبال اللاجئين، وهي مخاطر جدّية، لا يحتاج بعضها إلى رأي الخبراء، كالفوضى السياسية والأهلية المحتملة، والناجمة عن حالة الاحتقان والإقصاء، وانخفاض عدد السياح بصورة كبيرة.. فمن سيشدّ الرحال لزيارة بلد السلاطين، فيما مسؤولو هذا البلد يقولون، بالفم الملآن، إن الحالة الانقلابية لم تنته؟.
لمواجهة ذلك، لا بد من انفراج سياسي واجتماعي ملموسيْن، يستشعرهما المواطن في حياته اليومية، وبدون تراخٍ أمني بالطبع، وبما يمثل مكافأةً مستحقةً للشعب وللمعارضة والبرلمانيين، لدورهم المشهود في إنقاذ وطنهم ودولتهم من الانقلاب وشروره، ويضمن للدولة منعتها وتماسكها، وللنظام تفتحّه وحيويته، ويرسي حكم القانون مرة أخرى بغير افتئاتٍ ورؤوس حاميةٍ وأعصابٍ منفلتة، وبدون أن يفلت الانقلابيون، ومن ساندهم، وتواطأ معهم من المحاسبة والمساءلة، وفق مقتضيات العدالة، لا وفق نازع الانتقام.