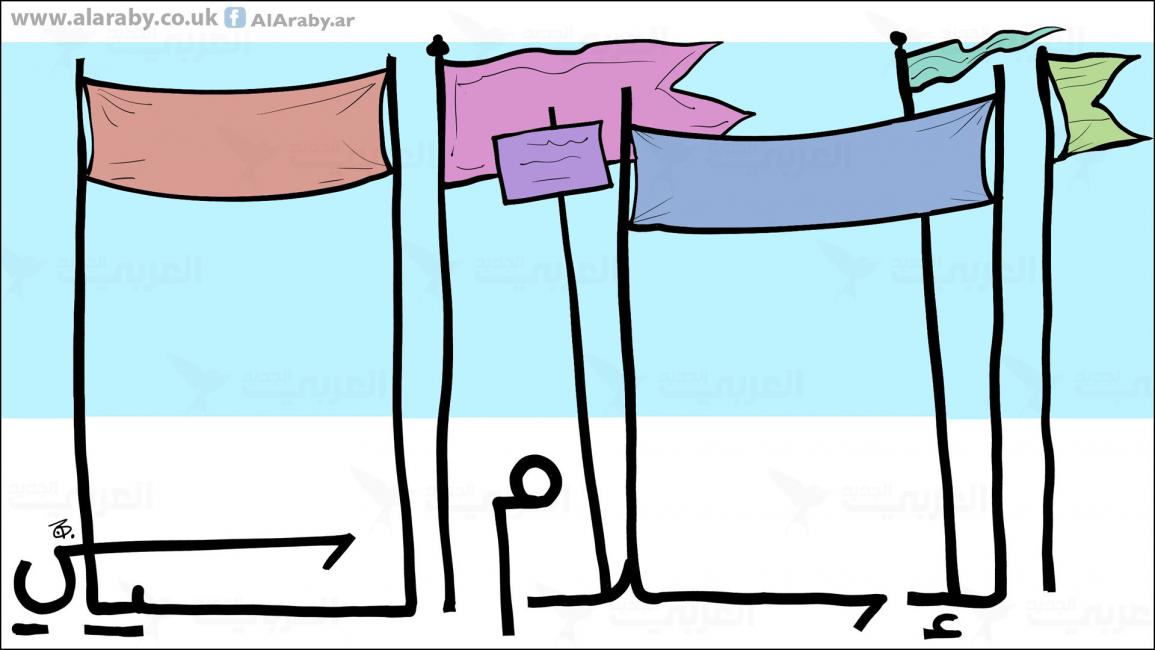23 اغسطس 2020
ثورية الحركات الإسلامية
يظهر البحث عن نشأة العلمانية في الغرب أن جذورها دينية، وأن أصل المصطلح ديني، وليس هذا جديداً ولا اكتشافاً حديثاً. لكن الملفت أن مقاربة التجربة العلمانية الغربية، وبيئتها الدينية، للحالة العربية الراهنة المتشظية طائفياً ومذهبياً وإثنياً، ستقود إلى التفتيش عن دور الحركات الإسلامية، وإسهاماتها في إمكان نهضة عربية ديمقراطية، وفي العلاقة المعيارية بين الدين والسياسة.
ومراجعة دور الحركات الإسلامية العربية، في المشرق والمغرب، تكشف عن دور ثوري كبير لهذه الحركات في الحيز السياسي والاجتماعي، الذي كان محكوماً، إما من نظم علمانية استبدادية، أو أحزاب وحركات قومية ويسارية. ودخول الحركات الإسلامية في سبعينيات القرن الماضي إلى ميدان العمل السياسي والاجتماعي، أحدث ثورة حقيقية، سلباً وإيجاباً، تتمثل أولاً بإدخال شرائح جديدة مستضعفة إلى العمل السياسي، والالتفات إلى القضايا الاجتماعية والمعيشية التي تغنت بها القوى اليسارية والعلمانية، لكنها لم تهتم بها، إذ صبت كل طاقاتها في العمل السياسي المباشر والمواجهة مع إسرائيل.
في فلسطين مثلاً، شكل دخول الحركة الإسلامية في أراضي 1948، ثمانينيات القرن الماضي، العمل السياسي كسراً لهيمنة الحزب الشيوعي الإسرائيلي على العمل السياسي البلدي أولاً، وأدخل قطاعات كبيرة من الشباب في العمل السياسي والاجتماعي، الذي لولا الحركة لما كانوا قد نزلوا ميادين العمل السياسي والوطني، واستكانوا في المساجد والعمل الدعوي، وتحديداً في النقب الذي اعتبر منطقة طرفيةً في العمل السياسي. ووصلت إلى ذروة ذلك، في إعلاء شأن قضية مسجد الأقصى، محلياً وعربياً، وتحويلها إلى قضية جماهيرية تجاوزت السياسي إلى بعد وطني – ديني، يكاد يكون الأمر الوحيد الذي يُجمع عليه الفلسطينيون في مختلف أماكن تواجدهم.
ينطبق ذلك في قطاع غزة والضفة الغربية، إذ أن ظهور حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتفاضة الأولى شكل تحولاً كبيراً ستظهر نتائجه لاحقاً على الساحة الفلسطينية، لكن الأمر الأبرز أن هذه الحركة تمكّنت من استقطاب شرائح واسعة في الشتات أيضاً، لم تتمكّن الفصائل التقليدية من استيعابها. كما تولت الرعاية الاجتماعية لشرائح واسعة من الفلسطينيين، سواء في غزة والضفة أو الشتات، ومنعت سقوط بندقية المقاتل الفلسطيني الذي ظن أن عملية أوسلو نهاية الطريق، وأن الوقت حان لرفع بندقية الدولة، بدلاً من بندقية الثائر المقاوم. ولا داعي للاستطالة لشرح الدور الذي لعبته جماعة الإخوان المسلمين في مصر في تحريك الجماهير وتحشيدهم. ولا داعي للاستفاضة في دور حزب العدالة والتنمية التركي في قلب الحيز السياسي ودمقرطته في البلد، واستقطابه قطاعات واسعة، سواءً في الأناضول أو الأطراف أو حتى الطبقات الوسطى الدنيا.
يشير هذا كله إلى أن الحركات الإسلامية (لا أفضل تسميتها الإسلام السياسي، لأن "العدالة والتنمية" ليس إسلاماً سياسياً في الواقع، بل حزب سياسي يحمل توجهات إسلامية محافظة، لكنها ديمقراطية) لعبت دوراً ثورياً في كسر احتكار قوى تقليدية للعمل السياسي، سواء كانت قومية أو يسارية علمانية أو عشائرية، وفي الوقت نفسه، التفتت في نشاطها إلى العمل الاجتماعي في أوساط المستضعفين.
ما الاستنتاج من هذا كله؟ الاستنتاج أن للحركات الإسلامية دوراً مصيرياً في تأسيس نهضة عربية ديمقراطية حقيقية، لكن ذلك يتطلب منها الارتقاء إلى مستوى آخر من التحديات. فإذا كان دور هذه الحركات ثورياً في العقود الأربعة الأخيرة على صعيد التنظيم والممارسة، لكنه لم يكن كذلك على صعيد الخطاب السياسي والاجتماعي، بل أنه كان رجعياً في حالات كثيرة، لما حمل من طائفيةٍ ومذهبيةٍ وتحديداً في الأزمات، أي أن هذه الحركات لم تتمكّن من استثمار ثوريتها في الخطاب السياسي العصري والعقلاني. لذا فإن مهمتها، في المرحلة المقبلة، لا تقل ثورية، لكنها تحمل عنواناً آخر، بدلاً من العمل السياسي والاجتماعي المباشر، وهو التجديد الفكري الديني والتطور السياسي. فقرب هذه الحركات من الجماهير لم يحمها من عسف السلطة. وتبيّن، في أول امتحان، أنها غير متهيئة لقيادة الانتقال من النظام القديم إلى الجديد، كما حصل في مصر مثلاً، إذ وصلت الحركة الإسلامية إلى السلطة محمية من الجماهير، لكنها لم تملك أي خبرة سياسية، أو خطاباً سياسياً عصرياً لإدارة الدولة والمجتمع والمرحلة الانتقالية. ولم تتوفر لديها مراكز تفكير وأبحاث تقدّم لها الاستشارة والرؤية لمواجهة التحديات الجسام، إلى درجة أنها لم تمتلك وسائل إعلام جماهيرية ومؤثرة، سوى قنوات الدعاة الذين هم غالباً على دين حكامهم.
لم يتجدد الفكر السياسي الديني غالباً، منذ كتابات سيد قطب الشهيرة، إلا في حالات قليلة، مثل تونس. وغالباً، لم يتطور العمل السياسي للحركات الإسلامية، لأنه تقوقع على نفسه، ودخل في نفسية مظلومية تارةً، وشعور بالثقة الزائدة بالنفس تارةً أخرى. وأي مشروع سياسي ضخم، إسلامياً كان أم علمانياً، لن يكتب له الاستمرار من دون تجديد فكري وتطور سياسي، والطريقة لإحداث ذلك هي بمراكز الأبحاث ووسائل الإعلام المؤثرة التي تخاطب الجماهير وتبث فكراً وخطاباً حديثاً. وتتحول هذه الحركات، بغير ذلك، إلى حركة دعوية وحركة أسيرة في سجون الاستبداد.
وتؤكد تجارب إسلامية غير عربية، في إندونيسيا وتركيا مثلاً، أن للحركات الإسلامية دوراً محورياً في ترسيخ الديمقراطية العلمانية، بعد انهيار النظام القديم، أولاً من خلال ما اصطلح عليه "العلمنة الداخلية للدين"، أي نزع الممارسات غير العقلانية والسحرية عن الدين، وتحويلها إلى ممارسات عقلانية، من دون المس بقدسية الدين، والتمييز بين "القيم المتعالية"
و"القيم المؤقتة" بحسب تعبير المفكر الإسلامي الإندونيسي، نورشليش مجيد، الذي دعا، في سبعينيات القرن الماضي، في محاضرة شهيرة أمام الطلاب، إلى "تأقيت" الفكر والممارسة الإسلامية، و"الاستعداد العقلي للبحث وإعادة البحث في حقيقة القيم"، ويخلص إلى أن "تقديس أي شيء سوى الله هو في الحقيقة شرك"، فالله هو القيمة المتعالية الوحيدة. ودعم مجيد فكرة العلمانية، على اعتبار أنها تحرّر العقل، وذلك يفيد في تطوير الممارسات الدينية. وقدم مجيد، والحركات الإسلامية في إندونيسيا، فكراً ثورياً حقيقياً يدعو إلى نظام جديد، يؤسس على الديمقراطية العلمانية، فيما القوى التقليدية التي ترتبط بالنظام القديم تحفظت على الديمقراطية على الرغم من علمانيتها.
خلاصة القول، إن ثورية الحركات الإسلامية في العقود الماضية لم ترتق إلى الخطاب السياسي، بل اقتصرت على الممارسة والتنظيم. ومن دون هذه الثورية في الخطاب السياسي والديني، فإنها تضع حداً لمسيرتها بنفسها. في المقابل، سيكون حالماً ذاك العلماني والديمقراطي الذي يظن أنه بالإمكان نهضة عربية حقيقية، من دون مشاركة قوى إسلامية، تصحح العلاقة المعيارية ما بين الدين والسياسة، أي الدين والديمقراطية، وإطارها العلماني، الذي من دونه لن تكون ديمقراطية.
ومراجعة دور الحركات الإسلامية العربية، في المشرق والمغرب، تكشف عن دور ثوري كبير لهذه الحركات في الحيز السياسي والاجتماعي، الذي كان محكوماً، إما من نظم علمانية استبدادية، أو أحزاب وحركات قومية ويسارية. ودخول الحركات الإسلامية في سبعينيات القرن الماضي إلى ميدان العمل السياسي والاجتماعي، أحدث ثورة حقيقية، سلباً وإيجاباً، تتمثل أولاً بإدخال شرائح جديدة مستضعفة إلى العمل السياسي، والالتفات إلى القضايا الاجتماعية والمعيشية التي تغنت بها القوى اليسارية والعلمانية، لكنها لم تهتم بها، إذ صبت كل طاقاتها في العمل السياسي المباشر والمواجهة مع إسرائيل.
في فلسطين مثلاً، شكل دخول الحركة الإسلامية في أراضي 1948، ثمانينيات القرن الماضي، العمل السياسي كسراً لهيمنة الحزب الشيوعي الإسرائيلي على العمل السياسي البلدي أولاً، وأدخل قطاعات كبيرة من الشباب في العمل السياسي والاجتماعي، الذي لولا الحركة لما كانوا قد نزلوا ميادين العمل السياسي والوطني، واستكانوا في المساجد والعمل الدعوي، وتحديداً في النقب الذي اعتبر منطقة طرفيةً في العمل السياسي. ووصلت إلى ذروة ذلك، في إعلاء شأن قضية مسجد الأقصى، محلياً وعربياً، وتحويلها إلى قضية جماهيرية تجاوزت السياسي إلى بعد وطني – ديني، يكاد يكون الأمر الوحيد الذي يُجمع عليه الفلسطينيون في مختلف أماكن تواجدهم.
ينطبق ذلك في قطاع غزة والضفة الغربية، إذ أن ظهور حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتفاضة الأولى شكل تحولاً كبيراً ستظهر نتائجه لاحقاً على الساحة الفلسطينية، لكن الأمر الأبرز أن هذه الحركة تمكّنت من استقطاب شرائح واسعة في الشتات أيضاً، لم تتمكّن الفصائل التقليدية من استيعابها. كما تولت الرعاية الاجتماعية لشرائح واسعة من الفلسطينيين، سواء في غزة والضفة أو الشتات، ومنعت سقوط بندقية المقاتل الفلسطيني الذي ظن أن عملية أوسلو نهاية الطريق، وأن الوقت حان لرفع بندقية الدولة، بدلاً من بندقية الثائر المقاوم. ولا داعي للاستطالة لشرح الدور الذي لعبته جماعة الإخوان المسلمين في مصر في تحريك الجماهير وتحشيدهم. ولا داعي للاستفاضة في دور حزب العدالة والتنمية التركي في قلب الحيز السياسي ودمقرطته في البلد، واستقطابه قطاعات واسعة، سواءً في الأناضول أو الأطراف أو حتى الطبقات الوسطى الدنيا.
يشير هذا كله إلى أن الحركات الإسلامية (لا أفضل تسميتها الإسلام السياسي، لأن "العدالة والتنمية" ليس إسلاماً سياسياً في الواقع، بل حزب سياسي يحمل توجهات إسلامية محافظة، لكنها ديمقراطية) لعبت دوراً ثورياً في كسر احتكار قوى تقليدية للعمل السياسي، سواء كانت قومية أو يسارية علمانية أو عشائرية، وفي الوقت نفسه، التفتت في نشاطها إلى العمل الاجتماعي في أوساط المستضعفين.
ما الاستنتاج من هذا كله؟ الاستنتاج أن للحركات الإسلامية دوراً مصيرياً في تأسيس نهضة عربية ديمقراطية حقيقية، لكن ذلك يتطلب منها الارتقاء إلى مستوى آخر من التحديات. فإذا كان دور هذه الحركات ثورياً في العقود الأربعة الأخيرة على صعيد التنظيم والممارسة، لكنه لم يكن كذلك على صعيد الخطاب السياسي والاجتماعي، بل أنه كان رجعياً في حالات كثيرة، لما حمل من طائفيةٍ ومذهبيةٍ وتحديداً في الأزمات، أي أن هذه الحركات لم تتمكّن من استثمار ثوريتها في الخطاب السياسي العصري والعقلاني. لذا فإن مهمتها، في المرحلة المقبلة، لا تقل ثورية، لكنها تحمل عنواناً آخر، بدلاً من العمل السياسي والاجتماعي المباشر، وهو التجديد الفكري الديني والتطور السياسي. فقرب هذه الحركات من الجماهير لم يحمها من عسف السلطة. وتبيّن، في أول امتحان، أنها غير متهيئة لقيادة الانتقال من النظام القديم إلى الجديد، كما حصل في مصر مثلاً، إذ وصلت الحركة الإسلامية إلى السلطة محمية من الجماهير، لكنها لم تملك أي خبرة سياسية، أو خطاباً سياسياً عصرياً لإدارة الدولة والمجتمع والمرحلة الانتقالية. ولم تتوفر لديها مراكز تفكير وأبحاث تقدّم لها الاستشارة والرؤية لمواجهة التحديات الجسام، إلى درجة أنها لم تمتلك وسائل إعلام جماهيرية ومؤثرة، سوى قنوات الدعاة الذين هم غالباً على دين حكامهم.
لم يتجدد الفكر السياسي الديني غالباً، منذ كتابات سيد قطب الشهيرة، إلا في حالات قليلة، مثل تونس. وغالباً، لم يتطور العمل السياسي للحركات الإسلامية، لأنه تقوقع على نفسه، ودخل في نفسية مظلومية تارةً، وشعور بالثقة الزائدة بالنفس تارةً أخرى. وأي مشروع سياسي ضخم، إسلامياً كان أم علمانياً، لن يكتب له الاستمرار من دون تجديد فكري وتطور سياسي، والطريقة لإحداث ذلك هي بمراكز الأبحاث ووسائل الإعلام المؤثرة التي تخاطب الجماهير وتبث فكراً وخطاباً حديثاً. وتتحول هذه الحركات، بغير ذلك، إلى حركة دعوية وحركة أسيرة في سجون الاستبداد.
وتؤكد تجارب إسلامية غير عربية، في إندونيسيا وتركيا مثلاً، أن للحركات الإسلامية دوراً محورياً في ترسيخ الديمقراطية العلمانية، بعد انهيار النظام القديم، أولاً من خلال ما اصطلح عليه "العلمنة الداخلية للدين"، أي نزع الممارسات غير العقلانية والسحرية عن الدين، وتحويلها إلى ممارسات عقلانية، من دون المس بقدسية الدين، والتمييز بين "القيم المتعالية"
خلاصة القول، إن ثورية الحركات الإسلامية في العقود الماضية لم ترتق إلى الخطاب السياسي، بل اقتصرت على الممارسة والتنظيم. ومن دون هذه الثورية في الخطاب السياسي والديني، فإنها تضع حداً لمسيرتها بنفسها. في المقابل، سيكون حالماً ذاك العلماني والديمقراطي الذي يظن أنه بالإمكان نهضة عربية حقيقية، من دون مشاركة قوى إسلامية، تصحح العلاقة المعيارية ما بين الدين والسياسة، أي الدين والديمقراطية، وإطارها العلماني، الذي من دونه لن تكون ديمقراطية.