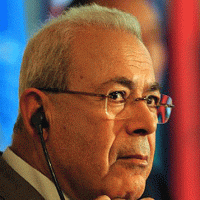17 أكتوبر 2024
حان الوقت لتجاوز طفولتنا السياسية
نازح من إدلب فرارا من غارات الروس والنظام (13/2/2020/الأناضول)
(1)
أعادت مأساة إدلب ومعاناة أبنائها إلى الواجهة المشكلة التي نعيشها منذ بداية الثورة السورية، من دون أن نجد جوابا شافيا لها، وهي إيجاد مركز قرار يوجه خطانا، ويثمر جهودنا ويعزّز من صدقية قوتنا السياسية، ويراكم الخبرة الضرورية لانتزاع حقنا في أن نقرّر مصيرنا بأنفسنا، أو على الأقل أن نشارك في القرارات التي تتعلق برسم مصيرنا الوطني، كسوريين. وقد فشلت جميع جهودنا لإيجاد مثل هذا المركز، وبقينا أشتاتا متفرقة، ومجموعات تعمل كل واحدة منها حسب رأيها وظروفها واعتقاداتها، وشيئا فشيئا حسب ما تطلبه منها القوى التي تضمن بقاءها، او حسب ما تعتقد هي أنه مفيدٌ للتقرّب من هذه القوى الخارجية، للحفاظ على موقعها ووجودها.
لا يوجد أي شك في أنه كان للتدخلات الأجنبية الدور الأكبر في تمكين الأسد من خوض الحرب التي فرضها على الثورة، والاستمرار فيها، بفضل ما قدّمه له شركاؤه الإيرانيون والروس من دعم متعدّد الأشكال، لوجستي وعسكري ومالي وإعلامي ودبلوماسي، لا يمكن مقارنته بما توفر لقوى الثورة والمعارضة. ولا يوجد أي شكّ كذلك في أن الغرب الديمقراطي الذي كان الحليف المنتظر للديمقراطيات الوليدة في العالم أجمع، والذي راهن على تدخله قسمٌ كبير من الجمهور السوري الملوّع بعنف النظام، تردّد في الوقوف إلى جانب السوريين، وعمل على تشتيت قواهم بدل مساعدتهم على تنظيم أنفسهم ومواجهة أعدائهم، على الرغم مما كان قد أغراهم به من وعود وآمال، منذ تبنّيه شعار تنحي الأسد. وهذا ما تجلى في افتقار من أطلقوا على أنفسهم اسم "أصدقاء الشعب السوري"، والذين تجاوز عددهم في أول مؤتمراتهم 70 عضوا، للإرادة والاستراتيجية والوسائل اللازمة لردع الأسد عن الاستمرار في حرب الإبادة وانتهاك قرارات مجلس الأمن وتجنيب السوريين الكارثة الإنسانية التي يشكل التملص من عواقبها اليوم سببا جديدا لاستمرار الحرب. ولا يوجد شك أيضا في أثر الإرث السلبي لنصف قرن مما ينبغي أن نسميه حرب الاستنزاف التي خاضها نظام الأسد لتحطيم المجتمع، وقتل روحه وقيمه الإنسانية، في تعميم انعدام الثقة والافتقار إلى الخبرة السياسية والتجارب التنظيمية، ولا في أثر وفعالية الألغام التي زرعتها السلطة المخابراتية بين جنبات المجتمع، والتي احتفظت وحدها بمفتاح تفجيرها في اللحظة المناسبة، لفرط عقده، وتوجيه طوائفه بعضها ضد بعض، وزعزعة إرادة السوريين وإرهابهم.
ولا يوجد شكٌّ أخيرا في الأثر السياسي المدمر لنزوع النخب السلفية إلى تصدّر الخطاب وواجهة
الكفاح المسلح، ومحاولة الإسلام السياسي عموما ابتلاع الثورة وتجييرها لحسابه السياسي الخاص، بصرف النظر عن الدوافع والنوايا والتدخلات الخارجية، أقول لا يوجد شكٌّ في أثر ذلك كله على تراجع صدقيتنا السياسية وانقلاب الرأي العام العالمي علينا. وما كان للصعود المدوي لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وإعلانه عن تأسيس "دولة الخلافة"، بعد تمكّنه من الوصول إلى الوسائل العسكرية التي جعلته قوةً يحسب حسابها، ليعيد قلب الصورة تماما، فيحلّ مصطلحات الجهاد والكفر والطائفية والإرهاب محل مصطلحات ثورة الحرية والكرامة والمواطنة والدولة المدنية التعدّدية، ويقضي على أي أمل لنا باستعادة تأييد الرأي العام العالمي، بل العربي، وتعاطفه مع الثورة السورية وشعاراتها التحرّرية.
كل ذلك أصبح من البديهيات المعترف بها من الجميع، لكن البقاء على هذا المستوى من التحليل لا يقدّمنا كثيرا ولا يفسّر، في ما وراء ذلك، التراجع المستمر الذي تشهده قضيتنا، بالرغم من استمرار الشعب في تقديم التضحيات الباهظة. إنه يدفعنا، كما هو ظاهر منذ سنوات، ببساطة، إلى اليأس من قدرتنا على العمل كشعب مستقل، وإلى الاستقالة السياسية والرهان، في خلاصنا على تقاطع المصالح الدولية، أو انتظار المعجزات والتحولات الاستثنائية التي لا نملك أي إمكانية لإحداثها أو التسريع بحصولها.
(2)
ما زلت أعتقد أن مشكلتنا الرئيسية، قبل أن تكون خارجية، تكمن في انقساماتنا الداخلية أولا، وغياب أي استراتيجية مستقلة وفعالة، للعمل على تحقيق الأهداف التي لا نزال متمسّكين بها بعد تسع سنين من التضحيات والمعاناة القاسية ثانيا. ومن يتأمل في ممارستنا السياسية يدرك بسهولة أننا عقدنا العزم على التعايش مع هذه الانقسامات، داخل المعارضة نفسها، والاستغناء عن أي محاولة لبناء استراتيجية مستقلة، تراعي أوضاعنا، وتعتمد على تطوير قوانا الذاتية، وترتبط بحساباتنا الوطنية. وتتلخص استراتيجيتنا الراهنة عمليًا بالرهان على انتظار ما يحتمل أن تنتجه الضغوط الدولية، وعلى ما يمكن أن يصيبنا من مكاسب جانبية، في حال نجحت القوى الدولية التي تؤيدنا في تحقيق أهدافها الوطنية. وعلى احتمال تفاهم دولي يصبّ في مصلحتنا ولو جزئيا. وأخيرا على نتائج العقوبات الاقتصادية على النظام وحلفائه. وبينما يتفاءل بعضنا باحتمال تفاهم روسي أميركي يفتح الطريق المغلق نحو تسوية سياسية ولو بحدها الأدنى، يغذي بعضنا الآخر الوهم في أن تؤتي العقوبات الاقتصادية والسياسية التي وضعها المجتمع الدولي على النظم الثلاث: السورية والإيرانية والروسية، أكلها، وتجبر هؤلاء على الصّدع للإرادة الدولية، ممثلة بقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى انتقال سياسي، يقوم به السوريون أنفسهم، في وقتٍ أصبح من الصعب فيه تحديد هوية "السوريين"، بل هوية المعارضة السورية ذاتها. ويذهب بعضنا، أبعد من ذلك، إلى أنه لم يعد لنا أملٌ في الخروج بحلٍّ ينقذ آخر ما تبقى لنا من مصالح وطنية سوى الالتحاق بخطط واستراتيجيات الدول التي نعتقد أن بإمكانها أن ترعى بشكل أفضل من غيرها مصالحنا، أو تلك التي تتقاطع مصالحها الوطنية مع إعادة السلام والاستقرار الإقليمي، مع الأمل في أن يرافق وقف الحرب إدخال الحد الأدنى من الإصلاحات السياسية إلى نظامٍ يصوغه الروس على شاكلة نظامهم شبه القيصري.
وإلى حد كبير، تفسر هذه المواقف والرهانات الاستراتيجية الضعيفة انعدام أي نقاش جدّي داخل
صفوف المعارضة حول الخط السياسي والاستراتيجية والخيارات الاجتماعية، باستثناء التناحر بين إسلاميين وعلمانيين، والذي يشكل هو نفسه انعكاسًا للاصطفافات الإقليمية، حتى لم يعد من المبالغة القول إن الولاء الخارجي أصبح المحدّد الرئيس لاختلاف المواقف السياسية أو الخط السياسي لمجموعات المعارضة المتعدّدة، كما أظهرت ذلك بجلاء بدعة المنصّات السياسية التي لا تحدد هويتها سوى أسماء العواصم والمدن التي عقدت فيها اجتماعاتها التأسيسية، فلا يتميز "سياسيو" المعارضة اليوم بنوعية توجهاتهم الفكرية والاجتماعية والاقتصادية أو السياسية، وإنما بخياراتهم الاستراتيجية أو تحالفاتهم الإقليمية والدولية.
يعتقد الموالون للتحالف مع تركيا أن أنقرة هي الحليف الأهم لما تمثله من قوة إقليمية، وتملكه من أوراق النفوذ، وفي مقدمها السيطرة على أجزاء استراتيجية من الجغرافيا السورية، وعلاقتها القوية والمباشرة مع القسم الأعظم من القوى العسكرية المنظمة التي نشأت خلال الثورة، ولا تزال قادرة على الفعل. في المقابل، يعتقد خصومهم ومنافسوهم أن "المخلص" الوحيد الذي يملك أوراق التغيير في سورية هو موسكو لما تتمتع به من روح المبادرة، وما تمثله اليوم من سلطة وصاية فعلية على دمشق، ومن سيطرة على الأرض، ومن نفوذٍ داخل أجهزة الدولة والنظام، وما تحظى به من مكانةٍ وإمكانات قوة عظمى عسكرية، تؤهلها للعمل من الداخل السوري، وبحرية أكبر من أي دولة أخرى. أما الفريق الآخر فهو لا يرى أملا في أي تقدم ممكن من دون العمل مع الولايات المتحدة التي تشكل القطب الوحيد القادر على الوقوف في وجه التحالف الروسي الإيراني الذي يقبض على رقابنا، والتي كان لها الدور الأكبر في إضعاف النظام وحلفائه من خلال ما فرضته عليه من عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، وما يمكن أن تفرضه عليه من عقوبات جديدة وملاحقات قانونية لمجرمي الحرب السورية، بعد تصويت الكونغرس على قانون قيصر لحماية المدنيين في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2019.
(3)
ليس لهذه "الاستراتيجية" التي تراهن على حسن نية الدول المتنازعة على اقتسام الإرث الأسدي في سورية أي مضمون سوى اعتراف المعارضة، بمختلف منصاتها ومؤسساتها، بالهزيمة السياسية والتسليم بها. وهذا هو الوصف الحقيقي لوضعنا اليوم، معارضين راديكاليين ومعتدلين، بعد أن سلمنا بانعدام قدرتنا على العمل الجماعي، والفعل المتسق والمنسق، وانقسمنا بين موالين لهذه الدولة أو تلك، وقبلنا بترك المستقبل رهين ما يجود به الموقف الدولي ونتائج الصراع الدائر من حولنا وعلينا. وكما هي العاقبة لأي هزيمة، ما كان لنا أن نبلع الموسى، من دون أن يدب الإحباط في نفوسنا، وفي أثره الشك بالذات، وانعدام الثقة واختلاق المثالب الذاتية والنقص الولادي أو التكويني. هكذا بينما يعمل الروس، بكل الوسائل، لإعادة تأهيل النظام الفاجر، المسؤول عن قتل الألوف وخراب البلاد، حتى يستعيدوا من خلاله السيطرة على كامل الجغرافيا السورية، ويفرضوا الحل الذي يناسبهم، ينشغل نشطاؤنا وكثيرون من أفراد المعارضة وسياسييها ومفكريها بنشر غسيل بعضهم، والتشكيك بنواياهم، وفي خلق الخصوم والعداوات والمظلوميات على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي. ويسود الاعتقاد، على طريقة ما كان يحدث في القرون الوسطى من ملاحقة الساحرات وحرقهن، بأن ملاحقة هؤلاء ومحاسبتهم وشل فاعليتهم، إن لم يكن إخراجهم من الحياة وإجبارهم على الاختفاء، هو السبيل الوحيد لتطهير الثورة من أخطائها وأسباب فشلها وإعادة إطلاقها ناصعةً وبيضاء كالثلج.
والواقع أن الحرب التي كنا نخوضها ضد النظام وحلفائه قد انتقلت، من دون أن ندري، إلى داخل
صفوفنا، بذريعة الكشف عن المندسّين والخونة والمتآمرين والفاسدين. وحل محل الحوار والنقاش المطلوبين من أجل بلورة رؤية وخط سياسيين أكثر نجاعةً وفاعلية، يمكّنان المعارضة من استعادة صدقيتها وتفاعلها مع جمهورها، والمساهمة في رصّ صفوفه، وتنظيم مقاوماته المتنامية، التسابق على تأسيس الكيانات والمؤسسات والتجمعات المتنافسة على شرعية تمثيل الثورة، أو الداعية إلى عقد مؤتمرات وطنية بحجم أعضائها، وعدد المجموعات والمنصّات المتنازعة على ملء الفراغ، ووراثة موقع لم يعد له وجود. وبهذا، يستطيع كل فريق أن يبرئ نفسه، ويحمل مسؤولية فشل المعارضة على الآخرين، ويتطهر من الخطيئة المحتملة بالتشهير بالنخب السياسية المنافسة. ومن البديهي ألّا ينجم عن هذا المسعى أي تحليلٍ موضوعي، يساعد على تجلية الموقف وتقدم النقاش، ولا من باب أولى تدشين مرحلة جديدة وشق طريقٍ يقود إلى إعادة تأسيس سياسي جديد، أو يساعد على بناء أي مقاومةٍ فعلية وفعالة لقلب موازين القوى وفرض التغيير. إنه يمثل بالأحرى نوعا من الانتحار السياسي الجماعي، ونهاية حزينة لملحمة كبرى، لا بداية لأي حل.
من السذاجة الاعتقاد أن من الممكن خلاص سورية اليوم من دون تعزيز الضغوط الدولية، وحدّ أدنى من تفاهم الدول الكبرى المتنازعة على النفوذ في سورية والمنطقة الشرق أوسطية، ومن خلالها على السيطرة الإقليمية والعالمية، وذلك بمقدار ما أصبحت الحرب السورية إقليمية ودولية معا. ولكن من السذاجة أيضا الاعتقاد أن نهاية هذه الحرب يمكن أن تضمن الحد الأدنى من المصالح الأساسية لسورية والسوريين معا، من دون وجود فاعل جمعي ومؤسّسي سوري يجسّد هذه المصالح، ويمثل السوريين فيها، ومن ثم من دون وجود استراتيجية وخطة عمل سورية للدفاع عنها. وغياب مثل هذا الفاعل يعني أن الدول، في أحسن الأحوال، سوف تنظر إلى المصالح السورية من منظار مصالح تلك القوى السورية التي تواليها، إن لم نقل تعمل كأدوات في خدمة أهدافها. وهذا يعني مضاعفة خريطة تقاسم النفوذ الدولي في سورية بخريطة تقاسم نفوذ سورية سورية، لا تجعل من سورية دولةً فاشلةً فحسب، ولكنها تحول دون قيامها دولة مدنية تعدّدية، تضمن كرامة أبنائها وحقوقهم المتساوية في المواطنة المتساوية والحرّة التي تبرّر وحدها تضحيات الملايين منهم بأشكالها المختلفة.
(4)
في المقابل، لا أعتقد أننا، على الرغم من كل ما أصابنا ولا يزال يصيبنا، قد أسقط نهائيا في يدنا ولم يعد أمامنا خيار سوى الاستسلام للقدر، والقبول بالالتحاق بالقوى الأجنبية، والتفرّغ خلال "الوقت الضائع" لتصفية حساباتنا الداخلية، على أمل قطف بعض ثمار التسوية الدولية. وعلى الرغم من المحن والمآسي التي يعيشها السوريون، في كل المناطق والمواقع، والتي تنذر بتدهور الأوضاع لوقت طويل قادم، ولهذا السبب بالذات، ينبغي أن نوقن أن هناك خيارات أخرى أمامنا، وأن الحل لا يكمن، مهما كان الحال، في الارتماء في أحضان القوى الدولية أو المراهنة على هذا المحتل أو ذاك، ولا من باب أوْلى في التخلي عن مسؤولياتنا والخلود لليأس والانتحار السياسي، فالنظام، على الرغم من احتفاظه بوجوده الشكلي، قد انهار تماما أمام الضربات القوية والمستمرة منذ سنوات، لجمهور رمى بنفسه على الموت للتخلص من الطاغية، ولولا هزيمته لما اضطر إلى الاستعانة بالمليشيات والجيوش الأجنبية. وهو لم يعد يعني شيئا لأي طرفٍ، بما في ذلك رجالاته الذين يبحثون عن حماتهم الخارجيين.
كما أن الصراع بين القوى المحتلة أصبح أكثر فأكثر احتداما، بعد أن أدركت جميعها أنها وصلت إلى طريق مسدود، وأن من الصعب، إن لم يكن المستحيل، التوفيق بين مصالحها، بمقدار ما تغلب البعد الجيوسياسي لهذه المصالح على أبعادها الأخرى، وصار الأمر يتعلق مباشرة بالنسبة لجميعها بالدفاع عن موقعها ودورها وهيبتها في التوازنات الإقليمية والدولية. بالإضافة إلى أن المنطقة تعيش اليوم بأكملها في غليانٍ شعبي لا يهدأ، من الجزائر إلى العراق، بما في ذلك داخل إيران الخامنئية ذاتها التي لعبت الدور الأكبر في تأجيج صراعاتها، وزرع الخراب والفوضى في حياة مجتمعاتها.
وتكاد جميع نخب المنطقة السياسية تكون اليوم فاقدة للشرعية، وعاجزة عن استعادة الحد الأدنى
من الصدقية التي تمكّنها من تهدئة الجمهور المهدّد في حياته ومستقبله. وينذر ذلك كله بحقبة من زعزعة الاستقرار الشامل واستمرار القلاقل والاضطرابات التي لا يمكن أن تنتهي من دون تغيير عميق في أسلوب ممارسة السلطة والحكم في هذه المناطق، ومن دون معالجة شمولية للأزمة الإقليمية المستمرة منذ نهاية الحقبة العثمانية، والتي افتتحتها الاتفاقية الفرنسية الإنكليزية التي كرّست الانقسام الدائم والعداء والتنافس بين الدول الجديدة، الهشّة والفاقدة للسيادة والثقة والقوة، والتي زادها تفجرا واشتعالا المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الذي لا يزال يصب الزيت على نارها، ويحرم المنطقة من أي أمل في السلام والاستقرار. وهذا يعني أن شيئا لم يحسم ولن يحسم قريبا في الصراع الدائر في منطقتنا، وأن حسم النزاع والتوصل إلى حالةٍ من الأمن والاستقرار الاقليمي والوطني لن يتحقق في هذه المنطقة، من دون تعافي شعوبها وتمكنها من استعادة المبادرة، وأخذ مصيرها بيدها، والتخلي عن انتظار مبادرات القوى الخارجية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء والازدهار. فلا تنبع المشكلة التي نواجهها من الإرث الثقيل الذي خلفه الاستعمار، والذي تجسّد في التشكيل الجيوسياسي البنيوي الملغوم للمنطقة، وفي إدارته صراعاتها بما يضمن استمرار تبعيتها واختلال توازناتها وبؤس نموها فحسب، وإنما ينجم أيضا عن عجزنا عن تطوير أنماط من التفكير والسلوك الفردي والجماعي التي لا بد منها لتجاوز تفتتنا وتخبطنا الاستراتيجي، واستعادة المبادرة السياسية.
يكمن قسط كبير من المشكلة في نمط تفكيرنا وممارستنا، فنحن نعيش تناقضاتٍ نرفض الاعتراف بها. نفكر بطريقة ونعمل عكسها. نقول إن العالم يقف ضدنا، لكننا لا نكفّ عن مطالبته بالتدخل
لصالحنا. ونقول إنه هو أصل مشكلاتنا وسبب ضعفنا، وننتظر منه أن ياتي ليحل مشكلاتنا أو يساعدنا على حلها. ونعترف بضعفنا وتقصيرنا في تنمية قدراتنا، ولا نعمل أي شيء لتجاوز انقساماتنا وتطوير قدراتنا الذاتية، وتعزيز التواصل والتفاهم والتعاون فيما بيننا، والسعي الجدي إلى تحسين أنماط التنظيم والإدارة لجهودنا. نقول دولة الأسد انتهت وزالت، وهي زالت بالفعل، لكننا لا نقوم بأي عملٍ من أجل بناء البديل السياسي، أي البذرة الحاملة لدولة الشعب أو دولة المواطنة التي تملأ الفراغ، وتحل محل الدولة البائدة أو على الأقل تعد لذلك. نتحدّث عن وطنية وقيم ديمقراطية، وكل جهدنا مكرس لتحطيم بعضنا بعضا، وإقصاء واحدنا الآخر، وتشويه وجهة نظره وتسويد صفحته واسمه.
والحال لن نستطيع أن نقنع المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانبنا، ونستفيد جدّيا من فرص التضامن من مؤسسات قانونية وحقوقية، ونحن نكاد نسلم بعجزنا عن حل خلافاتنا وتحقيق الاتفاق والتفاهم فيما بيننا. ولن نتمكّن من بناء الديمقراطية التي هي هدفنا الأول، من دون أن نعمل على تكوين قوى ديمقراطية منظمة. ولن تفيدنا المراهنة على تدخل تركيا أو روسيا أو أميركا أو أوروبا لصالح مشروع الديمقراطية السورية، إذا لم تتجلّ ملامح هذا المشروع، ولم تظهر في ممارساتنا وعملنا وتفكيرنا. ولا يمكن أن نطمح إلى أن تضحّي الدول من أجلنا إذا لم نظهر، نحن أنفسنا، استعدادنا للتضحية في سبيل قضيتنا، والاستثمار في مشروع تحرّرنا. كما سيكون من المستحيل أن نشجع الآخرين على الوفاء بالتزاماتهم السياسية والأخلاقية تجاهنا، إذا تخلينا نحن أنفسنا عن التزاماتنا السياسية والأخلاقية تجاه قضيتنا وشعبنا.
بمعنى آخر، لا يمكن لشعبٍ أن ينال من الحقوق أكثر مما يستطيع أن ينتزعه، بقوته وإرادته وتصميمه وتنظيمه أيضا. وأن من يخسر معركته في التحول إلى شعبٍ منظم القوى، وموحد الإرادة، يخسر معركة التضامن الدولي، ويعامل بوصفه ضحية، وتتحول قضيته إلى قضية إنسانية لا تثير التعاطف إلا بمقدار ما تنتفي صفتها السياسية. ومن دون "محوّل وطني" يجمع الجهود ويثمرها، يخشى أن تتحول تضحياتنا جميعا إلى جهود مجانية، تصبّ في مصلحة الآخرين الذين يملكون وحدهم القدرة على تثميرها، وتحويلها إلى مكاسب وإنجازات سياسية أو استراتيجية، وتحقيق أهدافهم الخاصة على أكتافنا.
لا يوجد أي شك في أنه كان للتدخلات الأجنبية الدور الأكبر في تمكين الأسد من خوض الحرب التي فرضها على الثورة، والاستمرار فيها، بفضل ما قدّمه له شركاؤه الإيرانيون والروس من دعم متعدّد الأشكال، لوجستي وعسكري ومالي وإعلامي ودبلوماسي، لا يمكن مقارنته بما توفر لقوى الثورة والمعارضة. ولا يوجد أي شكّ كذلك في أن الغرب الديمقراطي الذي كان الحليف المنتظر للديمقراطيات الوليدة في العالم أجمع، والذي راهن على تدخله قسمٌ كبير من الجمهور السوري الملوّع بعنف النظام، تردّد في الوقوف إلى جانب السوريين، وعمل على تشتيت قواهم بدل مساعدتهم على تنظيم أنفسهم ومواجهة أعدائهم، على الرغم مما كان قد أغراهم به من وعود وآمال، منذ تبنّيه شعار تنحي الأسد. وهذا ما تجلى في افتقار من أطلقوا على أنفسهم اسم "أصدقاء الشعب السوري"، والذين تجاوز عددهم في أول مؤتمراتهم 70 عضوا، للإرادة والاستراتيجية والوسائل اللازمة لردع الأسد عن الاستمرار في حرب الإبادة وانتهاك قرارات مجلس الأمن وتجنيب السوريين الكارثة الإنسانية التي يشكل التملص من عواقبها اليوم سببا جديدا لاستمرار الحرب. ولا يوجد شك أيضا في أثر الإرث السلبي لنصف قرن مما ينبغي أن نسميه حرب الاستنزاف التي خاضها نظام الأسد لتحطيم المجتمع، وقتل روحه وقيمه الإنسانية، في تعميم انعدام الثقة والافتقار إلى الخبرة السياسية والتجارب التنظيمية، ولا في أثر وفعالية الألغام التي زرعتها السلطة المخابراتية بين جنبات المجتمع، والتي احتفظت وحدها بمفتاح تفجيرها في اللحظة المناسبة، لفرط عقده، وتوجيه طوائفه بعضها ضد بعض، وزعزعة إرادة السوريين وإرهابهم.
ولا يوجد شكٌّ أخيرا في الأثر السياسي المدمر لنزوع النخب السلفية إلى تصدّر الخطاب وواجهة
كل ذلك أصبح من البديهيات المعترف بها من الجميع، لكن البقاء على هذا المستوى من التحليل لا يقدّمنا كثيرا ولا يفسّر، في ما وراء ذلك، التراجع المستمر الذي تشهده قضيتنا، بالرغم من استمرار الشعب في تقديم التضحيات الباهظة. إنه يدفعنا، كما هو ظاهر منذ سنوات، ببساطة، إلى اليأس من قدرتنا على العمل كشعب مستقل، وإلى الاستقالة السياسية والرهان، في خلاصنا على تقاطع المصالح الدولية، أو انتظار المعجزات والتحولات الاستثنائية التي لا نملك أي إمكانية لإحداثها أو التسريع بحصولها.
(2)
ما زلت أعتقد أن مشكلتنا الرئيسية، قبل أن تكون خارجية، تكمن في انقساماتنا الداخلية أولا، وغياب أي استراتيجية مستقلة وفعالة، للعمل على تحقيق الأهداف التي لا نزال متمسّكين بها بعد تسع سنين من التضحيات والمعاناة القاسية ثانيا. ومن يتأمل في ممارستنا السياسية يدرك بسهولة أننا عقدنا العزم على التعايش مع هذه الانقسامات، داخل المعارضة نفسها، والاستغناء عن أي محاولة لبناء استراتيجية مستقلة، تراعي أوضاعنا، وتعتمد على تطوير قوانا الذاتية، وترتبط بحساباتنا الوطنية. وتتلخص استراتيجيتنا الراهنة عمليًا بالرهان على انتظار ما يحتمل أن تنتجه الضغوط الدولية، وعلى ما يمكن أن يصيبنا من مكاسب جانبية، في حال نجحت القوى الدولية التي تؤيدنا في تحقيق أهدافها الوطنية. وعلى احتمال تفاهم دولي يصبّ في مصلحتنا ولو جزئيا. وأخيرا على نتائج العقوبات الاقتصادية على النظام وحلفائه. وبينما يتفاءل بعضنا باحتمال تفاهم روسي أميركي يفتح الطريق المغلق نحو تسوية سياسية ولو بحدها الأدنى، يغذي بعضنا الآخر الوهم في أن تؤتي العقوبات الاقتصادية والسياسية التي وضعها المجتمع الدولي على النظم الثلاث: السورية والإيرانية والروسية، أكلها، وتجبر هؤلاء على الصّدع للإرادة الدولية، ممثلة بقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى انتقال سياسي، يقوم به السوريون أنفسهم، في وقتٍ أصبح من الصعب فيه تحديد هوية "السوريين"، بل هوية المعارضة السورية ذاتها. ويذهب بعضنا، أبعد من ذلك، إلى أنه لم يعد لنا أملٌ في الخروج بحلٍّ ينقذ آخر ما تبقى لنا من مصالح وطنية سوى الالتحاق بخطط واستراتيجيات الدول التي نعتقد أن بإمكانها أن ترعى بشكل أفضل من غيرها مصالحنا، أو تلك التي تتقاطع مصالحها الوطنية مع إعادة السلام والاستقرار الإقليمي، مع الأمل في أن يرافق وقف الحرب إدخال الحد الأدنى من الإصلاحات السياسية إلى نظامٍ يصوغه الروس على شاكلة نظامهم شبه القيصري.
وإلى حد كبير، تفسر هذه المواقف والرهانات الاستراتيجية الضعيفة انعدام أي نقاش جدّي داخل
يعتقد الموالون للتحالف مع تركيا أن أنقرة هي الحليف الأهم لما تمثله من قوة إقليمية، وتملكه من أوراق النفوذ، وفي مقدمها السيطرة على أجزاء استراتيجية من الجغرافيا السورية، وعلاقتها القوية والمباشرة مع القسم الأعظم من القوى العسكرية المنظمة التي نشأت خلال الثورة، ولا تزال قادرة على الفعل. في المقابل، يعتقد خصومهم ومنافسوهم أن "المخلص" الوحيد الذي يملك أوراق التغيير في سورية هو موسكو لما تتمتع به من روح المبادرة، وما تمثله اليوم من سلطة وصاية فعلية على دمشق، ومن سيطرة على الأرض، ومن نفوذٍ داخل أجهزة الدولة والنظام، وما تحظى به من مكانةٍ وإمكانات قوة عظمى عسكرية، تؤهلها للعمل من الداخل السوري، وبحرية أكبر من أي دولة أخرى. أما الفريق الآخر فهو لا يرى أملا في أي تقدم ممكن من دون العمل مع الولايات المتحدة التي تشكل القطب الوحيد القادر على الوقوف في وجه التحالف الروسي الإيراني الذي يقبض على رقابنا، والتي كان لها الدور الأكبر في إضعاف النظام وحلفائه من خلال ما فرضته عليه من عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، وما يمكن أن تفرضه عليه من عقوبات جديدة وملاحقات قانونية لمجرمي الحرب السورية، بعد تصويت الكونغرس على قانون قيصر لحماية المدنيين في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2019.
(3)
ليس لهذه "الاستراتيجية" التي تراهن على حسن نية الدول المتنازعة على اقتسام الإرث الأسدي في سورية أي مضمون سوى اعتراف المعارضة، بمختلف منصاتها ومؤسساتها، بالهزيمة السياسية والتسليم بها. وهذا هو الوصف الحقيقي لوضعنا اليوم، معارضين راديكاليين ومعتدلين، بعد أن سلمنا بانعدام قدرتنا على العمل الجماعي، والفعل المتسق والمنسق، وانقسمنا بين موالين لهذه الدولة أو تلك، وقبلنا بترك المستقبل رهين ما يجود به الموقف الدولي ونتائج الصراع الدائر من حولنا وعلينا. وكما هي العاقبة لأي هزيمة، ما كان لنا أن نبلع الموسى، من دون أن يدب الإحباط في نفوسنا، وفي أثره الشك بالذات، وانعدام الثقة واختلاق المثالب الذاتية والنقص الولادي أو التكويني. هكذا بينما يعمل الروس، بكل الوسائل، لإعادة تأهيل النظام الفاجر، المسؤول عن قتل الألوف وخراب البلاد، حتى يستعيدوا من خلاله السيطرة على كامل الجغرافيا السورية، ويفرضوا الحل الذي يناسبهم، ينشغل نشطاؤنا وكثيرون من أفراد المعارضة وسياسييها ومفكريها بنشر غسيل بعضهم، والتشكيك بنواياهم، وفي خلق الخصوم والعداوات والمظلوميات على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي. ويسود الاعتقاد، على طريقة ما كان يحدث في القرون الوسطى من ملاحقة الساحرات وحرقهن، بأن ملاحقة هؤلاء ومحاسبتهم وشل فاعليتهم، إن لم يكن إخراجهم من الحياة وإجبارهم على الاختفاء، هو السبيل الوحيد لتطهير الثورة من أخطائها وأسباب فشلها وإعادة إطلاقها ناصعةً وبيضاء كالثلج.
والواقع أن الحرب التي كنا نخوضها ضد النظام وحلفائه قد انتقلت، من دون أن ندري، إلى داخل
من السذاجة الاعتقاد أن من الممكن خلاص سورية اليوم من دون تعزيز الضغوط الدولية، وحدّ أدنى من تفاهم الدول الكبرى المتنازعة على النفوذ في سورية والمنطقة الشرق أوسطية، ومن خلالها على السيطرة الإقليمية والعالمية، وذلك بمقدار ما أصبحت الحرب السورية إقليمية ودولية معا. ولكن من السذاجة أيضا الاعتقاد أن نهاية هذه الحرب يمكن أن تضمن الحد الأدنى من المصالح الأساسية لسورية والسوريين معا، من دون وجود فاعل جمعي ومؤسّسي سوري يجسّد هذه المصالح، ويمثل السوريين فيها، ومن ثم من دون وجود استراتيجية وخطة عمل سورية للدفاع عنها. وغياب مثل هذا الفاعل يعني أن الدول، في أحسن الأحوال، سوف تنظر إلى المصالح السورية من منظار مصالح تلك القوى السورية التي تواليها، إن لم نقل تعمل كأدوات في خدمة أهدافها. وهذا يعني مضاعفة خريطة تقاسم النفوذ الدولي في سورية بخريطة تقاسم نفوذ سورية سورية، لا تجعل من سورية دولةً فاشلةً فحسب، ولكنها تحول دون قيامها دولة مدنية تعدّدية، تضمن كرامة أبنائها وحقوقهم المتساوية في المواطنة المتساوية والحرّة التي تبرّر وحدها تضحيات الملايين منهم بأشكالها المختلفة.
(4)
في المقابل، لا أعتقد أننا، على الرغم من كل ما أصابنا ولا يزال يصيبنا، قد أسقط نهائيا في يدنا ولم يعد أمامنا خيار سوى الاستسلام للقدر، والقبول بالالتحاق بالقوى الأجنبية، والتفرّغ خلال "الوقت الضائع" لتصفية حساباتنا الداخلية، على أمل قطف بعض ثمار التسوية الدولية. وعلى الرغم من المحن والمآسي التي يعيشها السوريون، في كل المناطق والمواقع، والتي تنذر بتدهور الأوضاع لوقت طويل قادم، ولهذا السبب بالذات، ينبغي أن نوقن أن هناك خيارات أخرى أمامنا، وأن الحل لا يكمن، مهما كان الحال، في الارتماء في أحضان القوى الدولية أو المراهنة على هذا المحتل أو ذاك، ولا من باب أوْلى في التخلي عن مسؤولياتنا والخلود لليأس والانتحار السياسي، فالنظام، على الرغم من احتفاظه بوجوده الشكلي، قد انهار تماما أمام الضربات القوية والمستمرة منذ سنوات، لجمهور رمى بنفسه على الموت للتخلص من الطاغية، ولولا هزيمته لما اضطر إلى الاستعانة بالمليشيات والجيوش الأجنبية. وهو لم يعد يعني شيئا لأي طرفٍ، بما في ذلك رجالاته الذين يبحثون عن حماتهم الخارجيين.
كما أن الصراع بين القوى المحتلة أصبح أكثر فأكثر احتداما، بعد أن أدركت جميعها أنها وصلت إلى طريق مسدود، وأن من الصعب، إن لم يكن المستحيل، التوفيق بين مصالحها، بمقدار ما تغلب البعد الجيوسياسي لهذه المصالح على أبعادها الأخرى، وصار الأمر يتعلق مباشرة بالنسبة لجميعها بالدفاع عن موقعها ودورها وهيبتها في التوازنات الإقليمية والدولية. بالإضافة إلى أن المنطقة تعيش اليوم بأكملها في غليانٍ شعبي لا يهدأ، من الجزائر إلى العراق، بما في ذلك داخل إيران الخامنئية ذاتها التي لعبت الدور الأكبر في تأجيج صراعاتها، وزرع الخراب والفوضى في حياة مجتمعاتها.
وتكاد جميع نخب المنطقة السياسية تكون اليوم فاقدة للشرعية، وعاجزة عن استعادة الحد الأدنى
يكمن قسط كبير من المشكلة في نمط تفكيرنا وممارستنا، فنحن نعيش تناقضاتٍ نرفض الاعتراف بها. نفكر بطريقة ونعمل عكسها. نقول إن العالم يقف ضدنا، لكننا لا نكفّ عن مطالبته بالتدخل
والحال لن نستطيع أن نقنع المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانبنا، ونستفيد جدّيا من فرص التضامن من مؤسسات قانونية وحقوقية، ونحن نكاد نسلم بعجزنا عن حل خلافاتنا وتحقيق الاتفاق والتفاهم فيما بيننا. ولن نتمكّن من بناء الديمقراطية التي هي هدفنا الأول، من دون أن نعمل على تكوين قوى ديمقراطية منظمة. ولن تفيدنا المراهنة على تدخل تركيا أو روسيا أو أميركا أو أوروبا لصالح مشروع الديمقراطية السورية، إذا لم تتجلّ ملامح هذا المشروع، ولم تظهر في ممارساتنا وعملنا وتفكيرنا. ولا يمكن أن نطمح إلى أن تضحّي الدول من أجلنا إذا لم نظهر، نحن أنفسنا، استعدادنا للتضحية في سبيل قضيتنا، والاستثمار في مشروع تحرّرنا. كما سيكون من المستحيل أن نشجع الآخرين على الوفاء بالتزاماتهم السياسية والأخلاقية تجاهنا، إذا تخلينا نحن أنفسنا عن التزاماتنا السياسية والأخلاقية تجاه قضيتنا وشعبنا.
بمعنى آخر، لا يمكن لشعبٍ أن ينال من الحقوق أكثر مما يستطيع أن ينتزعه، بقوته وإرادته وتصميمه وتنظيمه أيضا. وأن من يخسر معركته في التحول إلى شعبٍ منظم القوى، وموحد الإرادة، يخسر معركة التضامن الدولي، ويعامل بوصفه ضحية، وتتحول قضيته إلى قضية إنسانية لا تثير التعاطف إلا بمقدار ما تنتفي صفتها السياسية. ومن دون "محوّل وطني" يجمع الجهود ويثمرها، يخشى أن تتحول تضحياتنا جميعا إلى جهود مجانية، تصبّ في مصلحة الآخرين الذين يملكون وحدهم القدرة على تثميرها، وتحويلها إلى مكاسب وإنجازات سياسية أو استراتيجية، وتحقيق أهدافهم الخاصة على أكتافنا.