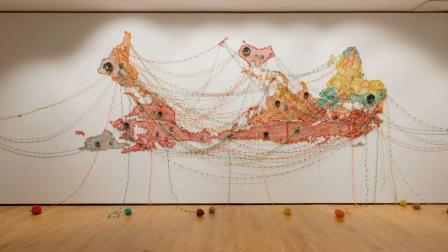أعدتُ كتابة الجملة "يفكّر السرير إذا ما كان يحمل بين طيّاته لا زال بصمات الكائنَيْن منذ الالتحام الأخير؟". أظنها أكثر إحساساً، أن يحملَ السريرُ طبعَ "بصماتِ" اثنين، أكثر كثيراً من حملِهِ دفءَ الكائنَين، كما كتبتُ أوّلاً. الدفء هو أوّلُ ما يخطر في بال القلم. وأنا وهو في مماحكة أبدية، لطالما احتدَمت وعنّفتُه لعملهِ بالآلية الخوارزمية.
ما إنْ أكتب شمساً حتى يتمّم ساطعة. من أين تسطع الشمس وأنا في هذه الزاوية؟ أكون بصدد الكتابة عن أناس متخيّلين غابوا تحت التراب، عن خجلِ عينَي فقيرةٍ أمام كاميرا مباغتة، أو عن أحدهم، ذهب ربما في مشوار قصير فأخذه قطار الأفول بعيداً جداً. من أين تسطع الشمس والروح رهينة عدد ساعات الشروق في الشمال والنوافذ قليلة صغيرة.
بحثتُ عن كلمةٍ نافرة، بالطبع لن يبقى السرير محتفظاً بدفء التحامٍ ما، وإن تمّ قبل ساعتين! عدا عن افتراض بعض معلومات طفيفة مثل درجة الحرارة المقتربة من الصفر، والنافذة القديمة، قيل من غير الممكن إصلاحها. تناكفني منذ سنين وهي تمرّر خيطاً هوائياً جامداً يكاد يملكُ لوناً. ولا أُخفي هنا العلاقة المريبة بينه، هذا الخيط الهوائي وبين يدي الحارة التي تمتدّ تصعد وتتسلّق عالياً، يداعبها وتسامره طوال الليل.
أنهضُ في الصباح بذراعٍ مشلولة تتطوّح سَكْرى ولا تُنصت. ذراعي التي يصعب أن تدخل في كمّ القميص، التي هي قلمي الحميم، أرفعُها باليد الثانية وأضعها على لوحة المفاتيح فتختار الأصابع بنشوتها كلمةَ مرورٍ نابية، شيءٌ من قبيل أنت وعزلتك وتختم برقمٍ لا أعرف سرّه، وكأن خيط الهواء الليلي اليتيم يرفعها كل ليلة مَنْزلةً أعلى، يوصلها بالعالم خارجاً، تقتصد في الكلام معي رأفةً فتجعلني أبدو أمام نفسي الأب أو الأم اللذين أوقفا الزمن عند محطة، كتاب، أو احتلال ما.
أعيد المحاولة لكتابة الجملة، أفكّر أن أكتب عن الصوت الذي يصدر عن السرير، عن خرخشة قماشِ شرشفٍ يُدشَّنُ للمرة الأولى ورائحته المُنشّاة؛ يفكّر السرير إذ ما كان يحمل بين طياته سناجب الكائنَيْن، ضحكتُ بسرّي. ليس بعيداً! حركةُ سنجابَيْن يلعبان داخل هذين الكائنَيْن، أو القلبين، سناجب ملبّدة الكساء، رطبة لاهثة سريعة قلقة متوتّرة نبهة. هل هو فرح، اشتهاء أم فزع؟ أقترب كثيراً من الشاشة وأحملق بالحروف جيّداً، أُثبِّتُ عينَيّ طويلاً، ربما لقياس صدقها، هكذا أفعل مع ابني وسرعان ما يخفض بصره إن أخفى عنّي شيئاً.
ربما رغبة صميمة مرجوّة أن تتفتّح أو تنفتح الكلمات لتقول لي شيئاً مكتوماً عصياً. أتلفّت يميناً ويساراً وأعاود الاقتراب منها. من الاستحالة طمأنتها، حاولت ذلك مراراً. أغضبُ، تفلت أعصابي فأنوي شَجَّها نصفين. لأترك السناجب ومبعث فزعها. جرّبتُ أن أكتب قطةً وانتظرت اقتراح القلم!
يفكّر السرير إذا ما كان يحمل بين طيّاته مفتاح الباب! ولكن لِمَ المفتاح؟ المفتاح الذي أضاعه السيّد وظلَّ الاثنان حبيسَي البيت، أحدهما يُنشب مخالبه بالآخر. هذا إن كانت قطةَ شوارع، قلت. الأمر سيختلف بلا شكٍّ لو كانت قطةَ بيت، ستكتفي بأن تعطيه جانبها ليمسّده، ترفع ذيلها ليتمّم طقس تدليلها ولا تلبث أن تنطّ وتندسّ إلى جانبه في السرير يتقاسمان المصير. عقلنة للأمور فحسب!
ماذا عن صوت منبهٍ إلكتروني، نبتة صبّار، أفكر وبشكل ملحّ ومرهق، لا أكتب شيئاً، أضمر الكثير. يفكّر السرير إذا ما كان يحمل بين طيّاته لا زال بصمات الكائنَيْن منذ الالتحام الأخير؟ لن أغيّرها، ولكن ما الذي ينبتُ في اللحم يا ترى ويظنّه لوغاريتم السرير التحاماً، ولماذا يظن أن ما يدور هو ما بين كائنَين اثنين؟
* كاتبة ومترجمة عراقية مقيمة في كوبنهاغن