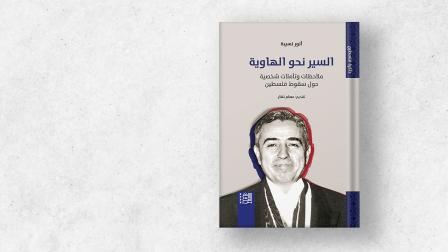درست الاقتصاد، وعندما ذهبت لدراسة الدكتوراه، كنت أرغب بأن أدرس التاريخ الاقتصادي لمصر. بعد التشاور مع المشرف قررنا أن من الأفضل دراسة مؤسسة ما وليس شخصية بحد ذاتها. وقررت دراسة الجيش كمؤسسة اقتصادية، ليس بالمفهوم الحديث ولكن بمفهوم علم التنمية، أي أن هناك قطاعا في الاقتصاد عنده القدرة على دفع كل القطاعات الأخرى إلى الأمام، وهو الرائد للتنمية. وهذا ما أصبح عليه حال الجيش في مصر بالقرن التاسع عشر حيث إن الصناعات الحديثة في مصر بدأت في خدمة الجيش، ومنها مصانع للطرابيش والمدافع والبنادق، وكان جيش محمد علي يستخدمها. وكنت أرغب بدراسة المصانع وسجلّاتها بطريقة بديلة بحيث أتمكن من دراسة وضع العمال عن طريق سجلات "ديوان الفبريكات" التي لم أجدها للأسف في دار الوثائق القومية في القاهرة، وبدلاً من ذلك وجدت أعداداً هائلة من السجلات التي أدخلتني لمعسكرات الجيش وتحديداً في بلاد الشام. استقر الجيش المصري هناك لحوالي عشر سنوات بدءاً من 1831. وهناك 63 محفظة وفي كل محفظة (Portfolio) حوالي 200 وثيقة. وتتضمن هذه الوثائق تقارير أسبوعية، "جورنال"، يتناول الأحوال الداخلية في المعسكر، بما فيها الصحية والتدريب وعلاقة الجنود بالسكان المحليين المدنيين في مدن وقرى بلاد الشام. كما تضم البيانات معلومات عن علاقات تجارية وتمردات وحتى علاقات جنسية للجنود، حيث كانت هناك أماكن عديدة من البغاء المنظم لخدمة الجيش، وهذا أدى لانتشار الأمراض الجنسية داخل الجيش. ومن هنا جاء اهتمام السلطات بالموضوع وتسجيله.
إذاً وجدت نفسي أستطيع أن أروي ما يحدث داخل الجيش من وجهة نظر الجنود. وأهم الملفات هنا هي المحاكمات العسكرية وسجلاتها، أحوالهم الداخلية وكيف يكتبون عنهم حيث كان عليهم توثيق شكاوي الجنود. هؤلاء أشخاص تم تجنيدهم لمدة عشر أو خمس عشرة سنة. وهنا بدأت أرى أننا نتحدث عن مجتمع كان في حالة حرب مستمرة لمدة عشرين سنة. أي من 1820 - 1840. هذا يعني أن جميع موارد مصر كما قراها كانت منخرطة في عمل عسكري. كما نلاحظ محاولاتهم الهروب من بطش قادتهم وعدم تأقلمهم مع ضباطهم الأتراك، وهم نخبة مختلفة عنهم لغوياً وإثنياً وجغرافياً. وكان الجنود يحاربون في جيش ليس جيشهم، صحيح أنهم تجنّدوا له وأنهم حققوا انتصارات ساحقة، ولكن بالنهاية هذا ليس جيشهم وهذه ليست قضاياهم أو حروبهم. وهذا ما لمسته من الوثائق. وهنا وجدت نفسي أطرح أسئلة جوهرية بعكس السائد. هذا جيش من بالضبط؟ ومن دفع الثمن؟ ومن جنى ثمار هذه التضحيات؟ وهذا سؤال يمكن أن يُسأل عن أي دولة.
* سنعود لاحقاً للفترة الحالية والجيش ووضع الدولة المصرية اليوم. أرغب بالحديث عن مسألة المذبحة التي ارتكبها محمد علي ضد المماليك وقتل 450 منهم واستمرارها خارج المكان والوقت الفعلي. ما أهميتها والإشكالية في القراءة التاريخية السائدة؟
هناك تغنّ بالدم والقول إن عملية التأسيس كانت تستدعي هذا. أنا لا أريد هنا الدفاع عن المماليك كأمراء حرب، ولكن إذا قرأنا المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي، وما يصفه في استكمال هذه المذبحة التي حدثت عام 1811، فإنه مرعب. كان للمماليك أعوان وحاشية وجنود يتوزعون على كافة أملاكهم في طول البلاد وعرضها. أطلق محمد علي العنان لابنه إبراهيم باشا، الذي كان عمره واحدا وعشرين عاماً، وبدأ هذا بإغلاق "بيوت" المماليك وهي عبارة عن أماكن مفتوحة يلجأ لها الفقراء والأرامل وعابرو السبيل. يصف الجبرتي كيف أن إبراهيم باشا كان "يشوي" الفلاحين الذين لا يدفعون الضرائب، كما تشوى الغنم! ويقول لهم "أنا مندوب أبي". هنا نشهد تحولاً ليس فقط بسبب الشكل الدموي ولكن بنمط العلاقة مع "السيد". المماليك على الرغم من أنهم أمراء حروب وبطشوا، كانت لهم مسؤوليات وكانت لهم أدوار اجتماعية ولو بحد أدنى. الدولة الحديثة احتكرت كل هذا.
* أنت أنهيت تقريباً كتابك الجديد، الذي يتناول مفهوم الدولة وتجلياتها وتفاعل المصريين معها، كيف تريد بحث هذا التواصل والتفاعل؟
لقد بدأت هذا المشروع قبل حوالي خمسة عشر عاماً. وهو كتاب مبني على بحث يعتمد على سجلات دار الوثائق القومية المصرية، ويتناول سجلات الدولة المصرية في القرن التاسع عشر. الفكرة ترتكز على أن الحديث عن الدولة المصرية فيه الكثير من العموميات. والسؤال هنا ما هي هذه "الدولة المصرية"؟. لا يوجد شيء صلب اسمه الدولة. الدولة هي مجموعة علاقات وقوانين وخطابات وممارسات ومؤسسات. وأحاول في بحثي أن أتتبع كل هذه المؤسسات والخطابات والقوانين وعلاقتها بالفرد أي الشعب والجماهير في الشارع، وذلك على مدار حوالي خمسين سنة من 1830 إلى 1880.
بعد قدوم الإنكليز ندخل في مرحلة أخرى، ليست منفصلة ولكن مختلفة. ولرؤية كيف يتفاعل الفرد المصري مع الدولة، أركز على مجالين أساسيين وهما: الطب والقانون. ويتعامل الكتاب مع تقاطع هذين المجالين مع بعضهما. هذا التقاطع الذي يؤدي إلى ممارسات مثل التعذيب والتشريح. وهنا أتحدث على تاريخ الطب الحديث وإدخاله إلى مصر في القرن التاسع عشر. كما تاريخ القانون الحديث وعلاقته بالشريعة والقضاء الشرعي وتفاعل هذه المؤسسات مع بعضها وتفاعل المصريين مع هذه المؤسسات.
* تتحدث عن تفاعل الناس مع الدولة ومؤسساتها. هل لك أن تشرح كيف تقرأ وتحلّل هذا التفاعل عن طريق السجلات الرسمية، وما هي دلالاته؟
لدينا كمّ هائل من الوثائق في دار الوثائق القومية، فهي غنية جداً، وتحديداً وثائق تلك الفترة. أنا أركزعلى المؤسسات وعندنا كم هائل من سجلات الشرطة والمحاكم والقضايا الجنائية والمالية والتجارية ونصوص قوانين ومسوّداتها وتلك التي لم تنشر ولم تصدر والنصوص النهائية من تلك القوانين، وكمية هائلة من عرض حالات الشكاوى المقدمة من الأفراد العاديين وردود الدولة أو المؤسسات على هذه الشكاوى. ناهيك عن الكشوفات الصحية بما في ذلك التعليم الطبي ومستشفى القصر العيني الذي أُسس عام 1827، بما في ذلك سجلات تعليم المدرسين وترجمة الكتب ونشرها في مطبعة بولاق وتعيين خريجي هذه المؤسسات في المناصب الطبية المختلفة، فضلًا عن المخاطبات الدقيقة جداً واليومية لما يسمى بمكاتب الصحة. وهذه عيادات مجانية مفتوحة ليس فقط في القاهرة بل في الأقاليم كذلك. وهنا همزة الوصل بين الشعب والدولة بالنسبة لي، لأن هذه المؤسسات هي التي تقوم بجمع الإحصائيات الصحية الحيوية، وتسجيل المواليد وتلقي إخطارات الوفاة، كما إصدار تصاريح بالوفاة أو كما كانت تسمى بـ "تذاكر الدفن".
بالنسبة لي هذه هي تجليات الدولة الحديثة، أي الدولة التي تمتلك القدرة على حصر جميع المواليد والتأكد من أسباب الوفاة لسكانها ومن ثم مدى قدرتها على التغلغل داخل النسيج المجتمعي. عند اللحظة التي توجد لدينا قاعدة البيانات هذه، تصبح هناك إمكانية للتجنيد وجمع الضرائب وإحكام السيطرة على السكان وبأشكالها المختلفة. ومن جهة ثانية أحاول أن أركز على طريقة تفاعل الناس معها. وكذلك القضايا الجنائية التي تتبلور فيها كل هذه العلاقات، وخاصة قضايا القتل. حيث عندنا السلطة التي تريد التأكد ما إذا كانت الوفاة طبيعية من جهة، ومن جهة أخرى رد فعل الناس لتواجد الشرطة في حياتهم اليومية بشكل قوي وفعال.
* الموظفون في تلك الفترة يستعملون في تخاطبهم اللغتين التركية والعربية. إلى أي مدى يمكن القول إن ما يرد في الملفات الرسمية هذه عبارة عن نظرة الموظف: الدولة/ الجهة الرسمية، إلى الفرد العادي بكل ما في ذلك من استعلاء ربما. كيف تتعامل مع هذه الإشكالية كباحث؟
هذا سؤال مهم. ما نشاهده هو وجود تحول تدريجي في الخطاب الأبوي للدولة، من دون أن يكون ذلك بشكل معلن أو واع أو حتى مقصود. ما نبدأ برؤيته هو وجود خطاب مغاير ينظر إلى الشعب، ليس على أنه وديعة يجب الحفاظ عليها، بل على أنه مصدر رزق يجب الحفاظ عليه وحمايته وتعظيم العائد الناتج منه. من هنا يأتي اهتمام "المسؤولين" بالصحة العامة والتعليم وغيرها، حيث إن السكان قد أصبحوا رعايا. وهناك علم الاحصائيات الحيوية كما الإدارة والشرطة والمراقبة تحكم جميعها. وهذا التحول لا يحدث نتيجة ترجمة نصوص من اللغات الأوروبية ولا بسبب الاحتكاك بالثقافة الأوروبية في رأيي، بل إنه نتاج محلي على علم بمتغيرات تحدث في باريس ولندن، ولكن أيضاً في إسطنبول والهند. في العالم كله هناك تحول في دور الدولة، وما يجب أن تقوم به. الدولة المصرية برأيي كانت سبّاقة في مجالات كثيرة، سبقت الدولة العثمانية في إجراء أوّل تعداد حديث للسكان عام 1848، قبل التعدادات العثمانية. وكانت كذلك سبّاقة في إحكام سيطرتها على السكان، حيث بدأت مصر التجنيد عام 1821، في حين قامت به إيران بعد قرن تقريباً، والدولة العثمانية لم تتمكن من عمل تجنيد شامل إلا في الأربعينيات من القرن التاسع عشر بناءً على التجربة المصرية. فهناك مجالات مختلفة من بينها القانوني واستحداث تشريعات جديدة غير مستوحاة من الشريعة الإسلامية، وهذا ليس نتاج تأثير نابليون كما يقال، بل نتاج عمل هذه الإدارة التي نسميها الدولة، وعلمها في كيفية التحكم بأذهان وأجساد السكان المصريين.
* تتطرق في كتاب "كل رجال الباشا: محمد علي وجيشه وبناء مصر الحديثة"، والمبني على أطروحة الدكتوراه إلى أمور عديدة من بينها مسألة بناء الجيش وهرب الناس من التجنيد ومقتل الآلاف والثورات التي قام بها الناس ضد جيش محمد علي ونظرة هذا الجيش إلى الصعيد والسودان. وتؤرخ لبداية الدولة المصرية الحديثة بقمع الجيش المصري آنذاك للمصريين، بعد المحاولات الفاشلة بتجنيد السودانيين وموت الآلاف منهم. هل لك أن توضح؟
كانت حملة التجنيد الأولى عام 1818 في السودان، وكذلك ما أطلق عليه حملة تجنيد "العبيد"، حيث إن غرضها الأساسي كان إجبار أكبر عدد ممكن من الناس في السودان على دخول الجيش. وبحسب روايات الرحالة الذين صاحبوا إسماعيل باشا للسودان مع القوات المصرية غير النظامية، تمكنت تلك القوات من أخذ عشرين ألف شخص. لكن أغلبهم ماتوا في الطريق ولم يبق إلا ثلاثة آلاف. وذلك بسبب عدم وجود طرقات أو معدات أو أكل أو رعاية صحية. فشلت التجربة، وقرر محمد علي تجنيد عدد صغير من الفلاحين، بعيداً عن أعين القاهرة. حيث كان هناك تمرد فيها ضده من قبل جنوده الألبان قبل ذلك في عام 1815.
وتمكّن من تجنيد أول فوج وكتيبة من تلك الأقاليم، ومن ثم انتشر الأمر إلى الأقاليم الأخرى وواجه معارضة وتمردات وثورات ضد التجنيد. لكن الكتائب المصرية الأولى التي جنّدها هي التي قمعت التمردات. وهنا كانت نقطة التحول والتحدي في بناء الدولة المصرية الحديثة، أي عندما استطاع الجيش الحديث، جيش محمد علي، قمع التمرد ضدّ التجنيد على يد الكتائب المصرية الأولى. تُقدّر أعداد الفلاحين الذين اشتركوا في تلك الثورات ضدّ التجنيد بعشرين ألفا، ومات منهم أربعة آلاف. في المنوفية مثلًا، ذهب محمد علي بنفسه لإخماد الثورة، وقامت ستة مدافع بدك القرى. أما ثاني استخدام فكان في الجزيرة العربية في عسير، جنوب الحجاز. وتمكّن الجيش المصري من إخماد ثورة أكبر من ثورة الصعيد. وأصبح واضحاً لمحمد علي أن المقامرة نجحت وأنه تم إنتاج ماكينة عسكرية نجحت بإخضاع الداخل والخارج.
* لماذا جاء هذا الاعتراض القوي على التجنيد؟ وما نوعية المقاومة؟
الممارسات القمعية سبقت الاعتراض على التجنيد. لقد كان هناك احتكار للمواد الزراعية وضرائب باهظة وسخرة، وزاد على كل هذا التجنيد. وبدأت عمليات التمرد الفردية، بعدما تم قمع الثورات والتمردات. وأخذت عمليات التمرد الفردي أشكالًا مختلفة، أقصاها قطع السبابة كي لا يتمكنوا من شدّ الزناد. وآخرون قاموا بوضع سم الفئران في أعينهم، لأنه يُحدث حالة مؤقتة من العمى على ما يبدو. ولكن حتى هذه العمليات فشلت، لأن محمد علي أدرك الأمر، وبدأ يشكل وحدات عسكرية من المشوهين. وبدأوا يهربون من الجيش، على الرغم من العقوبات القصوى التي تلحق بهم لو تمّ الإمساك بهم. الإحصائيات تقول إنه كان هناك حوالي ستين ألفا من الهاربين من الجيش الذي كان قوامه في وسط ثلاثينيات القرن التاسع عشر ما بين 120 إلى 150 ألفًا، إذا احتسبنا الأسطول كذلك.
* تتحدث في أكثر من مناسبة عن إشكالية الوصول للسجلات في دار الوثائق المصرية. ما السبب برأيك على الرغم من غنى هذه المؤسسة بالسجلات وهي كنز وملك للشعب على الباحثين الاستفادة منه. وكيف تربط هذه الصعوبة بالنظام اليوم في مصر؟
كنت محظوظاً، أنه سمح لي بالاطلاع على سجلات دار الوثائق، حيث عملت لأكثر من خمس عشرة سنة على وثائق من هناك. ولكن لا يحصل طلابي وزملائي على الموافقة على طلباتهم للاطلاع والبحث، حيث يحتاجون إلى ترخيص من الجهات الأمنية، وازداد التضييق مؤخراً وبشكل ملحوظ. نحن نعيش في دولة بوليسية. الدولة البوليسية لا تسيطر فقط بالقتل والتعذيب والسجن والاختفاء القسري. بل إن ما يضمن سيرورة هذه السيطرة هو احتكار الخطاب والسردية. والدولة المصرية غيورة على رؤيتها لنفسها وعلى ما يقال عنها. لذلك يتم الحديث عن "شكل مصر" وهذا مهم للنخبة الحاكمة. ولذلك يخافون من أشخاص كالباحث إسماعيل الإسكندراني ويقبضون عليه لأنه يعمل بحوثاً استقصائية، ويعرض بياناته ورؤية مغايرة لما تدّعي الحكومة أنه يحدث في سيناء. وبالنسبة لهم هذا خطير جداً لأنهم محتكرون لهذا الخطاب والسردية وبالتالي الموضوع ليس مصادفة. ليس مصادفة أن الدولة مهتمة بالإعلام، وأن الميزانية التي تخصصها لوزارة الثقافة ضخمة وعبارة عن جزء مهمّ للتحكم في المجال الثقافي والعلمي الذي ينتج خطابات عن عمل هذه الدولة.
النظام ينظر للبحث العلمي، الذي لا ينتجه هو، كتجسس، بشكل حرفي وليس مجازياً. العقلية الحاكمة ترى المعلومات كجزء أساسي من السلطة، ويجب اكتنازها والحفاظ عليها وعدم إتاحتها للناس من أجل إنتاج معرفة جديدة مستقلة. وهذه العقلية التي تحكم مصر اليوم.
* كمؤرخ كيف ترى الوضع الحالي؟ قلت في إحدى كتاباتك إن ثورة 25 يناير عبارة عن نضال مستمر منذ مئتي سنة؟
من جهة، يمكننا النظر للثورة من اللحظة الراهنة وما آلت إليه وما تمثّله. ومن جهة أخرى، من وجهة نظر الثورة المضادة ومحاولتها لإحكام سيطرتها على المجال العام. إذا أخذنا الدولة فإنها تمر بأزمة عميقة، ولا يوجد عندها مخرج. ولا تأتي أزمتها فقط بسبب الثورة، بل إنها تضرب في الأعماق. إنها أزمة اقتصادية. لقد أتت الثورة بمثابة إنذار للدولة كي تعيد تشكيل أوراقها والتصدي للخلل الهيكلي في البيئة والماء والطاقة والأكل، وكلها مشاكل عميقة جدًا لأمور أساسية، ناهيك عن التعليم والمواصلات وغيرها.
نحن شعب كبير وموارده محدودة، ونعتمد على مساعدات خارجية لدول أصبحت تعاني من أزمات مالية خانقة كالمملكة العربية السعودية والإمارات وحتى الولايات المتحدة. نحتاج إلى آلية جديدة تحكم علاقات القوى ببعضها. الدولة لا تدرك ذلك وقررت أن تنظر إلى ثورة يناير كسبب للمشكلة وليس انعكاساً لها. إنها ثورة فجّرتها عقود من الممارسات الخاطئة.
نحن ما زلنا نعيش ونتعامل بأسلوب هزيمة 1967. لم تتراجع الدولة آنذاك عند انكشاف الكذبة وقدّمت بعض الضباط للمحاكمة ككبش فداء ولكن المنطق نفسه ما زال متبعاً، أي منطق الأجهزة السيادية وكأن الموضوع أمني فقط وليس هيكلياً. أنا عكس الكثيرين أرى أن الثورة انتصرت وأنها ما زالت مستمرة.
* كيف؟
إن هؤلاء الذين قدّموا التضحيات والأفكار البديلة في الثورة، هم حتى اليوم من يطرح البدائل والرؤى المختلفة وعندهم تخيل مستقبلي في حين تعيش الدولة في الماضي. أما الحلول التي تطرحها فهي قصيرة المدى، ولا ترى الأزمة الهيكلية العميقة. الأفكار الجديدة والخلاقة لا تخرج من الدولة. الدولة تحتاج لفتح المجال السياسي، ناهيك عن وضع اقتصادي قاتل ومشاكل ري ومياه جذرية منذ عقود ولا يمكن حلّها من دون إشراك الفلاحين، أي أننا نحتاج إلى حل سياسي للمشاكل الاجتماعية. ما هوالحل عند النظام؟ المعونات والمزيد من العونات.
نحن لا نريد إسقاط الدولة، ولكن نريد إسقاط النظام الذي يسقط الدولة، والنظام الحالي هو الذي يهدم الدولة. نريد دولة مستقلة راسخة تخدم شعبها، ونريد المشاركة في إدارة شؤون الدولة. والناس عندهم أفكار، وأنت لو سألتني كمؤرخ أقول إن هذه اللحظة من أروع لحظات الإنتاج المصري، يوجد مقالات غاية في الجدية والثراء والابتكار، كلها من صحف مستقلة والدولة تواجهها بصحف عقيمة ليست على قدر المسؤولية.
أنا أشعر بالقلق على الدولة وليس على الثورة. كنت سأشعر بالقلق وأقول إن الثورة انتهت، لو تمكنت الثورة المضادة من خلق فكر جديد برؤية وحل جديد، حتى لو لم يعجبني. ولكن رغم القتل والقمع والسجون ما زال هناك من ينظم ويكتب ويعمل الثورة في بدايتها وليس في آخرها.