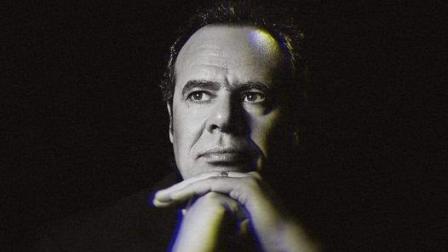المخرجة اللبنانية دانيا بدير امتداد عميق لما يُعرف اليوم، في بعض الأدبيات السينمائية العربية، بالحساسية الجديدة، وهي موجة تشهدها المنظومة الثقافية العربية في الأشكال كلّها للفنون التعبيرية، في محاولةٍ للقطع مع مختلف الموضوعات والتصوّرات والقوالب السينمائية الجافة، المُعطِّلة لمسار السينما العربية ونموّها.
لذا، فإنّ بروز تجارب سينمائية واعدة، كدانيا بدير والعراقي علي كريم عبيد والفلسطيني ركان مياسي، قادرٌ على فتح آفاقٍ جديدة في الحركة السينمائية، بهدف الاشتغال والحلم والتخييل. وهذا أكّدته بدير في فيلمها القصير "بالأبيض" (2017)، ثائرةً فيه على ذاتها أولاً، كما على تقاليد وأعراف اكتسبتها منذ صباها، بارتداء زيّ أبيض يوم عزاء، وإخفاء الهوية الدينية لحبيبها. وفي الوقت نفسه، هناك تمجيد لقيمة الحب. والفيلم يمثّل صرخة قوية في وجه هذه الأعراف، التي تحدّ من حرية الفرد العربي، والتي اكتسبها هذا الفرد العربي منذ صغره، من دون التفكير يومًا في ماهيتها، وفي ما تمارسه عليه أحيانًا من عنف رمزي في الحياة المعاصرة.
"العربي الجديد" التقت دانيا بدير في حوار عن الفيلم وخباياه، وعن علاقتها بالسينما والاجتماع اللبناني.
ـ حين كنتُ صغيرة، أحببتُ الأفلام كثيرًا. كنتُ أرغب في أن أصبح ممثلة. كنتُ أشارك في أعمال مسرحية في المدرسة، وأشاهد أفلامًا، وعندما أعود إلى المنزل، أؤدّي الأدوار أمام المرآة والكاميرا. حين بلغت 16 عامًا، اشترى والدي لي كاميرا، لم أعرف استخدامها جيدًا. لكن والدي أحسّ بي، وآمن بقدراتي التخييلية. منذ ذلك الوقت، غيّرت الكاميرا حياتي. أصبحتُ أصوّر كلّ شيء. ثم نقلتُ مكاني من أمام الكاميرا إلى ورائها، وبدأت تصوير الأصدقاء وأفراد العائلة وهم يروون قصصهم. كلّما أعود إلى البيت، أعلّم نفسي طرق تركيب المَشَاهد بالاستناد إلى برامج تقليدية على شبكة الكومبيوتر.
بعد انتهائي من المدرسة، تخصّصت في الإخراج. في الحقيقة، كنتُ خائفة، يعتريني شكٌّ في ما إذا كان الإخراج هواية أو ما ينبغي أن أكونه. درست فنّ التصميم ولم أندم، فهو حثّني على طريقة تفكير تساعدني اليوم كثيرًا في الإخراج والتواصل. بعد 3 أعوام، سافرتُ إلى نيويورك لزيارة شقيقتي، فذهبتُ إلى جامعة كولومبيا، ورأيتُ كيف يعلّمون الإخراج. تحمّست كثيرًا. قلتُ لنفسي إنّ هذا ما أريده في حياتي. بعد عودتي إلى لبنان، أنهيت دراسات عليا في كتابة السيناريو والإخراج، وأنجزتُ أفلامًا عدة.
(*) هل هناك تجارب سينمائية عربية تأثّرتِ بها وأنت يافعة، وفي خطواتك الإخراجية الأولى؟
ـ صغيرة، أحببتُ الأفلام الهوليوودية، إذْ لم أشاهد أفلامًا أوروبية وعالمية كثيرة. "بيروت الغربية" لزياد دويري أول فيلم أثّر بي. بفضله، بدأتُ أفكّر: إذا أنجزتُ فيلمًا يومًا ما مثل هذا الفيلم سأعتبر نفسي محظوظة، فهو يعطي مشاعر، وفي الوقت نفسه هو فيلم مُضحك وحقيقي، إذ يقدّم قصصًا كثيرة. شاهدتُه 3 مرات، وحفظته، وقرأت عنه. دويري كتبه متأثِّرًا بما عاشه صغيرًا في الحرب (الأهلية اللبنانية). لذا، أعتقد أن هذا النوع من الأفلام يُؤثر في الناس، بتناوله مشاكل لبنان، فيشعر المُشاهد غير اللبناني بهذه القصص الإنسانية ذات النفحة الكوميدية والدرامية الحقيقية.
(*) فيلمك القصير "بالأبيض" (2017) يحكي قصة لارا، الفتاة التي تعيش في نيويورك وتزور لبنان بسبب وفاة والدها، فتصطدم بأعراف العائلة ورفض أفرادها حبّها لصديقها ونمط عيشها. برأيك، كيف يستطيع المرء إقامة حدود بين حياته الخاصة ـ الواقعية، والعالم المتخيّل في الفيلم؟
ـ هذا موجود في أفلامي كلّها. حاليًا، أكتب فيلمًا قصيرًا سأذهب به إلى الـ"برليناله". فيه الشيء نفسه: أحدهم يعيش حياة عادية بين الناس، وله حياة شخصية داخلية لا يستطيع مشاركتها مع العالم كلّه. لا أعرف لماذا أفكّر في هذا كثيرًا، وأيضًا في قصصٍ نضطرّ أن نعيشها، ثم الطريقة التي نعيشها مع أنفسنا، ونحن نضع سياجًا حول قلوبنا. هذه أشياء مؤثّرة. في نيويورك، شعرتُ بأنّ حياتي في بيروت، بينما عشتُ حياتي هنا. صعبٌ أن أعيش في بلدٍ ثانٍ وأنا معتادة على نمط تفكير ونظرة معيّنة إلى الحياة. نيويورك عالم أكثر تنوعًا: أديان وعناصر وألوان وأشكال. هناك، تغيّرت وجهة نظري إزاء ما عشته في لبنان. كلما أعود إليه، أطرح على نفسي أسئلة حُرمت منها وأنا صغيرة: لماذا العزاء والعرس؟ لماذا هذا يجوز، وذاك لا؟
في نيويورك، انتبهتُ إلى أني كلّما تعرّفتُ إلى أحدٍ من بلدٍ جديد، يسألني: "لماذا أنتم تعملون كذا؟". لا أعرف كيف أجيب. هذه مسائل نتعلّمها هكذا. أسئلة كهذه غير محبّبة في لبنان، في العائلة وبين الأصدقاء. هؤلاء ينتقدوني لأني تغيّرت. لكن، ما تغيّر هو نمط تفكيري ونظرتي إلى الأمور.
توفي والدي عام 2009. ما صوّرته في الفيلم منبثقٌ من ذاكرتي للعزاء، لكن ليس بالطريقة التي كان بها، بل بما أشعر أنا به. الناس في العالم متشابهون. الطريقة التي صوّرت بها الجنازة مبنية على التذكّر، كأني أختفي بين الناس. كأن وجودي غير مهم، فالمهم كيف يراني الناس وهذا أثّر فيّ كثيرًا. كان من الضروري أن أروي هذا كلّه بطريقة بسيطة.
(*) يصطدم مُشاهد الفيلم بسؤال الهوية الدينية، وما يفرضه السؤال من تعامل حذر. هل هذا مرتبطٌ ببلدٍ كلبنان؟
ـ أعتقد أن سؤال الهوية الدينية يخصّ البلدان العربية كلّها. لكن، هناك ما اكتشفته من كلمات في اللغة العربية: يهودي، إسرائيلي، صهيوني. كلمات نستعملها دائمًا من دون التفريق بينها. بعد ذهابي إلى نيويورك، تعرّفت إلى يهودٍ متضامنين مع القضية الفلسطينية. في لبنان، ننظر إليهم دائمًا كأعداءٍ، رغم أن بعضهم غير متّفق مع ما تمارسه إسرائيل من تنكيل بالفلسطينيين وبفلسطين. هذا انتبهت إليه، لأني عشت معهم، وصار بعضهم أصدقاء لي. لم أحكم عليهم يومًا بسبب دينهم. لكن، هناك صراعات سببها الأديان. الحرب الأهلية قسّمت لبنان إلى فرق دينية مختلفة باتت متحكّمة بالحياة فيه. أنا ضد هذه التوجّهات، لأني أرى الدين مسألة شخصية بين الفرد وخالقه.
(*) أضفى الصمت في الفيلم رونقًا جماليًا خاصًا. ما هي الأبعاد الرمزية والجمالية لهذا الصمت؟
ـ أنا لا أحبّ الحوارات الكثيرة في الأفلام. في "بالأبيض"، اشتغلتُ مع المُصوّر كريستوف فرعون للمرة الأولى. تحدّثنا كثيرًا عن كيفية إيصال القصّة إلى الناس بأقلّ قدر ممكن من الكلمات، وبأساليب سينمائية. بدأ الشغل على الطريقة التي تشعر بها لارا، باعتبار أن الإحساس والتفكير يتغيّران في الفيلم على مدى 3 أيام، على عكس الأشياء الأخرى التي ظلّت تتكرّر (وقوف الناس ثم جلوسهم). من هنا، جاء التفكير في الصمت للتعبير عن إحساس لارا من دون أن تتكلّم كثيرًا. تعبير ناشئ من الصوت والثياب. كنتُ أريد الاقتراب منها بالكاميرا، كي أُحْدِث شعورًا بضيقٍ إزاء العالم. حتى على مستوى الإضاءة، يوحي الأبيض باختفاء هويتها التي، شيئًا فشيئًا، تتلاشى وتضيع. الأمر نفسه بالنسبة إلى التعبير بالصوت والصورة.
(*) ثورة لارا على أمها، بارتدائها لباسًا أبيض، تضمر في طياتها خطابًا تحرّريًا. بل إنها تشكّل بحدّ ذاتها صرخة تجاه المجتمع العربي بأعرافه وتقاليده المبهمة. كيف تعاملت عائلتك مع الفيلم بعد عرضه؟
ـ عائلتي، خصوصًا والدتي، لم تكن فرحة به. بدوا كأنهم يسألونني: لماذا تتناولين خصوصية عائلتنا؟ لكن، بعد مشاهدة والدتي الفيلم، شعرتْ بأنه ليس قصّة حياتنا بل قصة أفراد كثيرين في المجتمع اللبناني. هي عرفت بتأثّر مُشاهدين كثيرين به، وبأن كبارًا في السنّ قالوا لي إنهم معتادون حضور العزاء لكنهم لم ينتبهوا يومًا إلى التفاصيل، وإلى ما تمارسه التقاليد من عنفٍ خفيّ.
(*) عرفت الساحة السينمائية العربية أخيرًا تجارب سينمائية شابة، استطاعت أن تفرض نفسها بقوّة، وأن تجترح أفقًا سينمائيًا مغايرًا. كيف ترين الحركة السينمائية اللبنانية الشبابية؟
ـ أعرف شبابًا لبنانيين كثيرين يشتغلون في السينما. بعضهم درس في لبنان، وبعضهم الآخر خارج البلاد العربية. أشعر بأن لديهم طاقة كبيرة. في لبنان، هناك إمكانات جيدة لهم لتحقيق أفلام كثيرة. أظنّ أن السينما اللبنانية بدأت أخيرًا تحقيق تراكم فني متميز في البلاد العربية، على عكس الأفلام الهوليوودية التي شغلت فترة طويلة الساحة العالمية، فأصبحت قصصهم متشابهة إلى حدّ كبير. نحن بحاجة إلى قصص تشبهنا، وتحكي عن أحاسيسنا وتقاليدنا ومشاكلنا. في لبنان، هناك مؤسّسات فنية تشجع الشباب من خلال ورش عمل ومنح وعقود شراكات مع مخرجين شباب من دول أخرى.
(*) ما هي مشاريعك السينمائية المقبلة؟
ـ الآن أشتغل على فيلم طويل جديد في بيروت، عن شابّة في العشرينيات من عمرها، تدرس في الجامعة اللبنانية، وتخوض تجارب، وتُحارب بعض أشكال النظام الأبوي السيئ، وتُقيم علاقة بشابٍ يُدعى حسن، تتعلم معه أشياء عدة عن الحياة. ثم هناك فيلم قصير سأذهب به إلى مهرجان برلين برفقة 9 مخرجين، ضمن مشروع لمؤسّسة فنية اختارت مشروعي هذا، الذي يُفترض أن أشتغله مع أساتذة مشرفين على كتابة السيناريو، وسأبدأ تصويره في سبتمبر/ أيلول 2019.
(*) هل لديك رغبة في تصوير فيلمك الطويل الأول هذا، أم أنك من المخرجين الذين يحبّون الأفلام القصيرة؟
ـ بالتأكيد لدي رغبة كبيرة في تصور فيلم طويل. لكن الفيلم الطويل يحتاج إلى وقتٍ للكتابة وإلى تكاليف إنتاجية كي يكون جيدًا سينمائيًا، على عكس الأفلام القصيرة التي أحبها وأتفاعل مع أفكارها وعوالمها سريعًا. لذا، لا أعتقد أني سأتوقف عن تصوير أفلامي القصيرة بعد فيلمي الطويل الأول.