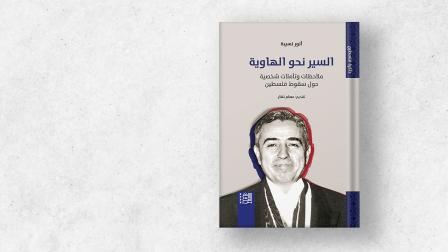جرَّ كتابُ "المتنبي: رسالة في الطريق إلى ثقافتنا" لمحمود محمد شاكر (أبو فهر) (1909-1997)، زمنَ صدوره سنة 1936، معاركَ مُدوّية، رمزيتها أكبر من مضمونها، وكان استعارُ أوارِها بسبب ما استدعاه من وجوه الأدب المُمجَّدة، لا ما تضمّنه من المعلومات ووقائع التاريخ، نفياً وإثباتاً، فجُلها مجال اجتهادٍ ونظر بين الباحثين.
ويكاد المتنبي، موضوع الكتاب الرئيس، أن يكون مجرد ذريعة، توسَّل بها شاكر للحديث عن مكانة التراث في مصر، في حقبة ما بين الحربَيْن، وقيمة الآداب العربية في صياغة النسيج الثقافي العصري، وتحديد منهج درس تاريخ الإسلام كيف يكون. وفي ساحة هذه المعركة، تقابَل من وجوه الثقافة العربية ثلاثةٌ: عميد الأدب العربي، طه حسين (1889-1973)، ومحقق التراث محمود شاكر، ومحور سجالهما: المتنبي (915- 965م)، أبرز شعراء الضاد. وجالت أقلامهما، انتقاداً ودفاعاً، عن الاستشراق ومناهجه، وغَنائه أو عقمه في تفهّم نصوص التراث.
ويعود مبتدأ هذا الكتاب إلى أزمة شابٍ مثالي رفض "بشاعةَ السطو، وبشاعة التستر عليه من عارفٍ خبير، لا يكتفي بالتَّسَتر، بل ويطالب بالتغاضي عنه وبتوقير الساطي". والسطو المرادُ هنا استجلاب آراء المستشرقين حول التاريخ الإسلامي، واستنساخها بالعربية، ثم نسبتها إلى الذات، فمهاجمة التراث والتشكيك فيه بالاعتماد عليها: فقد اتهم شاكر أستاذه طه، كما يحلو له أن يسميه، بأنه لم يفعل شيئا في كتابه: "في الأدب الجاهلي" سوى الإغارة على أطروحة المستشرق الإنكليزي ديفيد صمويل مارجليوث، (1858-1940) النافي لصحة الشعر الجاهلي، واعتباره منتحلاً على يد القصاصين. وأمّا المتغاضون عن هذا السطو فزملاء الجامعة، وبعض الطلبة المتملّقين.
واحتجَّ شاكر بعقم المنهج الذي اتَّبعه كلاهما، وأشاد بنهجه هو القائم على "التذوق"، أي المعرفة الدقيقة باللغة، وإدراك معاني المُدوّنة، واستنباطها من داخل النص، عبر المقارنة والتتبّع والاستقصاء، دون إسقاط لها من الخارج. وقد طبق هذا المنهج في كتابه عن المتنبي، المقسّم إلى سبعة عشر فصلاً، خصّصها للبحث في أصول هذا الشاعر، والتدقيق في نَسبه، مع التدليل على "عَلويته"، أي: انتسابه إلى علي بن أبي طالب، وهذا مكمن الجدّة في الكتاب. كما أبطل شاكر، عبر هذه "العَلَويّة"، دعوى نبوة المتنبي، وتتبع بأناةٍ وتدقيق، أيام هذا الشاعر المضطربة وتطوافه من الكوفة، إلى الشام وحلب، ثم مصر والعراق، وارتحاله - قبيل مقتله - إلى بغداد وشيراز. ومن أطرف الفصول ذاك الذي عقده للتدليل على عشق المتنبي لخولة، أخت سيف الدولة (915 -967م).
واعتمد المحقق المصري على غير المقول في الأبيات، بمنهج يشبه إلى حد بعيد التحليل النفسي في درس الأدب، ذاك الذي طبَّقه في نفس الفترة صديقه عباس محمود العقاد (1889-1964) في كتابه "ابن الرومي: حياته من شعره" (1938)، حيث استدل بصور البيان، واختيارات المعجم وحتى نَظم الأبيات وترتيب ورودها، على حياة الشاعر. والسمة الغالبة في الكتاب هو الجمع بين منهج التحليل النفسي والمنهج التاريخي، والاستدلال بتشخيصات هذا على إثبات وقائع ذاك، والعكس بالعكس. كما عضد المحقق هذين المنظورين بـ"التذوّق" المعمّق لأبنية القصائد والوحدات المعجمية والنحوية، فضلاً عن الصور البلاغية التي تزيِّنها. وأضاف إلى ذلك كله عرضاً مدققاً لآراء المؤرخين العرب وشارحي ديوان المتنبي.
وبعد ظهور الكتاب بنصف قرن، أصدر الباحث التونسي حسين الواد (1948) "التجربة الجمالية عند العرب" (1987)، وخصصه للبحث في علاقة المتنبي بالتلقي الجمالي، وبَيَّن أنَّ الذي جعله "يملأ الدنيا ويَشغل الناس"، ليس سيرته رغم ما فيها من مواطن الإشكال والغموض، ومنها حديث نبوّته، ولا عصره واهتزاز السياسة فيه، ولكنْ شعرُه وتصرّفه في فنون القول، والتعابث بمعجمها وتراكيبها، وروعة تصاويرها، حتى زعم أنه لم يكن يكتب شعره لسيف الدولة قطُّ، بل للغويّين ونقدة الكلام، وإليهم يتوجه برقائق تفننه في الخطاب.
كتاب أبي فهرٍ من محطات الطريق إلى التراث العربي، يعكس ردود فعلٍ أصيلة حيال منهج التغريب ورؤى الاستشراق في درس التاريخ الأدبي. وفي الكتاب عمقٌ وصفاء عبارة، ولكنَّ ارتهانه بسياقه الذاتي أضاع منه العلمية، فقد أنجزه غيرةً من المستشرقين، ورداً على تبجحهم، وكان فيه محكوماً بانفعالات الشباب، وخيبته من الجامعة المصرية، التي غادرها لفسادها، وهو في أوج سنيّ التحصيل، نأياً بالنفس عن التقليد الأعمى والسطو، ولذلك يظل في تاريخ النقد العربي الحديث من أمتع المحطات.