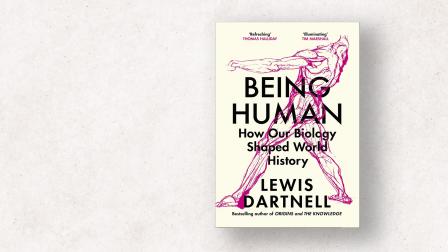يوم الثلاثاء، 4 حزيران 1967، وبعد شهر واحد من "حرب الأيام الستة"، قمنا أنا وشقيقتي بزيارة بيتنا في حي القطمون في القدس للمرة الأولى منذ تسعة عشر عاماً. كان ذلك حدثاً حزيناً، أشبه بلقاء شخص تحبه بعد أن رأيته آخر مرة وهو في ريعان شبابه، متمتعاً بالصحة والعافية، وإذا بك تصادفه فجأة وهو مسن ومريض وهرم. الأسوأ من ذلك رؤية صديق عزيز كنت تتوق لرؤيته لتكتشف أن شخصيته تغيّرت كلياً وكأنه لم يعد الشخص ذاته.
قضينا طيلة السنوات اللاحقة لعام 1948 في المنفى، بعيداً عن القدس. كنا على وشك فقدان الأمل برؤية القطمون أو بيتنا مرة أخرى. وحينما سنحت لنا الفرصة أخيراً لزيارة حيّنا القديم، ترددنا لوهلة. لم نكن نريد أن "نعود" بهذه الطريقة. كنا هناك للمرة الأخيرة بتاريخ 30 نيسان 1948، حينما هربنا من القدس خلال حرب فلسطين. كان عمر بيتنا وقتها أحد عشر عاماً تماماً. وكان لا يزال يبدو جديداً. منزلنا بكافة تفاصيله كان جميلاً ومتألقاً. كنا، قبل شهر فقط من مغادرتنا للبيت، قد دهنّا النوافذ بألوان زاهية. كان بستاننا في حالة جيدة، وكان في ذلك اليوم الربيعي من عام 1948 بكامل نضارته. كم تغيّر شكل المنزل والحديقة الآن.
لحظة تاريخية
جئنا من رام الله، حيث نعيش الآن، إلى البلدة القديمة بسيارة أجرة. أكملنا الطريق سيراً على الأقدام نحو باب العامود، ثم مررنا من أزقة البلدة القديمة المألوفة علينا نحو "طلعة" باب الخليل (الذي كان مغلقاً). جزء من الجدار الحجري قرب باب الخليل كان قد تهدّم. عندما عبرنا حطام الجدار المكسو بالغبار، التفتُّ إلى دمية وقلت لها: "هاي لحظة تاريخية من حياتنا". – تخيلوا،ـ لم نكن على الجانب الآخر من الجدار الذي يفصلنا عن حينا طيلة تسعة عشر عاماً.
خلال سيرنا، أخذنا نلاحظ بعض المعالم القديمة المألوفة: محل تلميع الأحذية، حيث كنّا نجلس على المقاعد الطويلة أثناء طفولتنا ونراقب صديقنا الأرمني وهو يصقل أحذيتنا بعناية. كان المحل الآن قد أصبح ركاماً. إلى الأمام قليلاً، على الجانب المحاذي من الشارع، رأينا دكّان الحلويات لصاحبه أبو شفيق المعروف بحلوياته العربية الشهية. إلى الأمام رأينا البناية الرفيعة المؤلفة من طابقين على حافة الشارع. محل الفواكه لصاحبه جودت العمد، والذي كان يبيع، إضافة إلى ذلك الصحف العربية مثل فلسطين والدفاع وغيرها. في تلك الأيام. كما مررنا من هذا الدكان في طريقنا من نزلة فندق فيصل نحو موقف الباصات لنركب باص رقم 4 الذي يقلّنا إلى القطمون ومن ثم إلى منزلنا.
أكملنا السير عبر ماميلا، والذي كان شارعاً نابضاً في السابق، وتحوّل الآن عام 1967 إلى ضاحية قبيحة متسخة. مشينا عبر عمارة الزنانيري، التي بالكاد تعرّفنا إليها. إلى الأعلى كان الغسيل متدلياً على الشارع وكأنك في مدينة نابولي في إيطاليا.
وهكذا دواليك واصلنا المسير. كانت مفاجأة سارة أن نكتشف دكان شتيرن تماماً كما تركناه قبل تسعة عشر عاماً. أعتقد أنه الدكان الوحيد في ذلك الشارع الذي لم تتغير معالمه. بعد ذلك مررنا من صالون حمودي للتجميل والحلاقة، أو بالأحرى الذي "كان يوماً ما" صالون حمودي. كان هناك دوماً بعض الحركة و"العجقة" قرب ذلك الصالون، بزبائنه الوافدين ذهاباً وإياباً عبر بوابته العريضة المزيّنة بالخرز الملوّن.
بيكاديللي ومحلات أخرى
من المحلات الأخرى التي كان يرتادها الناس في الشارع المحاذي لمحل حمودي – مقهى بيكاديللي (الذي كان صاحبه، السيد عيسى السلفيتي، جارنا في القطمون). كان بيكاديللي مكاناً مزدحماً يلتقي فيه الناس. كلما سرت قربه أو مررت منه وأنت في الحافلة رقم 4 أو 6 سترى طاولات في الجزء الخارجي للمقهى يجلس عليها رجال عرب، كبار وصغار، يدخنون النارجيلة (الشيشة). كان بيكاديللي، خلال الأربعينيات، المقهى المفضّل لوالدي وشقيقي.
انتقلنا إلى اليسار وأخذنا نسير إلى الأعلى صوب جمعية الشبان المسيحية (Y.M.C.A) و"فندق الملك داود". هنا وجدنا كل شيء تماماً كما كان قبل تسعة عشر عاماً. شعرت لوهلة أننا في عام 1948، وكأن الوقت كان قد تجمّد وعدنا إلى تلك اللحظة.
حال وصولنا إلى جمعية الشبان المسيحية توقّفنا قليلاً. نظرنا بحنين إلى تلك البناية الضخمة الشامخة – حيث القاعة الكبيرة الذي كنا نتابع فيها محاضرات شيّقة، والساحة الواسعة في الخارج التي كثيراً ما استمتعنا فيها بعروض موسيقية في ليالي الصيف، وقاعة الرياضة حيث كنا نأخذ دروساً في الجمباز. بعدها مررنا من ملاعب التنس، التي كثيراً ما رأينا فيها أخانا سري وهو يلعب التنس مع أصدقائه روبرت مشبك والإخوة ديب.
بعد جمعية الشبان المسيحية أخذنا نمشي بتمهل وروية، نستذكر المشاهد الجميلة المألوفة لنا. كم مشينا في ذلك الطريق حينما كنا سكّان القطمون، في طريقنا إلى المنزل في ليالٍ قمرية بعد فعاليات عروض موسيقية أو أفلام في السينما.
سررنا برؤية المدرسة العمرية على يميننا وسط حرش الزيتون، إضافة إلى بعض المشاهد المألوفة الأخرى مثل محطة سكة الحديد إلى الأسفل، وموقف الوقود في المقابل. الجدار الرمادي حول محطة سكة الحديد كان يبدو أخفض مما كنت أتخيّل.
وصلنا بعد ذلك إلى "الكولونيالية الألمانية" حيث كنا قد أمضينا ستة أعوام سعيدة خلال طفولتنا. كانت مدرستنا خلال الثلاثينيات. الصالة القديمة المحاذية للمنزل التابع للمدرسة كان قد أصبح كنيسة أرمنية. كانت الساعة القديمة أعلى البناية في مكانها ولكن جرسية المدرسة الكبيرة المعلّقة عند بوابة المدرسة كانت قد اختفت. كان الملعب الكبير قد أصبح الآن أكواخاً قبيحة متراصة ومشوهة المعالم.
واصلنا السير عبر الطريق الذي تظلّله الأشجار. كان كل شيء هنا تماماً كما عرفناه قبل تسعة عشر عاماً لكن البيوت كانت تبدو رثة ومهترئة، والحدائق مُهملة وباهتة. عند دكان ايبينغر(الذي كان أيضاً قد تحوّل إلى شيء آخر) التفتنا يسرة نحو الطريق الذي كنا نعيش فيه في الأعوام 1931-1937. رأينا في البداية دكان البقالة الصغير على زاوية الطريق، والذي كان معروفاً لسكان "الكولونيالية الألمانية" باسم "لعدلي". كان يبدو بحالة فوضى أكثر من أي زمن مضى.
في النهاية وقفنا قرب منزل باورلي في منطقة سكننا. كان ذلك المنزل بسقفه القرميدي قد أصبح مهترئاً أيضاً. كان يبدو مظلماً وشاحباً، وكأن طبقات من الرماد قد رست عليه خلال السنوات دون أي موسم شتاء يغسله ويعيد إليه رونقه. الأشجار اليانعة في البستان كانت قد نمت بفوضوية وكان ينقصها الكثير من العناية.
الوصول إلى القطمون
عدنا إلى الطريق الرئيسية وأكملنا السير. كان مخفر الشرطة السابق على يسارنا، ثم مررنا بمحل "سبينيز" أو بالأحرى حيث كان محل سبينيز يوماً ما. واصلنا السير نحو صيدلية صايغ، ثم محل الدجاني للخضروات وملحمة الكالوتي، ثم "فيلا" عائلة غارابيديان الأرمنية، والمقبرة الألمانية، وعمارة سماحة البيضاء في الزاوية، وإلى اليمين كانت الكولونيالية الألمانية والنادي الرياضي. تذكرت "اللّفات" الممتعة على الدراجة التي كنا نقوم بها أنا وصديقتي جين في هذا الطريق في أمسيات الصيف في أوائل الأربعينيات.
كنا الآن نقترب من حينا – القطمون. أخذنا نتحمّس وأصبحنا الآن بفارغ الصبر لرؤية بيتنا. أول شيء لاحظناه هنا هي البنايات الجديدة المتراصة التي أصبحت مشيدة في الفراغات بين الأبنية. لاحظنا أيضاً أن بعض الفلل السابقة كان قد أضيف على سقفها طابق ثان، الأمر الذي صعب علينا مهمة التعرف على بعض المنازل.
في النهاية أخذنا نتجه إلى "الطلعة" المؤدية إلى آخر محطة من رحلتنا: طلعة بيتنا. شعرنا ببعض الاطمئنان حينما رأينا المنزلين الاثنين لعائلة طليل في مكانهما، وكأنهما بوصلة تأخذنا إلى معالم المكان. بعد منزلي طليل، انتقلنا إلى منزلي عائلة مرقس، واللذين كانا أيضاً على حالهما. بين هاتين البنايتين بدت ملامح منزلنا للمرة الأولى. آخ. منزلنا وأخيراً. أسعفتنا رؤية السقف القرميدي الأحمر في مكانه، الأمر الذي كان يشير إلى عدم بناء طابق آخر فوق منزلنا.
أسرعنا خطانا مروراً بمنزل عائلة دمياني (كانت تلك الفيلا تبدو مهجورة وموحشة داخل بستانها الواسع). درنا يمنة ومشينا عبر الممر المألوف المحوط بالأشجار، مروراً ببستان دمياني، وشقق حمصي، حيث كانت تعيش جدتي وعمومي وعائلة عوض وصفير والبديري، ورأينا المنزل الثالث لعائلة طليل، دار جارنا المحاذي لمنزلنا. وأخيراً. إذن وصلنا. كنا الآن في بيتنا. كانت لحظة حزينة للغاية.
كان البيت يبدو سليماً من الخارج، ولكن كان نوعاً ما يبدو مظلماً أكثر. الجدران كانت تبدو مغبرة، لون الستائر كان قد ضاع رونقه. الأدراج كانت متسخة. ولكن باعتقادي ما جعل الأمر سوءاً هو حالة البستان المزرية. لم تعد هناك نبتة صريمة الجدي الجميلة ذات الرائحة العطرة عبر بوابة البستان، أو شجيرة الياسمين المتدلية على المنزل. أما الدالية الطويلة قرب المنزل فقد كانت قد اختفت. الحديقة كانت قاحلة وبنية ومغطاة بنثار النباتات الميتة. بجوار المنزل، وفي وسط البستان، كانوا قد شيدوا جسماً خشبياً قبيحاً.
أخبرنا رجل من الشارع أن المنزل يستخدم كحضانة للأطفال. كان في ذلك بعض العزاء. تذكرت كلمات والدي وهو يعيد بحنان كلمات السيد المسيح: "دعوا الأطفال يأتون إليّ".
لم يعد بيتنا الذي نعرفه
صعدنا الأدراج. كانت الفيراندا تبدو عارية من الخارج. على السقف كان المصباح القديم في مكانه. الفيراندا محاطة بدرابزين حديدي على ما يبدو لحماية الأطفال من التسلق. ترددنا لبضع لحظات، ثم تجرأنا وفتحنا الباب الأمامي لدارنا ودخلنا (بما أن الجرس الكهربائي كان قد أزيل من مكانه، يبدو أن لا أحد سمعنا نطرق الباب).
وأخيراً وقفنا في الداخل، تماماً في صالون (غرفة جلوس) منزلنا. كان الباب الواسع الذي يفصل غرفة الجلوس عن غرفة الطعام قد أزيل. الغرفتان الآن تشكلان قاعة كبيرة يبدو أنها تستعمل الآن كقاعة لعب للأطفال. كانت الغرفة فارغة باستثناء بعض الزينة والرسومات المعلقة على الحائط. مشينا إلى الداخل، وألقينا نظرة على ما كانت صالة الطعام (السُفرة) في منزلنا.
 شعرت أنني في حلم غريب. وددت لو تسنى لنا إمضاء بعض الوقت لوحدنا في المنزل لنعيش بهدوء بعض الذكريات التي أخذت تتدفق على بالي. كان ذلك مستحيلاً. خفنا أن يخرج أحدهم من إحدى الغرف ويأخذ باتهامنا بالاختراق (على غرار ما حدث لعدد من أصدقائنا الذين ذهبوا لزيارة منازلهم). سمعنا صوت أطفال.
شعرت أنني في حلم غريب. وددت لو تسنى لنا إمضاء بعض الوقت لوحدنا في المنزل لنعيش بهدوء بعض الذكريات التي أخذت تتدفق على بالي. كان ذلك مستحيلاً. خفنا أن يخرج أحدهم من إحدى الغرف ويأخذ باتهامنا بالاختراق (على غرار ما حدث لعدد من أصدقائنا الذين ذهبوا لزيارة منازلهم). سمعنا صوت أطفال.
طرقنا الباب. ظهرت امرأتان: امرأة شابة سمراء وأخرى أوروبية مسنة. خاطبناهما في البداية باللغة العربية، ولكن يبدو أنهما لم تفهما. سألناهما إن كانتا تتكلمان اللغة الإنجليزية، ولكن أشارتا بالنفي أيضاً، فأخذنا نتكلم بالألمانية. فهمت المرأة المسنة. حاولنا أن نوضّح الأمور: "هذا منزلنا. كنا نعيش هنا قبل عام 1948. هذه أول مرة نراه منذ تسعة عشر عاماً".
بدت على المرأة المسنة علامات التأثر، ولكنها أخبرتنا مباشرة أنهاً أضاعت منزلها أيضا في بولندا، وكأننا نحن شخصياً، أو العرب بشكل عام، نتحمل مسؤولية ذلك. رأينا أنه من غير المجدي مجادلتهما.
قمنا بجولة في المنزل غرفة غرفة – غرفة نوم والدينا، غرفة نومنا، غرفة العمة ميليا، الصالون، المكتبة (والتي كانت جميعها الآن غرفة واحدة لأن الحائط بينها كان قد أزيل)، إضافة إلى صالة الطعام والمطبخ. كان البيت بشكل عام بحالة جيدة، ولكن كل شيء فيه كان قد تغيّر. لم يعد بيتنا الذي نعرفه.
خرجنا إلى الفيرندا. أحاط بنا أطفال بأصواتهم السعيدة، ولكننا وقفنا هناك ذاهلتين ننظر إلى الشارع ومفترق دار جيراننا – عائلة سلحيت، عائلة سروجي، وعائلة طليل. الناس هم من يشكلون معالم المكان، وحينما يغادرون لا تصبح الأمور على ما كانت عليه.
تركنا منزلنا وحيّنا بمشاعر يملؤها الفراغ والخيبة والإحباط. كانت الشوارع في مكانها المألوف، كانت المنازل في مكانها، ولكن كان ينقصها الكثير. شعرنا أننا غرباء في حيّنا.
* ترجمة: اليز أغازريان