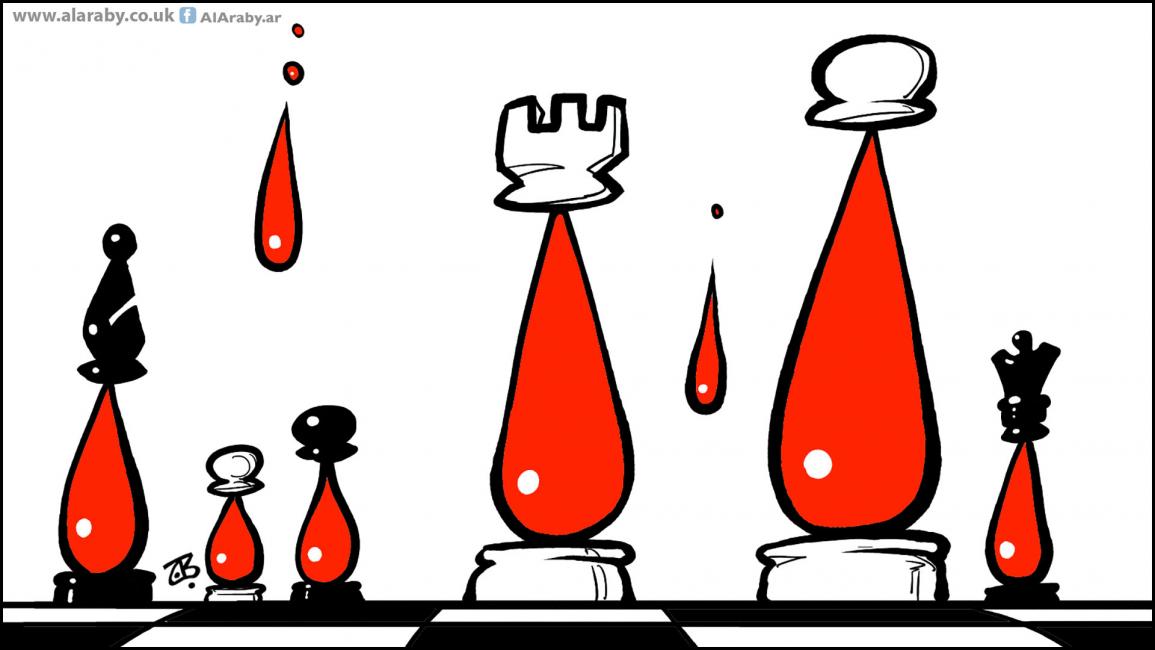14 نوفمبر 2016
فرص تاريخية ضائعة في سورية
جرى في حلب، في بيت عائلة ميسورة، بعضٌ من أفرادها يساريون وآخرون إسلاميون، في عام 1980 اجتماعان ضيقان بين عدد ضئيل من قياديي "الإخوان المسلمين السوريين" وما كان يسمى آنها الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي، والذي وصار اسمه حزب الشعب.
أنْ تجري اجتماعات واتصالات بين هذين الحزبين، من أجل بحث العمل ضد النظام، كان وقتها فتحاً كبيراً في عالم السياسة السورية. شيوعيون و"إخوان" أمر جلل، وقد سبق الاجتماعين تنسيقٌ ما، وتبعهما تنسيقٌ في الخارج مؤكد.
لكي يدرك المرء استثنائية الأمر، عليه أن يعود إلى أعوام السبعينيات والثمانينيات، ويلاحظ كيف كان نظام حافظ الأسد يبني، بوضوح، سدوده الأمنية، وكيف كان ينسج علاقات عالمية ومحلية، هدفها الحفاظ على السلطة، وفق سياسة أقلوية طائفية.
وكان الجو الفكري الداخلي الذي انطلق منه "المكتب السياسي - الشيوعي" نحو هذا "التحالف (!)" يرتكز على مفهومين. مفهوم "الكتلة التاريخية" المؤهلة والقادرة على التغيير، أي أن يجري تحالف واسع من الفئات التي لها مصلحة في التغيير. ولأن النظام، وباختصار، كان ذا صبغة أقلوية طائفية أمنية علمانوية يسراوية، كانت الشروط تضغط نحو "كتلة تاريخية" معاكسة، أي نحو تكتل أكثري ديمقراطي مدني ليبرالي إسلامي. وكان المفهوم الثاني نوعاً من رمي القشرة الأيديولوجية الماركسية، وملاقاة الجمهور الأعرض، بعد عزلة وغربة، وفي هذا تأثرٌ، إلى حد ما، بتجربة الحزب الشيوعي السوداني الذي كان على رأسه بعض القادة "الصائمون المصلون (!)" الذين كان لتجربتهم في كسر الغربة تجاه الناس البسطاء قيمةٌ كبيرة.
كان الحزبان "الإخوان والمكتب" وقتها في حالة عداء قوية مع النظام وأجهزته الأمنية، وكانا الأكثر جذرية في "المعارضة" السورية، وربما لا يزالان. ولكن، من الخطأ أن يحاول بعضهم أن ينسب تحرك الثمانينيات إلى تحالفهما، والأكثر خطأ أن يُجير لصالح "الإخوان"، فقد كان الجو السياسي العام يشبه بداية ثورة 2011، وكان للنقابات المهنية وجامعتي حلب ودمشق دور بارز في التحرك المدني، وفي إيجاد جو معارض واسع النطاق والتأثير، كما كان للشخصيات المستقلة ذات النفوذ الشعبي مثل هذا الدور.
وأيضاً، حصل في انتفاضة 1980 مثل الذي حصل في ثورة 2011. إذ إضافة إلى الضغط
الأمني الهائل، استمر تنظيم "الطليعة المقاتلة"، وهي جزء من جماعة الإخوان المسلمين، في خطاب مزاود عنيف وطائفي أعمى، عبر صحيفة النذير السرية، والتي كانت تطبع في الأردن وتسرب إلى الداخل. وكانت الطليعة المقاتلة تاريخياً المثال الأول على الجهادية السنية في كل المنطقة العربية. قامت الطليعةُ بعملياتٍ، لا قيمة عسكرية لها، ولا فائدة سياسيةً، ترتجى منها. ومن أحد المساجد المسيطر عليها في حلب، خطب شيخٌ إخواني إن "الشيوعيين الجرذان مدّوا رؤوسهم، وعلى هذه الجرذان أن تعود إلى جحورها". وانكفأ بذلك مشروع تحالف مُستجدّ، له ما له وعليه ما عليه.
ارتبك حافظ الأسد بالثورة الناقصة، مثلما ارتبك نجله فيما بعد. وفي خطاباته، التي أسماها السوريون آنذاك "المسلسل"، أعلن أن "رائحة البيادر تحت ضوء القمر أحب إليه من السلطة" وأنه "لو علم أن سورياً واحداً لا يقبل به رئيساً لتنحى عن هرم السلطة". تصوّروا كم كان كاذباً أشراً. ولكنه سرعان ما تماسك، وتماسك معه نظامه وأجهزته، وبرعايةٍ روسيةٍ بشكل مباشر، وعن طريق مخابرات ألمانيا الشرقية بشكل غير مباشر، وأكاد أكون متأكداً بمساعدة أمنية إيرانية أيضاً. ما أشبه اليوم بالبارحة.
رأى المخططون، وقتها، من هذه الدول، إضافة لشخصي حافظ الأسد وعلي دوبا وبعض شخصيات النواة الأمنية الصلبة، أن مقتل حراك الثمانينيات هو حصره، ودفعه إلى أن يتحول إلى تحرك طائفي سني. وعلى هذا الأساس، اعتقل سياسيون ومدنيون كُثرٌ، ومن أحزاب متعددة، وتركوا في السجن مدداً دهرية، من أجل أن لا تكون للحراك سمة مدنية حداثية بأي صورة. جُرّم "الإخوان" على الرغم من محاولة قيادتهم السياسية التنصّل من جماعة "الطليعة المقاتلة"، وخطابها الطائفي الفاقع. كما جرى اختراق "الطليعة المقاتلة" أمنياً، ودفعت إلى عمليات قذرة. ومن المفارقات أن قيادات "الإخوان" هربت قبل صدور "قانون" تجريم الانتماء للتنظيم، بينما قبض على كل قيادات الصف الأول في الشيوعي – المكتب، وأمضوا في السجون سنوات طويلة.
هكذا ضاعت فرصةٌ في إيجاد كتلة تاريخية. ضاعت بين إسلاميين متغطرسين مـتأثرين بالصحوة الإسلامية والغيرة من الثورة الإيرانية والهوس المرضي بالتاريخ والنصوص والشريعة، وبين معارضين يساريين وحداثيين ضعاف البنية والتأثير. هل بنا حاجة، إذن، أن نرى، الآن، في الثورة السورية الحالية أن الفرصة الثانية تضيع؟ هل نحتاج أن نقول إن من أضاعوا الأولى أضاعوا الثانية، وبحجم خسائر مهول؟
ستظل الفرصة الضائعة من أجل بناء دولة عدالة وديمقراطية في سورية قائمة، طالما بقي الإسلاميون هم الأقوى، وطالما ظلت النصوص تتحكم بالواقع، بدلاً من أن تكون تفسيراً للواقع وجزءاً منه. ضاعت الثورة الأولى تحت تأثير الصحوة الإسلامية السنية، وتحت تأثير الثورة الإيرانية الشيعية. وتضيع، الآن، الثورة الثانية تحت تأثير الجهادية السنية والتوسع الإمبراطوري الإيراني. والمشكل أنه "زيد على الحِمْل علاوةٌ ثقيلة". إنها روسيا القيصر المؤمن.
أنْ تجري اجتماعات واتصالات بين هذين الحزبين، من أجل بحث العمل ضد النظام، كان وقتها فتحاً كبيراً في عالم السياسة السورية. شيوعيون و"إخوان" أمر جلل، وقد سبق الاجتماعين تنسيقٌ ما، وتبعهما تنسيقٌ في الخارج مؤكد.
لكي يدرك المرء استثنائية الأمر، عليه أن يعود إلى أعوام السبعينيات والثمانينيات، ويلاحظ كيف كان نظام حافظ الأسد يبني، بوضوح، سدوده الأمنية، وكيف كان ينسج علاقات عالمية ومحلية، هدفها الحفاظ على السلطة، وفق سياسة أقلوية طائفية.
وكان الجو الفكري الداخلي الذي انطلق منه "المكتب السياسي - الشيوعي" نحو هذا "التحالف (!)" يرتكز على مفهومين. مفهوم "الكتلة التاريخية" المؤهلة والقادرة على التغيير، أي أن يجري تحالف واسع من الفئات التي لها مصلحة في التغيير. ولأن النظام، وباختصار، كان ذا صبغة أقلوية طائفية أمنية علمانوية يسراوية، كانت الشروط تضغط نحو "كتلة تاريخية" معاكسة، أي نحو تكتل أكثري ديمقراطي مدني ليبرالي إسلامي. وكان المفهوم الثاني نوعاً من رمي القشرة الأيديولوجية الماركسية، وملاقاة الجمهور الأعرض، بعد عزلة وغربة، وفي هذا تأثرٌ، إلى حد ما، بتجربة الحزب الشيوعي السوداني الذي كان على رأسه بعض القادة "الصائمون المصلون (!)" الذين كان لتجربتهم في كسر الغربة تجاه الناس البسطاء قيمةٌ كبيرة.
كان الحزبان "الإخوان والمكتب" وقتها في حالة عداء قوية مع النظام وأجهزته الأمنية، وكانا الأكثر جذرية في "المعارضة" السورية، وربما لا يزالان. ولكن، من الخطأ أن يحاول بعضهم أن ينسب تحرك الثمانينيات إلى تحالفهما، والأكثر خطأ أن يُجير لصالح "الإخوان"، فقد كان الجو السياسي العام يشبه بداية ثورة 2011، وكان للنقابات المهنية وجامعتي حلب ودمشق دور بارز في التحرك المدني، وفي إيجاد جو معارض واسع النطاق والتأثير، كما كان للشخصيات المستقلة ذات النفوذ الشعبي مثل هذا الدور.
وأيضاً، حصل في انتفاضة 1980 مثل الذي حصل في ثورة 2011. إذ إضافة إلى الضغط
ارتبك حافظ الأسد بالثورة الناقصة، مثلما ارتبك نجله فيما بعد. وفي خطاباته، التي أسماها السوريون آنذاك "المسلسل"، أعلن أن "رائحة البيادر تحت ضوء القمر أحب إليه من السلطة" وأنه "لو علم أن سورياً واحداً لا يقبل به رئيساً لتنحى عن هرم السلطة". تصوّروا كم كان كاذباً أشراً. ولكنه سرعان ما تماسك، وتماسك معه نظامه وأجهزته، وبرعايةٍ روسيةٍ بشكل مباشر، وعن طريق مخابرات ألمانيا الشرقية بشكل غير مباشر، وأكاد أكون متأكداً بمساعدة أمنية إيرانية أيضاً. ما أشبه اليوم بالبارحة.
رأى المخططون، وقتها، من هذه الدول، إضافة لشخصي حافظ الأسد وعلي دوبا وبعض شخصيات النواة الأمنية الصلبة، أن مقتل حراك الثمانينيات هو حصره، ودفعه إلى أن يتحول إلى تحرك طائفي سني. وعلى هذا الأساس، اعتقل سياسيون ومدنيون كُثرٌ، ومن أحزاب متعددة، وتركوا في السجن مدداً دهرية، من أجل أن لا تكون للحراك سمة مدنية حداثية بأي صورة. جُرّم "الإخوان" على الرغم من محاولة قيادتهم السياسية التنصّل من جماعة "الطليعة المقاتلة"، وخطابها الطائفي الفاقع. كما جرى اختراق "الطليعة المقاتلة" أمنياً، ودفعت إلى عمليات قذرة. ومن المفارقات أن قيادات "الإخوان" هربت قبل صدور "قانون" تجريم الانتماء للتنظيم، بينما قبض على كل قيادات الصف الأول في الشيوعي – المكتب، وأمضوا في السجون سنوات طويلة.
هكذا ضاعت فرصةٌ في إيجاد كتلة تاريخية. ضاعت بين إسلاميين متغطرسين مـتأثرين بالصحوة الإسلامية والغيرة من الثورة الإيرانية والهوس المرضي بالتاريخ والنصوص والشريعة، وبين معارضين يساريين وحداثيين ضعاف البنية والتأثير. هل بنا حاجة، إذن، أن نرى، الآن، في الثورة السورية الحالية أن الفرصة الثانية تضيع؟ هل نحتاج أن نقول إن من أضاعوا الأولى أضاعوا الثانية، وبحجم خسائر مهول؟
ستظل الفرصة الضائعة من أجل بناء دولة عدالة وديمقراطية في سورية قائمة، طالما بقي الإسلاميون هم الأقوى، وطالما ظلت النصوص تتحكم بالواقع، بدلاً من أن تكون تفسيراً للواقع وجزءاً منه. ضاعت الثورة الأولى تحت تأثير الصحوة الإسلامية السنية، وتحت تأثير الثورة الإيرانية الشيعية. وتضيع، الآن، الثورة الثانية تحت تأثير الجهادية السنية والتوسع الإمبراطوري الإيراني. والمشكل أنه "زيد على الحِمْل علاوةٌ ثقيلة". إنها روسيا القيصر المؤمن.