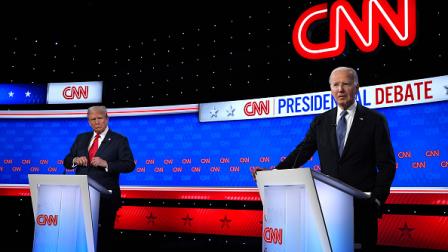العنف الفردي العشوائي في أميركا زائر دوري جوّال، يضرب ويغيب إلى حين، ثم يعود ليكرر ضربته بدرجة أو بأخرى من الشراسة والدموية، لكن كلفته هذه المرة في لاس فيغاس غير مسبوقة.
القاتل تمترس وبحوزته عشر بنادق حربية، في غرفة بالطابق 32 في أحد فنادق لاس فيغاس المطلة على ساحة غصت بألوف الحاضرين لحفل غنائي كبير.
قبيل الانصراف فتح النار على الجمع، وتيسر له الوقت الكافي ليحصد حوالي 60 قتيلاً وأزيد من 515 جريحاً، والعدد مفتوح. العملية هزّت أميركا بحجمها ولو أنها اعتادت على هذا النوع من الفواجع.
في العادة، يعزى مثل هذا العنف الجنوني إلى اختلال عقلي لدى الجاني، أو إلى نوع من الانتقام الشخصي بدافع رد الاعتبار أو للثأر من ربّ العمل لطرده من وظيفة. وأحياناً إلى نزوع إجرامي تكوّن بتأثير ظروف حياتية مضطربة. تعطى تفسيرات كثيرة، لكنها لم تكن كافية لتقود إلى المعالجة السليمة.
المحيّر في هذه الحالة، حسب المعلومات الأمنية التي توفرت حتى اللحظة، أن القاتل الأميركي الأبيض من أبناء منطقة مجاورة للمدينة، ليس من أصحاب السوابق ولا هو مختل أو عضو في واحدة من جمعيات العنف المسلحة. كما تبين من التحقيقات الأولية أنه لا يضمر شراً لفرد أو لجهة معينة، ولا دخل في خلاف كبير مؤخراً مع أحد.
في ضوء ذلك، تميل تقديرات بعض الجهات إلى تصنيف العملية في خانة السادية التي يتلذذ صاحبها بمتعة القتل، أو في خانة "العمل الشرير"، كما قال الرئيس دونالد ترامب. لكن هذه التخمينات لم تقدم الإجابة الشافية أو تهدئ القلق، بقدر ما قفزت فوق عاملين أساسيين، ليست عملية لاس فيغاس سوى واحدة من تعبيراتهما التي تنغّص حياة الأميركيين: انتعاش ثقافة العنف في الآونة الأخيرة، واستفحال ظاهرة حيازة السلاح الفردي.
العنف ليس طارئاً على الحياة الأميركية، فـ"نحن شعب عنيف" قال مرة السناتور جون ماكين، وهذا توصيف لواقع الحال.
عوامل مختلفة ساهمت في تكوينه منذ ولادة الاتحاد، وفي السنوات الأخيرة أخذت هذه الثقافة شحنات متوالية من الزخم الذي تغذى من الخارج، كما من تعمّق الانقسام الداخلي بفعل الخطاب السياسي المتطرف الذي استبدل لغة الحوار مع الآخر بلغة الإقصاء.
وكان لخطاب حملة انتخابات الرئاسة الأخيرة حصة كبيرة في تعزيز هذه النعرة، وما حصل الشهر الماضي في مدينة شارلوتسفيل في ولاية فرجينيا على يد العنصريين البيض، لم يكن سوى التعبير المكثف لهذا النزوع التصادمي القائم على العنف المكشوف.
أما حيازة السلاح، فقد باتت معضلة أميركية، خطيرة ومعيبة في آن. فالأميركيون يملكون أسلحة بما يزيد على عدد السكان البالغ 330 مليون نسمة.
الكمية والنوعية، في ظل هكذا ثقافة، تحولت إلى نزيف دموي يتجول ويتكرر في أنحاء أميركا بصورة شبه منتظمة. ما قصده التعديل الدستوري من حق اقتناء السلاح لتكوين مليشيا تدافع عن الاستقلال في زمن تكوين الدولة، تحوّل إلى "حرية تعبير" يحميها الدستور وممنوع مسّها، وبما يجيز للمواطن تكديس ما يريد من الأسلحة الفردية.
ثم تطور هذا الحق بضغط لوبي الأسلحة ليصبح بإمكان المواطن حيازة رشاشات أوتوماتيكية من الصنف الذي تستخدمه القوات المسلحة. والمعروف تاريخياً أن البيض هم الفئة الأكثر إصراراً على التمسك بحق التسلح. وفي بعض الولايات، صدرت قوانين محلية تسمح بحمل السلاح على المكشوف، خاصة في الجنوب، بزعم حق الدفاع عن النفس، وكأن قوات الأمن تأتي بالدرجة الثانية في حماية الأمن الداخلي.
كما يذكر أن عمليات القتل العشوائي يرتكبها عادة وفي الغالبية الساحقة من الحالات أميركيون بيض، وفي معظم الأحيان ضد البيض أيضاً.
لم يتناول الجدل الذي أثارته الحادثة موضوع السلاح وكثرة انتشاره. على الأقل حتى الآن، ولو أنه سيعود إلى فتح هذا الملف، لكن مثل كل مرة سيتلاشى عند وصوله إلى مدخل الكونغرس، الذي طالما "تلطّى" وراء الدستور للنأي عن موضوع اقتناء السلاح الذي يقف وراءه أقوى لوبي أميركي داخلي، وبما يعادل قوة اللوبي الإسرائيلي الخارجي.
ولذلك من المشكوك فيه، في ضوء السوابق، أن يحدث أي تغيير لضبط مشكلة السلاح؛ ولو أن القاتل الحالي كان بحوزته عشر بنادق حربية استقدمها معه إلى غرفته في الفندق واستعان بها لتنفيذ جريمة فظيعة خطط لها ببرودة أعصاب، وتعمد ارتكابها من محطة عالية وكاشفة، لضمان سقوط أكبر عدد من الأبرياء. فلولا هذه الترسانة لما تيسر له قتل هذا العدد، لكن يبقى، وحتى إشعار آخر، صوت لوبي السلاح أقوى من صوت المطالبين بلجم انفلات العنف وأدواته في أميركا.