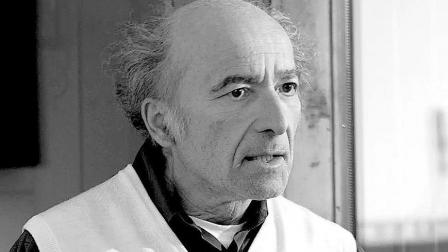لوحة للفنان الفرنسي بول غوغان
رحلةٌ مشحونةٌ بالتاريخ المُعتّقِ والعِبر الكثيفة، قمتُ بها في يناير 1985، لا تغادر ذاكرتي. ربما لأنها مزيجٌ تتضارب فيه، في الوقت نفسه، الأمزجةُ الجيوسياسية والمناخية القاهِرة بالمفاجآت السريالية الإنسانية المؤثرة، القرفُ بالدهشة.
وصلني بداية ذلك الشهر هاتفٌ يحمل خبراً عائليّاً حزيناً. ولأني سأسافر إلى عدَن عبر موسكو، فقد كلّفتني أسرَتي بلقاء أختي الصغيرة التي وصلت قبل أشهر إلى لينينغراد للدراسة، لأمهّد الخبر لها لئلا تصدم.
طلبتُ من مسؤول في سفارة جنوب اليمن في باريس كتابة رسالة للقنصلية السوفييتية، شارحاً سبب زيارتي، لتسهيل حصولي على الفيزا لبلاد السوفييت المغلقة تماماً، لاسيما على القادمين فرادى من دول الغرب. بعد عراكٍ دام عدة ساعات، حصلت على الرسالة؛ رفض المسؤول في البدء "إزعاج الرفاق السوفييت، المشغولين بقيادة قوى التحرر والاشتراكية العالمية، بطلب تافه!"، كما قال.
توجّهتُ للقنصلية السوفييتية. القنصل أذربيجاني. لم يرفض طلبي. ربما لأنه يفهم "الشعبكات" الأسرية الشرقية. بعث برسالة طلب لموسكو، ودعاني للعودة كل صباح إلى القنصلية حتى يصل الرد. أعلمت بسفري أختي التي قالت إنها ستستقبلني في مطار موسكو عندما أصل. بعد أيام، كنتُ بباب القنصلية وحيداً، أنتظر كعادتي، رغم أنه يوم إجازة سبت. فوجئت بوصول القنصل في العاشرة. بعد نصف ساعة، دعاني وأعطاني الفيزا، لأن "الرد وصل إيجابياً قبل دقائق". لعلّ هذا الإعجاز من محاسن فترة حكم أندروبوف الذي هيأ لجلاسنوست غورباتشوف و"بيروستريكاه".
وصل طقس يناير 1985 إلى رقمٍ قياسي لا يتكرّر: 20 درجة تحت الصفر في باريس، أمّا في موسكو فكان 40 تحت الصفر. ولحسن الحظ أن صديقاً أعارني ملابسَه الإسكيموية الخاصة بالتزحلق بالجليد. أدينُ له بالحياة: لولاها لوجدوني جثّةً مثلّجةً في شوارع موسكو.
وصلتُ مطار موسكو ظهراً. لم أر أختي. إشعاراتٌ بالميكرفون كل نصف ساعة لتحديد موقعي في المطار، فيما إذا وصلتْ متأخرةً بسبب الطقس. انتظارٌ لا يطاق، في مطارٍ صقيعيٍّ كئيب، حتى منتصف الليل، عندما أخبروني أن المطار سيغلق ويلزمني مغادرته؛ "إلى أين؟"، سألتُ. "أمامك فندق الأيروفلوت، على بعد حوالى كيلومتر من المطار. ثمّة من سيجيب عن سؤالك" قال لي مسؤول في استعلامات المطار.
اقرأ أيضاً: ساخاروف، غاغارين، والمهدي المنتظر
ثلاث خطوات لا غير خارج الباب. خطرٌ وقلق: حاولتُ قرص أنفي بكل ما أمتلك من قوة. لم أحس شيئاً. تجمّد دمي من زمهرير البرد. بدا لي ذلك الفندق، ذو البناء المعماري السوفييتي القبيح، قصيّاً مستحيلاً في هذه الطريق الوحشية التي أمشي فيها بصعوبة، مجرجراً حقيبة سفري فوق كثبانٍ جليدية، في ليلٍ قطبيٍّ مخيف. كل عشر خطوات يقابلني روسيٌّ تنبعث منه روائح داكنة: "دولار؟". وجوهٌ لا تبشر بخير. أتقدّم رافضاً طلبهم بالصرف في السوق السوداء؛ تذكّرتُ بحسرة سخافة أسطورة "الإنسان السوفييتي المكتمل الصفات" التي تلقّيناها في عدن.
وصلتُ الفندق. رفضتني مسؤولته ببيروقراطيةٍ سوفييتيةٍ تقليدية، قائلة إنه فندق للمجموعات السياحية الخاصة بأيروفلوت فقط. وعليّ الذهاب إلى المدينة بحثاً عن فندق آخر. أجبتُ: لا يمكنني مغادرة الفندق خطوةً واحدة. فأمرتني بالخروج حالاً. زاد رفضي بعنادٍ وقوة لأني كنت فعلاً هالكاً، غير قادرٍ على مواجهة مدينةٍ عدوانية في ليلٍ سيبيريٍّ بهيم. التفّتْ حولي مجموعةٌ سياحية من الأوروبيين، تدعم طلبي. استنكارٌ وصخبٌ جماعي. أصرَّ أحد الأوروبيين قائلاً إن في غرفته سريراً شاغراً. وبعد مكالمةٍ هاتفية مع مجهول، قالت لي: ستنام في غرفة الفرنسي، شريطة أن تدفع 50 دولاراً، وتغادر الفندق غداً في السابعة صباحاً، قبل أن يراك أحد.
غرفةٌ من ثلج لم أستطع النوم فيها إلا بالمعطف، وعند الخامسة فجراً تحديداً. يُوقظني ميكرفون في جدار الغرفة يزعق بعنف أخباراً بالروسية، بعد ساعةٍ من نومي فقط. فطورٌ رديءٌ في السادسة والنصف، بدأهُ النادل بكلمة "دولار؟".
ثم توجّهتُ قبل السابعة بالتاكسي إلى سفارة جنوب اليمن. انتظارٌ طويل وبيروقراطيةٌ قاتلة، رغم سؤالي البسيط: أين أختي، وكيف أراها؟
بعد قليل، وصل شابٌ يسكن في شارع مجاور لمنزلنا في عدَن، يدرس في لينينغراد. قال لي إنه سمع أن أختي في المستشفى، لذلك لم تصلها برقيتي البارحة. أوضح لي كيف أصل إليها، وأعطاني عنوان المستشفى. شرح لي أيضاً كيف أتوجّه إلى غرفته الجماعية في السكن الجامعي للنوم فيها: "ثمة حارس للعمارة سيمنعك إذا جئت من الباب". استغربتُ: تقاليدهم لا تشبه نمط حياتنا الطلابية الفرنسية: بدون حراس ولا منع ولا غرف جماعية. أردف: يلزمك أن تصل من خلف العمارة، وتدخل الغرفة من النافذة الخلفية. ستجد أصدقائي في انتظارك.
بعد ساعات ثلاث، كنت في المطار من جديد، في طريقي إلى لينينغراد. الظروف الجويّة أخّرت موعد السفر. باصٌ كبيرٌ خاص ينقلني مع أمريكي فقط من صالة الانتظار إلى باب الطائرة. وباصٌ ينقل حشداً مزدحماً من الروس. وباصٌ ثالث ينقل طاقماً عسكرياً سوفييتياً بطلعات مهيبة.
أمام باب الخروج في مطار لينينغراد طابورٌ لا نهاية له، ينتظر التاكسيات. المواصلات شبه مستحيلة. عدةُ ساعات انتظار في جوٍّ قاتل. تجمّدَ نخاعي الشوكي، قبل أن آخذ التاكسي باتجاه المستشفى. وصلت حوالى العاشرة مساء. موعد الزيارات قد انتهى قبل ساعات، لكني أردتُ محاولة الاتصال هاتفياً بأختي من بهو المستشفى، للاطمئنان عليها ومحاولة رؤيتها ولو دقيقتين.
تصلُ ممرضة تقول إنها سكرتيرة المنظمة القاعدية للحزب في المستشفى، وستقودني لغرفة أختي. تسرد في طريقنا، بلغة خشبية وإنجليزية تقريبية، ما يشبه خطابات صحيفة البرافدا عن دور الاتحاد السوفييتي في السلام الدولي ورفضه لحرب النجوم الريغانية (رونالد ريغان). "دعاية وتحريض أيديولوجي، وفي هذه الساعة!"، قلت لنفسي.
ما إن اقتربنا من عمارة أختي حتى لاحظتُ نساءً في أكثر من نافذة. فاجأتني السكرتيرة: راهنتْ كل واحدة منهن أنها ستُبشِّر أختك بمجيئك. أصلُ، أرى أختي تنتظرني قرب باب صالة مرضى كبيرة. عناق. بعد قليل كنا وسط لفيفٍ من نساءٍ غادرن أسِرّتهنّ قادمات صوبنا. غيّرنَ خارطة الصالة لوضعِ طاولةٍ ضخمة في وسطها. كنا، أختي وأنا، في المركز، يُحيطنا حشد يحتفل بنا في جوّ إنساني بريء وكثيف، يصعب وصفه.
ازداد الجوّ غرائبية: أخرجت كل واحدة من أسفل سريرها قنينة فودكا كانت تحتفظ بها سرّاً، وكثيراً من المأكولات التي هيأنها للمناسبة! فودكا داخل مستشفى: أمّ الجن، آخر ما يخطر ببال.
عرفتُ أنها ليلة الميلاد الأورثوذكسي. ولم يبق في المستشفى إلا هؤلاء النساء اللواتي لا قريب يشاركهن العيد، إلا أنا وأختي. ثمّ موسيقى ورقص حتّى الفجر، سعادةٌ بلا حدود، وسط مستشفى تحوّل إلى مرقصٍ محموم، في كوكبٍ من ثلج، وفي بلدٍ قمعيٍّ يفصله ستارٌ حديديٌّ عن العَالم.
وصلني بداية ذلك الشهر هاتفٌ يحمل خبراً عائليّاً حزيناً. ولأني سأسافر إلى عدَن عبر موسكو، فقد كلّفتني أسرَتي بلقاء أختي الصغيرة التي وصلت قبل أشهر إلى لينينغراد للدراسة، لأمهّد الخبر لها لئلا تصدم.
طلبتُ من مسؤول في سفارة جنوب اليمن في باريس كتابة رسالة للقنصلية السوفييتية، شارحاً سبب زيارتي، لتسهيل حصولي على الفيزا لبلاد السوفييت المغلقة تماماً، لاسيما على القادمين فرادى من دول الغرب. بعد عراكٍ دام عدة ساعات، حصلت على الرسالة؛ رفض المسؤول في البدء "إزعاج الرفاق السوفييت، المشغولين بقيادة قوى التحرر والاشتراكية العالمية، بطلب تافه!"، كما قال.
توجّهتُ للقنصلية السوفييتية. القنصل أذربيجاني. لم يرفض طلبي. ربما لأنه يفهم "الشعبكات" الأسرية الشرقية. بعث برسالة طلب لموسكو، ودعاني للعودة كل صباح إلى القنصلية حتى يصل الرد. أعلمت بسفري أختي التي قالت إنها ستستقبلني في مطار موسكو عندما أصل. بعد أيام، كنتُ بباب القنصلية وحيداً، أنتظر كعادتي، رغم أنه يوم إجازة سبت. فوجئت بوصول القنصل في العاشرة. بعد نصف ساعة، دعاني وأعطاني الفيزا، لأن "الرد وصل إيجابياً قبل دقائق". لعلّ هذا الإعجاز من محاسن فترة حكم أندروبوف الذي هيأ لجلاسنوست غورباتشوف و"بيروستريكاه".
وصل طقس يناير 1985 إلى رقمٍ قياسي لا يتكرّر: 20 درجة تحت الصفر في باريس، أمّا في موسكو فكان 40 تحت الصفر. ولحسن الحظ أن صديقاً أعارني ملابسَه الإسكيموية الخاصة بالتزحلق بالجليد. أدينُ له بالحياة: لولاها لوجدوني جثّةً مثلّجةً في شوارع موسكو.
وصلتُ مطار موسكو ظهراً. لم أر أختي. إشعاراتٌ بالميكرفون كل نصف ساعة لتحديد موقعي في المطار، فيما إذا وصلتْ متأخرةً بسبب الطقس. انتظارٌ لا يطاق، في مطارٍ صقيعيٍّ كئيب، حتى منتصف الليل، عندما أخبروني أن المطار سيغلق ويلزمني مغادرته؛ "إلى أين؟"، سألتُ. "أمامك فندق الأيروفلوت، على بعد حوالى كيلومتر من المطار. ثمّة من سيجيب عن سؤالك" قال لي مسؤول في استعلامات المطار.
اقرأ أيضاً: ساخاروف، غاغارين، والمهدي المنتظر
ثلاث خطوات لا غير خارج الباب. خطرٌ وقلق: حاولتُ قرص أنفي بكل ما أمتلك من قوة. لم أحس شيئاً. تجمّد دمي من زمهرير البرد. بدا لي ذلك الفندق، ذو البناء المعماري السوفييتي القبيح، قصيّاً مستحيلاً في هذه الطريق الوحشية التي أمشي فيها بصعوبة، مجرجراً حقيبة سفري فوق كثبانٍ جليدية، في ليلٍ قطبيٍّ مخيف. كل عشر خطوات يقابلني روسيٌّ تنبعث منه روائح داكنة: "دولار؟". وجوهٌ لا تبشر بخير. أتقدّم رافضاً طلبهم بالصرف في السوق السوداء؛ تذكّرتُ بحسرة سخافة أسطورة "الإنسان السوفييتي المكتمل الصفات" التي تلقّيناها في عدن.
وصلتُ الفندق. رفضتني مسؤولته ببيروقراطيةٍ سوفييتيةٍ تقليدية، قائلة إنه فندق للمجموعات السياحية الخاصة بأيروفلوت فقط. وعليّ الذهاب إلى المدينة بحثاً عن فندق آخر. أجبتُ: لا يمكنني مغادرة الفندق خطوةً واحدة. فأمرتني بالخروج حالاً. زاد رفضي بعنادٍ وقوة لأني كنت فعلاً هالكاً، غير قادرٍ على مواجهة مدينةٍ عدوانية في ليلٍ سيبيريٍّ بهيم. التفّتْ حولي مجموعةٌ سياحية من الأوروبيين، تدعم طلبي. استنكارٌ وصخبٌ جماعي. أصرَّ أحد الأوروبيين قائلاً إن في غرفته سريراً شاغراً. وبعد مكالمةٍ هاتفية مع مجهول، قالت لي: ستنام في غرفة الفرنسي، شريطة أن تدفع 50 دولاراً، وتغادر الفندق غداً في السابعة صباحاً، قبل أن يراك أحد.
غرفةٌ من ثلج لم أستطع النوم فيها إلا بالمعطف، وعند الخامسة فجراً تحديداً. يُوقظني ميكرفون في جدار الغرفة يزعق بعنف أخباراً بالروسية، بعد ساعةٍ من نومي فقط. فطورٌ رديءٌ في السادسة والنصف، بدأهُ النادل بكلمة "دولار؟".
ثم توجّهتُ قبل السابعة بالتاكسي إلى سفارة جنوب اليمن. انتظارٌ طويل وبيروقراطيةٌ قاتلة، رغم سؤالي البسيط: أين أختي، وكيف أراها؟
بعد قليل، وصل شابٌ يسكن في شارع مجاور لمنزلنا في عدَن، يدرس في لينينغراد. قال لي إنه سمع أن أختي في المستشفى، لذلك لم تصلها برقيتي البارحة. أوضح لي كيف أصل إليها، وأعطاني عنوان المستشفى. شرح لي أيضاً كيف أتوجّه إلى غرفته الجماعية في السكن الجامعي للنوم فيها: "ثمة حارس للعمارة سيمنعك إذا جئت من الباب". استغربتُ: تقاليدهم لا تشبه نمط حياتنا الطلابية الفرنسية: بدون حراس ولا منع ولا غرف جماعية. أردف: يلزمك أن تصل من خلف العمارة، وتدخل الغرفة من النافذة الخلفية. ستجد أصدقائي في انتظارك.
بعد ساعات ثلاث، كنت في المطار من جديد، في طريقي إلى لينينغراد. الظروف الجويّة أخّرت موعد السفر. باصٌ كبيرٌ خاص ينقلني مع أمريكي فقط من صالة الانتظار إلى باب الطائرة. وباصٌ ينقل حشداً مزدحماً من الروس. وباصٌ ثالث ينقل طاقماً عسكرياً سوفييتياً بطلعات مهيبة.
أمام باب الخروج في مطار لينينغراد طابورٌ لا نهاية له، ينتظر التاكسيات. المواصلات شبه مستحيلة. عدةُ ساعات انتظار في جوٍّ قاتل. تجمّدَ نخاعي الشوكي، قبل أن آخذ التاكسي باتجاه المستشفى. وصلت حوالى العاشرة مساء. موعد الزيارات قد انتهى قبل ساعات، لكني أردتُ محاولة الاتصال هاتفياً بأختي من بهو المستشفى، للاطمئنان عليها ومحاولة رؤيتها ولو دقيقتين.
تصلُ ممرضة تقول إنها سكرتيرة المنظمة القاعدية للحزب في المستشفى، وستقودني لغرفة أختي. تسرد في طريقنا، بلغة خشبية وإنجليزية تقريبية، ما يشبه خطابات صحيفة البرافدا عن دور الاتحاد السوفييتي في السلام الدولي ورفضه لحرب النجوم الريغانية (رونالد ريغان). "دعاية وتحريض أيديولوجي، وفي هذه الساعة!"، قلت لنفسي.
ما إن اقتربنا من عمارة أختي حتى لاحظتُ نساءً في أكثر من نافذة. فاجأتني السكرتيرة: راهنتْ كل واحدة منهن أنها ستُبشِّر أختك بمجيئك. أصلُ، أرى أختي تنتظرني قرب باب صالة مرضى كبيرة. عناق. بعد قليل كنا وسط لفيفٍ من نساءٍ غادرن أسِرّتهنّ قادمات صوبنا. غيّرنَ خارطة الصالة لوضعِ طاولةٍ ضخمة في وسطها. كنا، أختي وأنا، في المركز، يُحيطنا حشد يحتفل بنا في جوّ إنساني بريء وكثيف، يصعب وصفه.
ازداد الجوّ غرائبية: أخرجت كل واحدة من أسفل سريرها قنينة فودكا كانت تحتفظ بها سرّاً، وكثيراً من المأكولات التي هيأنها للمناسبة! فودكا داخل مستشفى: أمّ الجن، آخر ما يخطر ببال.
عرفتُ أنها ليلة الميلاد الأورثوذكسي. ولم يبق في المستشفى إلا هؤلاء النساء اللواتي لا قريب يشاركهن العيد، إلا أنا وأختي. ثمّ موسيقى ورقص حتّى الفجر، سعادةٌ بلا حدود، وسط مستشفى تحوّل إلى مرقصٍ محموم، في كوكبٍ من ثلج، وفي بلدٍ قمعيٍّ يفصله ستارٌ حديديٌّ عن العَالم.