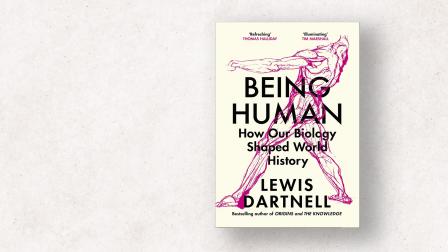تقف هذه الزاوية مع الكتّاب العرب في يومياتهم أثناء فترة الوباء، وما يودّون مشاركته مع القرّاء في زمن العزلة الإجبارية.
أتي ربيع هذا العام وقد ضرب الوباء العالم، أروح في النوم على أريكة بالصالة وأصحو على التلفاز وأرقام الموتى والمصابين تتصاعد وتقفز بصورة جنونية، أشاهد قادة العالم مجتمعين لأول مرة على مواجهة عدو واحد، لا يفرق في الأعراق ولا النوع أو الطوائف، لا يمنح المهيمنون على السلطة استثناءات... لكن سرعان ما انفضّت روح التضامن وانتصرت روح التزاحم والعداء ثانية.
تحت سطوة الحجر الصحي، صرتُ أسيرَ جدران الوحدة، وبدأت الحياة تأخذ منحى غريباً، بتُّ أرى نفسي وحيداً في كون شاسع، أستيقظ وأنام على مهاد ساكنة من مياه المحيط الشاسعة، تبدو السماء فارغة، والشمس خابية، عقلي ساكن مستسلم لسحر هذا الوجود الذي يبدو وكأنه ينتمي لعالم آخر. ينتابني شعور غريب مفعم بالراحة، لديّ رضا لم أعرفه من قبل... ولا أفهم كيف انبثق من صدري هذا الشعور الممتلئ بالفرح...
أعيش يوماً أو اثنين في هذا الصفاء، وفجأة ينقلب الوجود رأساً على عقب، يتحوّل السكون إلى أمواج هادرة ترتفع ذراها عشرات الأمتار، سماء سوداء والسحاب جحافل تجرّها عربات البرق، تنهمر الأمطار وسط هزيم الرعد، وأنا محض جسد ضئيل يتأرجح بين القاع والقمم على براكين الصخب والهلاك...
أُمضي الوقت منعزلاً تحت حصار الوباء والحياة، أستيقظ ليلاً ولدي شعور أن وجودي المادي محض هباء... هل أنا حيٌّ حقاً... هل أنا ميت... هل أعيش عالم الأشباح؟
للوباء وجه آخر، إنه يصحح المناخ ويغلق فتحة الأوزون، ويُعافي طبقات الجو العليا من مخلفات البشرية، كوميديا ساخرة لكائنات كونية تنتقم من حماقة البشرية وحماقة قادة يتجاهلون الدمار الذي سيتركونه للأجيال القادمة...
تحت ظلال الوباء تستعيد ذاكرتي أول تلك الأحداث الكبرى مع العدوان الثلاثي عام 1956، كنا نسكن أحد أحياء شُبرا الجميلة، أذكر وجه أمي الذي أعشقه، ولم أتمكن من البوح لها بذلك قبل موتها، كانت تأخذني كل أسبوع إلى مستوصف بشارع مسرة، كي آخذ مصلاً أو لقاحاً لا أذكر عن ماذا. رغم العلاقة النافرة بين الأطفال والحقن، أذكر أنني كنت متماسكاً لا أبكي، كنت سعيداً بعدم بكائي واستمرت تلك الرحلة المسيجة بعطرها ووجها الفاتن ستة أسابيع، لا تروح رائحتها من خياشيمي وأكاد أبكيها الآن، في المرة الأخيرة لم أتمالك وبكيت، لأثاب بحضنها الدافئ… آه يا أمي كم أحبك... كم أعتذر لك عن أخطائي…
في ذلك اليوم عدتُ إلى المنزل حيث كان الأزرق يلوّن نوافذ القاهرة، نشاهد طائرات العدوان الثلاثي وصوت المدافع المضادة للطائرات يسري في السماء...
على مائدة طعام الظهيرة سألت أبي إذا كان ينوي أن يحمل السلاح ليقاتل مع المقاومة الشعبية، أذكر أنه أجابني ببرود بالنفي... أصبت بالصدمة وددت لو أسأله عن السبب، فحماسة الجماهير والأناشيد الوطنية، وخطب عبد الناصر (سنقاتل... سنقاتل... سنقاتل...) كانت تملأ اللحظة، لكن الزمن لم يمنحني الوقت الكافي، فقد مات بعد عامين ورحل وأنا في التاسعة من عمري، وتمضي الحياة..
إحدى اللحظات الكبرى في حياتي حدثت في ثلاثينيات العمر حين كنت في أوج نشاطي وطاقتي الذهنية والجسدية، أعمل صباحاً ومساء في مشروع مترو أنفاق القاهرة، وأكتب في الليل رواية "نهر السماء"، وأمارس الحب بدهشة، وفجأة أصبت بمرض السلاسيميا (تكسير كرات الدم الحمراء في الدم)، اضطرني المرض لعمل نقل دم شهري ما أصابني بانهيار عصبي، في ذاك اليوم رتبت نفسي أن حياتي لن تستمر لما بعد الأربعين، ولن يتيسر لي من الحياة سوى أربع أو خمس سنوات، لكني شُفيت فجأة وبمعجزة، وعشت لأشهد "ثورة 25 يناير" (2011)، أعظم ثورة في تاريخ مصر المعاصرة، كانت حدثاً غير متوقع على الإطلاق، وأذكر في ندوة أقيمت في الحادي عشر من يناير/ كانون الثاني 2011 في المجلس الأعلى للثقافة أني قلت إبانها إنني أعيش منذ أربعة عشر عاما كابوساً لا أستطيع التفرقة فيه بين الواقع والبلاء الذي نعيشه في ظلال الجمهوريات الوراثية، وأن تاريخ مصر المعاصر الذي استهل في مطلع القرن التاسع عشر، بالتخلص من حكم المماليك (العبيد)، ها نحن في مطلع القرن الواحد والعشرين بين يدي طغمة من سدنة الجمهوريات الوراثية تقودنا كالقطعان إلى مجتمع العبودية.
لكن مصر البهية ولّادة، فبعد أسبوعين بالتحديد قام الشباب المصري بثورته العملاقة رافعاً رايات الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية... ولأن حياتي شهدت سلسلة من التطوّرات المذهلة، حل كوفيد-19 مثل حلم يصعب الاعتراف بكونه حقيقة أم مجرد قبض من الخيال...
يعودني ذاك الشعور الذي انتابني قبل "ثورة 25 يناير"... وهو أنني أحيا داخل كابوس... قبل الثورة كنّا أحياء فرض علينا أن نعيش الموت، الآن الأمر مختلف، لديّ رضا كبير عن حياتي، غير مهتم بشيء سوى استكمال ما يمكنني إنجازه من رواياتي وعددها كثير جداً، لن يسمح لي العمر بإنجازها جميعاً... حسناً وليكن... لم يعد هناك ما يهم، فالعالم يعيش على حافة الجنون، وما أظنه صائباً صار بعيد المنال، والجولان والقدس تم ضمهما، والضفة الغربية يجري ابتلاعها برعونة مقززة، كاغتصاب الأطفال الرضع، ولا يزال الساكنون في قصور الرئاسة يتأتئون حيناً وحيناً يهددون بالانسحاب من الاتفاقيات، حسناً الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله، هو الكتابة ثم الكتابة ثم الكتابة...
* روائي من مصر