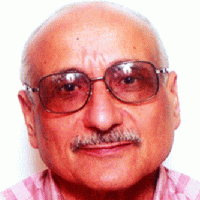06 نوفمبر 2024
14 تموز يوم سقوط "المدينة"
قادة انقلاب 14 تموز في العراق والملك فيصل
سألت الروائي الراحل، فؤاد التكرلي، ماذا يعني له يوم 14 تموز/ يوليو 1958. أجاب: إنه يوم سقوط المدينة. لم أجد اليوم وصفا أكثر صدقا ودلالة من وصف التكرلي ذلك الحدث المهول الذي صنعته "العسكريتاريا" العراقية، ووضعت العراق، من خلاله وفي ظله، على طريق انهيار قيم التحديث والعصرنة، وسيادة تقاليد الريف، وطمس دور الطبقة المتوسطة الجسر نحو التحولات الكبرى، وهي الطبقة نفسها التي دعمت الحدث، ومهّدت لصنعه عبر صفقة خادعة بين ممثليها من سياسيين ومثقفين معارضين والعسكر، وانتهى بها، بعد عقود، إلى التشرذم والانتحار، وكان أن تسلم مقاليد المجتمع والدولة طفيليون شرهون، ممثلو طوائف ومليشيات، وعشائر، ومافيات مال حرام، لتبدأ حقبة توحش واستغلال وعبودية، لم يشهدها العراق من قبل، تمثل قطعا شبه نهائي مع حضارة خمسة آلاف عام، وتعيدنا إلى عصر ما قبل الدولة، واضعة البلد كله على كف عفريت.
لا سبيل لمماحكات وطروحات زائفة، تزعم أن ما حدث كان "ثورة"، بهدف التغيير الجذري للمجتمع. صحيح أن بعض من ساهم في إنجاز "الحدث" من السياسيين والمثقفين المعارضين لحكم الملوك، وحتى بعض العسكر امتلكوا، على نحو أو آخر، توجهاً وطنياً خالصاً، وبعضهم ساهم في تحقيق "منجزات" على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، صفقنا لها وهللنا، لكنها ظلت منجزات مبتورة، لم يقدر لها الصمود في مواجهة الاتجاهات الشعبوبة للعسكرتاريا القامعة، والأحزاب الشمولية التي تناوبت على سلخ جلد المواطن وإذلاله، وعملت على ترييف المدينة، وتسطيح الوعي، وترسيخ التمايز الطائفي والمذهبي والعرقي، مكلفة البلاد خسائر متلاحقة في الأرض والبشر والموارد.
ما أعقب 14 تموز لم يكن يشبه ما قبله، كان أشبه بمنحدرات، أحدها جر إلى الآخر، وصلت إلى غايتها، في العقدين الأخيرين من القرن، مع عسكرة الدولة والمجتمع، وقيام "دولة عميقة" زجت البلاد في حروب ومنازعات، وعملت على نشر ثقافة الموت، حتى انتهى بها المطاف، بوعي أو بدونه، إلى الحدث الأكثر هولا وشراسة، هو حدث الاحتلال، والسيطرة الأميركية المباشرة، وتسليم بقايا الدولة إلى تابعين محليين، متواطئين على إحكام القبضة على موارد البلاد وثرواتها.
ثمة أسئلة كثيرة تبقى في البال: ألم يكن بالإمكان إنجاز التحولات الاجتماعية والاقتصادية، المطلوبة في حينها، بطريق التطور الديمقراطي الذي كانت نواته قائمة في عهد الملوك؟ كيف استدرجت قوى المعارضة اليسارية والقومية، تحت شعارات التسريع في إنجاز التحول، إلى الفخ الذي أسقطت نفسها فيه، لتنتهي إلى ما هي عليه اليوم؟ هل ثمة قوى خارجية شجعت على الاستقطاب، وحرّضت على التمرد بطريقة أو بأخرى؟ هل حصل ما حصل في إطار التنافس بين القوة البريطانية التي كانت شمسها على وشك أن تغيب والقوة الأميركية التي كانت، آنذاك، تتسلق السلم؟ وهل ثمة علاقة بين ما حدث وما تردد في حينه من أن العراق يعوم على بحيرة من النفط؟
ظلت تلك الأسئلة حبيسة الصدور، لم يجرؤ كاتب على طرحها أيام المد الشعبوي الذي اتسمت به حقبة ما بعد 14 تموز وامتداداتها، خشية أن يواجه اتهامات شتى من القوى التي حملت، في حينه، مشروع "الثورة"، والتي انتهى بها المطاف إلى أن تصبح فاعلة في المشروع المعاكس، بعد أن ارتضت أن تسلم أمورها وتستسلم أمام طوفان المد الأميركي الذي زحف إلى منطقتنا بشراسة. الشيوعيون انحنوا أمام الغزو، ورحبوا به راضين بشيء من الفتات، إذ دخلوا في "مجلس الحكم" الطائفي، وشاركوا في "العملية السياسية" التي هندسها الأميركيون، ودخل البعثيون في تحالفات مشبوهة، حتى مع الشياطين، من أجل العودة إلى السلطة، والديمقراطيون الذين انسحبوا من الميدان إبان الأزمات القاتلة، عادوا ليقرأوا على الناس مزاميرهم، فيما استقر بعض دعاة مشروع "الثورة" في عواصم "إمبريالية"، كانوا يناصبونها العداء، وتلقوا مساعدات ومعونات منها، وحصلوا على جنسياتها، وبعضهم شرع يكتب عن مناقب الملوك ومآثرهم، ربما ليكفر عن خطيئة إجهاض تجربة "الدولة الوطنية" التي كانت ستنمو نمواً طبيعياً، لو لم تسقط "المدينة"، وينهار رجالها، وينتحر المثقفون ورجال الفكر وأهل الرأي، ويتسيد الميدان الثقافي الأفاقون، والمتاجرون بالدين، والغارقون في ظلمات التجهيل والعتمة.
هنا، ومع وصول المشهد إلى خاتمته، يصبح الحديث عن الحرية والديمقراطية والعدل والوطن الواحد والمواطن الحر وتقاليد الحداثة والتمدن واللحاق بالعصر محض هراء، فقد غادرنا التاريخ، ولم يعد بلدنا ينتمي إلى العصر، وليس ثمة حاضر يعين على الخطو، ولا ثمة مستقبل يلوح في الأفق، بل وليس ثمة أفق.