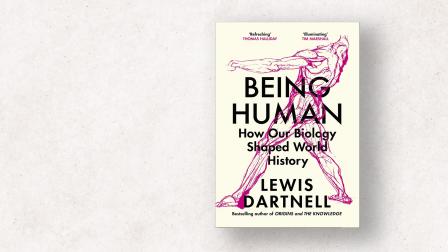فاق المعرّي معاصريه من الكتّاب في حفظ الشعر العربي حدّ أنه قال: "ما سمعت شيئاً إلا حفظته، وما حفظت شيئاً فنسيته"، ولم يفلت بالطبع العديد من الشعراء من أحكامه الجريئة والقاسية، وهو المشهود عنه تلك السخرية اللاذعة في إطلاق تشبيهاته الطريفة (والعنصرية أحياناً)، التي لم يسبقها إليه أحد، وسبّبت عداوات لا تُحصى كان لها نصيب في اختلاق عيوب لم تكن موجودة فيه.
بحلول عام 1007 ميلادية، قصد صاحب "رسالة الغفران" بغداد في زمن كان فيه البويهيون هم الحكام الفعليين لها مع ضعف الخلافة العباسية، مبتغياً حظّه من المكانة الأدبية حيث قضى عاماً ونصف عام، ابتعد عن المجالس ومخالطة الناس في أيام إقامته الأخيرة، فأفاض النقّاد في التعليق على طرده من مجلس الشريف المرتضى، بعد إبدائه التعصّب للمتنبي، إلا أنهم قصروا في تفسير مغادرته المبكرة للحاضرة الأقرب إلى قلبه.
هل حلّ المعرّي بمدينة السلام في زمن انحطاطها وتدهورها، حيث لم تعد القصيدة تمنح ما قدّمته لمعلّمه أبي الطيب، الذي حلم أن ينال شهرته ويتقمّص روحه فخابت آماله العريضة، وتملّكه الأسى والأسف فلم يُعرف عنه ذات الافتخار بنفسه بعد رحيله عنها قائلاً: "يا لهف نفسي على أني رجعْتُ إلى/ هذي البلاد ولم أهلك ببغداذا".
محطّة أساسية تركت أثرها البالغ على بقية حياته، وربما دفعته إلى شرح ديوان المتنبي في كتابه "معجز أحمد" الذي حقّقه الباحث المصري عبد المجيد ذياب في أربعة مجلّدات، مضمّناً ملاحظاته التي تعكس إعجابه بـ"الشاعر" - كما كان يطلق عليه، بينما كان يسمّي بقية الشعراء بأسمائهم - وآرائه في الشعر وأساليبه ومعانيه.
جدلٌ لا يزال مفتوحاً حول هوية صاحب المُعجز إلى اليوم
لم يتوقّف المحقّق عن البحث في أكثر من مسألة شكّكت بنسبة الكتاب إلى المعرّي منذ صدور طبعته الأولى عام 1984، مضيفاً في تقديمه لكلّ طبعة ما وصل إليه من خلاصات، إذ أثيرت شبهات مردّها عدم ذكره هذا المؤلَّف في ثبت كتبه، والخلط بيه وبين كتاب آخر يُنسب إلى أبي العلاء بعنوان "اللامع العزيزي"، ويشرح فيه ديوان أبي الطيب أيضاً، وعدم احتواء مخطوطه على مقدّمة كعادة صاحب "سقط الزند" في تصدير مؤلّفاته.
جدلٌ لا يزال مفتوحاً حول هوية صاحب المعجز إلى اليوم، لكن مقدمة الطبعة الأخيرة رجّحت أن يكون الكتاب آخر ما ألّفه أبو العلاء، وأن اعتداء الفرنجة على مكتبته ربما أدى إلى فقدان الصفحات الأولى منه التي تضمّنت تقديماً على الأغلب، وأن الادعاء أن الشرح مختصر، لا أساس له، بل هو "أوفى شروح المتنبي استقصاءً لشعره. ونجد فيه ما لا نجده في كتاب"، بحسب المقدّمة.
يضمّ الجزء الأول بابين: "العراقيات الأولى" و"الشاميات" تبرز فيهما ذائقة الشارح كأساس النقد القديم لدى العرب، وتركيزه على أمور النحو والصرف والبلاغة التي تكرّس فهمه المتطوّر للغة وعلومها، حتى إن بعض معاصريه أشاروا إلى أنه أدرى بالنحو من سيبويه وباللغة والعروض من الفراهيدي. وفي شرحه بيتاً من عراقيات المتنبي الأولى، وهو: "أرَى من فِرِنْدي قِطعَةً في فِرِنْدِهِ/ وَجودةُ ضربِ الهَامِ في جودة الصّقلِ"، يكتب المعرّي: "فكأنه يقول: كيف أترك النهوض وأقعد عن محاربة أعدائي؟ ولي جوهر في المضاء والشجاعة، وللحرب آلة موفورة، وهو السيف الذي فيه الجوهر الكريم والصقل الجيد".
تأخذ الشروح طابع الوصف والتحليل للوقوف على أسلوب المتنبي، بتفريقه عن أساليب غيره من الشعراء، مع وقوعه على ما يراه من تكرار أو إعادة أو سرقة كذلك، من خلال تفسير المعاني الغامضة، وتبيانه جمال القول والعبارة وإبراز الصواب والخطأ فيهما، في تغليب للناقد المتذوّق على طابع السجال والردود التي اعتمدها المعرّي في مؤلّفات أخرى، تكاد تكون غاية تأليفها الرد على عصره ومعاصريه والاشتباك معهم.
تعكس الشروح فهماً عميقاً لشخصية المتنبي الذي يحيل اعتداده بذاته إلى فرادة فكره ولغته في المقام الأول، فيدوّن المعرّي في تعليقه على البيت التالي من باب "الشاميات": "لَهُ هِمَمٌ لا مُنتَهى لِكِبارِها/ وَهِمَّتُهُ الصُغرى أَجَلُّ مِنَ الدَهرِ"، عبارة من ستّ كلمات يقول فيها: "إلا أنه قلب الهمم إلى الرأي".
وقد صدرت عدّة دراسات حول "معجز أحمد"، نبّهت إلى انفراد صاحب "اللزوميات" في تفسير العديد من الأبيات، ومنها قوله باجتماع التعجب والتعظيم في تشكّيه سيف الدولة في قصيدة مطلعها: "أيَدْري ما أرابَكَ مَنْ يُريبُ/ وَهل تَرْقَى إلى الفَلَكِ الخطوبُ/ وَجِسمُكَ فَوْقَ هِمّةِ كلّ داءٍ/ فَقُرْبُ أقَلّها منهُ عَجيبُ"، خلافاً لجميع الشروحات التي سبقها غيره لشعر المتنبي ورأت أنها صيغة استفهام حقيقي.
يلتفت قارئ الكتاب إلى انتقادات المعرّي في مواضع كثيرة لأبي الطيب، ومنها شرح بيت: فلا تبلغاه ما أقول فإنّه/ شجاعٌ متى يذكر له الطّعن يشتقِ"، حيث علّق عليه: "وهذا بيت "كثير" نقله من النسيب إلى الشجاعة، وهو: فلا تذكراه الحاجبية يشتق، وهذه السرقة قبيحة، لأنه أخذ المعنى واللفظ والوزن والقافية".
أدخلا للشعر تأمّلات فلسفية وعقلية كانت من اختصاص النثر
أما في بيت: "وما نجا من شفار البيض منفلتٌ/ نجا ومنهنّ في أحشائه فزع"، فيوضّح المعرّي: "ومنفلت ليس بالفصيح. والجيد المفلت، والأول أيضاً لغة"، ولا يغفل أيضاً عن التنويه بأشعار سابقة اقترب المتنبي من معناها أو مبناها، مبيّناً إذا كان تجاوزها بلاغة ولغة، أو لم يبلغ جمالها وقصّر عنه، وأحياناً لا يرجّح أحداً على أحدٍ.
قراءة تحيل إلى موضوعية صاحب "رسالة الملائكة" في نقد معلّمه الذي سار على خطاه بالابتعاد عن أساليب العرب المتوارثة، فأدخل تأمّلات فلسفية وعقلية من اختصاص النثر إلى الشعر، وفي ذلك تحدّ كبير لم تعهده الثقافة العربية من خلال تحويل الأفكار المجرّدة إلى صياغات شعرية لا ينقصها جمال التركيب ولا القدرة على انتقاء الألفاظ الملائمة، وما يجعلنا نقف على أنهما تعاملا مع الشعر بوصفه صنعة وتجربة وليس موهبة وإيحاءً وفطرة كانا الأبرع فيها أيضاً.
وفي الوقت نفسه، يبدو ذلك دليلاً إضافياً على أن الكتاب وضعه المعرّي في آخر حياته، بفارق زمني ونفسي طويل عن مواقفه التي تعصّب بها للمتنبي، ولخصها بمقولته: "ليس في شعره لفظة يمكن أن يقوم عنها ما هو في معناها فيجيء حسناً مثلها"، وأخرجته من بغداد إلى عزلته المديدة، التي آلت إلى مراجعات معمّقة بناها على تبصّر وتفكّر بدل من انحيازٍ أعمى قاد مساجلاته وجدالاته دفاعاً عن معلّمه، التي احتشدت كتب المؤرخين بشواهد عليها لا تعدّ ولا تحصى.
لكن الصلة بين الشاعريْن لا يمكن تبسيطها واختزالها بخلاصة محدّدة، إذ يُنسب إلى أبي العلاء أنه قال بعد أن أنهى مؤلّفه هذا: "رحم الله المتنبي، كأنما نظر إليّ بلحظ الغيب، حيث يقول: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي/ وأسمعت كلماتي من به صمم"، ما يشير إلى أن مكانته لم تتغيّر إلا أنه حين درسه تمكّن من رؤية عيوب ونواقص لم يرد أن يراها من قبل.
لأسباب نفسية وشخصية وأخرى تتعلّق بالظروف التي عاشها كلّ منهما، فإن المتنبي اختار ذاته منطلقاً لمحاكمة كلّ ما يدور من حوله والإمساك بالمعنى، بينما سيرتدّ المعرّي إلى تأمّل الوجود للنفاذ إلى ذاته التي تخفّت بلبوس الحكمة والفلسفة، ليظل الالتباس قائماً إلى اليوم إن كان الإعجاز منسوباً إلى أحمد بن الحسين المتنبي حين عنون كتابه بـ"معجز أحمد"، أو قصد به نفسه؛ أحمد بن عبد الله المعرّي.