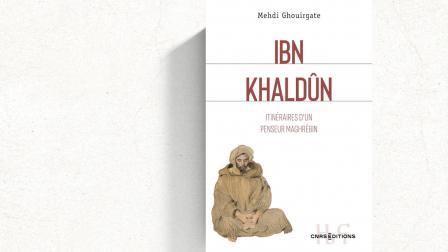ننشر على حلقات رواية "أَطفال الندى"، أبرز أعمال الشاعر والروائي والناقد الراحل محمد الأسعد الذي غادر عالمنا في أيلول الماضي، وكان من طليعة كتّاب القسم الثقافي في "العربي الجديد" وأحد أبرز كُتّاب فلسطين والعالم العربي.
ذلك الصباح... الصباح نفسه... بعتمتهِ ونداه حين لم أكن مولوداً بعد، ولا كان بيتنا في خضرة الوادي قد برز بعد... في ذلك الصباح كان لجدّي أربعة أبناء، أصغرهم في العاشرة من عمره، وهو من سيكون أبي بعد ذلك، ولكن بعد أن جرّده ذلك الصباحُ هو وإخوته من كلّ معنى، فحين برزت الشمسُ وألقتْ الصيافير العالية ظلالها باتجاه الغرب، وظلّلَ الكرملُ جزءاً من حيفا الراقدة بين أقدامهِ.
كان جدّي ما يزال متّكِئاً على مسنده في غرفة الضيوف، مُسبلَ العينين، وقد مالَ رأسُه جانباً، وأمامه قدح قهوته الصباحية وعلبة تبغه النحاسية... وكان حصانه مسرجاً ينتظر يبلّلُ ناصيته الندى.
وحين استبطأته جدّتي دخلتْ لتُفاجَأ به ميتاً من النظرة الأولى... وميتاً هذه تعني الأبد الذي سيكون شاسعاً بحيث لا تستطيع احتواءه صرخةُ الجدّة الحادة. ولأنها لم تكن متأكّدة من هذا الفراغ الهائل الذي هبط فجأة فقد هزّته... وهزّته لعلّه يستيقظ.
لم يحدّثني أبي عن أمّهِ بل عن يتمهِ... ابن الاثني عشر ربيعاً الذي فقدَ دفعة واحدة شيئاً لم يستطع استعادته حتى آخر عمره... وسيُروى عنه أنّ أوّل شيءٍ فقده كان الأرض... الأرض الواسعة التي ضمّها عمّه إلى أملاكهِ وأعطى الأولاد ثمنها... فبذّروه.
ويخيّل إليّ أنه فقد شيئاً أكثر أهميةً لا يمكن التكهّن به... شيءٌ ضاع في ذلك الاتّساع الهائل الذي انفتح فجأة... فكان صباحٌ... وكان مساءٌ... وظهرَ الوجودُ خالياً من الأب والبيت. ولم أكن موجوداً بعد، ولا كان وجودي ضرورياً إلى جانب هذا الصمت الذي تميّز به والدي وهذه اليوميات الباهتة التي تنقّلتْ بين قرى الكرمل طوال أكثر من ثلاثين عاماً.
الأمّ التي لا تترك فرصة إلا وتمتدح أخوالنا الأشدّ حناناً من الأعمام
وأراه يحلم الآن.. ذلك الذي لا أستطيع تخيّله طفلاً يحلم كثيراً، وأفرض عليه طبيعة الحلم الذي يسترجع فيه تلك النزوات التي كانت تقوده إلى حيفا منحدراً، وهو يحاول جاهداً نسيانها، كأنها من أحداث ما قبل التاريخِ من عصرٍ حجريّ لم يكن فيه الناسُ قادرين على تبادل الحديث أو احتساب دورات الفلك.
عائلة من الصمت تتشابه في حديثها عن الصيافير والزيتون والسرّيس وكأنها هذه الأشياء نفسها... أشياء تمثل في الذهنِ... في أقصاه. تعرف أنّي ولدتُ في زمن الحصاد. وكان الوقتُ صيفاً، وتعرف أن الإنكليز لم يتركوا في البيتِ لا زيتاً ولا قمحاً إلا وخلطوه بالشِّيد وطاردوا الدجاج ومعسوا رؤوسه بالشيد، وتعرف أن الثوار كانوا يخطؤون، وأن الخيانة كانتْ منتشرة مثل الرائحة.
ومع ذلك فيجب أن تتواصل الرواية كما يتواصل الحلمُ، ونشقّ طريقاً إلى الدالية أو عين حوض فجنين. وتنتظرنا شاحناتُ الجيش العراقي. وهذا النُّواح الطويل حول قبرٍ شقّته النسوة وتراقصن حوله كالأشباحِ في معسكر بعيد في أقصى جنوب العراق.
يجب أن تتجمّع كلّ هذه الحسرات المجهولة، فلا بدّ أن يكون لكلِّ هذا معنى... لهذا الدفتر الصغير الذي يحتشد بالكلمات الإنكليزية، ولهذا الجندي التركي الذي أراه بين الناس يراهم ولا يراهم، لهذا الشيخ الذي اختفى ذكرُه، وهذه الأرملة التي جمعتْ حولها أولادها الأربعة، لهذه المِس دوروثي غرود التي بدأت تعاني آلام المخاض في برايتون، لهذه المغارات الغامضة التي ينحدر إليها ماء المطر ويبلّلُ ترابها الأحمر وما يزال في غيابنا... وحتى الأبد.
لا بدّ أن يكون لكل هذه الألغاز معنى. ألغازٌ ألقاها أبو الهول بالأمسِ، ويلقيها اليوم، وسيلقيها غداً... ونحن نحمله في عروقنا جائلين في غابة العمالقة أو مختبئين نتجنّب الطرقات العامة.
لم يحدّثني أبي عن أمّه، بل عن يتمهِ حتى من رواية واسعة عريضة تصطخب كما أتخيّل رواية الماضي، لقد لعب دورَ المعلّق والمصحّح أحياناً على النص الأصلي، وإن كان قد ضحك حين ذكّرته أمّي بهربهِ حين كانا عائدين على مقربة من البيت في الليلة التي استيقظ فيها الحَمام، وفاجأتهما أصواتٌ عبرية تتحدّث.
تقول أمّي: "ارتمينا وراء السنسلة حتى مرّوا وما إن وقفتُ وتلفّتُّ حولي لم أجدِ الحاج إلى جانبي". كأن ما حدث ليس إلا لعبة من ألعاب الأطفال... ولم يعد الأمر يعنيه.
يقول تاريخنا العائليّ إنّ إطعام خمس بنات وولدين احتاج من أبينا أن يتحوّل إلى بائع متجوّل، يبيع البيض والزيتَ والنفط متنقّلاً على حماره بين القرى والقبّانيات. كان يتاجر مع اليهود، منعزلاً في ذلك البيتِ النائم في خُضرة الوادي، حتى إذا احتجتَ إلى أن تأتيه من البلد أتيته مُنحدِراً. وفي المناسبات القليلة كان الأمرُ يحتاج إلى رحلةٍ لمعرفة أخبار العالم... رحلة إلى العالم الفوقي... عالم أمّ الزينات. وكأننا من سكان العالم السفلي.
وقد تأكّدتُ من شبحيةِ هذا الوجود حين كنتُ أتصفّح مُجلّداً ضخماً عن الفلسطينيين قبل تهجيرهم وبعده. فما وجدتُ ذِكراً لأبي وأمّي ولا لأيّ من الذين تعيهم ذاكرة أمّي، ولم أفهم لماذا هذه العزلة في قلب الوحشة حتى اكتشفتُ تلك الصراعات العائلية التي جرّدتْ أبي من الأرض والمعنى. وأبقتْ له هذه القطعة الصغيرة، أو الجزيرة الصغيرة بعد أن فقد العالمُ الفوقي كلّ معنى. كان المجلّدُ الضخم يذكرنا ضمناً حين يقول: "الفلاحون الفلسطينيون". أما في الصور التذكارية التي أخرجها صاحبه من محفوظاته فما كان هناك أبي ولا خالي ولا أخي.. ولا الحاج القطروز ولا الأرملة، ولا الشيخ حمزة. وهذا هو الأهم.
هكذا تعلّمنا أن نتهامس بأخبار العالم، ونتّصل به عن طريق الأمّ التي لا تترك فرصة إلا وتمتدح أخوالنا الأشدّ حناناً من الأعمام، فتتحدّث عن أخيها طالب الذي تسميه دائماً أبو علي بلهجة تشي بأن أبا علي هذه تعني الرجل الحقّ أو المثَل الذي يعصم الذاكرة من التهاوي. ولكنها لم تكن تعني علاقته بالسلاح، هو الذي لا يحضر في الذاكرة إلا مسلّحاً وغائباً عن البيت، يأتي الإنكليز، فلا يجدونه ويسألون عنه، فلا يحظَون بجواب، بل كانت تعني علاقته بها، وحنّوه الدائب عليها وعلى أولادها... إنها أخت أبو علي... وكثيراً ما كانت تُمتدَح لهذا السبب.
وأقول لهذا الخال وأنا أحاوره كما لو كان تلميذاً صغيراً:
"لم تكونوا تعرفون شيئاً عمّا يحدث. أما الآن فالأمورُ أوضح. ما الذي حدث عندكم في العام 1967؟"
ويتحدّث، هو الذي فوجئتُ بحجمه الناحل بعد أن ظلّ لسنوات طويلة يقيم في ذاكرتي طويلاً فارعاً، وأتابعه وهو يجلس في مخيّم عين شمس، والآلياتُ الإسرائيلية تمرّ من أمامه. ليس لديه ما يهرب إليه أو منه. وحين استدعاه الحاكم العسكري، تهامس الناس: "وأخيراً كشف عن نفسه. إنه جاسوسهم".
وتحت أسواره العالية كانوا يتجمّعون حين ينصب الإنكليز المشانق لمن وجدوا بضع رصاصات في جيبه
"واتّخذتُ طريقي إلى المكتب، ودخلتُ... قال الضابط الكبير: "نحن نعرفك جيّداً... ولكن دعنا من الماضي. لديك أرضٌ في أمّ الزينات ونريد أن ندفع لك ثمنها"، قلتُ له: "لا... لن أبيع... أنتم تحتلون الأرض... حسناً... ولكنني لا أبيع" كان عددٌ من الضباط يحيط به وهم يلحّون ويزيدون في إلحاحهم: "ماذا تستفيد من الأرض؟ أليس من الأفضل أن تأخذ الثمن؟" لا... قلتُ لا. وخرجت".
كان واهناً وهو يتحدّث بأناة. وأتخيّل مشهده في حضرة الضباط الذين يريدون شراء أرض احتلوها منذ ثلاثين سنة، ومنه هو الذي لا سلطة له على الأرض، ولا على الفصول... هذا الإله المتقاعد الذي لا يرغب في شيءٍ الآن قدرَ رغبته في أن يجلس بهدوء على جانب الطريق يراقب الآليات الاسرائيلية وهي تمرّ صاعدة فيتموّج الناسُ أمامها ويفرّون إلى أشجار الزيتون، وتدور وتدور لتعودَ من نفس الطريق مخلّفةً الغبار... والغبار وحده.
ويبدأ أخي دفتره الصغير بكلماتهِ الإنكليزية في وقت لم أكن مولوداً فيه بعد:
"اليوم أخذوا أبي إلى حيفا بسبب بندقية عمي، قلبوا بيتنا قلباً، لم يتركوا خابية إلّا ونبشوا فيها. أما جِرار الزيت فقد قلبوها، والطحين بعثروه. تقول أمّي إنهم شاهدوا عمكَ يلقي بها بين السرّيس ولكنهم لم يتأكّدوا من ملامحه، فأخذوهما معاً. لم يكن في البيت غير الصغار برعاية أختك... وحين عدتُ من البلد هلعةً بعد انتهاء الطوق، وجدتُ الصغار مختبئين في المغارة... المغارة التي حفرناها لتكون ملجأ لنا".
ما زال أبي يتحدّث بالصمت عن يُتمه وعزلته، فلم يحدث أن عيّره أحد كما عيّرته أمّي بمتاجرته مع اليهود، بنزواته في حيفا، ومع ذلك فإن مشهده وراء القضبان يبعث الرأفة والحنان في صوتها. فبعد أن حطّم "صوصة" ضلعين في صدره بعقب البندقية، أخذوهما إلى سجن عكّا، وإلى هذا السجن كان يذهب القرويون لمشاهدة آبائهم وأبنائهم، وتحت أسواره العالية كانوا يتجمعون حين ينصب الإنكليز المشانق لمن وجدوا بضع رصاصات في جيبه.
يالله كم من أسماءٍ ووجوه مرّت قبل أن أكون موجوداً! واختفتْ وذابتْ كما لو أنها لم توجد قطّ في خضرة ذلك الوادي الذي تكاثف شجره الآن حتى ما عاد الإنسانُ يستطيع النفاذ خلاله.
إن أبناء هذا الإله المتقاعِد ينتشرون، حتى ليصعبَ على ذاكرة أمّي أن تعدّهم وتعدّ أحفاده. وحين يجلس بهدوء وهو يرقب الآليات الاسرائيلية قادمة، وحيداً في مخيم خلا من سكانه... أتخيّله كثيفاً كهذا الشجر من الصعب اختراقه.