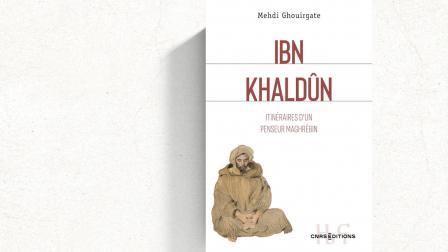ننشر على حلقات رواية "أَطفال الندى"، أبرز أعمال الشاعر والروائي والناقد الراحل محمد الأسعد الذي غادر عالمنا في أيلول الماضي، وكان من طليعة كتّاب القسم الثقافي في "العربي الجديد"، وأحد أبرز كُتّاب فلسطين والعالم العربي.
"بعدنا تنحدر الأرضُ، فنحن آخر المرتفعات وآخر الصيافير، وربما آخر النهارات"... هكذا يصف صديق من عانين، ويحدّد موقع قريته التي مرّ بها أهالي أمّ الزينات فأقاموا عند منابع المياه، وفي الكهوف والبساتين، ولكنّه لا يصفُني بالتأكيد، ولا يصف الأسماءَ التي أحملها، ففي تلك النهارات التي رحلتْ وراء الكرمل غرباً، وخلّفتِ الليلَ، والنيران المنتشرة، كنّا قد بدأنا الدخول في الحالة الحجَرية، مغلّفين بهذا الغموضِ الأملسِ الذي لا يأتيه الإنسانُ من أيّ جهةٍ إلّا واصطدمَ بما يشبه اللُّغز. نحن ألغازٌ إذن.
ويتذكّر الصديقُ هؤلاء الذين جاؤوا بضجيجهم وصراخ أطفاهم، واقتحموا طفولته الملساءَ، وغادروا دون أن يتسرّبوا في شقوق البيتِ أو حوله. لم يكونوا قادمين من الندى بل من غَبشٍ مُعتمٍ، ومن ارتجاجٍ مفاجئ.
ويروي أنّ هؤلاء الغامضين داروا في أحاديث مَضَافة والده، كما يدور الدخانُ الذي ينفثه الجالسون، وتبدّدوا مثله، فقد رحلوا وتوزّعوا بعد ليلةٍ عاصفة اقتلعت الخيامَ والشجر. ما الذي يبقى إذن؟ لقد رحلوا حاملين أبا هولهم معهم... أعني زمنهم الحجريّ الذي لم يتوقّف عن إلقاءِ الأسئلة حتى على الذين ماتوا دون أن يعرفوا الأجوبة. حتى على الذين أُصيبوا بالذهول وغادروا عالمهم منذ زمنٍ طويل ولم يعودوا بعد. حتى على الذين غابوا ولم يعرف أحدٌ تحتَ أيّ الصيافير تبعثرت عظامهم، أو في أيّ بلد غامض توزّعوا.
إنه في العمق أبو الهولِ هذا، يتّخذ أشكالاً لا سبيل إلى التكهّن بها، فهو يوماً جنديٌّ يهرع بعربةٍ معبّأة بالخبز إلى صفوفنا المنتظرة، وهو يوماً طبيبٌ ضَجِر، يُمسك بأيدينا الغضّة، ويغرس فيها شيئاً يشبه شوكةَ الطعام، على الكتف، أو على الذراع، وهو رجلٌ يُلاطفنا ويمرُّ مخلّفاً التفاتاته، وهو يوماً هذه الوجوه الصغيرة المتفرّسة التي أحاطتْ بي وأنا أخرج من غرفة مدير المدرسة، وهو هؤلاء الرجال الذين تجمّعوا حولي في دكّان بقّالٍ، يودّ كلٌّ منهم أن يفهم ماذا أريد ولا يفهم.
كلُّ شيءٍ يدور، والبطُّ العائمُ في نهر دجلة يبدو وكأنه نهايةُ المطاف، فهناك يستيقظ شيءٌ في الروح على رؤية الماءِ والبطّ وأمٍّ وأبٍ يسيران ببطءٍ مع طفل صغير، وأراقب المشهد لا أعرف أين حدث كلّ هذا؟ ومتى؟ ولماذا كان الماءُ صافياً... والبطّ هادئاً... وما عدتُ أرى هذا المشهد أبداً؟
دارُوا في أحاديث المَضَافة كما الدخانُ الذي ينفثه الجالسون
لم أتحجّرْ إذن، ولا سمعتُ صراخ الضبع في ذلك الدُّغلِ الذي تحدّث عنه والدي، فقد عبرتُ خفيفاً، هكذا مثلَ غيمة، لم يجاورني جسدي، ولا عنفُ الشوك أو صلابة الصخور، ولا بردُ الشتاءِ، ولا حرارة الصيف. ولا انطبعتْ بروحي حشرجاتُ الأهلِ الغامضين الذين أستعيدهم، إنني الندى نفسه. الندى في التماعه الآن، وتكاثُفهِ مع أواخر الفجرِ، وعلى الأكماتِ والصخور والأودية وأبوابِ المغارات، وتلوّيهِ في عتمةِ الخُضرةِ، وتساقطهِ بدَداً على الترابِ مغادراً أمَّه السرّيسة أو البطمة أو الزيتونة أو الهواء. إنني الندى، ولا أهلَ لي.
هكذا أستطيع أن أفقد الحنينَ لشيءٍ محدّدٍ، وأراقبُ النشيجَ الذي تبعثه حلقةُ النسوة الدائراتِ حول القبر وظلالهنّ السوداء تتقاطع، وأحتفظ بالمشهدِ، لأُضفيَ عليه فيما بعد تأويلاتي كما أشاء. هكذا أستطيع أن أسخرَ من الحاج القطروز وهو يتحدّث بوقارٍ عن أيامهِ، وأيامِ تجنيدهِ في الجيش التركي، وأتخيّله بلحيته وانحناءة ظهرهِ وأنفه المحدّب وقد أثقلته الحقيبة على ظهرهِ، والبندقية العثمانية الطويلة.
هكذا وبهذه الحرية البالغة أستطيع أن أصفَ الشيخ حمزة بالأبله، أما خليل فهو نصف أمّي، وأراقبَ خالي وهو يتحوّل إلى شبحٍ غير واقعي هو وبندقيته وصديقه الإنكليزي كشيءٍ لم يكن، ولم يحدث.
ولكنّني أتوقّف أمام أمّي وحسرتها الدائمة، هي التي تعرِّفُني على الطُّرق التي جئتُ منها، والمنافذ التي تسرّبتُ خلالها وأنا في حالة الندى، وأنتظرُ أن تقول شيئاً لأجادلَها، وأفسّرُ ما غمضَ من كلامها. وأجيبُ على أسئلتها، تلك التي أنتظرُ أن تطلقَني مرّة أُخرى إلى الوعر والسهوبِ، والمغاور، والليالي التي لا تبيدُ ولا تشرقُ الشمسُ بعدها، وإن أشرقتْ فلكي أعودَ إلى حالتي الحجرية... إلى السكون الأملس الذي لا يخدشه شيء، ولا ينطبع عليه شيء.
أمّي هي التي وضعتني في حالةِ الندى، وسواء كانت تعرف أم لا فإنّ ذبذباتِ صوتها، والأسماء الغريبة التي تكرّرها، وكأنها تحدّث نفسها، تضعني خارج الأشياء. وحين كانت تتجاهلُ أسئلتي كانت تمنعُني من دخول الغرفة المحرّمة، تلك التي ترتيبها السابع والسبعون في وقت تأخذني فيه إلى كلّ الغرف، وكأنما توصيني دائماً بأن أتوقّف، ولا أغامر بدخول الغرفة الأخيرة.
ولكن الحسن البصري في الرواية يقتحم أخيراً هذه الغرفة، ولا تحميه بعد ذلك عناية أخواته من حالة البُكاء الدائم. لقد كفّ عن حالة الندى، وسلبتهُ الطيورُ - النساءُ أو النساءُ - الطيورُ طمأنينة العيش، وقطعتْ عليه طريقَ العودة إلى الغابة الحجرية.
هنالك شيءٌ يستيقظ في الروحِ، وتهبُّ الصبيةُ من أعماقِ البحيرة باحثةً عن ثوب الريش الذي أحتفظُ بهِ... ولا أستطيع. إنّ العريَ الكامل لهذا الوجودِ ثقيلٌ على من كانت طفولته الندى، ثقيلٌ إلى درجة أنه لا يستطيع التحديق فيه إلى اللحظة التي يتلاشى فيها.
وهكذا أتخلّى عن الثوبِ والروايةِ كلّها، وأُغلق بابَ الغرفة المحرّمة كأن شيئاً لم يحدث. هكذا لم يُمسكني أحدٌ متلبّساً بحالةِ الطفولة أو حالة الندى، أو الحالة التي ينطبع فيها كلُّ شيء في أعماق الروح ولا يزول.
سلبتهُ الطيورُ - النساءُ طمأنينة العيش وقطعتْ عليه طريقَ العودة
سيمثّل الآخرون الأدوارَ التي أحببتُ وسيصفون مشهدي والمشاهدَ التالية، فأنا الذي اقتحمَ الوعرَ بخيولهِ، وانتشر متخلّصاً من تطويق الإنكليز، وأنا الذي أصابتني البلاهةُ فجأة في الطريق إلى الدالية، صامتاً، بدائياً لا أعرف ما هذا النواح والضجيج الذي امتدّ وامتدّ، وأنا الذي لا يعرفون أين ذهبَ بعد تلك الليلة، وفي أيّ الطرقات صادفهُ الضبعُ أو الرصاصة أو السكون.
لا أتخيّل نفسي راكضاً، أو هَلِعاً، بل خفيفاً كما الندى، ولستُ بالطبعِ ذلك الصغير بين الصغار الذي تركَته أمُّه، وتركه أبوه وهما يعودان إلى البيتِ في الليلة التي رفَّ فيها الحمامُ وأحدثَ انقلاباً في دورةِ الفصول، ولا ذلك الذي كان بين المئات الذين انتشروا حول عانين فكانوا حديث الموسم لأهلها، وتبدّدوا مثل غيومٍ ترحل إلى الشرقِ، وتتوزّع بعيداً عن ذاكرةِ أطفالها.
سيتوقّف الزمنُ ويؤجّلُ كلّ شيء من دورةِ الفصولِ إلى الصباحات والليالي، إلى رغبات الصغار الذين كانوا يشبهون الندى في عيون أهاليهم، ويؤجّلُ كلُّ شيء، بعد أن هبط الفلاحون آخر المرتفعات واستقبلتهم البساتين والعيون والطُّرقُ وحالةٌ لا هي بالزمان ولا هي بالمكان.
لا أتخيّل نفسي غائباً أو حاضراً بل موجوداً، ولكنّ التفاصيلَ هي التي تُصابُ بالضبابِ، فيختلطُ الناسُ بالمكانِ، ويختلط الزمانُ برائحة الماء، ونهداتِ العشبِ الأخضر، وتراب الكهوف الأحمر، وطعم الخرّوبِ. ويكونُ لهذه المملكة العجيبة الغارقة أن تظهر، وإلّا فإنّ الحزنَ سيظلّ رفيقنَا الدائم، فحين غادر ذلك الصيادُ أعماقَ البحرِ، ورجع إلى اليابسة، اكتشف أن مئات السنين قد مرّتْ منذ أن سقط في البحرِ وتسلّمته الحورياتُ، فأيّ حياةٍ يمكن أن يبدأها الآن؟
إن ما يملكه هو أن يعود ولكن إلى أين والبحرُ أغلقَ أبوابه؟ إنّنا نعود في القصص بعد سنة أو سنتين أو أكثر، ولكن الوقوع في أسر الحوريات يحوّل نصّ الرواية حيث لا زمان ولا مكان.
يقتحم الغرفة ولا تحميه عناية أخواته من حالة البُكاء الدائم
كلُّ شيء يبدو خارج العالم... خارج السفوح والصيافير، وحتى الضباع والمطر الثقيل الذي لا يكاد يتوقّف، كأنّنا تحوّلنا فعلاً إلى أشجارٍ حجرية لا تنمو، وتحقّقتْ حياةُ الجنديّ التركي المُنذرة في حياة كلٍّ منّا... ولا يربطنا إلى السرير، ويمنعنا من الاندفاع ليلاً، إلّا هذا الحديث الذي يرمّم ثغرات وجودنا، ويجعلنا نصدّق أنّنا لم نُصَبْ بالجنون...
أعني لم نتلقِ ما يكفي من العالم ليجعلنا أشجاراً أو أحجاراً... حديث يدور ويتواصل مع كلِّ قادمٍ جديدٍ، يضيف قطعةً إلى نسيج الحياة الذي تهلهلَ حتى ليصعبَ أن نصنع منه فراشاً أو كفناً، فكِلا الأمرين: الموتُ والحياةُ يحتاجان إلى شيء حقيقي يتمسّك به الإنسان، وما كان هناك شيءٌ حقيقي بعد وادي عارة غير ذكرى البكاء... ومشاهد الجبل الذي يتوقّف عن التغلغل، ويتركنا وحيدين باتجاه الشرق... الشرق الغامض. إنه لا يمضي معنا بالطبع، ولم يمض منذ آلاف السنوات... ومع ذلك فلا شيء أشدّ حنوّاً من صيافيرهِ وأوديتهِ وصمته اللّيلي... لا أشدّ حنوّاً من الحقيقي مقابل الوهمي الذي سقطنا فيه.
إنّ الصيّادَ لا يجد بابَ البحرِ مغلقاً فقط، بل إنه ليهرمُ فجأة. وبمجرّد أن يخرج من الماء ويستيقظ سيختلط الأمر: الحقيقي الذي تفصلُه عنه مئات السنوات... والوهمي الذي تفصلُه عنه إغفاءة، وهذه اللحظة التي لا هي بالحقيقة ولا بالوهم.
لم يعد خالي إلى الدالية إذاً، ولا غادرناها إلى عانين وجنين... بل سقطنا في هذه اللحظة، ولذا لم تستغرب أمّي من رؤيتها، صديقنا الجنديّ التركي بين جموع الناس المنتشرة بين الكهوف والخيام، ولا لفتَ نظرها أن الشيخ حمزة لم يكن له وجود، ولا أنّ الوالد يحثّها ليسجّل اسمه مع الراحلين إلى العراق.
كلّ شيء لا يبدو حقيقياً، سوى هؤلاء الأطفال الذين يلهون أحياناً، ويصمتون في أحيان كثيرة... ولا يسألون. أطفالٌ تودُّ أن تطعمهم وتقودهم خارج هذا الوهم الذي يلفُّ بضبابهِ الناسَ والبساتين والطرق، فبعدنا تنحدرُ الأرضُ، وينحني الزمنُ، في يوم مقداره ألفٌ مما يعدّون.