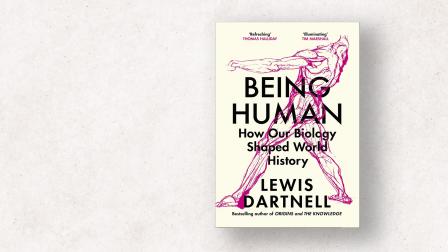تُغنّي الفنّانة الفلسطينية ريم الكيلاني فتجمع الصوت والموقف الصَّلب معاً، حيث الغناء روحٌ مقاومة، وحيث فلسطين حاضرة دوماً بتفاصيل تاريخها وتراثها المنبَثِّ في فَهْم حداثيّ معاصر للفنون ووظيفتها... تُغنّي فلا يجدُ المستمع نفسه إلّا وقد عاد معها إلى مدن وحواضر بلدٍ سرقه الصهاينة إلى حين، وأجرموا بحقّ أهله تهجيراً وتقتيلاً، أيضاً إلى حين... تُغنّي فتذكّر بجُرح نكبةٍ مستمرّة منذ عام 1948، وكفاحٍ موازٍ لم ينقطع سواء بقوّة الحقّ وسلاحه، أو الانتفاضات والهبّات الشعبية، وصولاً إلى معركة الأمعاء الخاوية، ومثلها الأقلام والحناجر.
هذا هو حالُ المغنّية الفلسطينية (من مواليد مانشستر عام 1963)، فهي تقول كلّ شيء دفعة واحدة؛ حكايات الحبّ والنزوح والشتات والأجيال التي يأخذ ويُتابع بعضُها عن بعض وعي وتجسيد القضية. وهذا ما كانت عليه، بالفعل، صاحبة ألبوم "الغزلان النافرة" (2006) في الأمسية التي سُجِّلت أغنياتُها في بريطانيا لصالح معرض "بلدٌ وحدُّه البحر"، وبُثّت عبر حسابات "المتحف الفلسطيني" في بيرزيت على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء الماضي.
من سيّدات المخيّمات إلى سلمى الجيوسي وشيرين أبو عاقلة
ولمّا كان المعرض الذي استمرّ قرابة عامين (من 29 أيلول/ سبتمبر 2021 حتى 30 أيار/ مايو الماضي)، يتّخذ من البحر موضوعة كبرى تجسّدت في لوحات الفنَّانِين الفلسطينيِّين، فإنّ الكيلاني بالمقابل سعَت في حفلها (شاركها كلٌ من: الأميركي برونو هاينين: بيانو، والبريطاني رايان تيربلكوك: كونترباص، والإيطالي ريكاردو شيابيرتا: إيقاع) إلى تحقيق تصادٍ ملحوظ بين الكلمة واللّحن من جهة والتشكيل من جهة ثانية. واللّافت أنّ ما قدّمته من أغنياتٍ تكشف عن حيوية المجتمع الفلسطيني خلال فترة الاستعمار البريطاني لفلسطين، تلك الفترة التي مهدّت، بطبيعة الحال، إلى نشوء أبشع الكيانات الاستيطانية عبر التاريخ.
نستمع إلى الكيلاني فلا نرى مجداً غابراً يتردّد على وقع حزين، بل مدينة تعجّ بالأشغال؛ قوارب وسواعد وأرزاق، رجالاً وفتية وشباباً، وقبل كلّ ما سبق صبايا ونساء هنّ من صلب المشهد اليومي للحياة الفلسطينية، حيث كنّ - وما زلن - أولى من تستهدفهنّ آلة القتل الصهيونية. تتبّعت صاحبة "قال المغنّي: طائر السحر" (2022) أصواتهنَّ وذكرياتهنَّ في مخيمات الشتات من الأردن إلى لبنان، ووضعتهنّ في صميم مشروعها. وفي هذا السياق، يجب التنبّه إلى أن هذا المشروع ليس ذا بُعدٍ إحيائي واحد، بمعنى أنه لا يفتّش في ماضٍ قد مضى فقط، إنما هو قراءة حيّة لتاريخ مستمرّ؛ ذهابٌ وعودة في اللحظة ذاتها بين أوائل القرن العشرين والراهن الذي نعيش.
هذا وقد حضر العرس وأهازيجه بقوّة في أغاني الحفل، إنها مقدّمات في استقصاء الفرح؛ وعيون ترصد المحبوب، وأيادٍ مرتجفة تطمح إلى ضمّه، وعائلة يستنفر أفرادُها في تجهيز ولدهم لحياتِه الجديدة. كذلك تفعل أسرة العروس، التي تأخذ في الاستعداد لمغادرة إحدى بناتها الدار. هنا يبدو الخطُّ شفيفاً بين الحزن والفرح، إلّا أنّ أكثر ما يعنينا هنا هي تلك الرمزية المُشتغِلة في الخلفية، إذ سرعان ما يستحيل العُرس من طاقة موجَّهة صوب الحياة، وخالقة لها، إلى عنفوان وإرادة ضدّ الموت والإخضاع الاستعماري المُمنهَج، إلى ولادة تنبض بأجيال مقاومة، وهنا أيضاً للمرأة مركزيتها.
شملت كاريزما الكيلاني المحبَّبة الفرقة والجمهور معاً
المُهاهاة والتهاليل والزغاريد وغيرها... كلُّ ما سبق تصويتاتٌ مندمجة بروح الموسيقى التي تقدّمها الكيلاني، لكنّ مساحات الارتجال التي شفع بها العازفون الثلاثة هذه التصويتات، ومن ثمّ قدرتهم على تصديرها بنسق لا يتجافى فيه المُعاصر والعالمي مع المحلّي، هو ما أكسب الحفل طابعاً من الرهبة والانفتاح. فصحيحٌ أنّ من يتابع صاحبة "هذه الأرض هي أرضك" (2022)، على عِلمٍ تامٍّ بتلك الكاريزما المُحبَّبة التي تصحبُها، إلّا أنّ شيئاً من ذلك قد انبثّ بطريقة هارمونية مع العازفين. فليس بالنوتات والأنغام وحدهما يُشارك المغنّي فرقته أو يُقدّمها، بل بالحضور أوّلاً، والذي يمسُّهم وينسربُ من بعد ذلك إلى عموم الجمهور سواء الحاضر منه أو الافتراضي.
أما كلمات الأغاني غير التراثية، فهي مأخوذة من كتابات شخصيات تُمكن تسميتُهم بأنهم روّاد الحداثة الفلسطينية على ما بينهم من اختلافات: من الشاعر الشعبي نوح إبراهيم (1913 - 1938)، صاحب "تحيا رجال البحرية"، ومحمود سليم الحوت (1916 - 1989)، الذي كتب قصيدة "يافا"، إلى ازدهار الفرخ أفيوني ونصها السردي المؤثّر، وفايزة اليحيا السفاريني ("نداء الزنابق: سيرة فلسطينية"). ووراء كلّ اسم من هذه الأسماء حكاية إنسانية، بل إنّ تتبُّع قصة كلِّ واحد منهم يضع أمام المستمع مشهدية تتتالى فيها طرائق الاستعمار البريطاني بسَلْبِ المُمتلكات الفلسطينية، ثم تابعتها من بعده عصابات المُستوطنين البِيض. نعم، هناك مدَنِيّة فلسطينية قد تمّ السَّطو عليها، ولحظة النكبة تعبّر عن ذروة المشروع الكولونيالي في فلسطين، والذي بدأت إرهاصاتُه من أواخر القرن التاسع عشر.
لكنْ ما هو هذا البحر المُلهِم، وما هي مُدنُه التي يتحدّث عنها المعرض؟ عن هذا يُجيب لسان حال الكيلاني بأنّه تلك الجغرافيا التي تجمع مدن عكا وحيفا ويافا المُحتلَّة بغزّة المُحاصَرة. فهذه المُدن الأربع تبني سردية وطنية واحدة عن الساحل الفلسطيني، بوصفه الحدّ الأول الذي لطالما كان هدف الغُزاة والطارئين. ولئِن أكّد النمط الغنائي والمرويّات الشعبية ذلك، فليس أدلّ من الراهن أيضاً، والذي ثأرت فيه غزّة - رغم جراحها وسنِي الحصار الإجرامي الذي تتعرّض له - لعموم فلسطين من شمالها إلى جنوبها.
نبقى دائماً مع النساء الفلسطينيات اللواتي يعجِنّ مادّة الأغنية الأساسية عند الكيلاني مثل "يا غزيّل" و"آه يا ريم الغزلان"، فإذا كان المُنطلق نساء المُخيمات والشتات، فإنّ الغاية والإهداء إلى أُخريات راحلات حملن في ذواتهنّ قبَساً أبدياً من روح فلسطين المُقاومة، وهنّ: الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، والشاعرة والأديبة سلمى الخضراء الجيوسي، وابنة غزّة التشكيلية ليلى الشوا. إلى هذا الثالوث النسوي الذي يكثّف عمراً من نضالات شعب وأُمّة (تكثيف نسوي حقيقي بلا ضجيج)، توجّهت المُغنّية المثقفة في إهداء اشتغالاتِها. والأمر لا يحتاج لطول تأمّل حتى ندركَ أنّ إرث هؤلاء النساء لن يندثر، وذِكْرَهنّ باقٍ ممتدٌّ في حاضر ومستقبل البلاد.
في لقاء كانت قد أجرته "العربي الجديد"، في الشهر الأول من هذا العام، مع ريم الكيلاني، تحدّثت فيه عن مشاريعها الأخيرة والمُقبلة، وتطرّقت إلى رؤيتها لراهن البلاد السياسي التي تستبدّ به - فضلاً عن الاحتلال - سلطة "التنسيق الأمني"، كما تناولت نظرة الغرب إلى موسيقى العرب "الإكزوتيكية"، وكيف يمكن أن نقرأ تراثنا العربي. كلُّ هذه الرؤى والطموحات عادت المغنّية لتجسّدها فعلاً وصوتاً - لا قولاً فحسب - عبر حفلها الأخير، في مثال حيّ على تقدّمية الفنّان الذي لا يُساوم بين قِيَمه الفنّيه ووعيه ودوره الطليعي.