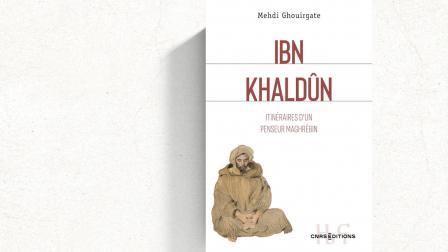ننشر على حلقات رواية "نصّ اللاجئ"، والتي لم تُنشَر في كتاب، وهي من أهم أعمال الشاعر والروائي والناقد الراحل محمد الأسعد الذي غادر عالمنا في أيلول/ سبتمبر 2021، وكان من طليعة كتّاب القِسم الثقافي في "العربي الجديد"، وأحد أبرز كتاب فلسطين والعالم العربي.
مع تباشير الفجر الأُولى، أو حتى قبلها بقليل، كنتُ أصحو من النوم تلقائياً أو على يد الأمّ وهي تهزُّني بلطفٍ: إنه موعد الذهاب إلى المخبز وشراء الخُبز. أما لماذا التبكير المبالغ فيه لشراء الخبز اليومي، فذلك لأن المخابز، ومع ارتفاعِ شمس النهار، تكتظُّ بالمُشترين، ولا يستطيع الصغارُ أمثالنا الوصول إلى نصيبهم وسط التدافُع والفوضى والصراخ.
في هذه الرحلات الليلية تعرّفتُ على الشيوعيين والأكراد والفلّاحين العراقيين مبكّراً. ذات فجر، كنت مبكّراً أكثر من المُعتاد كما يبدو، وجدتُ المخابز ما تزال مغلقةً، ومع ذلك مضيتُ من شارع إلى شارع في سكون الليل باحثاً عن ضوء ما، لعلّ مخبزاً من المخابز يرميه الحظّ في طريقي. وأخيراً لاح لي ضوءُ مخبزٍ بدا وكأنه هبةٌ من السماء وسط الظُّلْمة الحالكة والبرد القارص.
دخلتُ وأنا أتهلّل فرحاً في داخلي، إلا أنّ عجَبي وخيبتي كانا بالغين حين بادرني أحد الخبّازين، وكان غليظ الرقبة والذراعين، بِقوله "لا خبز اليوم". سألت لماذا؟ فتبرّع بالجواب شخص يفترش الأرض: "لأنّنا شيوعيون كما يقولون". واستدرتُ على أعقابي من دون أن أفقه شيئاً. حسبتُ الرجلَ يسخر منّي، إلّا أنّ لهجته المتأفّفة كانت تؤكّد أنه لم يكن ساخراً بقدر ما كان يقول حقيقةً تُسبّب له قلقاً.
كان ذلك في العهد المَلَكي الذي اعتدنا فيهِ أن نخشى الإلحاف أو الظهور بمظهر الجَهَلة حتى لا تحيط بنا السخرية. ومع ذلك كانت السخرية كثيراً ما تُحيط بإنسانٍ آخر نحيلٍ من كائنات آخر الليل. كان ذا وجهٍ نحيل، وملابس أكثر غرابة، اعتدتُ على رؤيته مبكّراً. وكثيراً ما كنّا نلتقي وحيدين عند بوابة المخبز، وأمام طاولته التي تُلقى عليها الأرغفة الساخنة. ما كان يبدو غريباً؛ لباسه المميز ولغته غير المفهومة أو المنحرفة قليلاً. وكثيراً ما سمعتُ الخبّازين أو زعيمهم موزِّع الخبز وجامعَ النقود، يُطلقون تعابير وتعليقات ساخرة تتهم الرجل بالعته أو البلاهة، أو الجنون أحياناً.
ربما كانت نظراتُه التي لا تستقرّ على شيء هي السبب، كان يُهَمهِم بكلمات غريبة لامعنى لها بينه وبين نفسه، ويحتقن وجهُه، فيتناول أرغفته، وهي كثيرة عادة، متجاهلاً التعليقات، وينصرف وعلى وجهه شيءٌ من الألم الغاضب، ربما كنتُ الوحيد الذي يلمحه.
في هذه الرحلات الليلية تعرّفتُ على الشيوعيين والأكراد والفلّاحين
كان الرجل كرديّاً من المعزل الذي أعرفه، وكثيراً ما مررتُ ببوّابته الكبيرة. لم يكن من المألوف مصادفةُ أحدِ الأكراد في الطريق، ويبدو أنّه كان ممنوعاً عليهم الخروجُ من معزلهم كما خُيّل لي، فكانوا يرسلون بِورقهم رجلاً منهم لشراء حاجياتهم هو هذا الذي أطلق عليه الخبّازون لقب "المجنون".
كانوا سكّان كهف بالتأكيد، إلّا أن رجلهم لم يكن مجنوناً، بل كان ذا لسانٍ لا يفهمونه، وهم من لسان لا يفهمه. بضعةُ ألفاظ كانت تكفي لشراء أرغفة الخبز، وأُخرى مثلها لشراء الطعام من السوق الذي يضجُّ بأصواتِ الباعة، والحمّالين، والذُّباب، وعربات اليد الطويلة التي يدفعها أصحابها أمامهم صارخين بالناس أن يبتعدوا عن طريقهم. ولم يكن هذا الكائن المنفي - لا اللاجئ - يشعر بالحاجة للتنازُل عن لسانه.
النفي درجة أفضل من اللجوء، لأن المنفي لا يشعر بالمهانة. إن اختلاف المعنى في ذهنه يظلّ محدّداً بمنظومة ألفاظ لغته. فهي التي تُحدّد له بحقلها الدلالي والصوتي معاني الأشياء واختلافها. أمّا اللاجئ فإنّ ما يتسرّب إلى نفسه ولغته من سيولٍ لشبيهٌ بأخاديد تثلمُ الشخصية المتعبة، والروح المُثقلة بجريمة تودّ الخلاص منها اسمها اللجوء.
في هذه الأجواء سمعتُ بلفظة الشيوعيين والأكراد. وستكون مناسبة تعرفي على الفلّاحين في ظروف مختلفة. اعتدتُ على رؤية ريفيّ شاب قوي البُنية وحافي القدمين، كانت الأقدامُ الحافية مألوفةً في البصرة، وقد عجبتُ ذات يوم من امرأةٍ لاجئة تسيرُ حافية القدمين ولا تشعر بالحرج.
كان هذا الريفي يضع على رأسه ما يشبه خرقةً تحت صينية خشبية، تحمل أقداحاً فخّارية عديدة ممتلئة باللّبن الرائب ذي القشدة الكثيفة. وكثيراً ما كان يستوقفه شخص من "التوراة" ليشتري منه قدحاً أو اثنين في أُمسيات رمضان. إلّا أن مفاجأتي كانت لا حدَّ لها ذات يوم، حين فُوجئت بفلاح من نوع آخر يحمل صينية مماثلة، كان أحد زملائي في المدرسة وقد اختفى منذ زمن طويل، ولم أعد أشاهده حتى أنني نسيتُه. وفجأة ظهر ليبيعنا اللبن، وضع صينيته عن رأسه بهدوء، ثم قدّم الأقداح وهو يتحاشى النظر إليّ... وتشاغلت ُعنه بدوري.
النفي درجة أفضل من اللجوء، فالمنفي لا يشعر بالمهانة
ستعود هذه الأسماءُ كلّها، ما تعرّفتُ عليه وما لم أتعرّف، بشكلٍ أو بآخر في السنوات التالية. وستتّخذ أشكالاً جديدة مختلفة بعد العام 1958 الذي كان طوفاناً تغلغلت أمواجُه في حياة كلِّ إنسان آنذاك، بدءاً من الأطفال ووصولاً إلى العجائز. ومروراً بالفتيات طبعاً، وبخاصة من اللواتي بدأن يرتدين بناطيل المقاومة الشعبية، فازداد انتباهُنا إلى أجسادهن أكثر ممّا كُنّا نفعل في الماضي.
كُنّا مستثارين بالحدث بيننا وبين زملائنا، أما عجائزنا فيبدو أن الأمر لم يكن مهمّاً بالنسبة لهم. أذكرُ عجوزاً لاجئاً، أسمر الوجه ذا لحية بيضاء، وقامة قصيرة، مرّ بنا ونحن في زُقاقنا أمام "التوراة"، ومعنا صورة الزعيم عبد الكريم قاسم مُمسكاً بمدفعه الرشاش المعلّق بشريطٍ إلى كتفه، وعينيه فزعتين في انتباهةٍ غير مفهومة، وقد طُبعت على ورق خشن رديء على عجَل. وعرضنا الصورة على العجوز طالبين رأيه، فقال بدون تروٍّ: "ماله مكهرباً". ولأن العجوز كان ينطق الكاف قافاً، فقد أثار ضحكنا لفظُه أكثر ممّا أثارتنا السخرية التي يتضمّنها تساؤله. وثبتت هذه القاف في الذاكرة، لأكتشف أنها كانت أبلغ وصف لمهزلةٍ عرضت نفسها بجدّية تامة.
سيظهر الشيوعيون فيما بعد من ظُلمةِ ذلك المخبز المغلق، وأحدهم ولا شك ذلك الخبّاز الغليظ الرقبة والذراعين، وزميله المتأفّف ذات ليلة شتائية باردة، ويرتدون ملابس "المقاومة الشعبية"، أو ربطات العُنق الحمراء وهم يحملون الرشاشات، أو يجلسون في صدر الندوات التي كانت تُقام في الساحات، أو يسيرون في المسيرات ذات الرايات، وسيتحوّلون إلى رمزٍ لكلِّ ما هو مُخيف ومهدِّد. وسنسمع بأن أكراد المعزل المنفيّين عادوا إلى الشمال، لينحدروا فيما بعد إلى الموصل ويشاركوا في مجزرة تُسحق فيها عائلاتٌ بأكملها بشبابها وأطفالها في سبيل "الثورة". أما الفلاح، بائع اللبن، فقد أعطته "الثورة" وظيفة جديدة؛ لقد ترك الأرض واللبن والتحق بالمدينة يترصّد أعداء "الثورة" ليجرّهم في الشوارع.
كلّ ضربةٍ كانت انتقاماً لجِراحٍ أصابته بيد أُناس آخرين
لم ينقلبِ الناسُ إلى أضدادهم كما قد يخيل إلينا، بل مُنحوا فرصةً وأملاً لتغيير كونهم البائس، من مضطهدين ومُهانين إلى متسلّطين ومتسيّدين. وكان لابدّ أن ينشبوا مخالبهم في ضحايا، وكان لابد أن يُقدّم لهم أحد ما الضحايا. وأعتقد أنّ كلّ ضربةٍ كان يضربها كلّ واحدٍ من هؤلاء الصارخين أو المزمجرين، كانت انتقاماً لجِراحٍ عميقة ربّما أصابته في مكان ما، وفي أزمان أُخرى وبيد أُناس آخرين، ولكن ما أهمية هذا الفارق؟ ما دام الهمُّ الأولُ هو الانتقام لجُرح مهانة عميقة ألا وهو جُرح الضآلة.
سيفعل الصهاينةُ الأمرَ نفسه في فلسطين، حين توافدوا عليها من معازل أوروبا، ومهانة شوارعها ومُدنها المتكبّرة وأضوائها البرّاقة، فيطلق أحدهم رصاصَه على فلّاحين فلسطينيّين عائدين إلى قراهم مساءً صارخاً "من أجلكِ يا شوشانا". وشوشانا هذه قد تكون حبيبته التي اغتصبها ألماني، أو سحق رأسها أوكراني في معسكر اعتقال، ولكن أنّى لهذا الذي حوّلته المهانة إلى وحش أن يشعر بالمفارقة وبموقفه الهازل؟
البشرُ متساوون كما يقال، ولهم الحقُّ نفسه في الكرامة والوطن والجنسية، وكلّ هذه الألفاظ المدرجة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كل هذا صحيح، ولكنهم متساوون أيضاً في ردود أفعالهم على الذلّ والمهانة، أعني في تحوُّلهم، حين يخلق منهم ذئبُ الاضطهاد والإذلال ذئاباً. وليس من الأمور المدهشة، التي تبلغ فيها المفارقة قمّتها الهزلية، أن نجد الآن شرطياً فلسطينياً سحقه الذلُّ في مخيم عين الحلوة أو الشاطئ، يتحوّل إلى جلادٍ خطر في شوارع غزة أو رام الله منتقماً من صحافي أو طالب أو امرأة أو رجل أعمال أو أي ضحيّة يومئ إليها دمُه الملوَّث برغبة الانتقام.
في تلك الليالي الباردة التي كنتُ أنسلُّ فيها مبكراً بحثاً عن خبز للعائلة، لم يكن يخطر ببالي الخوفُ من شيء، ربما لأن وحوش العالَم الخفي لم تكن قد ظهرت بعد، وربما لأن العالم كان يبدو أشدَّ أمانا لأن الناس لم يكونوا يفكّرون بالسلطة بعد، أما الحكومات آنذاك، فيبدو أنها لانشغالها بمباذلها وحساباتها، حسبت أنّ لا أحد يجرؤ على فتح بوّابة الجحيم الموكلة بها وحدها.
سيتغيّر سكان هذا الجحيم بين فترة وأُخرى، وستتنوّع هويات الداخلين والخارجين منه، ولكن من المؤكّد أن الفردوس الذي حلم به كلُّ هؤلاء الخاطئين والمُجرمين والمُبتذلين لم يكن يقع في أيّ زاويةٍ من زوايا هذا الجحيم.