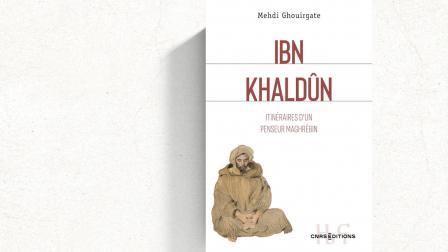تعود ساعة "تستور" التي تتوسّط صومعة الجامع الكبير في المدينة التونسية إلى العمل، بعد ثلاثة قرون من التوقّف، وتُشغّل كما كانت تدور سابقاً بشكل معاكس للاتجاه المألوف لدوران العقارب.
بُنيت ساعة تستور بعد تشييد الجامع الكبير سنة 1630، على يد محمد تغرينو، أحد الأندلسيين الذين وفدوا إلى المدينة بعد هجرتهم من إسبانيا، وتشير روايات شعبية إلى أن سرّ دوران عقارب الساعة من اليمين إلى اليسار، يعود إلى كون الأندلسيين كلما أجادوا عملاً يعمدون إلى تشويه جزء منه خوفاً من الحسد.
لكن يبدو أن للساعة سيرة تتّصل بموروث ثقافي أعمق، وهو ما يعكسه مشروع إعادة هذه الساعة إلى الحياة، والذي أشرف عليه وأنجزه عبد الحليم الكوندي، وهو مهندس تونسي، يعود في جذوره إلى إحدى الأسر الأندلسية التي فرّت من إسبانيا زمن "لا ريكونكيستا"، واستقرّت في بلدة تستور (70 كيلومتراً غرب تونس العاصمة).
المشروع يبدو مثل تقاطع لهذا البعد الانتمائي إلى البلدة وتاريخها، وكذلك لمهنة الكوندي الذي كتب "بما أنني مهندس، تعلّمت أنه لا ينبغي ترك آلة عاطلة عن العمل. قرّرت أن أدخل في مشروع إعادة الساعة للعمل بعد توقّف ثلاثة قرون".
منذ سنة تقريباً، يقدّم الكوندي بانتظام محاضرات حول هذا المشروع وحيثياته، وقد أصدر كتابين عنه، الأوّل بالفرنسية "ساعة تستور تسترجع الزمن" (2015)، والثاني بالعربية "ساعة تستور الأندلسية.. تدور" (2016).
في العمل الثاني، ينطلق المؤلّف من سرد ذاتي؛ بلدة تستور وأثرها في ذاكرته كطفل باعتبار محوريّتها في الأحاديث العائلية، حيث كانت منطلق أسرته قبل استقرارها في تونس العاصمة منذ زمن طويل. ذاكرة ستقوده إلى البحث عن قبر جدّه البعيد، علي الكوندي، والذي دُفن في تستور منذ أربعة قرون.
يروي الكوندي جزءاً مما سمّاه "دراما الموريسكيين" حين طُردوا من ديارهم على ثلاث مراحل في القرون الـ 13 و15 و17 الميلادية، ويتوسّع في تفصيل تفرّعات أسماء الأسر الأندلسية التونسية.
ستكون المقبرة - حيث دُفن جدّه البعيد - مدخل الكوندي في مشروعه. إنها تقع في هضبة تُشرف على البلدة التي تظهر في أولها صومعة سينتبه المقترب منها إلى أن ساعتها معطّلة، وأن أرقامها مكتوبة بشكل غير اعتيادي.
 يختار الكوندي تفصيلاً آخر يقودنا من خلاله إلى حكايته مع الساعة الأندلسية، إذ يتحدّث عن تراث شفوي في تستور يُسمّى "المنزل والمنزول" اللذَين يعنيان تحضير مقام الحياة (المنزل)، ومقام الموت (المنزول).
يختار الكوندي تفصيلاً آخر يقودنا من خلاله إلى حكايته مع الساعة الأندلسية، إذ يتحدّث عن تراث شفوي في تستور يُسمّى "المنزل والمنزول" اللذَين يعنيان تحضير مقام الحياة (المنزل)، ومقام الموت (المنزول).
ها هي الساعة قد بدأت تقول شيئاً من أسرارها، فدورانها المعكوس ليس سوى تجسيد لرغبة يائسة لاسترجاع الوقت والعودة به إلى نقطة في الماضي، فالساعة بحسب الكوندي "تشير إلى الأندلس بتوقيت الأندلسيّين".
ربما تحمل الساعة أبعاداً جغرافية، بحسب المؤلِّف، فالطريق من إسبانيا إلى تونس يشبه قوساً (ربع دائرة) ينطلق من الغرب ويتّجه نحو الجنوب الشرقي. إذن، فالساعة تحاكي، باتجاه دوران عقاربها، المسار المعاكس للطريق الذي سلكه الأندلسيون نحو منفاهم، مما يعني أن الساعة كانت تحمل رمزية استرجاعية من زاويتين وربما أكثر.
يقترح الكوندي على قارئه رحلة بين الساعات الحائطية معكوسة الدوران في العالم، إنها قليلة ومتناثرة هنا وهناك بين براغ ومونستر وفلورنسا ولاباز، ولكل واحدة منها حكاياتها وألغازها ورمزياتها. كما يلقي، بخلفياته العلمية، بعض الضوء على تطوّر الساعات ونظرياتها بين العصور، مركّزاً على موقعها في الحضارة الإسلامية.
من المسارات الأخرى التي ينعطف إليها الكوندي ويتشعّب به الحديث عنها، تلك الموجات البشرية التي غمرت تونس بعد سقوط المدن الأندلسية وهروب المسلمين منها. رحلة الشتات هذه يضيء من خلالها المشهد السياسي للمتوسّط، بين ملك إسباني (فيليب الثالث) قرّر طردهم، ووال عثماني مستقر في تونس (عثمان داي) احتضنهم باعتبارهم قادرين، من خلال صنائعهم، على تطوير البلاد وتنشيطها.
هذه الفتحة على التاريخ لا يتوسّع الكوندي في جوانبها الإشكالية، مثل دور الأندلسيين في سقوط الدولة الحفصية أو مواقعهم بين بقية المكوّنات الإثنية في تونس، مفضّلاً تلك القراءة الفوقية عن توزيع حسب الحِرف بين المدن والأرياف، ومن هنالك يخلُص إلى انعكاس هذه الموجات على تطوّر تستور العمراني، وتقنيات تخطيطها وتحوّلها إلى موقع نموذجي لاستقرار الأندلسيين، وفضاء للتعايش بيت المسلمين واليهود، من دون تعمّق في تقديم التفسيرات.
جزء من الكتاب خصّصه المؤلّف لتوثيق مسار إعادة الساعة للعمل، من التخطيطات الهندسية وصولاً إلى الإداريات والتدشينات الرسمية وحيثيات الدعم الذي وفّرته أجهزة الدولة والمجتمع المدني. هذا الجزء يُثقل على بقية جوانب العمل، خصوصاً مع إقحام البعد السياحي وإبراز الجوانب النفعية من المشروع، حتى أن العمل، بهيكلته وتقسيمه، يبدو من زاوية ما مثل مشروع تخرّج.