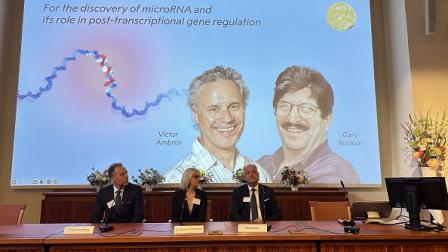يقدم الموسيقي المصري فتحي سلامة (1969)، نموذجا فريدا للموسيقي المتمرد. ورغم ابتعاده عن محاباة السوق التجارية، إلا أنه حقق نجاحاً كبيراً. في عام 1989، غادر مصر، إثر تقديمه أعمالاً مميزة لفنانين مثل عمرو دياب ومدحت صالح ومحمد منير. إلا أنه قلق من تكرار نفسه، فغادر ليؤسس فرقة "شرقيات" ويجوب بها أوروبا. هنا، حديث معه، يضيء فيه على تجربته، ورأيه في المشهد الموسيقي الحالي.
• ما الموسيقى التي تقدمها؟
- لست مع التصنيف بصفة عامة، وأتصور أن جزءاً كبيراً منه يعود إلى ما كان يحدث زمن الكاسيت والسيديهات، عندما حرص العارضون على تصنيف الأغاني المتشابهة، حتى يستطيع المستمع إيجاد ما يناسب ذوقه بسهولة. وبلغ من طرافة هذا المنطق التجاري أن روّج منتجو موسيقى الرقص "هاوس" الشهيرة، منذ الثمانينيات من القرن الماضي، لها بهذا الاسم. وبعد فترة، ومن أجل استمرار الرواج، قدموها تحت مسمى "تربل هاوس"، ثم "ديب هاوس"، وهكذا... قطعاً هناك أنواع من الموسيقى تشترك في عناصر معينة، لكن التصنيف يرسم حدوداً لا أميل إليها.
• ما الذي تتميز به موسيقى فتحي سلامة عن غيرها؟
- من الممكن أن أوجز الإجابة في كلمة واحدة تفي بالغرض: التنوع. درست الموسيقى الغربية (الكلاسيك) منذ كنت طفلاً، على يد خبراء روس، هم الأفضل في العالم في التدريس. لعبت بعدها مختلف أنواع الموسيقى، منها: الروك، والجاز... إلى جانب ذلك، أنا حريص على سماع الأنواع كافة: الهندي، والكلاسيك، والسوداني، والمغربي، والمهرجانات، وتراب (Trap).
لا أشعر برفض تجاه أي شيء. لذلك، أتصور أن لدي مقداراً كبيراً من التنوع، أفتقده في موسيقانا. على سبيل المثال، إذا استمعت إلى الموسيقى التصويرية للأفلام أو المسلسلات، ستلاحظ أنها جميعاً متشابة بدرجة كبيرة، بغض النظر عمّن لحنها. وتتجسد هذه الحالة في نموذج صارخ لموسيقي شهير، لا يتوقف عن تقديم الحفلات، وصنع الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الدرامية المعروفة، وجميعها متشابهة بصورة واضحة. هذه الحالة نتيجة لغياب التنوع الذي أتحدث عنه.
• درست وعملت في أوروبا. ما الفروق الجوهرية بين بيئة العمل هناك ونظيرتها هنا؟
- العلم أو المعرفة المتوافرة، سواء لدى من يقيم الحفلة، أو المستمع، أو الموسيقي. إضافة إلى أن تقبُّل المختلِف درجته أعلى كثيراً. أما لدينا، فالفنان أبعد ما يصل إليه، "لو كان شاطر"، قراءة النوتة واللعب على إحدى الآلات.
لن تجد في الغرب أيضاً ما هو منتشر لدينا، من سرقة "اللوبس" (Loops)، وهي قطع موسيقية صغيرة، سواء لآلة أو لأغنية كاملة، متاحة على النت مجاناً أو بمقابل بسيط. يُركّب عليها كلام، ليصبح لدينا أغنية. لهذا، لو استمعت إلى الـ"تراب" لدينا، ستلاحظ أن أغلبه متشابه إلى حد بعيد، لأن الجميع يعود إلى المصدر نفسه.
وبالنسبة إلى مجال الصناعة، أتصور أنه لم تعد هناك اليوم اختلافات كبيرة. شركات الإنتاج توقفت في العالم. إذا استطعت أن تنتج لنفسك عملاً وحقق نجاحاً كبير، حينها فقط من الممكن أن تلتفت لك الشركات. أما أن تقدم تلك الشركات مشاريع فنية جديدة، فهذه قصة انتهت تماماً. إضافة إلى أن السوق ازدحم بصورة كبيرة، ويمكنك تلمُّس ذلك من خلال منصات مثل يوتيوب، وأنغامي، وسبوتيفاي. ستجد عليها عدداً لانهائياً من الأغاني.
• في تصريحات سابقة، وصفت كل ما يقدم حالياً من موسيقى بأنه تجاري ومسف. في رأيك، متى تبلورت سيطرة هذا التيار، ومن أبرز الأسماء وراءه؟
- ليست هناك أسماء بعينها. هي حالة عامة تلمسها مثلا لدى جيل الثمانينيات؛ فأغنيته اليوم هي نفسها التي كان يقدمها في تلك الفترة، وإن أصبحت "أشيك شوية". هذا كان مدعاة لملل الجمهور، ليحرض ذلك على ظهور ألوان أخرى، مثل المهرجانات وانتشارها على هذا النحو.
لكن حتى تكون الصورة مكتملة، في الثمانينيات كانت هناك بقية من قيمة فنية، إذ للمغني رؤية أو لون موسيقي معين، بينما شركة الإنتاج ترغب في تقديم ما تتصوره مناسباً للسوق. عندها، كان من الممكن أن يلتقي الطرفان في نقطة وسط، لكن اليوم الفنان (إذا أطلقنا هذه الصفة مجازاً) هو أيضاً تاجر، نتج عن ذلك انخفاض الجودة بصورة مؤسفة، ويحدث ذلك تحت يافطة "الناس عايزة كده". لكن "الناس مش عايزة كده، الناس على ما تعودوا عليه".
لا أحد يهتم اليوم إلا بالمشاهدات. في الورش التي أشارك فيها مع الشباب الراغبين بالتعلم، أسمعهم يتحدثون حول عدد المشاهدات التي حققتها كل أغنية، وليس عما إذا كانت جيدة أم لا. نعم، هذا الجانب التجاري موجود في كل العالم، لكن في بلادنا مساحته أوسع كثيراً.
هذا جعل مساحة الإبداع محدودة جدا، الأمر الذي دفعني سابقا إلى الرحيل عن مصر، رغم ما حققته من نجاح وقتها. فعلى سبيل المثال، لدى ذيوع أغنية "ميال" لعمرو دياب، جاءني وقتها العشرات يطلبون عملاً مثل "ميال"، حتى لو لم يكن مناسبا للمغني. وتعرضت لهذا مرارا عند انتقالي إلى مساحة مختلفة، كالموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات (قدمت ثلاثة أعمال للسينما). جاءني أحدهم مثلا يطلب موسيقى مختلفة لعمل درامي، لكن بمجرد أن قدمت له عملاً مختلفاً بدرجة بسيطة قوبل بالرفض. اليوم الوضع أسوأ، أمسى لدينا نجوم لا يعرفون "دو ري مي"، ليصنعوا أغانيهم عن طريق جهاز الكمبيوتر، من غير أن يمتلكوا أي قدر من الموهبة أو المعرفة اللازمة.