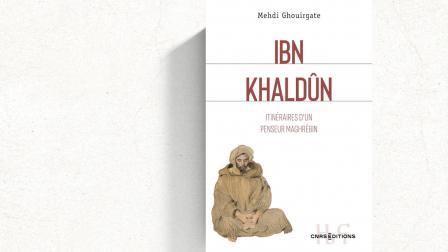لا يمكن فصل كتاب "في الحب والحب العذري" (1968) عن مجمل اشتغالات المفكّر السوري الراحل صادق جلال العظم، وإن ظهر حينها بوصفه محاولة لمقاربة ظاهرة الحب ثقافياً من خلال تأمّلات فلسفية - بالدرجة الأولى - لسير العشاق وسلوكيّاتهم عبر التاريخ العربي خصوصاً، أكثر من كونها دراسة علمية محكمة حتى مع استعارته مقولات علم النفس والاجتماع.
لو دقّقنا في تاريخ الإصدار نجد أنه أتى بعد نكسة حزيران 1967 بعام واحد، بمعنى أن العظم الذي بدأ مسيرته البحثية والأكاديمية في تلك الفترة، كان متأثّراً مع أبناء جيله بالهزيمة "الجديدة"، ضمن إحساس مثقل لديه ولدى آخرين بأنها حلّت كمحصلة تداعيات وانهيارات عصفت بالعقل والمجتمع سعى طوال مشواره لإخضاعها إلى النقد والمراجعة.
لكن صاحب "نقد الفكر الديني" لجأ إلى الحب على إثر النكسة، وكأنه يقول إن "الشهوة والحاجة والنزوع والميل إلى امتلاك المحبوب"، موضوع دراسته في الكتاب، تمثّل ظاهرة مرضية معقّدة سابقة على غيرها من الظواهر لدى المواطن العربي الذي يعتقد أن كبت انفعالاته الجنسية هو التعبير الأسمى عن الحب، المسمّى بـ "الحب العذري"، وبذلك يصبح الجنس المتخيّل والمفتقد والمنشود هو غاية العلاقة ومنتهاها.
رغم الانتقادات المتعدّدة إلى خلاصات العظم في هذا السياق، إلا أن توصيفه لتناقضات العشق والعشّاق أصابت ثقافة ووعياً عاشا عليها قروناً بمقتل، فحتّى لو ذهبنا إلى الرأي الذي يتهمه بالتعسّف في استقراء ظاهرة الحب العذري وتقديمه ملاحظات متطرّفة تتصل برموز الحب في تاريخنا العربي وانتقائه منهم ما يُثبت صحّة فرضياته، فإن تساؤلاته تبقى حاضرة حول رغبة عروة وجميل وقيس، مثلاً، بالاستمتاع بحبّ خفيّ مع معشوقاتهم بعد زواجهنّ، أو بتقديره أن بعضهم كان قادراً على منع زواج حبيبته من غيره لكنه لم يُقدم، وغيرها من التحليلات.
حدّد صاحب "ذهنية التحريم" موقفه من العاشق العذري بأنه لا يتردّد في اختلاق أسبابٍ تحول دون وصوله إلى إشباع شهوته، فيجعله مستثاراً على نحو متواصل إلى حدّ يدفع به إلى الجنون، وهنا تبرز إشارة لم تنل بحثاً كافياً من العظم الذي ربط بين الحبيبة "المشتهاة" على الدوام وبين المقدّس، باعتبارهما حقيقة مطلقة لا بدّ أن يسعى نحوهما المرء من دون الوصول إلى معنى متحقّق في نهاية المطاف.
الحب العذري كمعادل موضوعي للشقاء، هو تعبير عن "سادومازوشية"، بحسب العظم، الذي توقّف عند إشكاليات أخرى لا تقلّ تعقيداً، ومنها العلاقة الزوجية ضمن ثنائية "الامتداد والاشتداد"، التي تستبدّ بالإنسان الذي يريد حبّاً جارفاً حاداً متدفّقاً يجده في العلاقات القصيرة العابرة التي تعصف بالروح بقوّةٍ لا يمكن السيطرة عليها، وبين الحالة السكونية لحبّ ممتد وقارّ يتمظهر في أوضح صُوره ضمن مؤسسة الزواج، وعليه يظلّ أسير تناقض وجوديّ لا مفرّ منه؛ الخلاص والتحرّر من قيوده بالاشتداد والسعي إلى تقبّل المجتمع له والرضى عنه بالامتداد، وهي "مفارقة الحب" التي بُنيت عليها فرضية الكتاب.
نصل إلى تناقض آخر رصده المفكّر السوري، في حديثه عن "العاشق الدونكيشوتي" الذي لا يعشق امرأة بعينها، فكلّ واحدة هي موضوع حبّ بالنسبة إليه، وهؤلاء يشكّلون ظاهرة للدراسة في مجتمعات مكبوتة وتخضع لذهنية التحريم كما في مجتمعاتنا العربية، معبّرين بذلك عن انفصام تامّ لأن مخيّلتهم عن الحب منبتّة عمّا هو في الواقع، غير أنه يلتقي بذلك مع العاشق العذري في كونهما لا يجعلان "المحبوبة" موضوع الحب، بل يجعلان الحبّ ذاته غاية نفسه.
هل كانت قراءة صاحب "الاستشراق والاستشراق معكوساً" لأثر مفاهيم الحب على سلوكياتنا متصلة بالسلطة بتجلّياتها المختلفة؛ الذكورية والدينية والسياسية؟ سؤال يستدعي قراءات أعمق في دراسة العلاقات العاطفية في مجتمع يتمدّد الهامش أو الهوامش أضعاف المتن فيه، والإقرار بأن إخفاقنا فيها ليست مسألة ثانوية، بل هي أساس الاضطراب في شخصيّاتنا وهويّتنا ما يفضي إلى مزيد من الكبت وتعلّق بالخرافة.