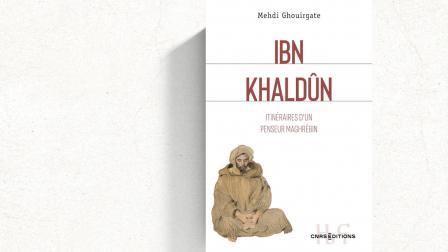لعلَّ أديبَ بلدةِ "الفريكة" اللبنانية، أمين الريحاني، أهمُّ رحَّالة عربيٍّ عرفه القرن العشرون، نظراً لرصيده المهم من كُتب الرحلات في البلاد العربية، والتي ابتدأها برحلة "مُلوك العرب"، فـ"قلب العراق"، و"قلب لبنان"، ثم "المغرب الأقصى"؛ وكلها "سلسلة من الكتب تُعنى بأحوالها كلِّها (أحوال البلاد العربية)، وتعرض لجميع مناحي الخير والضعف فيها، تكون خير سفير لتعاطف هذه الأقطار وتقاربها ووحدتها"، كما يقول الريحاني.
وهي أعمال تنم عن موقف حضاري ووعي قومي يسعى إلى استنهاض همم العرب، ولفت انتباههم إلى حالهم المزرية تحت نير قوى الاستعمار، بإلحاحه على قيمة الاتحاد في ما بينهم للإفلات من ربقة الاحتلال، ولتحقيق نهضة حقيقية تُؤكّد تميُّزَهم واستحقاقَهم ماضيَهم الذي تشهد عليه آثارُهم في بلادهم الحالية وخارجَها.
رحلةُ "نور الأندلس" هي آخر رحلةٍ أنجزَها الريحاني (1876-1940)؛ فبعد أنْ رُحِّب به من قِبَل المغاربة والمستعمِر، في منطقة الحماية الإسبانية، في ربيع 1939، ألَّف تلك الرّحلة الشهيرة الموسومة بـ"المغرب الأقصى: رحلة في منطقة الحماية الإسبانية".
ولم يكن الريحاني يمر عابراً أمام الأحداث والأشياء خلال رحلاته، فالمعروفُ أنّه كان يُعرب عن مواقفه صراحة، ولذلك فهو لَمْ يُخْفِ أثناءَ وجوده في المغرب انبهارَه بالمنجزات الكبرى في شتى المجالات، تلك التي حقَّقها وشيّدَها الإسبان في تلك الجهة من التراب المغربي، لذلك اهتبل الإسبانُ موقِفَه، فعرضوا عليه القيامَ برحلة إلى إسبانيا على نفقة نظامِ حُكم الديكتاتور فرانكو.
 وقد اعتبرَ بعضُهم قَبول الريحاني للدعوة رَشوةً لا غبار عليها، بل وعَمالةً، وأنّ هدفَها تلميع صورة نظام فرانكو الديكتاتوري، الذي كان يُعاني عزلةً دولية بعد مجازر الحرب الأهلية والانقلاب على الديمقراطية، بينما يضع الريحانيُّ رحلتَه "نور الأندلس" في سياقها، بقوله: "لم يكن من أغراضي في الرحلة المغربية أن أزور إسبانيا، ولكني بعد أن سِحْتُ في المنطقة، وشاهدت أعمال الحكومة الحامية ما هو في دور الإنشاء، وما لا يزال عهْداً وأمَلاً، رأيْتُ من الواجب عليَّ أن أقابل الجنرال فرنكو لأتحقَّق ما لاح لي -ولمْ أُخفِه على القارئ- من أنوار وظِلالِ الخطة المغربية الجديدة".
وقد اعتبرَ بعضُهم قَبول الريحاني للدعوة رَشوةً لا غبار عليها، بل وعَمالةً، وأنّ هدفَها تلميع صورة نظام فرانكو الديكتاتوري، الذي كان يُعاني عزلةً دولية بعد مجازر الحرب الأهلية والانقلاب على الديمقراطية، بينما يضع الريحانيُّ رحلتَه "نور الأندلس" في سياقها، بقوله: "لم يكن من أغراضي في الرحلة المغربية أن أزور إسبانيا، ولكني بعد أن سِحْتُ في المنطقة، وشاهدت أعمال الحكومة الحامية ما هو في دور الإنشاء، وما لا يزال عهْداً وأمَلاً، رأيْتُ من الواجب عليَّ أن أقابل الجنرال فرنكو لأتحقَّق ما لاح لي -ولمْ أُخفِه على القارئ- من أنوار وظِلالِ الخطة المغربية الجديدة".
لكنّ الشيءَ الأكيد، بالنسبة إلينا، هو أن "نور الأندلس" رحلةٌ وليدةُ "المُصادَفة"، لكونها لم تكنْ مُدْرَجةً ضمن المشروع الرِّحلي لأمين الريحاني، الذي نعرف أنه كان مشروعاً دقيقاً خطَّط له صاحبُه، لكنّ ما يتصوَّره بعضُهم رشوةً يَنْسِفُه الريحاني بإبدائه آراءَه في جرأة واقتناع، دون خشية من العرب أو الإسبان، الذين انتقدَهم بحدة يعكسها مَثلاً قولُه: "هذا الذي أقوله في ماضي إسبانيا يصح في حاضر البلاد العربية، فإذا كان الحكم الأجنبي في إسبانيا هو سبب تقهقرها، أو بالحري سبب جمودها أثناء ذلك الحكم، فهو كذلك في البلاد العربية اليوم. وليس في الحاليْن غيرُ نتيجةٍ واحدة. ما قامت النهضة الإسبانية الفنية الوطنية وازدهرتْ إلا بعد انقراض الحكم العربي في البلاد، ولا تقوم النهضة العربية الثقافية الوطنية وتزدهر ازدهاراً شاملاً، إلا بعد أنْ يخرج الأجانب المسيطرون من البلاد العربية".
ورحلةُ نور الأندلس هي آخر تأليف لأمين الريحاني، واستغرقتْ من مؤلِّفها شهريْن من صيفَ سنة 1939، وقدْ انطلقتْ مُباشرة بعد انتهائه من رحلته "المغرب الأقصى"، وابتدأتْ بالانطلاق من مطار تطوان على متن طائرة عسكرية، ويقول في ذلك: "وها أنا ذا والرفيق البستاني على الدوام، من تطوان إلى مطارها؛ لنطير هذه المرَّة في طيارة ألمانية إلى إشبيلية"، وانتهى من كتابتها في صيف العام نفسه، في لبنان.
تحضن "نور الأندلس" أجناساً متنوّعةً من الكتابة، فهي تحكي مشاهَدَات ومَعيشاً وتجارب، وتسرُدُ تاريخاً عربيّاً وإسبانياً، وتُقدِّمُ لوحاتٍ تصف العمران والطبيعة، وتخوض في النقد الفني، وتُعرِّف بمظاهر الحياة الاجتماعية الإسبانية، وتُحلِّل النظامَ السياسيّ العربيّ والإسبانيّ، وتنسج حكايات... إلخ.
ودُوّنتْ نور الأندلس في 11 فصلاً. وقد تهيَّأ لها الرَّحالة، وَفْق قوله، "بما تراكم بين يديَّ من أسباب الدرس والكتابة، كما كنتُ مسروراً بما مهَّدته الحكومة من سُبُل السياحة والعلِم". وكان دليلُه في إسبانيا مُترجِمَ الإقامة العامة الإسبانية في المغرب الأديب اللبناني ألفريد البستاني.
لقد عوَّدتنا كتبُ الرّحلات، عموماً، أن تُنجَز الرحلةُ إلى جغرافية تكون مغايرة لهوية الذات، لكنْ في حال "نور الأندلس" فإن الرحلة أنجزَها الريحاني إلى أرضٍ لها صلة عميقة بالثقافة العربية، لذلك ليس غريباً أنْ تتميَّز بالخروج ظاهرياً عن ميثاق الرحلة، اعتباراً للعلاقة الحميمة التي تربط العرب بالأندلس، لذلك فهي رحلة إلى الداخل أو الدخيلة أيضاً، نظراً لمكانة الأندلس في الذات العربية.
"نور الأندلس" كانت في عمقها رحلةً في الزمن إلى الماضي العربي المشرق، وإلى الماضي الإسباني والحاضر كليهما أيضاً، خصوصا تجربة اجتياح الإسبان لأميركا واستعمارِها، مثلما هي رحلة في الزمن إلى المُسْتَقْبَل نحو ما يَرغبُ فيه صاحبُها من نمو ونهضة لمجتمعه العربي، ويقترح فيها على مجتمعه العربي الأصلي الاسترشادَ بالتجربة العربية الرّائدة التي كانت الأندلس فضاءَها، فهي رحلةٌ تروم تنبيهَ العرب المستعمَرين والمتخلِّفين إلى الاهتداء بالزمن الأندلسي العربي الذهبي، وبتطوُّره الطبيعي والإيجابي في التراب الإسباني، حيث أفلح في تحقيق ازدهار حضاري كبير لإسبانيا.
و"نور الأندلس" تؤكِّدُ على إمكان النهضة العربية، وتعتمد على المثال الإسباني تحديداً، لأن إسبانيا بعد نهضتها، التي أعقبت طردَ العنصر العربي، دخلتْ في تدهور في كل المجالات، لكنها نهضتْ مجدَّداً وذلك هو الدرس الذي تُقدِّمه هذه الرحلةُ، وتضرب عليه أمثلة.
في الواقع، "نور الأندلس" رحلةٌ إلى بلد بعينه هو إسبانيا، ولم تقتصر على إقليم أندلوسيا أو الأندلس تجاوزاً مثلما يُشير العنوان، فالريحاني بلغ طليطلة وبورغوس ومدريد وغيرَها في الشمال، بمعنى أنه غادر الجغرافية الأندلسية.
لكنّ الأهمَّ في رحلة الريحاني هذه هو أن عنوان الفصل الأخير منها هو نور الأندلس، وهو فصلٌ تخييليٌّ لا يلتزم بميثاق الرحلة، التي يُفترضُ فيها أن تحكي الواقعيّ، ذلك أن المؤلِّف سَرَد فيه قصةً هي حُلُمٌ تَمَثَّل لِقاءً ليليّاً في قرطبة بالفيلسوف أبي الوليد ابن رشد، لكنّه حُلُمٌ يَنْضَحُ رَغبةً في النهوض بالعرب، واستدعاءٌ للزمن الرُّشديِّ ليحُلَّ في حاضرِنا، وهو ما يُذكِّرُنا كثيرا بالدعوة التي قادَها المفكّر المغربي محمد عابد الجابري، أواخرَ الثمانينيات من القرن الماضي، بضرورة استعادة اللحظة الرشدية لتحديث المجتمع العربي، وتحقيق نهضته، وهو ما نلمسه في محاورة الريحاني لابن رشد الذي قدَّم أجوبة يُفسِّر بها سبب تأخُّر العرب والسبيل إلى التقدّم:
"- فكَّرْتَ يا ريحانيّ وسألْتَ، فجئتُ أجلو فِكرَكَ وأُجيبُ سؤالَكَ.
- غمرتَني والله بفضلك.
- الفضل لذويه أرباب الفكر والرؤيا، ولسْتُ اليومَ منهم.(قال ذلك وهو يهز رأسه كمن تؤلمه الذكرى.)
- ولكنّ زيتك يا سيدي لم يزلْ يشتعل في مصابيحهم.
- نعم، في مصابيح الفرنجة لا العرب، والسبب في ذلك أنْ قد امتزج بزيتنا كثيرٌ من الماء، ولم يُحسِن العربُ تصفيتَه مثل الفرنجة...".