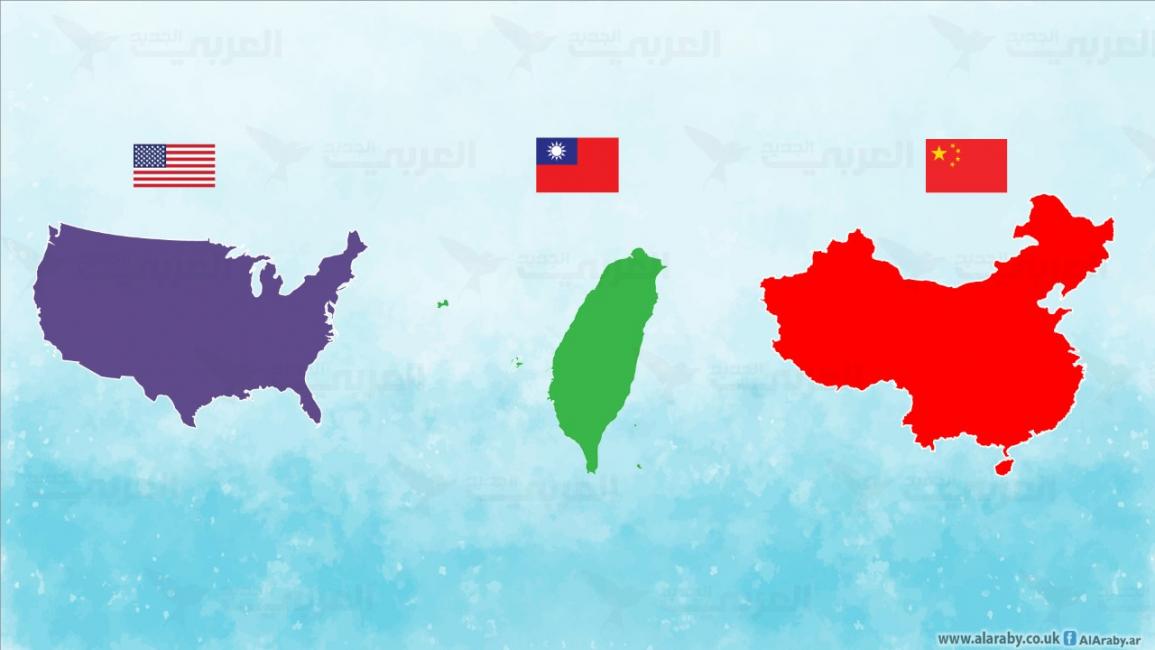أزمة تايوان .. المواجهة ليست حتمية أو وشيكة
في ستينيات القرن الماضي وحتى أواسط سبعينياته، كانت العلاقات بين الأردن والصين الوطنية ناشطةً على جميع المستويات، وزيارات الوفود الرسمية بين عمّان وتايبه لا تتوقف، والمعلقون الرسميون في الإذاعة الأردنية يواظبون على الإشادة بمستوى العلاقات بين البلدين. ذلك هو بعض ما يستذكره كاتب هذه الكلمات عن تايوان التي كانت تسمّى فرموزا، إضافة إلى مسمّى الصين الوطنية. وقد كانت العلاقات بين البلدين آنذاك جزءا من معادلات الحرب الباردة وتقسيم العالم إلى قطبين: أميركي وغربي من جهة، وسوفييتي وصيني من جهة ثانية، وكان الأردن يتموضع في القطب الغربي. في العام 1971، ونتيجة التقارب الأميركي (وتالياً الغربي) مع الصين، تمتعت الصين الشعبية بمقعد الصين في الأمم المتحدة، وهو ما أدّى إلى خروج الصين الوطنية من المنظمة الدولية، علما أن الصين الوطنية كانت عضوا مؤسّسا في الأمم المتحدة، وتحتل مقعداً دائماً في مجلس الأمن، إلى جانب الأربعة الكبار. وقد تطلّب الأمر بين عمّان وبكين (بيجين) انتظار ست سنوات أخرى لإقامة علاقاتٍ دبلوماسية بينهما، ما زالت تنشط على الدوام. أما العلاقات الدبلوماسية مع الصين الأخرى، أو الصغيرة، فقد توقفت، من غير أن تتوقف المبادلات التجارية بينهما، وإذ تبلغ هذه المبادلات أقلّ من نصف مليار دولار، فإنها لا تقارَن بحجم المبادلات مع الصين التي تزيد عن أربعة مليارات دولار. والعلاقات بين الأردن والصين وثيقة في سائر المجالات، وللأردن، كما لنسبة كبيرة من الدول، موقع على طريق الحرير الصيني البرّي، إضافة إلى طريق حرير بحري. وثمّة اتفاقية توأمة تجمع بكين بعمّان، واتفاقية أخرى بين تشنغتشو الصينية ومدينة إربد الأردنية. .. وحال الأردن الذي يمنح لتايوان ممثلية شبه دبلوماسية كحال بقية الدول العربية التي لم تعد ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع تايوان، لكنها تقيم درجات متفاوتة من التبادلات التجارية والعلمية، ومجالات أخرى غير سياسية أو عسكرية.
واشنطن ماضيةٌ في الدعم العسكري لتايوان، وبعبور سفنها مضيق تايوان، إضافة إلى سفن بريطانية
تتداعى هذه المعطيات إلى الخاطر، مع الأنباء المتواترة منذ أسابيع عن زيادة حدّة التوتر بين الصين وتايوان من جهة، وكذلك بين الصين والولايات المتحدة من جهة ثانية، إلى درجةٍ أبدى فيها الرئيس الأميركي جو بايدن استعداد بلاده للتدخل عسكريا إلى جانب تايوان في حال تعرّضت لهجومٍ صيني، وهو أقوى تصريحٍ من نوعه يصدُر عن واشنطن التي تقلّص وجودها العسكري، وكذا تدخلاتها العسكرية في مناطق شتى من العالم، لكنها تضع الصين في مقدّمة مصادر التهديد الاستراتيجي في العالم للولايات المتحدة، وهو ما حمل معلقين على التساؤل عما إذا كانت أزمة تايوان سوف تقود إلى حربٍ عالميةٍ ثالثة، أو إلى مواجهة عسكرية كارثية بين واشنطن وبكين. وفيما لجأت الأخيرة إلى اختراق الأجواء التايوانية (منطقة الدفاع الجوي) بقاذفات متطوّرة، مرّة تلو مرّة، في الأشهر الماضية، مع إطلاق تحذيرات للإدارة الأميركية بعدم تجاوز الخطوط الحمراء والكفّ عن اللعب بالنار، فإن واشنطن ماضيةٌ في الدعم العسكري لتايوان، وبعبور سفنها مضيق تايوان، إضافة إلى سفن بريطانية. ويتولى الكونغرس دعم توجهات الإدارة الديمقراطية بالتقدّم بمشاريع، مثل مشروع قانون أطلق عليه اسم "قانون التنافس الاستراتيجي لعام 2021"، بهدف السماح للولايات المتحدة بمواجهة "التحدّيات" التي تشكّلها الصين، كما مرّر الكونغرس أخيرا "مبادرة الردع في المحيط الهادئ"، والتي تم تمويلها بـ2.2 مليار دولار لعام 2021 لمواجهة قوة الصين العسكرية المتنامية، والحفاظ على الهيمنة العسكرية الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وترى واشنطن أن السيطرة على تايوان سوف تهدّد الأمن في هذه المنطقة، وتمثّل ضغطا خطيرا على دول، مثل اليابان وكوريا الجنوبية. أما في الصين فتقوم الأدبيات المتداولة على أن تايوان مقاطعة انفصالية، وأنها جزءٌ تم سلخُه من الصين (عام 1949)، وأنه لا بد لاعتباراتٍ قوميةٍ من إعادة الجزء إلى الكل، بمختلف الوسائل، بما في ذلك العسكرية منها، مع تفضيل الوسائل السلمية. وبينما تركن بكين إلى أن هناك إجماعاً داخلياً في دولة المليار و400 مليون شخص بشأن تايوان، فإن التايوانيين بدورهم يحبّذون المضي في استقلال كيانهم. وقد اختاروا في انتخاباتٍ تمّت ضمن المعايير الغربية تشين شوي رئيسة لبلادهم في العام 2016، وهي المعروفة بنزعتها الاستقلالية، وقد عيّنت، أخيرا، جنرالا سابقا وزيرا للدفاع (تشيو كو تشينغ)، ويُعرف عنه أنه خرّيج كلية الحرب الأميركية، ومن أشد المتحمسين لاستقلال تايوان.
استثمارات صينية في تايوان، تقابلها استثمارات تايوانية في الصين، بل هناك نحو مليون تايواني يقيمون على الأراضي الصينية
ومع هذه الدلائل على زيادة المخاطر، من الواضح أن بكّين قد فوجئت، بعض الشيء، بالنزعة العسكرية للرئيس بايدن، إذ إن اختبارات القوة التي أجرتها بدأت قبل اكتمال السنة الأولى لولاية الرئيس الديمقراطي. ولئن كان من الصحيح أن البنتاغون يساهم في وضع السياسات الاستراتيجية، إلا أن توتّراً كهذا لم يقع مثلا في عهد دونالد ترامب، وقد كان هناك نوع من الرهان الصيني على حمائمية بايدن. والواضح أن بكين سوف تواصل سياسة الضغوط والتلويح بالقوة، غير أن احتمالات المواجهة لا تبدو حتمية أو مرجّحة في الأمد المنظور، فأي مواجهة مع تايوان باتت تعني مواجهة مع الدولة العظمى، وسوف يجري، إذا وقع المحذور، تنافس شديد ومدمّر على استعراض الأسلحة الأشد فتكا بين الجانبين، في مواجهةٍ يتضرّر منها الداخل الصيني أكثر من الداخل الأميركي البعيد وراء المحيطات (قد يتعرّض هذا لمستوى من المخاطر إذا توسعت المواجهة وتم استخدام صواريخ عابرة للقارّات). ومن شأن مواجهةٍ كهذه أن تُضعف التوسع الاقتصادي الصيني في الداخل وفي العالم، وهو الرهان الاستراتيجي للقيادة الصينية لتعزيز مناطق النفوذ، بدءا بالاقتصاد واختراق أسواق العالم، وربط الدول الأقل نموا بالصين اقتصاديا، إلى درجة الاعتمادية بما في ذلك المرافئ والحدود. ويظلّ نموذج هونغ كونغ ماثلا في الأذهان، فقد انتظرت بكين طويلا عودة المقاطعة إليها من بريطانيا، وانتظرت كذلك عقودا للسيطرة على مفاصل الحياة الحساسة في هذه المقاطعة.
وضع تايوان مختلف، فهذا الجزء يرمي إلى تكريس "الانفصال"، وليست هناك من تعاقدات أو التزامات مع أطراف دولية تتيح استعادة هذا الجزء. ومع ذلك، لطالما انتهجت الصين سياسة الاحتواء الثابت والمتدرّج، فثمة استثمارات صينية في تايوان، تقابلها استثمارات تايوانية في الصين، بل هناك نحو مليون تايواني يقيمون على الأراضي الصينية، كما أن بكين انتظرت مضي أكثر من عقدين، قبل أن تنتزع مقعد الصين في الأمم المتحدة من تايوان، وقبل أن تنهمك بكين في خطط النهوض الاقتصادي، وتطوير أسلحة جيشها ومعدّاته. هذا من دون أن تتراجع مخاوف سكان تايوان من غزو شامل لبلدهم ذي الـ23 مليون نسمة، بل إنهم يحدّدون العام 2025 موعدا أقصى مفترضاً للاستهداف الصيني، وربما مع محطة انتخاب رئيس أميركي جديد، وما يبدو حينها من "فراغ" في موقع الرئاسة الأميركية.