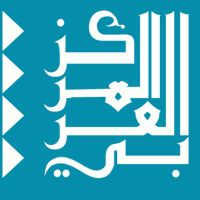عملية "ردع العدوان" وانهيار قوات النظام السوري ... الأسباب والتداعيات
مقاتلون من المعارضة السورية قرب بلدة أعزاز في محافظة حلب (1/12/2024 فرانس برس)
أطلق تحالفٌ من فصائل المعارضة السورية، ضمّ هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا)، وفصائل من الجيش الوطني الذي تدعمه تركيا، يوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، عمليةً عسكريةً كبيرةً تحت اسم "ردع العدوان"، ردًاً على استمرار قوات النظام وحلفائها في قصف مناطق سيطرة المعارضة في أرياف إدلب خصوصاً، وفي محاولة لاستعادة مناطق خفض التصعيد التي سيطرت عليها قوات النظام السوري في خرق لاتفاقيات أستانا. لكن الانهيارات السريعة، في صفوف قوات النظام في ريف حلب الغربي، أغرت فصائل المعارضة بتوسيع نطاق عمليتها لتنتهي بالسيطرة على مدنية حلب، باستثناء الأحياء الكردية (الشيخ مقصود والأشرفية) وكامل محافظة إدلب، والوصول إلى مشارف مدينة حماة منتزعة قطاعاً من الأرض مساحته نحو 7400 كيلومتر مربع خلال أربعة أيام.
التحضير للعملية وأهدافها
بدأت قوات المعارضة، منذ نهاية صيف 2024، التحضير لعملية عسكرية، كان يُقدّر لها أن تقتصر على استعادة المناطق التي سيطر عليها النظام في منطقة خفض التصعيد الأخيرة في إدلب، والتي جرى الاتفاق عليها بعد إنشاء مسار أستانا بين روسيا وتركيا مطلع عام 2017. وكان النظام وحلفاؤه خرقوا اتفاق أستانا الخاص بإدلب، وشنّوا هجوماً كبيراً أواخر عام 2019 ومطلع عام 2020، تمكّنوا خلاله من انتزاع أجزاء كبيرة من منطقة خفض التصعيد، شملت السيطرة على مدن خان شيخون ومعرّة النعمان وسراقب، وانتهت بالتوصل إلى اتفاق 5 آذار/ مارس 2020، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، ورسم خطوط التماسّ بين الطرفين مذاك. وخُطِّط للعملية، على أساس الاستفادة من الظروف الإقليمية والدولية التي أضعفت النظام وحلفاءه نتيجة حرب أوكرانيا، والمواجهة بين حزب الله وإسرائيل في لبنان وإضعاف إيران ومليشياتها في سورية، بفعل تصاعد الاستهداف الإسرائيلي لها بعد عملية طوفان الأقصى. ولم يكن من باب المصادفة أن العملية بدأت في الوقت نفسه الذي دخل فيه حزب الله وإسرائيل في اتفاق على وقف إطلاق النار، والذي أنهى نحو 14 شهراً من المواجهات بينهما.
وتشير مشاركة فصائل من الجيش الوطني القريب من أنقرة إلى دعم تركي للعملية، وإن كان غير معلن. وإذا كان هدف فصائل المعارضة هو إبعاد قوات النظام، ووقف القصف على مناطق سيطرتها، فقد سعت تركيا أيضًا للاستفادة من ضعف خصومها في سورية (روسيا وإيران) وانشغال الولايات المتحدة الأميركية بعملية انتقال السلطة من جو بايدن إلى دونالد ترامب، لتغيير موازين القوى على الأرض لتحقيق جملة أهداف، منها تعزيز مواقعها التفاوضية. وذلك في وقت تحاول فيه جر النظام السوري إلى طاولة المفاوضات للتفاهم على جملة من القضايا الأمنية والسياسية، أهمها عودة اللاجئين وإضعاف وحدات حماية الشعب الكردية (الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني)، وإجهاض أي محاولة لإقامة حكم ذاتي للأكراد في شمال سورية، والتفاهم على مصير مناطق شرق الفرات في حالة انسحاب أميركي منها في مرحلة حكم ترامب الثانية.
الانهيارات السريعة، في صفوف قوات النظام في ريف حلب الغربي، أغرت فصائل المعارضة بتوسيع نطاق عمليتها
وقد حاولت تركيا، على مدى العامين الماضيين بلا جدوى، الدخول في مفاوضات مع النظام، لحل مشكلة اللاجئين الذين يُقدّر عددهم بأكثر من ثلاثة ملايين سوري على أراضيها، وأخذت تتحوّل إلى أزمة سياسية واجتماعية في الداخل التركي، فضلًا عن رغبتها في الوصول إلى تفاهمات مع النظام السوري بخصوص المشكلة الكردية قبل وصول ترامب إلى البيت الأبيض ووجود احتمال بسحب قواته من سورية. لكن النظام داوم على رفض هذه الدعوات، بدعم إيراني، مشترطًا التزاماً تركيّاً مسبقاً بالانسحاب من الأراضي السورية قبل الدخول في أي مفاوضات.
توقيت العملية والانهيار
بحسب مصادر متعددة، كان مقرّراً أن تبدأ العملية في نهاية صيف 2024، للاستفادة من حال الضعف الشديد التي ألمَّت بقوات النظام وحلفائه. وكان التحالف الذي نشأ حول النظام في الفترة 2015-2020 وشمل قوات روسية نظامية وغير نظامية (جماعة فاغنر تحديداً)، إضافة إلى تشكيلات من الحرس الثوري الإيراني، ومجموعة من المليشيات الشيعية (العراقية، والأفغانية، والباكستانية)، فضلًا عن وحدات من حزب الله، قد ساعد في تغيير موازين القوى على الأرض بشدة لصالح النظام السوري، وفي استعادة أجزاء واسعة من الجغرافيا السورية، بما فيها الأحياء الشرقية من حلب التي كانت تحت سيطرة المعارضة حتى كانون الأول/ ديسمبر 2016. لكن ضعفَ هذا التحالف بسبب مجموعة من المتغيرات الإقليمية والدولية، بدءًا بالغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير 2022؛ فقد دفع التورط الروسي في تلك الحرب موسكو إلى سحب جزء كبير من قواتها من سورية، خاصة سلاح الجو الذي أدى دورًا حاسمًا في إخراج المعارضة من أرياف دمشق ودرعا والقنيطرة وحمص وحماة وحلب وإدلب ودير الزور. ويُقدر عدد الطائرات التي تملكها روسيا حاليّاً في قاعدة حميميم بنحو 5-7 طائرات فقط؛ ما يفسّر رد الفعل الروسي الضعيف تجاه التقدم السريع الذي حققته فصائل المعارضة والانهيار السريع لقوات النظام نتيجة غياب الغطاء الجوي الروسي. وغابت عن الساحة أيضًا جماعة فاغنر التي أُعيدت هيكلتها بقرار من بوتين، بعد التمرد الذي قاده زعيمها يفغيني بريغوجين في حزيران/ يونيو 2023. وقد حدد بوتين وجودها في أفريقيا تحت اسم "فيلق أفريقيا" الروسي.
علاوة على ذلك، دفعت المواجهة بين حزب الله وإسرائيل، على خلفية فتح جبهة إسناد غزّة من لبنان بعد عملية طوفان الأقصى، إلى سحب الحزب كثيرين من عناصره الذين كانوا منتشرين في أرياف حلب وإدلب في اتجاه لبنان أو الجنوب السوري قرب الجولان، أو أعاد نشرهم في القلمون على امتداد الحدود السورية - اللبنانية. وقد أدّت الضربات القوية التي تلقّاها الحزب في لبنان إلى تصفية القسم الأعظم من قيادات الصف الأول السياسية والعسكرية، كما جرى تدمير قسم كبير من قدراته العسكرية. ونتيجة لذلك، لم يعد مقاتلو الحزب مقتنعين بوجودهم في مواقعهم في سورية، في وقت كانت قراهم ومناطقهم تستبيحها إسرائيل في مناطق مختلفة من لبنان. أحدث ذلك كله فراغاً كبيراً، لم يستطع النظام أن يملأه. فعلى امتداد العقد الماضي، مثّل حزب الله، مدعوماً بالغطاء الجوي الروسي، العمود الفقري والقوة الضاربة لمعسكر حلفاء النظام.
على امتداد العقد الماضي، مثّل حزب الله، مدعوماً بالغطاء الجوي الروسي، العمود الفقري والقوة الضاربة لمعسكر حلفاء النظام
ولم تقتصر حالة الضعف على روسيا وحزب الله، بل شملت الوجود العسكري الإيراني والمليشيات المرتبطة به. فقد استهدفت الضربات التي وجهتها إسرائيل إلى سورية، منذ عملية طوفان الأقصى، وفاق عددها 155 ضربة، منذ بداية عام 2024 (86 ضربة خلال تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر فقط)، إضافة إلى مواقع لحزب الله، قواعد للحرس الثوري الإيراني والميليشيات الشيعية المتحالفة معه. وكان آخر هذه الهجمات وأعنفها الغارة التي شنتها إسرائيل على تدمر، في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، على تجمعات لميليشيات عراقية، وأسفرت عن نحو 100 قتيل.
أدت نحو 14 عاماً من الصراع إلى حال إنهاكٍ مطلقة بين قوات النظام، شملت موارده البشرية التي تناقصت كثيرًا بسبب الخسائر والانشقاقات. وتفاقمت أزمة الموارد البشرية في السنة الأخيرة، بعد قيام النظام لأسباب اقتصادية واجتماعية متعددة، بتسريح مجموعات كبيرة من عناصره وضباطه الذين احتفظ بهم لسنوات طويلة في الخدمة. وقد انعكست الظروف الاقتصادية الصعبة التي واجهها، بسبب الحرب والعقوبات الاقتصادية، وتفاقمت مؤخرًا بسبب حرب لبنان والعقوبات الاقتصادية التي سُلِّطت على الحلفاء (إيران، وروسيا)، على وضع عناصر جيش النظام. وحينما أطلقت المعارضة عملية "ردع العدوان"، وجدت في مواجهتها جيشًا مهترئًا تمامًا فاقدًا لإرادة القتال، معنوياته منهارة، خاصة مع غياب الحلفاء على الأرض وسلاح الجو الروسي في السماء؛ فحصل الانهيار سريعًا.
تحسّن أداء المعارضة كثيراً خلال السنوات الماضية، فاكتسبت خبرات واسعة في القتال، وصارت أفضل تنظيمًا وأكثر انضباطاً
في المقابل، تحسّن أداء المعارضة كثيراً خلال السنوات الماضية، فاكتسبت خبرات واسعة في القتال، وصارت أفضل تنظيمًا وأكثر انضباطاً، خاصة جبهة تحرير الشام التي أنشأت أقرب ما يكون إلى الجيش النظامي، وباتت تتمتع بنظام قيادة وسيطرة مركزي. وبهذا، أضحت المعارضة أفضل تجهيزاً وتسليحًاً نتيجة التصنيع المحلي أو اغتنام أسلحة من مواقع النظام وحلفائه أو نتيجة الحصول عليها من أطراف خارجية. وقد أدّت الطائرات المسيرة، التي صارت المعارضة تبرع في استخدامها، دوراً مهمّاً في اقتحام عديد من جبهات النظام. وأدّى أيضاً التنسيق الناجح بين مختلف فصائل المعارضة دوراً مهمّاً في تحقيق نتائج كبيرة على الأرض.
وبذلك، وفي حين كانت أوضاع حلفاء النظام تسوء بسبب الظروف الإقليمية والدولية (الحرب في أوكرانيا، والمواجهة مع إسرائيل)، كانت مواقف تركيا تتعزّز. وفي وقت كانت قوات النظام وحلفائه في تراجع، كانت قوات المعارضة تزداد قوة وخبرة.
انعكاس التطورات الميدانية على المسار السياسي
منذ تمكّن النظام من استعادة أجزاء واسعة من مدينة حلب بدعم روسي - إيراني أواخر عام 2016، ثم استعادة السيطرة على مساحات واسعة من البلاد عام 2018، خاصة في محيط دمشق وجنوب البلاد ووسطها (مناطق خفض التصعيد الثلاث) وانتهاءً بقضم أجزاء واسعة من منطقة خفض التصعيد الأخيرة في إدلب عامَي 2019 و2020، بات يتصرف بعقلية المنتصر، مع أنه لم يكن كذلك، رافضًا تقديم أيّ تنازلات أو حتى الانخراط في أي مسعىً سياسيٍّ جدّي لحل الأزمة، سواء من خلال مسار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة، أو مسار أستانا ومقترح اللجنة الدستورية التي أوجدتها روسيا بديلاً من مسار جنيف الذي ينصّ على انتقال سياسي.
وقد ازدادت ثقة النظام بنفسه واعتقاده عدم الحاجة إلى تقديم تنازلات، بعد أن بدأ الانفتاح العربي عليه أواخر عام 2018، من جانب الإمارات والبحرين أولاً، ثم من خلال مبادرة "خطوة مقابل خطوة" التي طرحها الأردن عام 2021 وبلغت ذروتها بتطبيع السعودية العلاقات مع النظام وإعادته إلى جامعة الدول العربية ودعوته لحضور القمّة العربية في الرياض في أيار/ مايو 2023، منهيةً بذلك 12 عاماً من عزلته عربيًا. دفع ذلك كله النظام إلى الاعتقاد أن في إمكانه استعادة عضويته وشرعيته في مجتمع الدول، والحصول على مساعدات اقتصادية لإعادة الإعمار، من دون الحاجة إلى تقديم أي تنازلات، لا للدول العربية ولا للمعارضة السياسية.
تشير مشاركة فصائل من الجيش الوطني القريب من أنقرة إلى دعم تركي للعملية، وإن كان غير معلن
غيّرت التطورات الميدانية الأخيرة كل هذه المعطيات، وبدّدت أوهام النصر التي عاشها النظام وحلفاؤه خلال السنوات الماضية؛ إذ تشكل سيطرة فصائل المعارضة على مدينة حلب الاستراتيجية وكامل محافظة إدلب وأجزاء من محافظة حماة تحولاً كبيراً في موازين القوى على الأرض. ويعني ذلك أيضاً أن المعارضة باتت تسيطر على كامل الشمال السوري، بما فيه عاصمته حلب التي يقطنها نحو خمس السكان، وباتت بذلك الكتلة البشرية في مناطق المعارضة تساوي تقريبًا تلك التي تقع تحت سيطرة النظام. علاوة على ذلك ستمثل حلب، بثقلها الاقتصادي والصناعي والبشري والسياسي، نقطة ارتكاز مهمة لفصائل المعارضة السورية، وسوف يعزّز مواقعها في أي مفاوضات محتملة؛ إذ يسود اعتقاد على نطاق واسع أن التطورات الأخيرة قد تشكل فرصة مهمة لبدء مسار تفاوضي جدي، يأمل كثيرون أن يؤدّي إلى إنهاء الصراع السوري المستمر منذ 14 عاماً.
المواقف العربية والدولية
منذ عام 2012، تحوّلت الثورة السورية إلى حرب وكالة إقليمية ودولية، لذلك تعد مواقف الدول المنخرطة في الصراع مؤشراً مهمّاً دالّا على اتجاهاته خلال المرحلة المقبلة. وكما العادة، تفاوتت المواقف العربية والدولية من التطورات الميدانية الأخيرة في سورية، فحينما حاولت تركيا أن تنأى بنفسها عن العملية العسكرية تفادياً للضغوط الإقليمية والدولية المحتمل ممارستها عليها، خاصة من "شركائها" في مسار أستانا (روسيا وإيران) وحلفائها كذلك (خصوصًا الولايات المتحدة)، وضعت أنقرة العملية في إطار رد الفعل على انتهاكات النظام اتفاق خفض التصعيد، معتبرة أن العمليات العسكرية الأخيرة تُعدّ تطوّراً غير مرغوب فيه، ناتجاً من انتهاك النظام لالتزاماته بموجب اتفاق أستانا. في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، هجوم المعارضة "خطة أميركية صهيونية بعد هزيمة النظام الصهيوني في لبنان وفلسطين"، مُعلنًا عن نيته زيارة دمشق وأنقرة، حيث حمل رسالة لرئيس النظام السوري بشار الأسد يؤكد فيها "الدعم الحازم للجيش والحكومة في سورية". وبحث عراقجي، هاتفيّاً، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، تطورات الأوضاع في سورية، إضافة إلى ملفّات إقليمية ودولية. وذكر بيان للخارجية الإيرانية أنّ الطرفين شدّدا خلال المباحثات على "ضرورة التنسيق بشأن سورية قدر الإمكان".
أما الولايات المتحدة، فقد نفت أي علاقة لها بالهجوم، مع العلم أن هيئة تحرير الشام مصنّفة منظمّة إرهابية لدى واشنطن، ودعت في بيان إلى "خفض التصعيد وحماية المدنيين والأقليات، مع التأكيد على ضرورة إطلاق عملية سياسية جدية وقابلة للتطبيق لإنهاء الحرب الأهلية". وأفاددت بأن رفض النظام السوري المستمر الانخراط في العملية السياسية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2254، واعتماده على دعم روسيا وإيران، هو ما أدّى إلى الانهيارات الحاصلة في خطوط النظام شمال غرب سورية. وأكّدت التزام الولايات المتحدة بـ "الدفاع الكامل عن أفرادها ومواقعها العسكرية في سورية، لضمان عدم عودة تنظيم داعش مجددًا".
قدرات النظام العسكرية متهالكة، وحلفاؤه غير قادرين على تقديم مساعدةٍ ذات معنى
أما مصر، فقد أكدت، على لسان وزير خارجيتها بدر عبد العاطي، موقفها "الداعم للدولة السورية ومؤسّساتها الوطنية وأهمية دورها في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة واستقرارها واستقلال ووحدة أراضيها". وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري مع وزير الخارجية السوري تناول التطورات الأخيرة في شمال سورية خاصة في إدلب وحلب. وجاء الموقف الأردني قريبًا من الموقف المصري، حيث أكد الملك عبد الله الثاني وقوفه إلى جانب سورية ووحدة أراضيها واستقراراها، وذلك في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، وفق بيان رسمي صادر عن الديوان الملكي الأردني.
وسارع رئيس النظام السوري، فور ورود أنباء عن سقوط حلب ومناطق أخرى في الشمال، إلى إجراء اتصالات بهدف حشد الدعم، وكان أول اتصال له مع رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، تعهد خلاله بالاستمرار في الدفاع عن استقرار سورية "ووحدة أراضيها في وجه كل الإرهابيين وداعميهم". وأضاف أن سورية "قادرة بمساعدة حلفائها وأصدقائها على دحرهم والقضاء عليهم مهما اشتدت هجماتهم"، على حد وصفه. وبحث الأسد في اتصال مماثل التطورات في سورية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي أكد، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن "أمن سورية واستقرارها يرتبطان بالأمن القومي للعراق، ويؤثران في الأمن الإقليمي عمومًا، ومساعي ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط". وتزامن ذلك مع إعلان فصيلين مسلحين في العراق، مدعوميْن من طهران، أنهما يستعدّان للتوجه إلى سورية للقتال إلى جانب قوات النظام.
خاتمة
على الرغم من تعهد النظام باستعادة السيطرة على المناطق التي خسرها أخيراً وهزيمة المعارضة، فإن ذلك لا يبدو محتملاً، أخذاً في الاعتبار الظروف التي يجد النظام وحلفاؤه أنفسهم فيها؛ فقدرات النظام العسكرية متهالكة، وحلفاؤه غير قادرين على تقديم مساعدةٍ ذات معنى هذه المرّة خلاف ما كان عليه الحال عام 2016 حينما تمكنوا من استعادة حلب. ولا يبدو أن الأمور سوف تتحسن كثيرًا بالنسبة إلى النظام وحلفائه مع مجيء إدارة ترامب التي تتّخذ مواقف متشدّدة من إيران. ومع أن النظام متمسّك بمواقفه الرافضة أي تسوية، فإن هناك احتمالاً أن تفتح التطورات الميدانية الأخيرة مساراً سياسيّاً أكثر جدية، إذا صار أكثر واقعية وتخلى عن أوهام الانتصار.