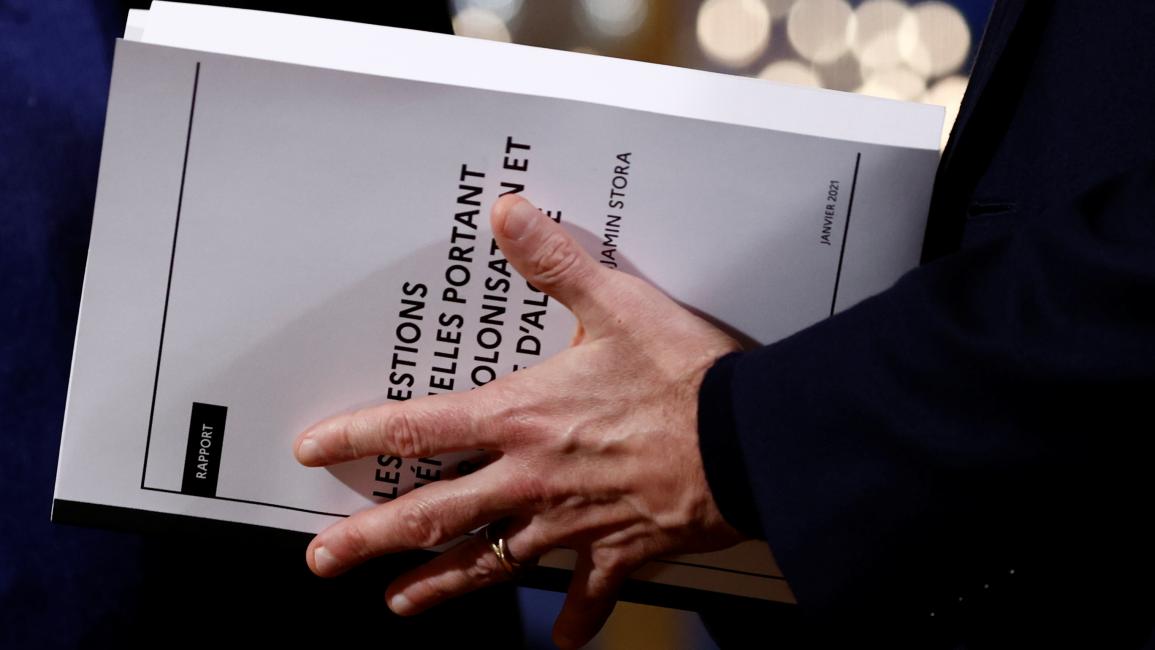لماذا لا تعتذر فرنسا للجزائر
تقرير المؤرخ ستورا عن الاستعمار الفرنسي في الجزائر بين يدي ماكرون (22/1/2021/فرانس برس)
أعلنت فرنسا عن خطوة جريئة وغير مسبوقة قبل نحو عامين، تتمثل في إعلان الرابع والعشرين من إبريل/ نيسان يوما وطنيا سنويا يخلد ذكرى المذابح التي قام بها الأتراك خلال الحقبة العثمانية ضد الأرمن. لا يشوب هذا الإعلان سوى شائبة واحدة، تتمثل في الطرف المعلن؛ فرنسا؛ كونها صاحبة باع طويل في الاستعمار والإبادات، وخصوصا في أفريقيا، وتحديدا في الجزائر، فهذا الإعلان إهانة بحق الضحايا الأرمن، كونه يصدر عن دولةٍ تأبى الاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائمها بحق الشعوب الأخرى، ما يفقده جوهره الإنساني لصالح أبعاد سياسية مصلحية بحتة.
وهو ما أكدته فرنسا في موضع آخر، وبالتحديد في العشرين من يناير/ كانون الثاني 2021، حين أعلنت الرئاسة الفرنسية اعتزامها القيام بـ "خطوات رمزية" لمعالجة ملف استعمار الجزائر، من دون أن تتضمن هذه الخطوات "أي ندم أو اعتذارات". حيث استند الإليزيه، في إعلانه، إلى تقرير موسع، أعده المؤرخ الفرنسي، بنيامين ستورا، عن فترة الاستعمار الفرنسي في الجزائر، والذي تزامن مع استعداد الرئيس ماكرون لحملته الانتخابية الثانية، الأمر الذي استغله الأخير مدّعيا أن رفضه الاعتذار عن الإبادة في الجزائر مبني على أسس علمية فقط، بلا أي أبعادٍ ديماغوجيةٍ تسعى إلى كسب أصوات اليمين الفرنسي. ما يعيدنا إلى فترة الاستعمار الأوروبي من القرن المنصرم، حين حاول الأوروبيون تبرير ممارساتهم العنصرية وحملات الإبادة التي ارتكبوها بحق الشعوب المستعمرة "الملونة"، بعلوم اصطنعوها لهذا الغرض تحديداً، كاعتماد "العنصرية العلمية" على توظيف الأنثروبولوجيا، وغيرها من التخصّصات الزائفة، في دعم نظرية تصنيف البشر إلى أجناس بشرية منفصلة جسديًا، بحيث تكون أجناس محدّدة أكثر رقيًا من أجناسٍ أخرى.
يطلق ماكرون حملته الانتخابية الثانية بالجوهر الاقتصادي النيوليبرالي نفسه الذي تبنّاه في حملته الأولى، بعد تضمينها خطابا شعبويا
غير أن التدقيق في الوضع الفرنسي الداخلي الحالي يظهر مدى نفور ناخبي الوسط واليسار وجمهورهما من ماكرون، نتيجة سياساته الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي عالجه بمحاولة استرضاء جمهور اليمين العنصري بشتى الطرق، ومنها رفض الاعتذار المشار إليه قبل، وزيادة العداء والتمييز ضد مسلمي فرنسا. لذا يطلق ماكرون حملته الانتخابية الثانية بالجوهر الاقتصادي النيوليبرالي نفسه الذي تبنّاه في حملته الأولى، بعد تضمينها خطابا شعبويا، على نقيض خطابه خلال حملته الانتخابية الأولى الذي تضمن بعض شعارات إنسانية وحضارية، كما في وصفه "الاستعمار الفرنسي بالجريمة ضد الإنسانية"، والذي اعتبره بعضهم مؤشرا لانفراج أزمة الذاكرة بين البلدين، إلا أن صلاحية تلك الشعارات لم تدم طويلا، لتنتهي بعد دخول ماكرون قصر الإليزيه.
لقد فرضت حرب التحرير الجزائرية على فرنسا الانسحاب، في حين نجحت الأخيرة في جرّ الجزائر إلى توقيع اتفاقية ايفان التي قبلها الجزائريون على أمل الخلاص من 132 عاما من الاستعمار. لكن لم تحترم فرنسا وزعيمها شارل ديغول الاتفاقية والتعهدات، من خلال نهب الخزينة الجزائرية، وتدمير معظم الآلات الزراعية بغرض فرض تبعية غذائية لهم، كما سحبوا الكادر التعليمي لإعاقة مسار نهضة الجزائر وإدامة تخلفها، وكذلك استمرّوا في تجاربهم النووية المشتركة مع الكيان الصهيوني حتى 1966 على الأرض والشعب الجزائريين. لكن وعلى الرغم من ذلك كله، نجح الجزائريون في مفاجأة العالم أجمع، وفرنسا خصوصاً مرة أخرى، بعد صدمتهم بحرب التحرير الجزائرية، عبر تغلّبهم على تحدّيات ما بعد الاستقلال بثورة زراعية حققت اكتفاء ذاتيا وفائضا إنتاجيا تم تصديره.
كما تلقى المستعمر السابق صفعة بعد تأميم شركات النفط الجزائرية عام 1971، ما سبّب طفرة اقتصادية سهلت على الجزائر البدء بتطوير الصناعات واستحداث صناعات جديدة. حيث لم تنتظر الجزائر في هذه الفترة أي اعتذار من المستعمر، ولم تفكر بشحن التعاطف الغربي، بل على العكس أدارت ظهرها لهم لتكون شبه قطيعةٍ معهم أفضل من انتظار الفتات منهم. إلا أن هذه الفترة لم تدم طويلا، بعد وصول الرئيس الشاذلي بن جديد إلى الحكم، الذي أعاد العلاقات مع الغرب، وخصوصا فرنسا، من خلال السماح لاستثماراتها بالعودة، وتحديدا في مجال الطاقة.
سحب حزب جبهة التحرير الوطني من البرلمان الجزائري مشروع قانون "تجريم الاستعمار الفرنسي"
لم يمنع الانفتاح الجزائري على فرنسا من استمرار الحكومات الجزائرية في مطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها، والاعتذار للشعب الجزائري تحت ضغط الشارع، فنحن أمام مطلب شعبي محق، تردّد صداه الجهات الرسمية الجزائرية. طبعا لا تثار أي شكوك في جدّية الشعب الجزائري بمطلبه هذا، إلا أن هنالك شكوكا محقّة عديدة حول مدى جدية الجهات الرسمية الجزائرية بهذا المطلب. ففي عام 2009، طالب الأمين العام للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني ووزير الدولة الجزائري، عبد العزيز بلخادم، فرنسا بالاعتذار والتعويض عن الجرائم الوحشية والإبادة الجماعية التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي بحق الشعب الجزائري خلال فترة الاستعمار. تصريح جانب ملامسة الحقيقة التاريخية كاملة، كونه تجاهل ذكر محاسبة فرنسا والكيان الصهيوني عن الحاضر والمستقبل أيضا، بسبب جريمتهما المشتركة ذات الآثار المستمرة حتى 4500 عام مقبلة على أقل تقدير (التجارب النووية). كما يمكن اعتباره تصريحا شعبويا، لا يرقى إلى مستوى جدّية الإرادة الشعبية، فالجدّية تفترض القيام بخطوات ضغط لا تفتقر الجزائر لأسبابها وآلياتها. لكن بدلا من الضغط، استمر النظام الجزائري زمن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في تقديم التسهيلات الاستثمارية التمييزية للفرنسيين، كدخول الشركات الفرنسية السوق الجزائرية من دون الحاجة إلى شراكة مع رؤوس أموال جزائرية، وهو ما يتعارض مع قانون الاستثمار الجزائري الذي يلزم الأجانب بإشراك طرف جزائري بحصة 51% في أي مشروعٍ يقام فوق التراب الجزائرية. وقبل حوالي شهر من تصريح الإليزيه الرافض الاعتذار عن الجرائم الفرنسية في الجزائر، سحب حزب جبهة التحرير الوطني من البرلمان الجزائري مشروع قانون "تجريم الاستعمار الفرنسي"، مؤكّدا عدم جدّية الجانب الرسمي الجزائري في الضغط على فرنسا، ومفجّرا مفاجأة من العيار الصغير، كونها المرة الثالثة التي يقرّر فيها الحزب صاحب الأغلبية النيابية، سحب مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، حيث سبق له فعلها في عامي 2010 و2016.
عدم اتخاذ السلطات الجزائرية أي خطوات صارمة بحق المستعمر السابق، كما فعلت في سبعينيات القرن المنصرم، يساعد الحكومة الفرنسية، ويسهل عليها التهرّب من الاعتراف بجرائمها بحق الأرض والشعب الجزائريَين. وبالتالي، يعزّز من موقفها الرافض تقديم الاعتذار، كما يقود التخاذل الرسمي الجزائري إلى ما هو أسوأ من ذلك، إذ يجعل فرنسا تتمادى أكثر، وتتغنى وتتمجد بماضيها الإجرامي، كما حصل في 23 فبراير/ شباط 2005، حين أقرّ البرلمان الفرنسي قانونا يمجّد الاستعمار الفرنسي في كل المستعمرات الفرنسية السابقة، ومن ضمنها الجزائر. فمن المعلوم اجتماعيا وسياسيا أن التراخي بتحصيل الحقوق وتمييع الإرادة الشعبية عن طريق خطاباتٍ شعبويةٍ لا طائل منها، سيفتح الأبواب أمام المستعمر وقوى الاستغلال العالمية مجدّدا، كي تنعم بخيرات الجزائر وثرواتها على حساب حرمان الجزائريين منها، تماما كما نعلم جيدا مدى صحة العبارة "ما ضاع حقٌّ وراءه مطالب"، كما خبرها الجزائريون جيدا في حرب التحرير الوطنية.