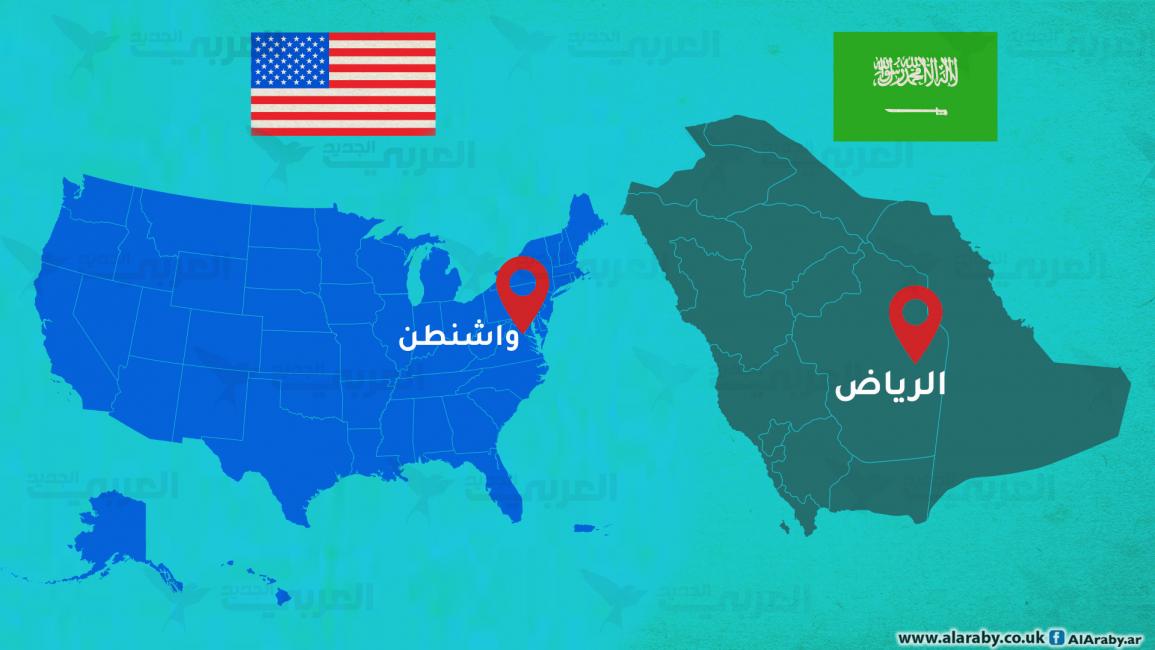ماذا تريد واشنطن من الرياض؟
كشفت صحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيعلن في زيارته الرياض، أواخر شهر يونيو/ حزيران الحالي، عن موافقة إسرائيل على اتفاقيات أمنية تترافق مع انتقال السلطة على جزيرتي تيران والصنافير من مصر إلى السعودية. .. وإذ لم يؤكد بايدن الزيارة، فالأهم في الترتيبات الجارية التي تتضمّن مفاوضات لعقد صفقة كاملة، تشمل موافقة الرياض على إجراءات تطبيع تدريجية مع إسرائيل، تبدأ بالسماح للطائرات الإسرائيلية بالتحليق فوق سماء المملكة.
لن تطالب واشنطن السعودية بالانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، على الأقل في المستقبل القريب، وإنما ستعتمد سياسة الخطوة خطوة، بالتفاهم الكامل مع إسرائيل، كما أعلن عن ذلك وزير خارجية الكيان الصهيوني، يئير لبيد. إذ إن السعودية، كونها راعية الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، لا تستطيع، في الوقت الحالي على الأقل، قبول تطبيع كلي قد يتضمن قبول السيطرة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، لكن تأنّي واشنطن متبوع بدوافع أخرى، أهمها الحصول على موافقة السعودية على تخفيض سعر النفط، الذي ارتفع إلى 120 دولارا للبرميل، جرّاء تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا. ولكن كل هذه الأهداف تحتاج مصالحة، نعم "مصالحة" بين الرئيس جو بايدن وولي العهد محمد بن سلمان، الذي يرفض أن يدعم الولايات المتحدة في محاولتها تقويض قوة روسيا الاقتصادية، متجاهلا، برأي مسؤولين ومحللين أميركيين، معادلة "الحماية الأميركية للسعودية والخليج مقابل النفط الرخيص"، أو أي خدمة أو أموال تريدها أميركا، كما فعل بنجاح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
إدخال الرياض في اتفاق مع إسرائيل يعني بالنسبة لواشنطن ضرب أي معارضة باقية للتطبيع مع إسرائيل، ومن ثم تصفية القضية الفلسطينية
هنا بيت القصيد، فواشنطن أرست، في عهد ترامب، قاعدة الدعم الكلي لمحمد بن سلمان مقابل كل ما تطلبه واشنطن من أموال، ضريبة ما تسمى "الحماية الأميركية". ولكن الوضع تغير في عهد بايدن، لذا، يريد بن سلمان اعترافا أميركيا صريحا بأنه القوة الرئيسة وراء والده الملك، وقوّة محرّكة في الخليج، وبل في المنطقة أيضا، ويرفض تهميش دوره، خصوصا وأن بايدن أصرّ، خلال حملته الانتخابية، على اعتبار الأمير السعودي "منبوذا"، يجب أن يعاقَب على دوره في جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وحتى بعد أن تراجع بايدن عن أقواله الانتخابية، لم يقتنع ولي العهد، ولذلك ما تزال مفاوضات "المصالحة" جارية سرا وعلانيةً. وهي ليست مفاوضات "مصالحة"، بمعنى تحقيق زيارة ناجحة للرئيس الأميركي إلى الرياض وصور أمام الكاميرات له مع ولي العهد السعودي، فما إن نصل إلى الصورة "الحدَث" التي ستنتشر على شاشات القنوات والحواسب والهواتف الخلوية، ستكون عدة تفاهمات قد جرت، وتهدف إلى دفع التطبيع مع إسرائيل، وخفض سعر نفط السعودية، أو زيادة الإنتاج، حتى وإن احتاج ذلك ترتيباتٍ مع "أوبك"، فحين أعلن المرشّح الرئاسي، جوزيف بايدن، عزمه تهميش ولي العهد، لم يكن يعرف أنه سيكون في أمسّ الحاجة إليه، لمساندة واشنطن في توفير النفط للسوق الأميركي بأسعار رخيصة ومحاصرة روسيا اقتصاديا.
نظريا؛ تستطيع واشنطن الضغط على الرياض، أو أي حليف، للمشاركة في معاقبة روسيا على غزو أوكرانيا، لكن هناك حدودا لسيطرتها، لم تتوقعها واشنطن، بعد أن تردّد كثيرون من حلفائها، ومنها إسرائيل، بمقاطعة النفط والغاز الروسيين، فالعالم بدأ بالتغير قبل التحدّي الروسي، فحين ردّ الرئيس الروسي على خطر توسيع قوات حلف الناتو، لتصل إلى حدود بلاده مع الجار الأوكراني، بالهجوم على أوكرانيا، لم ينفع تبجّح الغرب بحقوق الإنسان والقانون الدولي، ولم تؤخذ مطالب واشنطن بجدّية حتى من حلفائها، فالمصالح الاقتصادية هي التي تتحكّم بالمواقف، والاستثمارات الروسية والصينية في تمدّد، وأميركا فقدت جزءا من نفوذها وتأثيرها بوصفها القوة الأوحد في العالم. ويبدو أن ولي العهد السعودي يعي أنه يستطيع جعل بايدن يتعامل معه باعتباره القوة الرئيسة وراء أبيه الملك سلمان، إذا كان يريد دعما مقابلا. ولكن هذه، في الاستراتيجية الأميركية؛ تنازلات مقدورٌ عليها، فواضح أنها مستعدّة، أو فهمت أنها مجبرة، في الوقت الحالي، على تجاهل عدم انصياع دول حليفة لمطالبها بمقاطعة موسكو، لكنها لا تتخلّى عن أولويات الاستراتيجية الأميركية.
معروفٌ ماذا تريد أميركا من السعودية، لكن التفاصيل مهمة، منها أن إسرائيل تملك السيطرة الفعلية الأمنية على الممرّات المائية إلى جزيرتي تيران وصنافير
صحيحٌ أن الاتفاقيات الإبراهيمية تمثل، من وجهة نظر أميركية، منعطفا تاريخيا لتغيير خريطة المنطقة وترسيم حلف استراتيجي إسرائيلي عربي بقيادتها، لكن هذا الحلف والتطبيع لن يكونا كاملين بدون السعودية، فإدخال الرياض في اتفاق مع إسرائيل يعني بالنسبة لواشنطن ضرب أي معارضة باقية للتطبيع مع إسرائيل، ومن ثم تصفية القضية الفلسطينية. والمشكلة أن الدول العربية لا تعي الأهمية الاستراتيجية للتطبيع، وخطره على الأمن القومي العربي الذي اختفى من الخطاب العربي لغة ومفهوما، فهناك حالة خواء فكري عند أنظمةٍ كثيرة تعتقد أن قوتها تأتي من علاقاتها مع الدولة الصهيونية التي تخاف من الهوية العربية ليس في داخل فلسطين فحسب، وإنما في المحيط العربي أيضا، فالتطبيع هو محاولة للقضاء على "المحيط العربي"، وبالتالي تصبح كلها أنظمةً ذيليةً تأخذ الرضى بشكل مذلّ من عدوٍّ لا تفقه أنه عدو، وهذا ليس كلاما في الإنشاء، فشرعية الدولة الصهيونية ودمجها في المنطقة يعنيان إنهاء، ليس الهوية العربية فقط، وإنما الهويات القُطرية أيضا، فاختفاء الكل العربي، أي الهوية الجمعية العربية والترابط القومي، ينهي أهمية أي دولة وكل الدول العربية التي لا ترى أميركا فيها ليست إلا دولاً وظيفية، تجاملها أو تعاقبها كما تتطلب استراتيجيتها التي تريد أن تبقى إسرائيل هي الدولة التي لديها مقومات للبقاء، فحين قال المستشرق، برنارد لويس، إن هاك ثلاث دول في الشرق الأوسط لديها مقومات دول حقيقية، إسرائيل وتركيا وإيران، لم يكن الرجل الذي خدم الاستعمار طوال حياته، يتنبأ، وإنما كان يتحدث عن استراتيجية يجري تطبيقها.
لذا، نرى طاقم الخارجية الأميركية منهمكا في رحلات بين تل أبيب والرياض والقاهرة وواشنطن، فالقصة ليست مصالحة سعودية – أميركية، وإنما سحب السعودية والعالم العربي عميقا إلى هاوية التطبيع، فالتطبيع السرّي لم يعد له أهمية أو مكان، والخطوات الصغيرة، كما أعلن وزير خارجية إسرائيل، يئير لبيد، ليست صغيرة، بل "جزءٌ من سلسلة"، فالاستهانة بالكلام عن الخطوات التي تريدها أميركا من السعودية بالقول إن التطبيع قائم، تفتقر إلى عمق بالتفكير، فكل خطوة مهمّة، إذ إن إعلان التطبيع العلني الكامل هو المطلوب. .. قد لا يستمع الحكّام، لكن استمرار حركة المقاطعة، وظهور جيل جديد عربي وفلسطيني يتبوأ قيادتها، هو الوجه الآخر لمعركة الصمود الفلسطيني، وهما الأمل.
معروفٌ ماذا تريد أميركا من السعودية، لكن التفاصيل مهمة، منها أن إسرائيل تملك السيطرة الفعلية الأمنية على الممرّات المائية إلى جزيرتي تيران وصنافير، فهذه التفاصيل تعيد رسم خريطة المنطقة، ويجب أن تحفّز على الرد وعدم التردّد في الاندماج في حركة مناهضة التطبيع. .. ليس هذا حديثا عما يحدُث مع دولة واحدة، بل جميعنا معنيون، لأن الخسارة هي خسارة الجميع.