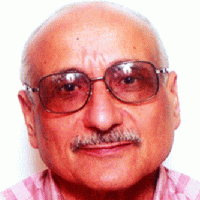06 نوفمبر 2024
عن "الشعبوية" لدى حكام بغداد
تسبب صعود دونالد ترامب إلى المسرح السياسي في هيمنة موجة جديدة من "الخطاب الشعبوي" في الولايات المتحدة، وهو خطاب كان قد اكتسح أقطاراً عديدة في أوروبا، خصوصاً في عهود هتلر وموسوليني وفرانكو، وفي ظل الأنظمة الشيوعية التي حكمت في شرقيها، وبعدها في أميركا اللاتينية، على أيدي قادة "اليسار الجديد"، وفي عالمنا العربي في ظل أنظمة العسكر والدكتاتوريات، وينطوي على دغدغة عواطف وأحاسيس قطاعات واسعةٍ من الجمهور، وخصوصاً الفئات متدنية الوعي، محاولا استمالتها وتضليلها عبر الصراخ العالي، واعتماد لغةٍ شعبيةٍ تلهب الحماس وتثير المشاعر، وطرح شعاراتٍ غامضة أو فارغة، والتركيز على قضايا تستولي على اهتمام العامة، وتغازل رغباتها المضمرة، وفي بعض الحالات الجنوح إلى استحضار أحداثٍ معينة في التاريخ، والتذكير بأمجاد أو مظالم سالفة، بقصد صرف الأنظار عن وقائع ماثلة، يراد طمسها أو التستر عليها. وفي بعض الحالات أيضاً محاولة دفع المتلقي إلى الاعتقاد بخلاف ما يراه على أرض الواقع، كتحويل الهزيمة الى نصر، أو الانتفاضات الشعبية إلى مؤامرات يدبرها الخصوم، أو إسباغ صفة التفرد والتميز على شعب أو طائفة أو حزب معين، والزعم بأن له رسالة مقدسة، عليه أن يؤديها للعالم، وكذلك السعي دائما لإيجاد طرفٍ وهميٍّ معاد لمصالح الشعب وأهدافه العليا، والتحذير منه، وقد يحمل "الخطاب الشعبوي"، في بعض الأحيان، قدراً من الابتذال أو البذاءة اللفظية أو النكات الساخرة لافتعال جو من المرح والفكاهة.
نرصد في "الخطاب الشعبوي" ظاهرتين متداخلتين: وصول التضليل إلى درجة اقتناع موجه الخطاب نفسه به، وتصوره أن كل ما يقوله واقع يقيني ماثل أمام عينيه، ونشوء جمهور "شعبوي"، إذا صح التعبير، بحكم التواصل والتكرار، يتجمع من حول صاحب الخطاب، وبتعاطف مع طروحاته، ويستجيب لقناعاته برضا وحماس، من دون مناقشة. ويؤدي تداخل هاتين الظاهرتين إلى ظهور "الدكتاتور" وصعوده المتسارع على أكتاف جمهوره الذي يصبح في حالة استلاب وتخدير وانتشاء كامل.
وقد اختبرنا، نحن العراقيين، "الخطاب الشعبوي" مع صعود "العسكرتاريا" إلى السلطة، في ظل النظام الجمهوري الذي أفرز حكاماً "شعبويين" بامتياز، ورأينا كيف دفع التنافس على الموقع الأول بين عبدالكريم قاسم وعبدالسلام عارف إلى طرح كل منهما خطاباً يكاد يكون واحداً في توجهاته ومساره، وإن كان كل منهما يسعى إلى تثبيت وجهة نظر تبدو مخالفةً للآخر، وحاولا دغدغة مشاعر الجماهير العريضة التي كانت خارجةً للتو من تجربة نظامٍ يمالئ الغرب، ويعطي هامشاً ديمقراطياً محدوداً لا يرضي طموحات المواطنين، ولا يتجاوب مع حاجات المرحلة، وهذا من عوامل عدة أعطت للخطاب آنذاك زخمه وقوته.
وفي مرحلة صعود حزب البعث إلى السلطة، شاهدنا نموذجاً آخر للظاهرة في شخصية صدام حسين الذي كان يسعى إلى تذكير المتلقي، بشكل أو بآخر، بدوره في قيادة الشعب والأمة، وفي تحقيق المكاسب والانتصارات، وبأن إرادته هي إرادة الشعب كله، وإن ما يقوله أو يفعله لا يمكن إلا أن يجانب الصواب.
وتجلت ظاهرة "الخطاب الشعبوي" على نحو أشدّ وضوحاً بعد الغزو الأميركي للبلاد، مع ولادة طبقة من السياسيين، لم تكن اختبرت الحياة السياسية وفنون الحكم، وفقد أفرادها الثقة في أنفسهم على خلفية إدراكهم أنهم صنيعة القوى الدولية التي نصبتهم على حكم البلاد في لحظةٍ تاريخيةٍ هجينة. وبحكم هذه العقدة، تراهم يحاولون كلما واتتهم الفرصة التركيز على الطائفة التي يدّعون تمثيلها، ومنحها صفات التفرد والتميز على باقي الطوائف، زاعمين أنهم أحفاد الحسين الذين بعثتهم العناية الإلهية للتمهيد لظهور المهدي، وملقين على الطائفة الأخرى صفاتٍ شريرةً جاعلين من أبنائها أحفاداً ليزيد، وساعين دوماً إلى استحضار واقعة كربلاء ومظلمة الحسين، لكسب دعم (ومساندة) جماهير يسحرها الخطاب الطائفي المريض، بحكم تدني وعيها، وخلفياتها الغيبية، ويفقدها القدرة على التمييز والحكم المنطقي. ووصل الحال إلى أن جمهرةً من أنصاف المثقفين والمتعلمين انصاعت لدعاوى الخطاب، ووقعت في فخاخه، ولم تستطع الفكاك من أسره، على الرغم مما يختلج في أعماقها من شكوك وشبهات.
وإذا كان ثمّة ما يفاقم الحال الماثل ويزيده بؤساً أن هذه الموجة "الشعبوية" أمدت في عمر "العملية السياسية"، وقللت من تأثير الخطاب الوطني المضاد وفاعليته، وخصوصاً بعد أن تمكّنت من ترويض جمهور عريض، أضحى مسلوب العقل والصوت والإرادة، وتلك أم المآسي.
نرصد في "الخطاب الشعبوي" ظاهرتين متداخلتين: وصول التضليل إلى درجة اقتناع موجه الخطاب نفسه به، وتصوره أن كل ما يقوله واقع يقيني ماثل أمام عينيه، ونشوء جمهور "شعبوي"، إذا صح التعبير، بحكم التواصل والتكرار، يتجمع من حول صاحب الخطاب، وبتعاطف مع طروحاته، ويستجيب لقناعاته برضا وحماس، من دون مناقشة. ويؤدي تداخل هاتين الظاهرتين إلى ظهور "الدكتاتور" وصعوده المتسارع على أكتاف جمهوره الذي يصبح في حالة استلاب وتخدير وانتشاء كامل.
وقد اختبرنا، نحن العراقيين، "الخطاب الشعبوي" مع صعود "العسكرتاريا" إلى السلطة، في ظل النظام الجمهوري الذي أفرز حكاماً "شعبويين" بامتياز، ورأينا كيف دفع التنافس على الموقع الأول بين عبدالكريم قاسم وعبدالسلام عارف إلى طرح كل منهما خطاباً يكاد يكون واحداً في توجهاته ومساره، وإن كان كل منهما يسعى إلى تثبيت وجهة نظر تبدو مخالفةً للآخر، وحاولا دغدغة مشاعر الجماهير العريضة التي كانت خارجةً للتو من تجربة نظامٍ يمالئ الغرب، ويعطي هامشاً ديمقراطياً محدوداً لا يرضي طموحات المواطنين، ولا يتجاوب مع حاجات المرحلة، وهذا من عوامل عدة أعطت للخطاب آنذاك زخمه وقوته.
وفي مرحلة صعود حزب البعث إلى السلطة، شاهدنا نموذجاً آخر للظاهرة في شخصية صدام حسين الذي كان يسعى إلى تذكير المتلقي، بشكل أو بآخر، بدوره في قيادة الشعب والأمة، وفي تحقيق المكاسب والانتصارات، وبأن إرادته هي إرادة الشعب كله، وإن ما يقوله أو يفعله لا يمكن إلا أن يجانب الصواب.
وتجلت ظاهرة "الخطاب الشعبوي" على نحو أشدّ وضوحاً بعد الغزو الأميركي للبلاد، مع ولادة طبقة من السياسيين، لم تكن اختبرت الحياة السياسية وفنون الحكم، وفقد أفرادها الثقة في أنفسهم على خلفية إدراكهم أنهم صنيعة القوى الدولية التي نصبتهم على حكم البلاد في لحظةٍ تاريخيةٍ هجينة. وبحكم هذه العقدة، تراهم يحاولون كلما واتتهم الفرصة التركيز على الطائفة التي يدّعون تمثيلها، ومنحها صفات التفرد والتميز على باقي الطوائف، زاعمين أنهم أحفاد الحسين الذين بعثتهم العناية الإلهية للتمهيد لظهور المهدي، وملقين على الطائفة الأخرى صفاتٍ شريرةً جاعلين من أبنائها أحفاداً ليزيد، وساعين دوماً إلى استحضار واقعة كربلاء ومظلمة الحسين، لكسب دعم (ومساندة) جماهير يسحرها الخطاب الطائفي المريض، بحكم تدني وعيها، وخلفياتها الغيبية، ويفقدها القدرة على التمييز والحكم المنطقي. ووصل الحال إلى أن جمهرةً من أنصاف المثقفين والمتعلمين انصاعت لدعاوى الخطاب، ووقعت في فخاخه، ولم تستطع الفكاك من أسره، على الرغم مما يختلج في أعماقها من شكوك وشبهات.
وإذا كان ثمّة ما يفاقم الحال الماثل ويزيده بؤساً أن هذه الموجة "الشعبوية" أمدت في عمر "العملية السياسية"، وقللت من تأثير الخطاب الوطني المضاد وفاعليته، وخصوصاً بعد أن تمكّنت من ترويض جمهور عريض، أضحى مسلوب العقل والصوت والإرادة، وتلك أم المآسي.