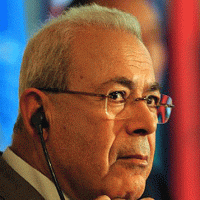17 أكتوبر 2024
مصير سورية في أيدي أبنائها
سوريون في حلب يتظاهرون مطالبين بسقوط الأسد (4/3/2016/فرانس برس)
يذكّر الوضع الذي تعيشه سورية الخارجة من الحروب الاستعمارية الجديدة اليوم، في الكثير من أوجهه، بوضعها عشية خروجها من الحرب العالمية الأولى، بعد انهيار السلطنة العثمانية وخيانة الدول الغربية وعودها التي اعطتها للشريف حسين، وللعرب أيضا. وكما تحطم في ذلك المنعطف التاريخي الحلم العربي بتشكيل مملكة عربية واحدة، تضم سورية والمناطق الناطقة بالعربية في المشرق الآسيوي، وتحفظ وحدتها وسيادتها، تحطم اليوم حلم السوريين الذين رموا بأنفسهم، كما لم يفعل أي شعب من قبل في أتون الثورة ومحرقتها، لنيل حريتهم واستقلالهم عن سلطة الاحتلال الداخلي. وكما قسمت سورية الطبيعية ما بعد العثمانية، بعد فصلها عن الجزيرة والعراق، إلى مجموعة من الدول، فلسطين التي لم تحسم حربها بعد والأردن ولبنان، وجزئت سورية "الفرنسية" هي نفسها إلى خمس دول: في الساحل والجزيرة السورية ودمشق وحلب وجبل الدروز، لا يكف الروس، ومن ورائهم بقية الدول الغربية، عن المطالبة بتحويل سورية إلى فدرالية، لإرضاء تطلعات رجالات الأقاليم أو الجماعات الاتنية والقومية المختلفة. فلا تعني الفدرالية هنا توحيد دول قائمة، كما هو معنى الفدرالية الأصلي، لتوسيع موارد الدولة وتعظيم وظائفها، ولكن إعطاء غطاء شرعي لتقسيم الدولة الواحدة وكسر نواتها المركزية، كما حصل من قبل في العراق الذي لم يخرج من محنة هذا الكسر بعد.
وكما فرض الفرنسيون انتدابهم بالقوة العسكرية، بعد هزيمة قوات وزير دفاع المملكة السورية الفيصلية، يوسف العظمة، في ميسلون 20 يوليو/ تموز 1920، نجح الروس اليوم في فرض الانتداب بالتفاهم مع الدول المتنازعة على سورية الأسدية، بعد كسرهم ذراع الثورة السورية المسلح وإخضاع فصائلها المقاتلة باستخدام عصا الهجمات الجوية، وجزرة المصالحات واتفاقات خفض التصعيد. ودخلت سورية اليوم، كما حصل لها منذ قرن ونيف، في دائرة الخراب والدمار والفوضى، فقدت فيها كل مقوماتها كدولة، وانهارت جميع مؤسساتها وأطرها الدستورية، وأضاعت سيادتها وفقد فيها الشعب وحدته، وتم تمزيقه إلى طوائف وأقليات
واتنيات، وأفرغ من محتوى هويته الوطنية، وحرم من حقه في تقرير مصيره، فيما تتنامى في شمالها حركة الانفصال التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي بدعم الأميركي، لكن بغطاء الشرعية التي تحظى بها القضية القومية الكردية المستعصية على الحل منذ قرن.
(1)
ليس المقصود من هذا التذكير المماثلة بين الوضعين، أو القول إن التاريخ يعيد نفسه، فروسيا اليوم غير فرنسا الإمبرطورية القديمة والولايات المتحدة الأميركية ليست بريطانيا العظمى التي كانت تتصدّى لقيادة النظام الاستعماري المشرف على الانحلال. كما أن الشرق الأوسط الراهن قد تغير كثيرا عما كان عليه منذ قرن. فإلى جانب القوى الدولية التي تزجّ قواتها ونفسها في الصراع على سورية، هناك اليوم قوى إقليمية كبيرة صاعدة تزاحم الدولتين الكبيرتين على التوسع وتقاسم مناطق النفوذ، ويعتقد قادتها أن لديهم حقا أقوى في السيطرة على إرث سورية الأسد المنحلة من الدول الكبرى الخارجية. وهي لم تعد دولا مكتفية بذاتها، ولكن أصبح لها حسابات جيوستراتيجية، لم يكن لها ما يماثلها في عشرينيات القرن الماضي. وجه الشبه الرئيسي ين الوضعين، الماضي والحاضر، هو أن سورية الدولة انحلت لصالح قوى أجنبية، وأن شعبها تمزق أشلاء، ولم يعد يعرف في أي اتجاه يمكن له أن يتوجه إلى إنقاذ وجوده، والهرب بنفسه. وبينما أجبر إرهاب الدولة نصفه إلى الهرب بنفسه خارج البلاد، تحول نصفه الآخر إلى لاجئ على أرضه، وفقد السيطرة على جميع موارده، ولم يعد يملك أي قدرةٍ أو وسيلة لتأكيد حقه في تقرير مصيره بنفسه، أو قول كلمته. وبعبارة أخرى، لم يكن هناك وضع أسوأ مما يشهده الشعب السوري اليوم، بعد فشل ثورته المسلحة سوى ما شهده بعد انهيار "الثورة العربية الكبرى" عام 1916، وتغول الدول الأجنبية، وتنازعها على تمزيقه وتحطيم هويته وإخراجه من المواجهة وفرض الأمر الواقع عليه.
ومع ذلك، صمدت سورية الوليدة والخارجة من العدم في بدايات القرن العشرين أمام نوائب التاريخ، واستعادت بسرعة وحدتها، قبل أن ينجح شعبها في توحيد نفسه من وراء جيل جديد من النخب الوطنية التي قادت السوريين نحو الاستقلال، ونجحت في إرساء أسس دولة جمهورية حديثة ديمقراطية، بعد أن كانت مفتقرةً لأي موطئ قدم، سياسيا كان أو عسكريا أو اجتماعيا، لممارسة أدنى قسط من حق تقرير مصيره.
ما من شك في أن الوضع السوري الراهن أكثر تعقيدا. لكنه ليس مغلقا ولا يائسا، بالعكس. فلدى سورية والسوريين اليوم موارد بشرية وفكرية واجتماعية، ورصيد من العلاقات الدولية أفضل بكثير مما كانت تملكه عندما خرجت كسيرةً وكسيحةً من خراب الحرب العالمية الأولى. وأصبح وراء السوريين، منذ ذلك الوقت، قرن كامل من خبرة الدولة والصراع الدولي والسياسي والقتالي أيضا. وقد أظهر السوريون، خلال ثورة 2011، من الشجاعة أضعاف ما أظهروه خلال ثورة 1925، وهم يثبتون في منافيهم وشروط معيشتهم الجائرة كل يوم، بعد ترحيلهم القسري، من الشهامة والمجالدة والصبر، ويبرزون من المرونة والذكاء والمهارة ما أثار إعجاب مضيفهم في جميع البلاد التي لجأوا مضطرين إليها. ولن يطول الوقت، بعد وقف إطلاق النار، قبل أن تتفجر طاقات ملايين السوريين الذين كانت الديكتاتورية الدموية قد شلت قواهم، وعطلت مواهبهم، وتبرز قدراتهم ودينامية شبابهم التي لا تضاهى، في سبيل استعادة المبادرة، في جميع الميادين، العلمية والسياسية والاقتصادية، وإعادة توحيد صفوفهم في وجه الانتداب الجديد الذي أكرهوا على القبول به أمرا واقعا، واحتلال بالقوة، كما أكره جيل آبائهم من قبل على قبول الانتداب الفرنسي، أي ليس لشرعنته، ولكن لمحاربته والتخلص منه.
يساعدهم في ذلك أمران: إرادة التحرّر العميقة التي ألهبت مشاعرهم منذ سنوات، والتي ستبقى أعظم تجربة عاشتها أجيالهم الجديدة، وأغناها بالمعاني والعبر والتطلعات والأحلام أيضا، وبسبب الطريق المسدود الذي وصلت إليه جميع القوى التي وقفت في وجه إرادتهم، وحاولت أن تحرمهم من حقهم في الحرية والسيادة والاستقلال والحياة. لم يربح السوريون رهانهم في إرساء نظام الحرية الذي تطلعوا إليه، وضحوا من أجله بكل ما يملكون، لكنهم حطموا نظام الطغيان، وأجبروا، بمقاومتهم وصمودهم الطويل، وتضحياتهم التي لا مثيل لها، كل فرصة على خصومهم، لتحقيق رهاناتهم. وجميع هؤلاء يقفون اليوم عارين أمام جريمتهم وتعاونهم على اغتيال حلم شعب كامل بالتحرر والانعتاق.
(2)
لم يحقق النظام رهانه في تركيع الشعب السوري، وإرغامه على الخضوع والاستسلام، ولكنه (النظام) أضاع البلد الذي توج ملكا عليه، ودمر أسس بقائه واستقراره، وضحّى من دون نتيجة تذكر، سوى التمديد لنفسه بعض السنوات في حكم بلدٍ مدمر، بالشباب السوري الذي زجّه في معاركه الظالمة واللاأخلاقية، وخسر سيادة قراره وأصبح حلقةً في نظام الهيمنة والانتداب الروسي. وبدل أن يخلد سلطته التي كانت شاملة ومطلقة، كما كان يأمل من خلال تدمير إرادة الشعب وسحق ثورته، أصبحت مشاركته في الحكم في المرحلة الانتقالية إحدى مسائل الخلاف وتعطيل الحل والتسوية السياسية. وحتى لو تمكن من البقاء في الحكم بعض الوقت، بضغط من الانتداب الروسي، فلن يبقى رئيسا للسوريين، ولكن أداة من أدوات السيطرة الروسية. وبالمثل، لن يكون نظامه الذي يريد الروس إنقاذه نظاما سورية، وإنما منصة روسية لتوزيع الحصص والمكاسب والمغانم على الدول المتنازعة على حساب السوريين وضدهم. ولن تستطيع
مؤسسات النظام القديم التي أخفقت في معالجة المشكلات التي أنتجتها إدارته وخياراته الفاسدة عندما كانت سورية في كامل صحتها وكامل مواردها وأمنها، أن تحل المشكلات المضاعفة التي ستخلفها الحرب، مهما سعت إيران وروسيا للتغطية عليها. ولن يمكن لأي نظام أن ينجح في حلها، من دون تعاون جميع أبناء الشعب السوري، وتفاهمهم ومشاركتهم في حكم يمثلهم، ويعبر عن اختيارهم ويجسد استقلال إرادتهم ومصالح وطنهم.
لذلك، بعكس ما يعتقد بعض السوريين من المعارضة والموالاة، بدأت الآن مشكلات النظام الحقيقية، وليس في أثناء الحرب التي خاضها في النهاية بأرواح الجنود الأبرياء والمرتزقة والمتطوعين الأجانب، ولم يخسر فيها، هو وحاشيته المقرّبة، شيئا. بل كانت مصدر إثراء إضافي له ولأنصاره. وسوف يجد نفسه، هو وحلفاؤه، أمام أنواع من التحديات التي ليس لديه أي إمكانية لمواجهتها، ولا يملك هو أصلا الأطر الفكرية والبشرية التي تمكّنه من استيعابها والتعامل معها، بعد أن جرد نفسه من أي خياراتٍ سياسية سوى القتل والتهجير والتجويع، وطرد غالبية أطر البلاد وخبرائها وتقنييها. وسوف يجد قادته أنفسهم أمام شعبٍ متطلبٍ ومتحفزٍ ومتحرّر من القهر الذي سقطت مقوماته، ونظام متقزم يقوده منطق التشبيح والتعفيش والنهب والسلب والابتزاز والاغتصاب. استمرار الحرب كان الخيار الوحيد الذي يقيه من المواجهة الحتمية العنيفة القادمة مع الشعب بكل فئاته، تلك التي كانت مواليةً للثورة، وأحبطت تطلعاتها من دون حق، وتلك التي وقفت مع النظام، ودفعت الثمن الغالي لإنقاذه، وتنتظر المكافأة من نظام أصبح مورده الرئيسي النهب والسلب.
وعلى الرغم من توسعهم خارج حدودهم، وسيطرتهم على مواقع أساسية في سورية، لم يحقق الإيرانيون رهانهم من الحرب، ولكنهم خسروا. وبدل أن يعزّزوا تماسك هلالهم الأخضر، أو الشيعي كما يسمونه، وتكبيد الشعب السوري هزيمةً تخرجه من معادلة القوة والسياسة، ليحلوا بأزلامهم وحشودهم محله، عمقوا قطيعتهم ونزاعاتهم مع العرب. وأثاروا فزع العالم، وسوف يواجهون رد فعل إقليمي ودولي قويا، يهدف إلى تحجيمهم، وتقييد حركتهم ومحاصرة الحرس الثوري ومليشياته التي تشكل سلاح توسعهم ونفوذهم في المنطقة والعالم. لقد أحرق الإيرانيون أصابعهم لالتقاط حبة الكستناء السورية من النار، ليجدوا أنفسهم مجبرين على تقديمها ناضحةً للدولة الروسية. فباؤوا بالخسارة والخيبة، وسوف يدفعون ثمن تهورهم وشرههم للتوسع والنفوذ في إيران التي تنتظر ثورتها الشعبية ضد السلطة الكهنوتية الفاسدة والفاشلة معا.
وبالمثل، يحلم الروس بأن ربحهم المعركة العسكرية في سورية ضد فصائل المقاومة الشعبية، الضعيفة وغير المنظمة، سوف يفتح لهم باب الدخول بقوة في نظام القطبية المتعدّدة، ويفرضون أنفسهم أخيرا، والغرب خصوصا، شريكا رئيسا في تحديد أجندة السياسة الدولية، وطرف لا يمكن تجاهله في تقرير الشؤون العالمية. ومنذ الآن، وقعوا مع الأسد اتفاقاتٍ تضمن لهم الاحتفاظ في سورية بقواعد عسكرية بشروط سيادية لنصف قرن، تسمح لهم بالتوطّن نهائيا في الشرق الأوسط، وربما حلم بعضهم بطرد الغربيين منه، والتعويض عن إخراجهم صفر اليدين في اتفاقات سايكس بيكو التي تقاسمت بموجبها بريطانيا وفرنسا، قبل قرن، إرث الإمبرطورية العثمانية. مشكلتهم الوحيدة، لكن العويصة، أنهم يأتون متأخرين بقرن عن شركائهم القدامى، وفي عصرٍ لم يعد فيه من الممكن إخضاع أي شعب بالقوة، وليس أمام أي مشروع للسيطرة بالقوة والإكراه، حتى على جماعات أقلية صغيرة، سوى بتبني خيار الحرب العدمية ومشاريع الإبادة الجماعية. وهذا ما دشّنه تحت رعاية الروس، وبإشرافهم، نظام الأسد، وعبر عنه استخدامه السلاح الكيميائي وأسلحة الدمار الشامل والعشوائي الأخرى، من دون محاسبة ولا عقاب حتى الآن.
(3)
ليس لدى الروس مشروع واضح لسورية سوى تقسيمها مناطق نفوذ، وتوزيع الحصص والمواقع على من يدّعي حقوقا له فيها، من الدول الأجنبية والوجاهات، أو النخب المحلية المتعاملة مع موسكو، والمستعدة للعمل معها، وذلك كله من أجل ضمان سيطرة موسكو على سورية، وتعزيز نفوذها وتوسيع دائرة القبول الدولي بها. كان الوطنيون السوريون يفاوضون السلطات الفرنسية حول إلغاء الانتداب انطلاقا من مرجعية قيم الجمهورية والاستقلال والحريات الديمقراطية والتعدّدية، وحق تقرير المصير للشعوب والحكومة التمثيلية. وتظهر تجربة السنوات القليلة الماضية صعوبة تحديد المرجعية التي يمكن التفاوض على أساسها مع الروس لإلغاء الانتداب الروسي، بينما يصرّون اليوم على تأكيد شرعية نظام دموي وراثي، ويرفضون جميع القيم والمبادئ التحرّرية الحديثة، ويمارسون سياسة فرض الأمر الواقع والحكم بالإكراه وتبرير الاستخدام المفرط للعنف وإسكات الأصوات المغايرة والنقدية، وربما اغتيالها، واحتقار مفهوم المعارضة ووجودها. وهم يراهنون في فرض عقيدتهم هذه على عصا الأجهزة الأمنية الغليظة وسياسة الترغيب والترهيب والسجن والملاحقة، وإخفاء الحقائق والدعاية الكاذبة واختلاق الإشاعات والأخبار الكاذبة.
في ظل هذه العقيدة، ومع افتقار الانتداب الروسي في سورية لشرعنة دولية، بعكس ما كان عليه الحال بالنسبة للانتداب الفرنسي في القرن الماضي، هناك خطر كبير في أن تتصرّف روسيا في سورية كما فعلت في أفغانستان، وتبرّر سياسة الأرض المحروقة التي اتبعتها هناك، ومن قبلها في شيشان روسيا نفسها. وهذا ما تؤكده بسلوكها عندما تصرّ على فرض إرادتها وتصوراتها على شعبٍ ضحّى بمليون شهيد من أجل التحرر من العبودية، والانعتاق من نيرها، وتراهن على إعادة تأهيل نظام كان ولا يزال المسؤول الأول عن تدمير سورية، وتشريد شعبها، وقتل مئات الآلاف من أبنائها للاحتفاظ بسلطة جائرة ولا مشروعة. ولن يتأخر الوقت قبل أن تدفع مثل هذه السياسة الشعب السوري إلى الثورة على الاحتلال الجديد، وأعوانه المحليين، بكل طوائفه وطبقاته ونخبه، لانتزاع حريته واستقلال بلاده.
يحلم الروس، بعد مئة عام، على تقسيم الشرق الأدنى بتعويض ما حرموا منه في "سايكس بيكو"، من خلال بسط سلطتهم ونفوذهم في سورية. ويحلم الإيرانيون بمنفذ على البحر المتوسط منذ أكثر من ألفي عام، وسيفعلون المستحيل من أجل تحقيقه، ويحلم النظام بأن تزداد حاجة الروس له واجهة للاحتلال، مع تنامي الاعتراض السوري عليه، أما الولايات المتحدة فهي تخطط لتوسيع قواعد سيطرتها العسكرية، في انتظار أن تستنزف قوى خصومها في المنطقة. ما يعني أن الصراع لايزال مفتوحا على تقرير مصير سورية. وبعكس ما تقوله
المظاهر اليوم، لن يمكن لأي طرفٍ أن يحسم الصراع، ويخرج البلاد من الأزمة الراهنة سوى الشعب السوري نفسه، فهو الأصل وهو القضية وصاحب المصلحة في إعادة بناء سورية، وإرساء قواعد أمنها وسلامها وازدهارها. لكن حتى ينجح في لعب دوره الحاسم المنتظر، ينبغي على السوريين:
أولا ألا يشكّوا لحظة في أن ثورتهم كانت على حق، وأنهم قاتلوا دفاعا عن حياتهم وحقوقهم وحرياتهم وكرامتهم، وهم الذين تم الاعتداء عليهم، ولم يعتدوا على أحد.
وثانيا ألا يسلموا بحكم القوة والاحتلال، ولن يسلموا، لأن ذلك يعني نهايتهم شعبا، ونهاية سورية بلدا، ونهاية أي أمل حتى في إصلاح الأحوال وتحويل سورية إلى وطن وملجأ آمن لأهلها. ليس أمامهم إلا أن يتمسكوا بحقوقهم، ويستمروا في المقاومة بكل الوسائل، بأفعالهم وأقوالهم وجوارحهم وأنفسهم، أينما كانوا، لأن هذه المقاومة هي التي تعطي لحياتهم السياسية معنى، وتجعل منهم رجالا أحرارا، وتحفظ لهم ما انتزعوه من شروط الحرية بأغلى الأثمان، كما تحفظ كرامة شهدائهم، وقيمة تضحياتهم الأسطورية.
ثالثا أن يراجعوا أخطاءهم، وينبذوا كل أشكال الطائفية والعنصرية القومية والتمييز الاجتماعي والطبقي، ويعترفوا لكل فرد منهم بهويته وأصالته واستقلاله وكرامته وحرية ضميره كإنسان، بصرف النظر عن أصله وفصله ودينه ووضعه الاجتماعي، وأن يتضامنوا أو يتعاضدوا على الدفاع عن حقوقهم المتساوية التي يشكل احترامها لكل فرد شرطا لحرية الأمة، واستقلالها ووحدتها وتمدّنها.
لن يمكن لأحد أن يحتل سورية إذا أراد شعبها تحريرها، ولن يتمكن من تقسيمها إذا أراد السوريون وحدتها. ولا يمكن توحيدها من دون الاعتراف المتبادل فيها من كل طرف بحقوق الأطراف الأخرى، وكل فرد بحقوق الفرد الآخر. ولن يكون في سورية حرية ولا كرامة لأحد ما لم تعم الحرية والكرامة الجميع. ولن يتمتع فيها أحد بالسلام، ما لم يتحقق الأمن والسلام لكل السوريين. ومن أحل ذلك، ينبغي تشجيع الحوارات الوطنية، وتوسيع دائرتها في كل الميادين والمناسبات. وعلى المثقفين والقادة السياسيين الانخراط بقوة وعمق في هذا الحوار، لمساعدة عموم السوريين على فهم الرهانات المطروحة، والمسائل الخلافية، والشروط الضرورية لبناء صرح الهوية الوطنية من جديد، بعد أن هدمتها الحرب الوحشية ضد السوريين، ومن أجل تقسيمهم وبث الفرقة بينهم، وإخضاعهم لإرادة القوى الأجنبية الطامحة إلى التوسع والسيطرة.
في هذه المسيرة التحرّرية المستمرة والمعقدة، أكثر ما يحتاجه السوريون هو العودة إلى روح ثورة آذار المغدورة، السلمية والمدنية، وإعادة تنظيم صفوفهم، في ما وراء الموالاة والمعارضة، وتوحيد كلمتهم حول انتقال سياسي، وعهد وطني يحفظ للجميع حقوقهم ومصالحهم، وينهي عهد الانقسام والفرقة التي اشتغل عليها النظام، وراهن عليها ونجح، إلى حد كبير، بفضل تقويضه المسبق، وخلال عقود، ثقافة السوريين الوطنية، وقيمهم المدنية، وروح التضامن والتكافل التي لا يقوم من دونها أي بناء وطني أو نسيج اجتماعي.
وتبقى ثورة العشرين من القرن الماضي، بمقاوماتها وكتلتها الوطنية، وتفاهم نخبها الاجتماعية، وخطها الديمقراطي التعددي، نموذجا ملهما لانبعاث سورية من موتها، وتعلم الأجيال السورية الجديدة أبجدية الحرية والاستقلال الوطنيين.
وكما فرض الفرنسيون انتدابهم بالقوة العسكرية، بعد هزيمة قوات وزير دفاع المملكة السورية الفيصلية، يوسف العظمة، في ميسلون 20 يوليو/ تموز 1920، نجح الروس اليوم في فرض الانتداب بالتفاهم مع الدول المتنازعة على سورية الأسدية، بعد كسرهم ذراع الثورة السورية المسلح وإخضاع فصائلها المقاتلة باستخدام عصا الهجمات الجوية، وجزرة المصالحات واتفاقات خفض التصعيد. ودخلت سورية اليوم، كما حصل لها منذ قرن ونيف، في دائرة الخراب والدمار والفوضى، فقدت فيها كل مقوماتها كدولة، وانهارت جميع مؤسساتها وأطرها الدستورية، وأضاعت سيادتها وفقد فيها الشعب وحدته، وتم تمزيقه إلى طوائف وأقليات
(1)
ليس المقصود من هذا التذكير المماثلة بين الوضعين، أو القول إن التاريخ يعيد نفسه، فروسيا اليوم غير فرنسا الإمبرطورية القديمة والولايات المتحدة الأميركية ليست بريطانيا العظمى التي كانت تتصدّى لقيادة النظام الاستعماري المشرف على الانحلال. كما أن الشرق الأوسط الراهن قد تغير كثيرا عما كان عليه منذ قرن. فإلى جانب القوى الدولية التي تزجّ قواتها ونفسها في الصراع على سورية، هناك اليوم قوى إقليمية كبيرة صاعدة تزاحم الدولتين الكبيرتين على التوسع وتقاسم مناطق النفوذ، ويعتقد قادتها أن لديهم حقا أقوى في السيطرة على إرث سورية الأسد المنحلة من الدول الكبرى الخارجية. وهي لم تعد دولا مكتفية بذاتها، ولكن أصبح لها حسابات جيوستراتيجية، لم يكن لها ما يماثلها في عشرينيات القرن الماضي. وجه الشبه الرئيسي ين الوضعين، الماضي والحاضر، هو أن سورية الدولة انحلت لصالح قوى أجنبية، وأن شعبها تمزق أشلاء، ولم يعد يعرف في أي اتجاه يمكن له أن يتوجه إلى إنقاذ وجوده، والهرب بنفسه. وبينما أجبر إرهاب الدولة نصفه إلى الهرب بنفسه خارج البلاد، تحول نصفه الآخر إلى لاجئ على أرضه، وفقد السيطرة على جميع موارده، ولم يعد يملك أي قدرةٍ أو وسيلة لتأكيد حقه في تقرير مصيره بنفسه، أو قول كلمته. وبعبارة أخرى، لم يكن هناك وضع أسوأ مما يشهده الشعب السوري اليوم، بعد فشل ثورته المسلحة سوى ما شهده بعد انهيار "الثورة العربية الكبرى" عام 1916، وتغول الدول الأجنبية، وتنازعها على تمزيقه وتحطيم هويته وإخراجه من المواجهة وفرض الأمر الواقع عليه.
ومع ذلك، صمدت سورية الوليدة والخارجة من العدم في بدايات القرن العشرين أمام نوائب التاريخ، واستعادت بسرعة وحدتها، قبل أن ينجح شعبها في توحيد نفسه من وراء جيل جديد من النخب الوطنية التي قادت السوريين نحو الاستقلال، ونجحت في إرساء أسس دولة جمهورية حديثة ديمقراطية، بعد أن كانت مفتقرةً لأي موطئ قدم، سياسيا كان أو عسكريا أو اجتماعيا، لممارسة أدنى قسط من حق تقرير مصيره.
ما من شك في أن الوضع السوري الراهن أكثر تعقيدا. لكنه ليس مغلقا ولا يائسا، بالعكس. فلدى سورية والسوريين اليوم موارد بشرية وفكرية واجتماعية، ورصيد من العلاقات الدولية أفضل بكثير مما كانت تملكه عندما خرجت كسيرةً وكسيحةً من خراب الحرب العالمية الأولى. وأصبح وراء السوريين، منذ ذلك الوقت، قرن كامل من خبرة الدولة والصراع الدولي والسياسي والقتالي أيضا. وقد أظهر السوريون، خلال ثورة 2011، من الشجاعة أضعاف ما أظهروه خلال ثورة 1925، وهم يثبتون في منافيهم وشروط معيشتهم الجائرة كل يوم، بعد ترحيلهم القسري، من الشهامة والمجالدة والصبر، ويبرزون من المرونة والذكاء والمهارة ما أثار إعجاب مضيفهم في جميع البلاد التي لجأوا مضطرين إليها. ولن يطول الوقت، بعد وقف إطلاق النار، قبل أن تتفجر طاقات ملايين السوريين الذين كانت الديكتاتورية الدموية قد شلت قواهم، وعطلت مواهبهم، وتبرز قدراتهم ودينامية شبابهم التي لا تضاهى، في سبيل استعادة المبادرة، في جميع الميادين، العلمية والسياسية والاقتصادية، وإعادة توحيد صفوفهم في وجه الانتداب الجديد الذي أكرهوا على القبول به أمرا واقعا، واحتلال بالقوة، كما أكره جيل آبائهم من قبل على قبول الانتداب الفرنسي، أي ليس لشرعنته، ولكن لمحاربته والتخلص منه.
يساعدهم في ذلك أمران: إرادة التحرّر العميقة التي ألهبت مشاعرهم منذ سنوات، والتي ستبقى أعظم تجربة عاشتها أجيالهم الجديدة، وأغناها بالمعاني والعبر والتطلعات والأحلام أيضا، وبسبب الطريق المسدود الذي وصلت إليه جميع القوى التي وقفت في وجه إرادتهم، وحاولت أن تحرمهم من حقهم في الحرية والسيادة والاستقلال والحياة. لم يربح السوريون رهانهم في إرساء نظام الحرية الذي تطلعوا إليه، وضحوا من أجله بكل ما يملكون، لكنهم حطموا نظام الطغيان، وأجبروا، بمقاومتهم وصمودهم الطويل، وتضحياتهم التي لا مثيل لها، كل فرصة على خصومهم، لتحقيق رهاناتهم. وجميع هؤلاء يقفون اليوم عارين أمام جريمتهم وتعاونهم على اغتيال حلم شعب كامل بالتحرر والانعتاق.
(2)
لم يحقق النظام رهانه في تركيع الشعب السوري، وإرغامه على الخضوع والاستسلام، ولكنه (النظام) أضاع البلد الذي توج ملكا عليه، ودمر أسس بقائه واستقراره، وضحّى من دون نتيجة تذكر، سوى التمديد لنفسه بعض السنوات في حكم بلدٍ مدمر، بالشباب السوري الذي زجّه في معاركه الظالمة واللاأخلاقية، وخسر سيادة قراره وأصبح حلقةً في نظام الهيمنة والانتداب الروسي. وبدل أن يخلد سلطته التي كانت شاملة ومطلقة، كما كان يأمل من خلال تدمير إرادة الشعب وسحق ثورته، أصبحت مشاركته في الحكم في المرحلة الانتقالية إحدى مسائل الخلاف وتعطيل الحل والتسوية السياسية. وحتى لو تمكن من البقاء في الحكم بعض الوقت، بضغط من الانتداب الروسي، فلن يبقى رئيسا للسوريين، ولكن أداة من أدوات السيطرة الروسية. وبالمثل، لن يكون نظامه الذي يريد الروس إنقاذه نظاما سورية، وإنما منصة روسية لتوزيع الحصص والمكاسب والمغانم على الدول المتنازعة على حساب السوريين وضدهم. ولن تستطيع
لذلك، بعكس ما يعتقد بعض السوريين من المعارضة والموالاة، بدأت الآن مشكلات النظام الحقيقية، وليس في أثناء الحرب التي خاضها في النهاية بأرواح الجنود الأبرياء والمرتزقة والمتطوعين الأجانب، ولم يخسر فيها، هو وحاشيته المقرّبة، شيئا. بل كانت مصدر إثراء إضافي له ولأنصاره. وسوف يجد نفسه، هو وحلفاؤه، أمام أنواع من التحديات التي ليس لديه أي إمكانية لمواجهتها، ولا يملك هو أصلا الأطر الفكرية والبشرية التي تمكّنه من استيعابها والتعامل معها، بعد أن جرد نفسه من أي خياراتٍ سياسية سوى القتل والتهجير والتجويع، وطرد غالبية أطر البلاد وخبرائها وتقنييها. وسوف يجد قادته أنفسهم أمام شعبٍ متطلبٍ ومتحفزٍ ومتحرّر من القهر الذي سقطت مقوماته، ونظام متقزم يقوده منطق التشبيح والتعفيش والنهب والسلب والابتزاز والاغتصاب. استمرار الحرب كان الخيار الوحيد الذي يقيه من المواجهة الحتمية العنيفة القادمة مع الشعب بكل فئاته، تلك التي كانت مواليةً للثورة، وأحبطت تطلعاتها من دون حق، وتلك التي وقفت مع النظام، ودفعت الثمن الغالي لإنقاذه، وتنتظر المكافأة من نظام أصبح مورده الرئيسي النهب والسلب.
وعلى الرغم من توسعهم خارج حدودهم، وسيطرتهم على مواقع أساسية في سورية، لم يحقق الإيرانيون رهانهم من الحرب، ولكنهم خسروا. وبدل أن يعزّزوا تماسك هلالهم الأخضر، أو الشيعي كما يسمونه، وتكبيد الشعب السوري هزيمةً تخرجه من معادلة القوة والسياسة، ليحلوا بأزلامهم وحشودهم محله، عمقوا قطيعتهم ونزاعاتهم مع العرب. وأثاروا فزع العالم، وسوف يواجهون رد فعل إقليمي ودولي قويا، يهدف إلى تحجيمهم، وتقييد حركتهم ومحاصرة الحرس الثوري ومليشياته التي تشكل سلاح توسعهم ونفوذهم في المنطقة والعالم. لقد أحرق الإيرانيون أصابعهم لالتقاط حبة الكستناء السورية من النار، ليجدوا أنفسهم مجبرين على تقديمها ناضحةً للدولة الروسية. فباؤوا بالخسارة والخيبة، وسوف يدفعون ثمن تهورهم وشرههم للتوسع والنفوذ في إيران التي تنتظر ثورتها الشعبية ضد السلطة الكهنوتية الفاسدة والفاشلة معا.
وبالمثل، يحلم الروس بأن ربحهم المعركة العسكرية في سورية ضد فصائل المقاومة الشعبية، الضعيفة وغير المنظمة، سوف يفتح لهم باب الدخول بقوة في نظام القطبية المتعدّدة، ويفرضون أنفسهم أخيرا، والغرب خصوصا، شريكا رئيسا في تحديد أجندة السياسة الدولية، وطرف لا يمكن تجاهله في تقرير الشؤون العالمية. ومنذ الآن، وقعوا مع الأسد اتفاقاتٍ تضمن لهم الاحتفاظ في سورية بقواعد عسكرية بشروط سيادية لنصف قرن، تسمح لهم بالتوطّن نهائيا في الشرق الأوسط، وربما حلم بعضهم بطرد الغربيين منه، والتعويض عن إخراجهم صفر اليدين في اتفاقات سايكس بيكو التي تقاسمت بموجبها بريطانيا وفرنسا، قبل قرن، إرث الإمبرطورية العثمانية. مشكلتهم الوحيدة، لكن العويصة، أنهم يأتون متأخرين بقرن عن شركائهم القدامى، وفي عصرٍ لم يعد فيه من الممكن إخضاع أي شعب بالقوة، وليس أمام أي مشروع للسيطرة بالقوة والإكراه، حتى على جماعات أقلية صغيرة، سوى بتبني خيار الحرب العدمية ومشاريع الإبادة الجماعية. وهذا ما دشّنه تحت رعاية الروس، وبإشرافهم، نظام الأسد، وعبر عنه استخدامه السلاح الكيميائي وأسلحة الدمار الشامل والعشوائي الأخرى، من دون محاسبة ولا عقاب حتى الآن.
(3)
ليس لدى الروس مشروع واضح لسورية سوى تقسيمها مناطق نفوذ، وتوزيع الحصص والمواقع على من يدّعي حقوقا له فيها، من الدول الأجنبية والوجاهات، أو النخب المحلية المتعاملة مع موسكو، والمستعدة للعمل معها، وذلك كله من أجل ضمان سيطرة موسكو على سورية، وتعزيز نفوذها وتوسيع دائرة القبول الدولي بها. كان الوطنيون السوريون يفاوضون السلطات الفرنسية حول إلغاء الانتداب انطلاقا من مرجعية قيم الجمهورية والاستقلال والحريات الديمقراطية والتعدّدية، وحق تقرير المصير للشعوب والحكومة التمثيلية. وتظهر تجربة السنوات القليلة الماضية صعوبة تحديد المرجعية التي يمكن التفاوض على أساسها مع الروس لإلغاء الانتداب الروسي، بينما يصرّون اليوم على تأكيد شرعية نظام دموي وراثي، ويرفضون جميع القيم والمبادئ التحرّرية الحديثة، ويمارسون سياسة فرض الأمر الواقع والحكم بالإكراه وتبرير الاستخدام المفرط للعنف وإسكات الأصوات المغايرة والنقدية، وربما اغتيالها، واحتقار مفهوم المعارضة ووجودها. وهم يراهنون في فرض عقيدتهم هذه على عصا الأجهزة الأمنية الغليظة وسياسة الترغيب والترهيب والسجن والملاحقة، وإخفاء الحقائق والدعاية الكاذبة واختلاق الإشاعات والأخبار الكاذبة.
في ظل هذه العقيدة، ومع افتقار الانتداب الروسي في سورية لشرعنة دولية، بعكس ما كان عليه الحال بالنسبة للانتداب الفرنسي في القرن الماضي، هناك خطر كبير في أن تتصرّف روسيا في سورية كما فعلت في أفغانستان، وتبرّر سياسة الأرض المحروقة التي اتبعتها هناك، ومن قبلها في شيشان روسيا نفسها. وهذا ما تؤكده بسلوكها عندما تصرّ على فرض إرادتها وتصوراتها على شعبٍ ضحّى بمليون شهيد من أجل التحرر من العبودية، والانعتاق من نيرها، وتراهن على إعادة تأهيل نظام كان ولا يزال المسؤول الأول عن تدمير سورية، وتشريد شعبها، وقتل مئات الآلاف من أبنائها للاحتفاظ بسلطة جائرة ولا مشروعة. ولن يتأخر الوقت قبل أن تدفع مثل هذه السياسة الشعب السوري إلى الثورة على الاحتلال الجديد، وأعوانه المحليين، بكل طوائفه وطبقاته ونخبه، لانتزاع حريته واستقلال بلاده.
يحلم الروس، بعد مئة عام، على تقسيم الشرق الأدنى بتعويض ما حرموا منه في "سايكس بيكو"، من خلال بسط سلطتهم ونفوذهم في سورية. ويحلم الإيرانيون بمنفذ على البحر المتوسط منذ أكثر من ألفي عام، وسيفعلون المستحيل من أجل تحقيقه، ويحلم النظام بأن تزداد حاجة الروس له واجهة للاحتلال، مع تنامي الاعتراض السوري عليه، أما الولايات المتحدة فهي تخطط لتوسيع قواعد سيطرتها العسكرية، في انتظار أن تستنزف قوى خصومها في المنطقة. ما يعني أن الصراع لايزال مفتوحا على تقرير مصير سورية. وبعكس ما تقوله
أولا ألا يشكّوا لحظة في أن ثورتهم كانت على حق، وأنهم قاتلوا دفاعا عن حياتهم وحقوقهم وحرياتهم وكرامتهم، وهم الذين تم الاعتداء عليهم، ولم يعتدوا على أحد.
وثانيا ألا يسلموا بحكم القوة والاحتلال، ولن يسلموا، لأن ذلك يعني نهايتهم شعبا، ونهاية سورية بلدا، ونهاية أي أمل حتى في إصلاح الأحوال وتحويل سورية إلى وطن وملجأ آمن لأهلها. ليس أمامهم إلا أن يتمسكوا بحقوقهم، ويستمروا في المقاومة بكل الوسائل، بأفعالهم وأقوالهم وجوارحهم وأنفسهم، أينما كانوا، لأن هذه المقاومة هي التي تعطي لحياتهم السياسية معنى، وتجعل منهم رجالا أحرارا، وتحفظ لهم ما انتزعوه من شروط الحرية بأغلى الأثمان، كما تحفظ كرامة شهدائهم، وقيمة تضحياتهم الأسطورية.
ثالثا أن يراجعوا أخطاءهم، وينبذوا كل أشكال الطائفية والعنصرية القومية والتمييز الاجتماعي والطبقي، ويعترفوا لكل فرد منهم بهويته وأصالته واستقلاله وكرامته وحرية ضميره كإنسان، بصرف النظر عن أصله وفصله ودينه ووضعه الاجتماعي، وأن يتضامنوا أو يتعاضدوا على الدفاع عن حقوقهم المتساوية التي يشكل احترامها لكل فرد شرطا لحرية الأمة، واستقلالها ووحدتها وتمدّنها.
لن يمكن لأحد أن يحتل سورية إذا أراد شعبها تحريرها، ولن يتمكن من تقسيمها إذا أراد السوريون وحدتها. ولا يمكن توحيدها من دون الاعتراف المتبادل فيها من كل طرف بحقوق الأطراف الأخرى، وكل فرد بحقوق الفرد الآخر. ولن يكون في سورية حرية ولا كرامة لأحد ما لم تعم الحرية والكرامة الجميع. ولن يتمتع فيها أحد بالسلام، ما لم يتحقق الأمن والسلام لكل السوريين. ومن أحل ذلك، ينبغي تشجيع الحوارات الوطنية، وتوسيع دائرتها في كل الميادين والمناسبات. وعلى المثقفين والقادة السياسيين الانخراط بقوة وعمق في هذا الحوار، لمساعدة عموم السوريين على فهم الرهانات المطروحة، والمسائل الخلافية، والشروط الضرورية لبناء صرح الهوية الوطنية من جديد، بعد أن هدمتها الحرب الوحشية ضد السوريين، ومن أجل تقسيمهم وبث الفرقة بينهم، وإخضاعهم لإرادة القوى الأجنبية الطامحة إلى التوسع والسيطرة.
في هذه المسيرة التحرّرية المستمرة والمعقدة، أكثر ما يحتاجه السوريون هو العودة إلى روح ثورة آذار المغدورة، السلمية والمدنية، وإعادة تنظيم صفوفهم، في ما وراء الموالاة والمعارضة، وتوحيد كلمتهم حول انتقال سياسي، وعهد وطني يحفظ للجميع حقوقهم ومصالحهم، وينهي عهد الانقسام والفرقة التي اشتغل عليها النظام، وراهن عليها ونجح، إلى حد كبير، بفضل تقويضه المسبق، وخلال عقود، ثقافة السوريين الوطنية، وقيمهم المدنية، وروح التضامن والتكافل التي لا يقوم من دونها أي بناء وطني أو نسيج اجتماعي.
وتبقى ثورة العشرين من القرن الماضي، بمقاوماتها وكتلتها الوطنية، وتفاهم نخبها الاجتماعية، وخطها الديمقراطي التعددي، نموذجا ملهما لانبعاث سورية من موتها، وتعلم الأجيال السورية الجديدة أبجدية الحرية والاستقلال الوطنيين.