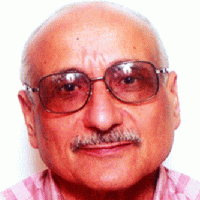30 أكتوبر 2024
الشعبوية في قراءة جديدة
يسألني بعض من أعرف عن "الشعبوية"، بعدما دخلت قاموسنا السياسي مع وثوب دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة، وهل عرفها عالمنا العربي؟
يتجاهل السائلون أننا كنا أكثر من عرف "الشعبوية"، واكتوى بنيرانها، وعاش عليها ومعها عقودا طويلة، وقد هتفنا لمن جاء بها بالروح وبالدم، لكننا، والحق يقال، كنا نعتبر أنفسنا محظوظين بوجود قادة شعوبيين عندنا، يخاطبوننا مباشرةً كأنهم من أهل بيتنا، وينوبون عنا في تقرير مصائرنا، وصياغة مستقبل أولادنا، ويمنحوننا مكرماتهم كلما ادلهمت الخطوب بنا. وعندما غابوا عنا دخلنا في الفوضى الكبيرة، وقد فقدنا في غيابهم الساعد الذي نتكئ عليه، والمشجب الذي نعلق عليه أخطاءنا وخطايانا!
مثل هذا السؤال واجه عديداً من الكتاب في بلدان وقارات أخرى، واحد منهم هو كارلوس دورادو، الأرجنتيني الذي قيل إن قارّته الأميركية اللاتينية عرفت "الشعبوية"، وتغذت عليها قبلنا، منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر، لكنه لا يقرّ بهذا. ولذلك، نشر دراسة قدم فيها قراءة جديدة، تؤصل التيارات الشعبوية إلى ما قبل ولادة السيد المسيح بأربعة قرون، وفيها يقول إن "الآباء" الذين منحوا الولادة للنظام الديمقراطي هم أنفسهم من شرعن "الشعبوية"، وأعطاها شهادة الحياة، وهو أيضا لا يضع فاصلا بين "الشعبوية" و"الديماغوجية"، فكل منهما تكمل الأخرى. يشرح دورادو كيف سيطرت إمبراطورية أثينا على خطوط البحر، وكيف هيمنت من خلال ذلك على العالم كله، وأمدّت شرايين حياتها بأموال فائضةٍ من موارد التجارة عالية القيمة، وحققت ازدهارا اقتصاديا ساعد على إيجاد مهنة جديدة هي مهنة "السياسة"، وفئة جديدة تعمل في هذا الميدان، قوامها مواطنون تطوّعوا لإدارة الخدمات العامة، والتخطيط لمستقبل عامة الناس، عبر إعداد القوانين والتشريعات المتعلقة بذلك، لكنهم يتقاضون من مواطنيهم مكافآت مالية كافية لتدبير حاجيات أسرهم، ولإبقائهم بعيدين عن البحث عن موارد للعيش، قد تكون غير شرعية، وقد تلقي بهم في مهاوي الفساد.
تلك كانت بداية نشوء ما يمكن أن يُطلق عليه "طبقة سياسية" شبه متفرّغة، وممثلة لرغبات مواطنيها بقدر ما، تلك أيضا كانت، بحسب دورادو، بداية نقل السلطة من الحاكم الدكتاتور والمستبد إلى الشعب، وهو ما عرف في ما بعد بالديمقراطية، ثمة إشكالية برزت هنا، إذ عندما شعر عامة الناس أن ممارسة السياسة يستتبعها نفع مالي أكثر، وجهد أقل، أخذوا يسعون إلى الانخراط فيها طريقة للعيش والحياة، وشرعوا يهجرون مهنهم، بعد أن كانوا يكدحون في حقول الزراعة والتجارة والخدمات العامة. وفي النهاية، حصل التوافق: تتولى النخبة سلطة القرار والتشريع، وعامة الناس تفوّض النخبة أمرها، على أن تتولى هي اختيار الناس الذين تراهم لقيادتها، وحيث أن عامة الناس الذين يتولون عملية الاختيار لا تبدو، كما يقول دورادو، مؤهلةً للتقييم، ولا تملك إمكانية التحليل المنطقي لاختيار الأفضل والأنسب لسلطة القرار، وكثيرا ما تكون اختياراتها ساذجة، وذات نزعة عاطفية، أدى ذلك كله إلى نشوء ما نسميه اليوم "الشعبوية"، وولادة "قادة" لهم شخصية كاريزمية، بارعين في الخطابة، ماهرين في اجتذاب الدهماء، قادرين على صياغة ما يريدونه لأنفسهم تحت لافتة "حماية الوطن وخدمة المواطن"، مستخدمين شتى أساليب الإقناع والترويج، ومنها إطراء الناس المتلقين، والإشادة بمآثرهم، والتغني بأمجادهم السالفة، والإيحاء لهم بأن الشعب وحده صاحب السلطة والقرار، فيما هم منفذون إرادته فقط!
يقول دورادو إن القادة الشعبويين ينجحون عادة في كسب مواطنيهم، إلى درجة أن حملات التضليل تصرف المواطنين العاديين عن مراقبة ما يفعله أولئك القادة، وحتى قد يساهم المواطنون أنفسهم في إيجاد المبرّرات لأخطاء القادة وخطاياهم، من دون وعي، وجرّاء السحر الذي يمارس عليهم، والذي سرعان ما يفرض عليهم الطاعة والانصياع والولاء التام.
عبر هذا السياق، تأسست "الشعبوية" على غرس صورة كارزمية، وقدرة على الحوار الغني بالوعود، والبراعة في الخطابة، والتلاعب بالألفاظ والكلمات، وتحول روادها إلى خبراء في مهنة "السياسة"، وهم، تحديداً، الآباء الأُول للشعبوية والديماغوجية معا، وما هو لافت للنظر أن مئات السنين مرّت على ولادتها، لكنها بقيت حية ومؤثرة، كما أطلقت في يومها الأول، واللافت أكثر أن الناس العاديين يكتشفونها، وينبذونها، لكنهم سرعان ما يعودون إليها، ويرضون بالعيش في ظلها، ذلك لأن الإنسان لا يتعلم من أخطائه، وهو "الحيوان الوحيد الذي يتعثر بالصخرة ذاتها مرتين، وربما مرات"، يقول دورادو.
يتجاهل السائلون أننا كنا أكثر من عرف "الشعبوية"، واكتوى بنيرانها، وعاش عليها ومعها عقودا طويلة، وقد هتفنا لمن جاء بها بالروح وبالدم، لكننا، والحق يقال، كنا نعتبر أنفسنا محظوظين بوجود قادة شعوبيين عندنا، يخاطبوننا مباشرةً كأنهم من أهل بيتنا، وينوبون عنا في تقرير مصائرنا، وصياغة مستقبل أولادنا، ويمنحوننا مكرماتهم كلما ادلهمت الخطوب بنا. وعندما غابوا عنا دخلنا في الفوضى الكبيرة، وقد فقدنا في غيابهم الساعد الذي نتكئ عليه، والمشجب الذي نعلق عليه أخطاءنا وخطايانا!
مثل هذا السؤال واجه عديداً من الكتاب في بلدان وقارات أخرى، واحد منهم هو كارلوس دورادو، الأرجنتيني الذي قيل إن قارّته الأميركية اللاتينية عرفت "الشعبوية"، وتغذت عليها قبلنا، منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر، لكنه لا يقرّ بهذا. ولذلك، نشر دراسة قدم فيها قراءة جديدة، تؤصل التيارات الشعبوية إلى ما قبل ولادة السيد المسيح بأربعة قرون، وفيها يقول إن "الآباء" الذين منحوا الولادة للنظام الديمقراطي هم أنفسهم من شرعن "الشعبوية"، وأعطاها شهادة الحياة، وهو أيضا لا يضع فاصلا بين "الشعبوية" و"الديماغوجية"، فكل منهما تكمل الأخرى. يشرح دورادو كيف سيطرت إمبراطورية أثينا على خطوط البحر، وكيف هيمنت من خلال ذلك على العالم كله، وأمدّت شرايين حياتها بأموال فائضةٍ من موارد التجارة عالية القيمة، وحققت ازدهارا اقتصاديا ساعد على إيجاد مهنة جديدة هي مهنة "السياسة"، وفئة جديدة تعمل في هذا الميدان، قوامها مواطنون تطوّعوا لإدارة الخدمات العامة، والتخطيط لمستقبل عامة الناس، عبر إعداد القوانين والتشريعات المتعلقة بذلك، لكنهم يتقاضون من مواطنيهم مكافآت مالية كافية لتدبير حاجيات أسرهم، ولإبقائهم بعيدين عن البحث عن موارد للعيش، قد تكون غير شرعية، وقد تلقي بهم في مهاوي الفساد.
تلك كانت بداية نشوء ما يمكن أن يُطلق عليه "طبقة سياسية" شبه متفرّغة، وممثلة لرغبات مواطنيها بقدر ما، تلك أيضا كانت، بحسب دورادو، بداية نقل السلطة من الحاكم الدكتاتور والمستبد إلى الشعب، وهو ما عرف في ما بعد بالديمقراطية، ثمة إشكالية برزت هنا، إذ عندما شعر عامة الناس أن ممارسة السياسة يستتبعها نفع مالي أكثر، وجهد أقل، أخذوا يسعون إلى الانخراط فيها طريقة للعيش والحياة، وشرعوا يهجرون مهنهم، بعد أن كانوا يكدحون في حقول الزراعة والتجارة والخدمات العامة. وفي النهاية، حصل التوافق: تتولى النخبة سلطة القرار والتشريع، وعامة الناس تفوّض النخبة أمرها، على أن تتولى هي اختيار الناس الذين تراهم لقيادتها، وحيث أن عامة الناس الذين يتولون عملية الاختيار لا تبدو، كما يقول دورادو، مؤهلةً للتقييم، ولا تملك إمكانية التحليل المنطقي لاختيار الأفضل والأنسب لسلطة القرار، وكثيرا ما تكون اختياراتها ساذجة، وذات نزعة عاطفية، أدى ذلك كله إلى نشوء ما نسميه اليوم "الشعبوية"، وولادة "قادة" لهم شخصية كاريزمية، بارعين في الخطابة، ماهرين في اجتذاب الدهماء، قادرين على صياغة ما يريدونه لأنفسهم تحت لافتة "حماية الوطن وخدمة المواطن"، مستخدمين شتى أساليب الإقناع والترويج، ومنها إطراء الناس المتلقين، والإشادة بمآثرهم، والتغني بأمجادهم السالفة، والإيحاء لهم بأن الشعب وحده صاحب السلطة والقرار، فيما هم منفذون إرادته فقط!
يقول دورادو إن القادة الشعبويين ينجحون عادة في كسب مواطنيهم، إلى درجة أن حملات التضليل تصرف المواطنين العاديين عن مراقبة ما يفعله أولئك القادة، وحتى قد يساهم المواطنون أنفسهم في إيجاد المبرّرات لأخطاء القادة وخطاياهم، من دون وعي، وجرّاء السحر الذي يمارس عليهم، والذي سرعان ما يفرض عليهم الطاعة والانصياع والولاء التام.
عبر هذا السياق، تأسست "الشعبوية" على غرس صورة كارزمية، وقدرة على الحوار الغني بالوعود، والبراعة في الخطابة، والتلاعب بالألفاظ والكلمات، وتحول روادها إلى خبراء في مهنة "السياسة"، وهم، تحديداً، الآباء الأُول للشعبوية والديماغوجية معا، وما هو لافت للنظر أن مئات السنين مرّت على ولادتها، لكنها بقيت حية ومؤثرة، كما أطلقت في يومها الأول، واللافت أكثر أن الناس العاديين يكتشفونها، وينبذونها، لكنهم سرعان ما يعودون إليها، ويرضون بالعيش في ظلها، ذلك لأن الإنسان لا يتعلم من أخطائه، وهو "الحيوان الوحيد الذي يتعثر بالصخرة ذاتها مرتين، وربما مرات"، يقول دورادو.