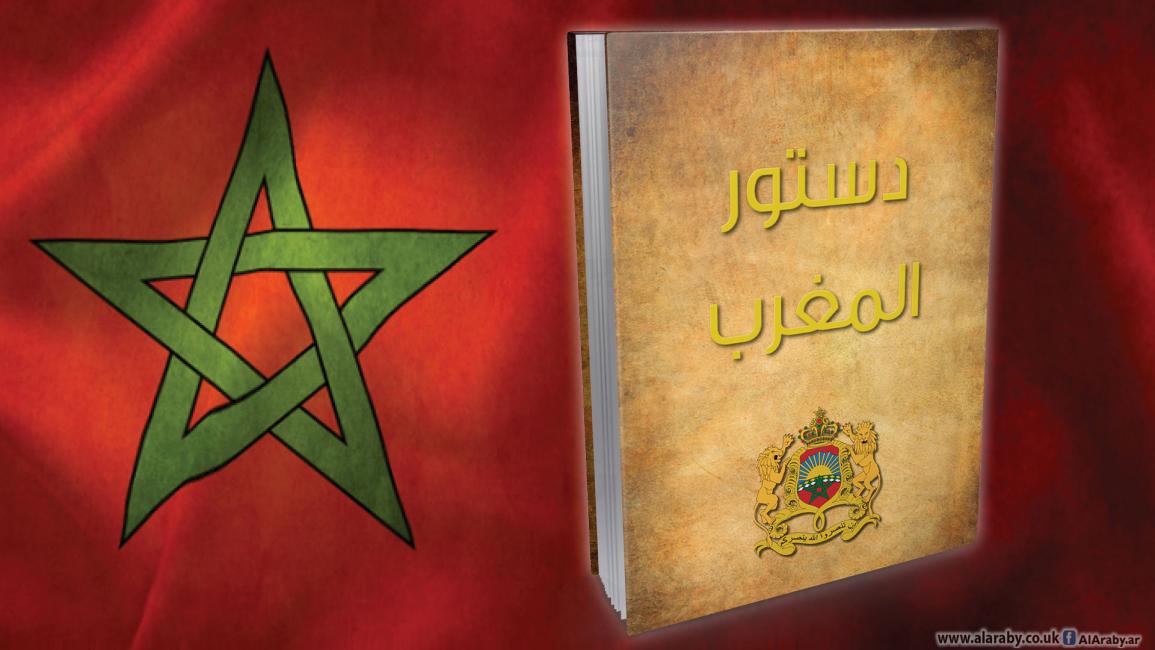01 فبراير 2019
المغرب.. معارضة الدستور
ظلت المعارضة في المغرب حاضرةً في جميع التجارب البرلمانية، من دون أن تتمتع بوضع قانوني خاص، يُكسبها حقوقا محدّدة تميّزها عن الأغلبية البرلمانية، ويعطيها وضعا امتيازيا إزاءها، اللهم ما يتعلق بـ"حقوق ضمنية" كانت متاحة لجميع البرلمانيين، بغض النظر عن اختياراتهم السياسية، قبل أن يُحدث دستور 2011 بعض التحول على هذا المستوى، لم تعد معه المعارضة مجرّد فاعل سياسي، بل أصبحت أيضا موقعا قانونيا، كما لم تعد مختزلةً في مؤسسة الحزب السياسي، وإنما امتدت إلى فضاء البرلمان، عبر قناة فرق المعارضة البرلمانية، وإن لم يمنع هذا التحول من استمرار عملها مكبلا بقيودٍ تحدّ كثيرا من هامش تحرّكها.
هكذا، إذا كان الاعتراف الدستوري بحقوق المعارضة البرلمانية يعد اختيارا أساسيا لعدد من الديمقراطيات الجديدة، فقد حاول الدستور المغربي مسايرة هذا التوجه، عندما عمل، ولأول مرة، على الإقرار الصريح بشرعية المعارضة البرلمانية، في التأكيد على أنها "مكون أساسي في المجلسين، وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة". والتسليم بحقها في "ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، محليا وجهويا ووطنيا". علاوة على تحديد قائمةٍ بالحقوق المتاحة لها، قبل أن يسند مهمة تحديد كيفية ممارستها تلك الحقوق إلى قوانين تنظيمية أو قوانين النظام الداخلي لكل مجلسٍ من مجلسي البرلمان.
هل نحن أمام وضع دستوري للمعارضة، أم أمام مكانةٍ تخولها حقوقاً، أم أمام مركز قانوني للمعارضة؟
إذا كان الدستور قد اعتمد كلمة المكانة مرادفا لمصطلح "un statut" الوارد في الصيغة
الفرنسية من الدستور، فإن على مستوى خطاب الفاعلين هناك تأرجح بين "المكانة" و"النظام الخاص"، بما في ذلك الخطب الملكية، حيث خصّص الخطاب الملكي، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثالثة من الولاية التاسعة، فقرات قوية للدعوة "إلى إخراج النظام الخاص بالمعارضة البرلمانية، لتمكينها من النهوض بمهامها، في مراقبة العمل الحكومي، والقيام بالنقد البناء وتقديم الاقتراحات والبدائل الواقعية". وفي افتتاح السنة التشريعية الثانية، تطرق الخطاب الملكي إلى احترام "الوضع القانوني للمعارضة البرلمانية ولحقوقها الدستورية".
الوجه الآخر، والأكثر تعقيدا، لإشكالية مكانة المعارضة، يوجد في الاجتهاد الذي طوّره المجلس الدستوري بشأن مسألة النظام الخاص للمعارضة، بمناسبة مراقبته النظام الداخلي لمجلس النواب، سواء في قراره، في 16 فبراير/شباط 2012، أو في 22 أغسطس/آب 2013. ويرتبط مضمون هذا الاجتهاد بتأكيد هذا المجلس "منح المعارضة حقا خاصا بها من دون أن يمنح أيضا للأغلبية" أمر مخالف للدستور، وفيه مسٌّ واضح بمبدأ النسبية، وبقاعدة المساواة في التمثيل الديمقراطي بين جميع نواب الأمة، فلا يمكن التمييز بين النواب، في ممارسة حقوقهم الدستورية ومهامهم البرلمانية، بسبب انتمائهم إلى فرق نيابية دون أخرى. وهذا ما يعني بالضبط أن للقضاء الدستوري فهماً معيناً لمسألة الوضع الخاص الذي يعطي المعارضة وضعا متقدّما عما يتيحه لها النظام العام (التمثيل النسبي). وهنا، يتسع هامش التأويل لدى القاضي الدستوري كلما كان هناك متسع من المساحة بين المبادئ العامة وبعض المقتضيات الخاصة.
لذلك، ينطلق هذا القاضي من مبدأ المساواة باعتباره مبدأ عاما، ومن قواعد تشجيع المشاركة النسائية، أو ضمان مكانة المعارضة كمقتضياتٍ خاصة. وهنا يُطرح السؤال الضروري: متى نطبق المبدأ العام؟ متى نطبق القواعد الخاصة؟ متى نعود إلى منطق المساواة، أو ما يسميه المجلس الدستوري قاعدة التمثيل الديمقراطي، المبنية على الانتخابات ونتائجها؟ ومتى نُطبق قاعدة "المكانة" التي حرص الدستور على تخويلها للمعارضة: مثلا في حالة اقتسام الحصة المتعلقة بالنواب في الجلسة الشهرية.
في حالة المقتضيات الخاصة بالمشاركة النسائية، كان القضاء الدستوري واضحاً في تحديد
الحجج المحدّدة لكل من الاختيارين: البقاء في مستوى القاعدة العامة أو اللجوء إلى المقتضيات الخاصة، حيث اعتبر المجلس الدستوري أن الإجراءات المؤقتة للتحفيز الإيجابي تبقى مطبوعةً بالخصائص التالية: المحدودة، الاستثنائية والمرحلية. وإذا كان المقصود بها تدخل المشرّع لتصحيح اختلالاتٍ مجتمعية وثقافية، لن تمكّن النساء، لحظة الاقتراع العام، من تمثيلية ملائمة، فإن من غير المقبول نقل العمل بهذه التدابير من المجتمع إلى داخل مؤسسات النخبة، مثل مجلس النواب.
وفي حالة وضع المعارضة، لا يوضح المجلس الدستوري في قراراته متى يتم الانتقال من النظام العام، أو قاعدة المساواة بين النواب، إلى قاعدة النظام الخاص للمعارضة، ما يجعل المجلس الدستوري يمارس سلطة تقديرية كبيرة في هذا الشأن.
في النهاية، يوضح الوقوف على النص الدستوري، والنظامين الداخليين للبرلمان واجتهادات القاضي الدستوري، أننا تجاوزنا قليلاً تعميم منطق المساواة والنسبية قاعدة وحيدة للعمل البرلماني، لكننا لم نصل بعد إلى مستوى النظام الخاص للمعارضة. وقد اعتبر المجلس الدستوري اللجوء إلى إعمال قواعد المكانة الخاصة بمثابة استثناء على قاعدة عامة هي التمثيل الديمقراطي. وهنا تبدو "اللغة" بليغة: هناك مكانة للمعارضة فقط وليس نظاماً خاصاً.
على مستوى الممارسة، تفيد معطيات الولاية التشريعية التاسعة (2011 ــ 2016) بأن الحصيلة التشريعية، بشكل عام، لا تتجاوز 7% تقريبا من القوانين المصادقة عليها بمبادرة برلمانية في مقابل 93% من القوانين المصادقة عليها التي ولدت بمبادرة حكومية. أما الحصيلة التشريعية للمعارضة فلا تتجاوز 1% على أبعد تقدير من القوانين المصادقة عليها بمبادرة برلمانية. وعلى المستوى الرقابي، لم تستطع المعارضة في علاقتها مع السلطة التنفيذية أن تفعل أيا من الآليات الرقابية الكبرى والأساسية.
هكذا، إذا كان الاعتراف الدستوري بحقوق المعارضة البرلمانية يعد اختيارا أساسيا لعدد من الديمقراطيات الجديدة، فقد حاول الدستور المغربي مسايرة هذا التوجه، عندما عمل، ولأول مرة، على الإقرار الصريح بشرعية المعارضة البرلمانية، في التأكيد على أنها "مكون أساسي في المجلسين، وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة". والتسليم بحقها في "ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، محليا وجهويا ووطنيا". علاوة على تحديد قائمةٍ بالحقوق المتاحة لها، قبل أن يسند مهمة تحديد كيفية ممارستها تلك الحقوق إلى قوانين تنظيمية أو قوانين النظام الداخلي لكل مجلسٍ من مجلسي البرلمان.
هل نحن أمام وضع دستوري للمعارضة، أم أمام مكانةٍ تخولها حقوقاً، أم أمام مركز قانوني للمعارضة؟
إذا كان الدستور قد اعتمد كلمة المكانة مرادفا لمصطلح "un statut" الوارد في الصيغة
الوجه الآخر، والأكثر تعقيدا، لإشكالية مكانة المعارضة، يوجد في الاجتهاد الذي طوّره المجلس الدستوري بشأن مسألة النظام الخاص للمعارضة، بمناسبة مراقبته النظام الداخلي لمجلس النواب، سواء في قراره، في 16 فبراير/شباط 2012، أو في 22 أغسطس/آب 2013. ويرتبط مضمون هذا الاجتهاد بتأكيد هذا المجلس "منح المعارضة حقا خاصا بها من دون أن يمنح أيضا للأغلبية" أمر مخالف للدستور، وفيه مسٌّ واضح بمبدأ النسبية، وبقاعدة المساواة في التمثيل الديمقراطي بين جميع نواب الأمة، فلا يمكن التمييز بين النواب، في ممارسة حقوقهم الدستورية ومهامهم البرلمانية، بسبب انتمائهم إلى فرق نيابية دون أخرى. وهذا ما يعني بالضبط أن للقضاء الدستوري فهماً معيناً لمسألة الوضع الخاص الذي يعطي المعارضة وضعا متقدّما عما يتيحه لها النظام العام (التمثيل النسبي). وهنا، يتسع هامش التأويل لدى القاضي الدستوري كلما كان هناك متسع من المساحة بين المبادئ العامة وبعض المقتضيات الخاصة.
لذلك، ينطلق هذا القاضي من مبدأ المساواة باعتباره مبدأ عاما، ومن قواعد تشجيع المشاركة النسائية، أو ضمان مكانة المعارضة كمقتضياتٍ خاصة. وهنا يُطرح السؤال الضروري: متى نطبق المبدأ العام؟ متى نطبق القواعد الخاصة؟ متى نعود إلى منطق المساواة، أو ما يسميه المجلس الدستوري قاعدة التمثيل الديمقراطي، المبنية على الانتخابات ونتائجها؟ ومتى نُطبق قاعدة "المكانة" التي حرص الدستور على تخويلها للمعارضة: مثلا في حالة اقتسام الحصة المتعلقة بالنواب في الجلسة الشهرية.
في حالة المقتضيات الخاصة بالمشاركة النسائية، كان القضاء الدستوري واضحاً في تحديد
وفي حالة وضع المعارضة، لا يوضح المجلس الدستوري في قراراته متى يتم الانتقال من النظام العام، أو قاعدة المساواة بين النواب، إلى قاعدة النظام الخاص للمعارضة، ما يجعل المجلس الدستوري يمارس سلطة تقديرية كبيرة في هذا الشأن.
في النهاية، يوضح الوقوف على النص الدستوري، والنظامين الداخليين للبرلمان واجتهادات القاضي الدستوري، أننا تجاوزنا قليلاً تعميم منطق المساواة والنسبية قاعدة وحيدة للعمل البرلماني، لكننا لم نصل بعد إلى مستوى النظام الخاص للمعارضة. وقد اعتبر المجلس الدستوري اللجوء إلى إعمال قواعد المكانة الخاصة بمثابة استثناء على قاعدة عامة هي التمثيل الديمقراطي. وهنا تبدو "اللغة" بليغة: هناك مكانة للمعارضة فقط وليس نظاماً خاصاً.
على مستوى الممارسة، تفيد معطيات الولاية التشريعية التاسعة (2011 ــ 2016) بأن الحصيلة التشريعية، بشكل عام، لا تتجاوز 7% تقريبا من القوانين المصادقة عليها بمبادرة برلمانية في مقابل 93% من القوانين المصادقة عليها التي ولدت بمبادرة حكومية. أما الحصيلة التشريعية للمعارضة فلا تتجاوز 1% على أبعد تقدير من القوانين المصادقة عليها بمبادرة برلمانية. وعلى المستوى الرقابي، لم تستطع المعارضة في علاقتها مع السلطة التنفيذية أن تفعل أيا من الآليات الرقابية الكبرى والأساسية.