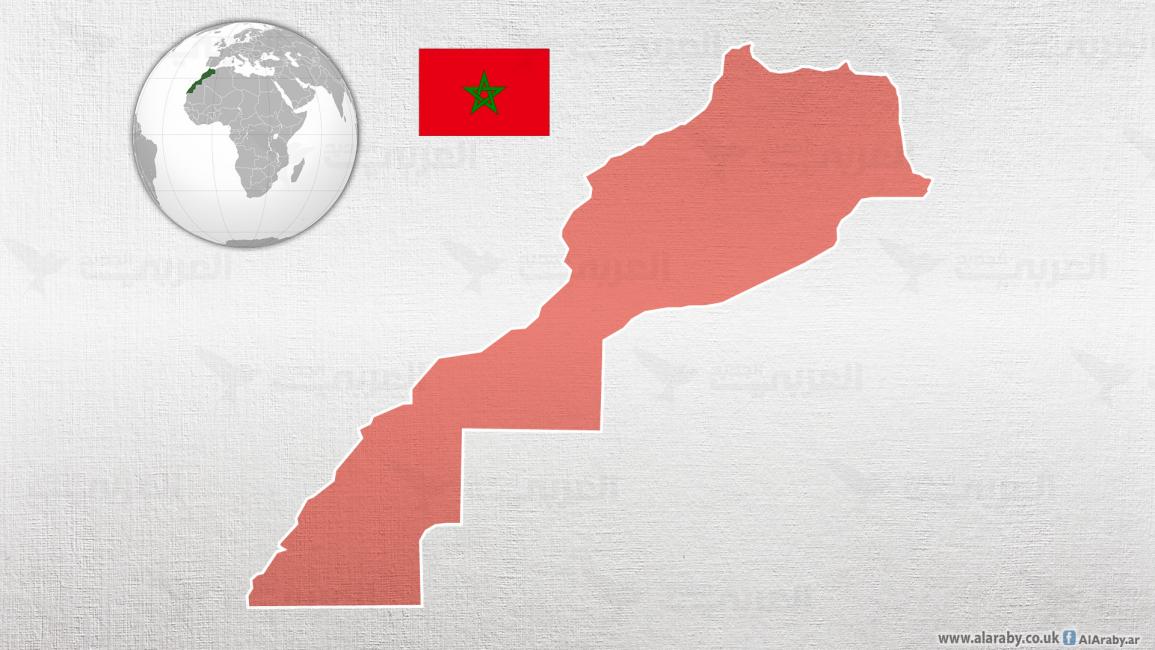19 نوفمبر 2024
خوف على حرية الشبكات الاجتماعية في المغرب
إذا كان من أعراض الحالة لفيروس كورونا، ضيق التنفس، فإن هذا الفيروس لم يكن هو المتسبب الأكبر له، في أوساط الطبقة السياسية والاعلامية في المغرب، بقدر ما يكمن السبب في الاطلاع على بعض مواد قانون أضحى يسمى "قانون المنصّات الاجتماعية". وعلى الرغم من أن هذا القانون لم يطرح بعدُ، رسميا عبر القنوات المؤسساتية المنصوص عليها في الدستور والقوانين المنظمة لدواليب الدولة في المملكة، فقد طغت مناقشات المغاربة تفاصيل هذا القانون وحيثياته، على مناقشة كل ما عداه وسبقه. ويحق القول، بدون كثير مبالغة، إن فيروس كوفيد 19 لم يفعل ما فعله القانون رقم 22/20، المتعلق بالمنصات الاجتماعية وشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، في الطبقة السياسية المغربية.
كان تدبير الجائحة الكونية قد وضع المغرب في مراتب متقدّمة في تصنيف الدول التي قادت، بنجاعة عالية، الإجراءات الاستباقية لاحتواء كورونا: وفرت الدولة الشروط مجتمعة، صحيا واجتماعيا واقتصاديا، بطريقةٍ جعلت الإعلام الفرنسي، كما هو حال "لوكانار أونشينيه" الساخرة والقاسية، والبرلمانيين، كما هو اليساري الراديكالي، جان لوك ميلانشون، الذي افتخر بأصوله المغربية أمام البرلمان، يطالبون زملاءهم في القبة والصحافة بإبداء الإعجاب بالتجربة المغربية.
كان كل شيء يسير على ما يرام، والطبقة السياسية كلها ملتفةٌ حول خطوات ملك البلاد، من
حيث إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية، وفرض الحجْر الصحي، ثم الطوارئ الصحية، وتعطيل التنقل والحركة والخروج ليلا من السابعة إلى الخامسة فجرا، ثم استدراك الخصاص الاجتماعي بتوفير مساعداتٍ ماديةٍ مهمةٍ لأزيد من خمسة ملايين أسرة، بما معدله ثلاثة أفراد في الواحدة، وهو ما يقارب 15 مليون مغربي، بمن فيهم الذين تعطلوا من العمل، والمحسوبون على هامش دورة الإنتاج والوظيفة،.. إلخ. وخلفت هذه القرارات وراءها نقاشات كبيرة في الدول الأورو - متوسطية على الضفة الشمالية خصوصا، وهو ما لم يحدث، في جنوبها. وساير المغاربة، بمن فيهم الأكثر شراسة في معارضة النظام والحكومة معا، هذه القرارات مع مراقبة سلامة التنفيذ. ولم تغمض الدولة بذاتها العين عن التجاوزات، وتمت تحقيقات أمنية وإدارية مع الذين تجاوزوا الحد في التعامل مع من خرق القانون المتعلق بالحرمان من الحق في التنقل والتجمع والتجمهر والتظاهر السلمي وبعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبر إغلاق المحال التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم.
ما الذي وقع حتى اهتزت الأرض، ودكت الجبال دكا؟ حدث أنه تم نشر ما سميت مسودة القانون المتعلق بالشبكات الاجتماعية، لا سيما منه المادة 14، والتي تهم معاقبة كل من يدعو إلى مقاطعة مواد تجارية بعينها، أو الدعوة إلى اتخاذ مواقف من بضائع أو مواد استهلاكية أو سحب الأموال من مؤسسات الائتمان.. إلخ. وثارت الثائرة العامة ضد العقوبات القاسية المقرّرة لهذه التهم، وتحولت الساحة العامة إلى ساحة نقاش حول القانون ومسؤوليات كل طرف فيه.
المشهد اليوم قابل للتلخيص بسرعة: الكل تنصل منه، والأكثر طيبوبة من مكونات الائتلاف الحكومي مع حليفهم الاشتراكي (المشارك في الأغلبية) دعوا إلى تسريع عرض المشروع على البرلمان من أجل مناقشته رسميا. وهؤلاء يريدون بالفعل أن يجرّوا رئيس الحكومة ووزير العدل إلى مقصلة برلمانية بترسيم عرض المشروع على البرلمان، وتسجيله في ذمتهم سلبيا،
كومضة سوداء للتاريخ و.. للانتخابات المقبلة.
أولا، حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة في شخص أمينه العام، سعد الدين العثماني، لم يحرّك ساكنا للدفاع عن مشروع القانون، على الرغم من أن رئيس الحكومة هو المسؤول، حسب القانون التنظيمي المتعلق بتسيير أشغال الحكومة وتنظيمها وتسييرها، بل إن المعروف، الى حد الساعة، هو موقف شبيبة الحزب التي يرأسها وزير الشغل والتكوين المهني في الحكومة الذي دعا إلى معارضة هذا المشروع، كما يعرف موقف وزير الدولة في حقوق الإنسان، من خلال ما سميت مرافعته ضد مادة من مواد هذا القانون، المذكورة سلفا. بل إنه يعود، في تدوينة يوم 28 إبريل/ نيسان الماضي ليعترف بأن النسخة التي كتب في حقها مرافعته ليست هي النسخة النهائية التي ستتبناها الحكومة.
الحكومة في ورطة تنظيمية وسياسية: أعلنت في بيان لها يوم 19 مارس/ آذار أنها صادقت على المشروع، وفي تبريراتها البعيدة تقول إنها تنتظر استكمال التعديلات، والتي تتولاها لجنة تقنية وأخرى وزارية! باقي أعضاء الأغلبية كل ذهب إلى مشربه، وترك الحبل على الغارب، فيما ينبئ بهشاشة كبيرة داخل الائتلاف الحكومي، وإن اعتادها المغاربة فهم لا يغفرونها اليوم في هذه الظروف الصعبة للغاية، فالاغلبية الحكومية أصدرت بلاغات (بيانات) تلو أخرى من أجل التبرؤ، بوضوح أو بتلميح، من هذا القانون، وذهب الأمين العام للحركة الشعبية (يرأسها وزير داخلية سابق) إلى حد وضع احتمال سحب المشروع "إذا ثبت أن الحكومة أخطأت (!).
حامل المشروع، الذي هو وزير العدل، من الاتحاد الاشتراكي، محمد بن عبد القادر، أصبح وحيدا وسط العاصفة، والتزم الصمت إلى حين رفع الحجر. ولكن المشهد أبعد من أن يكون صامتا، والغليان هو سيد الموقف حتى داخل الحزب الذي ينتمي إليه الوزير، والهيئات الموازية من محامين وحقوقيين وهيئات محلية، تنكرت لهذا القانون، ودعت إلى سحبه، أو راسلت رئيس الحكومة، كما فعل المجلس الوطني للصحافة الذي طالب بإحالة المشروع عليه، من أجل البت فيه، باعتبار هذا حقا دستوريا.
ووجدت الأحزاب المعارضة، الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، نقطة للتميز في وضع سياسي يعطي الحكومة الكلمة الوحيدة في المشهد، يُظهرها كمتحرّك وحيد في ظل التعبئة الوطنية خلف الدولة، فالحكومة، المسؤولة عن تنفيذ (وتنزيل) كل ما له علاقة
بالوضع، تبعا لاستراتيجية العاهل المغربي، كانت تستفرد بالمشهد، وإنْ كان الجميع يرى أن الأداء العام لرئيسها وللوزراء أقل بكثير مما هو مطلوب، سيما تلك الهفوات الصارخة من قبيل الدعوة الى عدم ارتداء الكمّامات في بداية الوباء، والتهوين كثيرا من حجم الإصابات والإجراءات الذي جاء على لسان المخاطب الرسمي في البلاد، مدير مديرية الأوبئة.
الواضح الآن أن نقاشات الحرية والتمتع بها لم تدخل عن طريق الإجراءات غير المسبوقة في تاريخ المغرب، ولا في تاريخ البشرية، كما أنها لم تطرح من باب مقارنات مع دول أخرى، بل طرحت من بنود مشروع تسرّبت عبر المنصّات الاجتماعية التي انتقمت لنفسها منه، عندما سعى إلى تقنينها. ويبدو أن المغاربة الذين قبلوا بالالتزام ببيوتهم، بسبب الحظر، اعتبروا محاولة تلجيم دخولهم إلى المنصات الاجتماعية، أو دخولها تحت طائلة التهديد بالعقوبة، حظرا مزدوجا.. كما لم يفهم جزء من الرأي العام كيف يكون التشهير بمادّة غذائية، كالحليب، موجبا لعقوبات تتجاوز ضرب معنويات الجيش مثلا! وهو ما أوله بعضهم بأنه انتصار لكبار الأثرياء والمقاولين الذين يجدون في وجوه وتنظيمات سياسية بعينها تمثيلية حقيقية..
الواضح كذلك أن الأزمة الحالية وضعت خبراء "الماركتينغ السياسي" على محك امتحان عسير، أمام بساطة العمل التواصلي، لأزيد من عشرين مليون مغربي ومغربية يلجون المنصات موضع القانون، كلهم يتنفسون الواقع من خلال التواصل والشبكات. وقد فات أصحاب المبالغة في بعض بنود القانون معنى قوة الشبكات التواصلية في المغرب، وكيف تحوّلت الى منصاتٍ لتقديم عروض سياسية، طالما تعامل معها مركز الدولة بالجدّية اللازمة. ليس فقط إبّان الربيع الفبرايري، بل أيضا في قضية البيدوفيلي الإسباني الذي سبق له أن مُتِّع بالعفو من العاهل المغربي، قبل سحب هذا العفو تجاوبا من عاهل البلاد مع موجات الغضب. وبالنسبة للوزراء، فليست المنصات والشبكات قضية تكنولوجيا فقط، بل هي قضية تجربة أيضا. ومن سبق منهم أن خضع لها لا يحتفظ عنها بذكريات جميلة أو أنهم اختفوا تماما.
ومع ذلك، فإن في النقاش الدائر نقطة قوة كبيرة: كل المواقف التي ناهضت القانون عادت إلى النص الدستوري، ووجدت في الوثيقة التي صادق عليها المغاربة، في عز الربيع العربي، مرجعيةً تقف في وجه المشروع الحكومي. ونقطة قوة ليست هينة، لأن الجميع عاد إلى ديباجة الدستور، ورفعه من قيمة حرية التعبير والرأي، وجعل من الخيار الديمقراطي رابع الثوابت، بعد الدين والملكية والوحدة الترابية.. علاوة على ربط الكل بالقيم الكونية والمرجعيات الدولية.
كان المشروع أيضا امتحانا للمؤسسات، بما فيها التي تعتبر دستورية، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني للصحافة، أو تعتبر، مهنيا، حارسة المعبد، من قبيل المحامين وهيئاتهم، وكلها تحتمي بالدستور، وتطالب بالحق في إبداء الرأي في المشروع..
خلاصة القول إن المأزق الحكومي، مع تشرذم الأغلبية في التعامل معه من زاوية موحّدة، وصعود الأغلبية إلى منصة التأجيج لا يقلل من قوة الارتجاج العام. إذ لم يسبق للمغرب أن كفَّر هذه المنصات، لا في عزّ التحركات والانتفاضات، ولا في عز مسيرات "20 فبراير" الربيعية عام 2011، ولا في حراكات الغضب في الريف والشرق المغربيين، ولا في التظاهرات الاجتماعية للطلبة الأطباء والمتعاقدين، ولم يتجاوز المطلق العام للحرية، كما يحدث مع بعض بنود القانون المشار إليه، الرامية إلى وضع آلية تقنين المنصّات الاجتماعية التي حازت قوة التنظيم الاجتماعي بقوة التعبئة.
كان كل شيء يسير على ما يرام، والطبقة السياسية كلها ملتفةٌ حول خطوات ملك البلاد، من
ما الذي وقع حتى اهتزت الأرض، ودكت الجبال دكا؟ حدث أنه تم نشر ما سميت مسودة القانون المتعلق بالشبكات الاجتماعية، لا سيما منه المادة 14، والتي تهم معاقبة كل من يدعو إلى مقاطعة مواد تجارية بعينها، أو الدعوة إلى اتخاذ مواقف من بضائع أو مواد استهلاكية أو سحب الأموال من مؤسسات الائتمان.. إلخ. وثارت الثائرة العامة ضد العقوبات القاسية المقرّرة لهذه التهم، وتحولت الساحة العامة إلى ساحة نقاش حول القانون ومسؤوليات كل طرف فيه.
المشهد اليوم قابل للتلخيص بسرعة: الكل تنصل منه، والأكثر طيبوبة من مكونات الائتلاف الحكومي مع حليفهم الاشتراكي (المشارك في الأغلبية) دعوا إلى تسريع عرض المشروع على البرلمان من أجل مناقشته رسميا. وهؤلاء يريدون بالفعل أن يجرّوا رئيس الحكومة ووزير العدل إلى مقصلة برلمانية بترسيم عرض المشروع على البرلمان، وتسجيله في ذمتهم سلبيا،
أولا، حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة في شخص أمينه العام، سعد الدين العثماني، لم يحرّك ساكنا للدفاع عن مشروع القانون، على الرغم من أن رئيس الحكومة هو المسؤول، حسب القانون التنظيمي المتعلق بتسيير أشغال الحكومة وتنظيمها وتسييرها، بل إن المعروف، الى حد الساعة، هو موقف شبيبة الحزب التي يرأسها وزير الشغل والتكوين المهني في الحكومة الذي دعا إلى معارضة هذا المشروع، كما يعرف موقف وزير الدولة في حقوق الإنسان، من خلال ما سميت مرافعته ضد مادة من مواد هذا القانون، المذكورة سلفا. بل إنه يعود، في تدوينة يوم 28 إبريل/ نيسان الماضي ليعترف بأن النسخة التي كتب في حقها مرافعته ليست هي النسخة النهائية التي ستتبناها الحكومة.
الحكومة في ورطة تنظيمية وسياسية: أعلنت في بيان لها يوم 19 مارس/ آذار أنها صادقت على المشروع، وفي تبريراتها البعيدة تقول إنها تنتظر استكمال التعديلات، والتي تتولاها لجنة تقنية وأخرى وزارية! باقي أعضاء الأغلبية كل ذهب إلى مشربه، وترك الحبل على الغارب، فيما ينبئ بهشاشة كبيرة داخل الائتلاف الحكومي، وإن اعتادها المغاربة فهم لا يغفرونها اليوم في هذه الظروف الصعبة للغاية، فالاغلبية الحكومية أصدرت بلاغات (بيانات) تلو أخرى من أجل التبرؤ، بوضوح أو بتلميح، من هذا القانون، وذهب الأمين العام للحركة الشعبية (يرأسها وزير داخلية سابق) إلى حد وضع احتمال سحب المشروع "إذا ثبت أن الحكومة أخطأت (!).
حامل المشروع، الذي هو وزير العدل، من الاتحاد الاشتراكي، محمد بن عبد القادر، أصبح وحيدا وسط العاصفة، والتزم الصمت إلى حين رفع الحجر. ولكن المشهد أبعد من أن يكون صامتا، والغليان هو سيد الموقف حتى داخل الحزب الذي ينتمي إليه الوزير، والهيئات الموازية من محامين وحقوقيين وهيئات محلية، تنكرت لهذا القانون، ودعت إلى سحبه، أو راسلت رئيس الحكومة، كما فعل المجلس الوطني للصحافة الذي طالب بإحالة المشروع عليه، من أجل البت فيه، باعتبار هذا حقا دستوريا.
ووجدت الأحزاب المعارضة، الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، نقطة للتميز في وضع سياسي يعطي الحكومة الكلمة الوحيدة في المشهد، يُظهرها كمتحرّك وحيد في ظل التعبئة الوطنية خلف الدولة، فالحكومة، المسؤولة عن تنفيذ (وتنزيل) كل ما له علاقة
الواضح الآن أن نقاشات الحرية والتمتع بها لم تدخل عن طريق الإجراءات غير المسبوقة في تاريخ المغرب، ولا في تاريخ البشرية، كما أنها لم تطرح من باب مقارنات مع دول أخرى، بل طرحت من بنود مشروع تسرّبت عبر المنصّات الاجتماعية التي انتقمت لنفسها منه، عندما سعى إلى تقنينها. ويبدو أن المغاربة الذين قبلوا بالالتزام ببيوتهم، بسبب الحظر، اعتبروا محاولة تلجيم دخولهم إلى المنصات الاجتماعية، أو دخولها تحت طائلة التهديد بالعقوبة، حظرا مزدوجا.. كما لم يفهم جزء من الرأي العام كيف يكون التشهير بمادّة غذائية، كالحليب، موجبا لعقوبات تتجاوز ضرب معنويات الجيش مثلا! وهو ما أوله بعضهم بأنه انتصار لكبار الأثرياء والمقاولين الذين يجدون في وجوه وتنظيمات سياسية بعينها تمثيلية حقيقية..
الواضح كذلك أن الأزمة الحالية وضعت خبراء "الماركتينغ السياسي" على محك امتحان عسير، أمام بساطة العمل التواصلي، لأزيد من عشرين مليون مغربي ومغربية يلجون المنصات موضع القانون، كلهم يتنفسون الواقع من خلال التواصل والشبكات. وقد فات أصحاب المبالغة في بعض بنود القانون معنى قوة الشبكات التواصلية في المغرب، وكيف تحوّلت الى منصاتٍ لتقديم عروض سياسية، طالما تعامل معها مركز الدولة بالجدّية اللازمة. ليس فقط إبّان الربيع الفبرايري، بل أيضا في قضية البيدوفيلي الإسباني الذي سبق له أن مُتِّع بالعفو من العاهل المغربي، قبل سحب هذا العفو تجاوبا من عاهل البلاد مع موجات الغضب. وبالنسبة للوزراء، فليست المنصات والشبكات قضية تكنولوجيا فقط، بل هي قضية تجربة أيضا. ومن سبق منهم أن خضع لها لا يحتفظ عنها بذكريات جميلة أو أنهم اختفوا تماما.
ومع ذلك، فإن في النقاش الدائر نقطة قوة كبيرة: كل المواقف التي ناهضت القانون عادت إلى النص الدستوري، ووجدت في الوثيقة التي صادق عليها المغاربة، في عز الربيع العربي، مرجعيةً تقف في وجه المشروع الحكومي. ونقطة قوة ليست هينة، لأن الجميع عاد إلى ديباجة الدستور، ورفعه من قيمة حرية التعبير والرأي، وجعل من الخيار الديمقراطي رابع الثوابت، بعد الدين والملكية والوحدة الترابية.. علاوة على ربط الكل بالقيم الكونية والمرجعيات الدولية.
كان المشروع أيضا امتحانا للمؤسسات، بما فيها التي تعتبر دستورية، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني للصحافة، أو تعتبر، مهنيا، حارسة المعبد، من قبيل المحامين وهيئاتهم، وكلها تحتمي بالدستور، وتطالب بالحق في إبداء الرأي في المشروع..
خلاصة القول إن المأزق الحكومي، مع تشرذم الأغلبية في التعامل معه من زاوية موحّدة، وصعود الأغلبية إلى منصة التأجيج لا يقلل من قوة الارتجاج العام. إذ لم يسبق للمغرب أن كفَّر هذه المنصات، لا في عزّ التحركات والانتفاضات، ولا في عز مسيرات "20 فبراير" الربيعية عام 2011، ولا في حراكات الغضب في الريف والشرق المغربيين، ولا في التظاهرات الاجتماعية للطلبة الأطباء والمتعاقدين، ولم يتجاوز المطلق العام للحرية، كما يحدث مع بعض بنود القانون المشار إليه، الرامية إلى وضع آلية تقنين المنصّات الاجتماعية التي حازت قوة التنظيم الاجتماعي بقوة التعبئة.