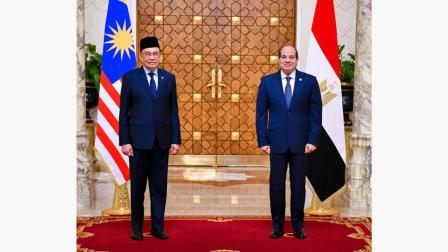تستمر دعوات تنادي بإصلاح منظّمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها المختلفة، وهناك العديد من المقترحات بشأن آليات هذا الإصلاح وكيفياته، لكن معظمها يتجاهل الحوامل الاجتماعية والسياسية التي تناط بها مهمة الإصلاح، والوظيفة التي ينبغي أن تقوم بها المنظّمة في المرحلة الراهنة، بعد سقوط وهم الإصلاح من أعلى في ظل تعارض الإصلاح المنشود مع توجهات واستراتيجيات النخبة السياسية الفلسطينية المهيمنة، التي حرصت تاريخيا على أن لا يخرج أي قرار مؤسسي عن تلك التوجهات والاستراتيجيات.
بعد مضي سنوات على نكبة العام 1948 بدون عودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، ظهرت الحاجة إلى تنظيمهم وإبرازهم شعبا واحدا. استطاع أحمد الشقيري أن ينتزع من الدول العربية المجتمعة في قمة القاهرة العام 1964 موافقة على تشكيل كيان فلسطيني وصفه الشقيري بأنه ليس حكومة، ولا يمارس سيادة، بل هو تنظيم للشعب الفلسطيني يوحّد طاقاته عسكريا وسياسيا وإعلاميا. وفي 28 مايو/أيار من العام نفسه، أعلن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأولى (تألف من 422 عضوا تم تعيينهم لا انتخابهم) قيام منظّمة التحرير الفلسطينية (م. ت. ف.)، وصادق المجتمعون على ميثاقها القومي، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية للمجلس الوطني. انتُخِبَ أحمد الشقيري رئيسا للجنة التنفيذية للمنظّمة، وكلّف باختيار أعضائها وعددهم 14 عضوا. تباينت ردود أفعال الكيانات السياسية والنقابية الفلسطينية ومواقفها من المنظّمة؛ فبينما قرر الاتحاد العام لطلبة فلسطين الانضمام إليها، توجّست منها الزعامة الفلسطينية التقليدية ممثلة بالهيئة العربية العليا بقيادة الحاج أمين الحسيني، ورفضتها "الإسلاموية" الفلسطينية، التي عبّر عنها في حينه "حزب التحرير الإسلامي"، الذي دعا لقيام دولة إسلامية تتم بعدها المباشرة بالجهاد لتحرير فلسطين. نادى كل من حركة القوميين العرب، وجبهة التحرير الفلسطينية، واتحاد طلاب فلسطين، والشباب العربي الفلسطيني في لبنان، إلى انتخابات حرة. تعاملت حركة فتح بحذر مع المنظمة، ونظرت إليها بوصفها وليدة قمم ومؤتمرات عربية سوف تنعكس عليها تناقضات تلك المؤتمرات، وأصرّت على منحها مضمونا ثوريا لتكون مرتكزا للثورة المسلحة لا بديلا عنها.
ارتبط رصيد المنظّمة، التي تشكلت بإشراف ووصاية عربيين، برصيد الأنظمة المهزومة في حرب العام 1967. ومع تدنّي هذا الرصيد، دخلت في عزلة سياسية وجماهيرية، بينما تعززت في المقابل مكانة فصائل الكفاح المسلح مع رواج فكرة حرب التحرير الشعبية. استقال الشقيري في ديسمبر من العام 1967 تحت ضغوط مارسها أعضاء في اللجنة التنفيذية، ولم يمضِ عامان حتى سيطرت الفصائل الفدائية بقيادة حركة فتح على المنظّمة، ومع تزايد وتيرة الكفاح المسلح، كمّا ونوعا، كانت المنظّمة أشبه بحكومة في المنفى؛ قدّمت خدماتها للفلسطينيين في مختلف المجالات. كان الكفاح المسلح أفضل وسيلة لتحريك الشتات الفلسطيني ومنحه اللحمة والتنظيم اللازمين، لكنه منح أيضا البيروقراطية العسكرية المهيمنة على لجنتها المركزية الشرعية التمثيلية، فأدارت الكفاح المسلح من خلال خياراتها السياسية وامتيازاتها السلطوية، متمسكة بنظام المحاصصة (الكوتا) الذي بقي سائدا رغم كل تحولات الساحة الفلسطينية سياسيا واجتماعيا، وقلّصت السلطوية تدريجيا الهامش المستقل الذي توافر للنقابات والاتحادات الشعبية والمهنية في مرحلة صعود المنظّمة.
شكّل هدف "تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني" إجماعا فلسطينيا، وبعد أيلول الأسود 1970، والاجتياح الإسرائيلي للبنان العام 1982، وفقدان المنظمة لقواعدها العسكرية والشعبية، فرضت فكرة "الدولة" نفسها على النخبة الفلسطينية المهيمنة، وبحثت عن قواعد إقليمية آمنة. مع الانتفاضة الفلسطينية الأولى العام 1987 انتقل الثقل إلى الداخل الفلسطيني، وبعد "أوسلو" العام 1993، الذي شكّل الانقسام الأخير في صفوف المنظمة، انتقل عشرات الآلاف من السياسيين والمقاتلين إلى الداخل الفلسطيني، التحم هؤلاء "العائدون" بالنخبة الفلسطينية في الداخل فيما بدا إعادة انتشارٍ وتموضعٍ وإنتاجٍ للنخبة الفلسطينية التي هيمنت على جهاز "السلطة الوطنية الفلسطينية"، واستأثرت بالقرار السياسي الفلسطيني، وأدارت ظهرها لأكثر من نصف الشعب الفلسطيني في المهجر والشتات، ولمليون ونصف المليون فلسطيني في الأراضي المحتلة العام 1948. تداخل القيادة بين "فتح" والسلطة والمنظمة أدى إلى عدم وضوح مؤسساتي، وبالتالي إلى عدم وضوح تمثيلي، خصوصا بعد تهميش منظّمة التحرير الفلسطينية التي حازت اعترافا عربيا ودوليا بصفتها ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني. وبينما خضعت السلطة لقيود "أوسلو" مكبّلة بالتزاماتها السياسية والأمنية، ومعايير واشتراطات الدول المانحة، استدعيت المنظمة والمجلس الوطني الفلسطيني عند الحاجة للإقرار والمصادقة الشكلية على قرارات السلطة الفلسطينية. لم تنجح النخبة الفلسطينية في بناء كيان وطني ذي سيادة، وفي غياب "شركاء سلام إسرائيليين"، بدت مفلسة سياسيا في وجه يمين إسرائيلي متطرف لا يتنازل عن عقيدة الاستيطان، وضمّ مزيد من الأراضي الفلسطينية. في مؤتمريها السادس (2009) والسابع (2016) تمت إعادة هيكلة حركة فتح لصالح مزيد من الصلاحيات لمحمود عباس، ولصالح السلام خيارا استراتيجيا. أتاحت الساحة السياسية الفلسطينية بعد "أوسلو" مزيدا من المجالات لتكريس السلطة، وفي أحسن الأحوال استبدالها بأخرى، واختزلت العملية الديمقراطية في صناديق الاقتراع، وطالما أُجّلت أو أُلغيت، تحت حسابات توقعات الربح والخسارة. أما المفاوضات بين "فتح" و"حماس" بشأن تفعيل منظّمة التحرير الفلسطينية، والمجلس الوطني الفلسطيني، فغالبا عطلها الخلاف على الحصص في نظام "الكوتا".
رفضت أيديولوجيا "حماس" الإسلامية الانضمام إلى منظّمة التحرير العلمانية، قبل أن تتيح لها براغماتيتها قبولا مشروطا بحصة عظمى في نظام "الكوتا" يعكس تمثيلها الشعبي، بحسب وجهة نظرها، وانضمّت إلى النخبة السياسية الفلسطينية رسميا منذ العام 2006، وهي التي قدّمت نفسها معارضا أيديولوجيا وسياسيا لحركة فتح، إلا أنها لم تفعل أكثر من استعادة تاريخ منافستها "فتح" فتراجع برنامجها من فكرة "التحرير الكامل" إلى فكرة "الدولة". تأكّد ذلك بعد أن قبلت وثيقة المبادئ الأساسية للحركة العام 2017 بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من حزيران 1967، ورغم أن الوثيقة تحاشت الاعتراف صراحة بإسرائيل، إلا أنها اعترفت بحدودها القائمة، وسعت "حماس" عبر جولات من المواجهات العسكرية إلى تثبيت أقدامها في مسار تفاوضي غير مباشر مع الاحتلال للوصول إلى هدنة طويلة الأمد، مقابل الإقرار الإسرائيلي والدولي بسيطرتها على قطاع غزة في صيغة شبه دولة لديها مطار في سيناء تحت السيطرة المصرية، وميناء عائم قبالة غزة تسيطر عليه إسرائيل. تمسّكت السلطة بنهج "أوسلو"، وما يقتضيه من علاقات سياسية واقتصادية وتنسيق أمني، ظنا منها أنها تحافظ على شرعيتها إقليميا ودوليا، وعلى ما تبقى من عملية تفاوضية، رغم انسحاب إسرائيل من تلك العملية نهائيا منذ العام 2014، وانهارت فعليا في مواجهة عقيدة الاستيطان الصهيونية، والتحاق مزيد من دول عربية بقطار التطبيع، بعد تبنّيها عقيدة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، التي تذهب إلى أن السلام العربي الإسرائيلي هو المفتاح لسلام فلسطيني إسرائيلي لا العكس. استراتيجية "أوسلو"، و"دويلة غزة"، أصبحتا عقبة في سبيل انتقال النخبة الفلسطينية من مسار استجداء الشرعية الدولية والإقليمية إلى مسار مبني في جوهره على الشرعية المستمدة من الشعب الفلسطيني وحلفائه الحقيقيين، ويتجاوز إصلاح منظّمة التحرير وتفعيل مؤسساتها مجرّد التفاهمات على نظام المحاصصة، وهو وثيق الصلة بتفعيل دور الجماهير الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني، الأمر الذي يبدو أنه يتعارض مع مصالح نخب سياسية واقتصادية وشرائح مجتمعية تستبد بمجتمعاتها، وتتمسك بمصالحها الفصائلية الضيقة.
هناك جيل فلسطيني جديد في الأراضي المحتلة، خاض ويخوض مواجهات ضد المشاريع الاستيطانية بحيوية وطرق مبتكرة، وهناك جيل فلسطيني جديد في المهجر والشتات لا يزال متمسكا بحقه في العودة، ويقاوم محاولات طمس الهوية، ولديه طاقات مميزة للحشد والتعبئة. هذا الجيل الأكثر تحررا من الفصائلية السياسية استطاع استنهاض حلفاء حقيقيين للقضية الفلسطينية في كل مكان، ويعيد اليوم رسم استراتيجيات وأولويات المواجهة مع المشروع الصهيوني وحلفائه، وقد برهن نضاله على الطاقات الشعبية الفلسطينية وعدم نفاد مخزونها النضالي، والتي تهدره، عن قصد وعن غير قصد، الحسابات الفصائلية السلطوية للنخب الفلسطينية التقليدية، الأمر الذي سيزيد من عزلتها وتآكل شرعيتها. إن أي حديث عن إصلاح المنظّمة ومؤسساتها لن يجدي دون إتاحة المجال للقوى الفلسطينية الناهضة في وجه تكلّس النخب الفلسطينية التقليدية، وحشد طاقاتها خلف استراتيجية نضال جماهيرية مدنية تقنن كفاح الشعب الفلسطيني في مواجهة تغوّل المشروع الاستيطاني الصهيوني، وتهافت المستوى السياسي العربي الرسمي وراء التطبيع. لا يمكن لأي إصلاح يستهدف منظّمة التحرير الفلسطينية أن يتم من أعلى، وهو ما ثبت فشله على الأقل منذ "أوسلو"، بل يتوضح أن منطلق الإصلاح يكمن في إعادة الاعتبار إلى المنظّمة بوصفها حاملا مؤسسيا ديمقراطيا للمشروع الوطني الفلسطيني، ومجددا لروافعه الثقافية والاجتماعية والمدنية، حيث تواجد الفلسطينيون، لتعزيز قدرتهم على التعبئة السياسية والوطنية والاجتماعية. بذلك، وغيره، يمكن استنهاض المنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وإلا بقي الإصلاح مفهوما فضفاضا بل مضللا أيضا.