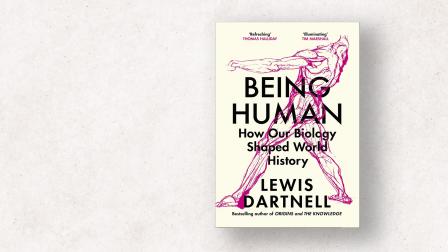تقف هذه الزاوية مع الكتّاب العرب في يومياتهم أثناء فترة الوباء، وما يودّون مشاركته مع القرّاء في زمن العزلة الإجبارية.
منذ بدء الحجر الصحّي مع أزمة كورونا، وكلمةُ "مجازفة" ومرادفاتها مثل "مخاطرة" و"مقامرة" تتردّد في ذهني باستمرار. هذا لا ينبع من مجرّد مخاطرة الخروج إلى الفضاء العام، والتي تُشبه في بعض نواحيها مخاوف الإنسان الحجري من الخروج من كهفه (مع فارق أنَّ الخوف سابقاً كان من وحوش كبيرة، وفي عصرنا من كائنات لا تُرى بالعين). إنه ينبع أيضاً من مفهوم "مجتمع المجازفة" أو "مجتمع المخاطرة" Risk Society الذي حذّر منه بعض المفكّرين وعلماء الاجتماع منذ عقود، لعل أبرزهم أولريش بيك Ulrich Beck، محدّدين بدايته مع نهاية الحرب العالمية الثانية، والتي اقترنت فيها، وللمفارقة، لحظة السلام الكبرى في تاريخ البشرية بظهور أسلحة دمار شامل تُهدّد الوجود البشري نفسه!
فللقرية الصغيرة، التي هي العالم كما بات يُسمّى في عصر العولمة، مخاطرها الكبيرة، لا مكاسبها فقط. والتقدُّم الذي حدث في بعض المجالات مثل القضاء على أمراض عديدة طالما التهمت البشر كالطواعين، بات مقترناً بحالة جديدة غير مسبوقة، وهي مخاطر قد لا تكون منظورة، ولكن إذا حدث أيٌّ منها فإنه سيكون ذا عواقب كبرى.
ذلك أنَّ الجديد في الأمر هو أنَّ تدخُّلات البشر في البيئة المحيطة بهم وصلت إلى درجة لم تعُد الطبيعة فيها قادرة على تصحيح الانحرافات التي يحدثونها فيها. بل أكثر من ذلك، إنّ كلّ حل لمشكلة جديدة، قد يولّد بدوره مشاكل أُخرى أكثر خطورةً لا تَظهر إلّا على المدى البعيد. وهذا هو جوهر نظرية المجازفة أو نظرية المخاطرة آنفة الذكر، وهو ما شخّصه مفكّرون بارزون آخرون من أمثال جيجك وفيريليو، ودعاة مراجعة حركة التقدُّم التقني بدءاً من هايدغر ومدرسة فرانكفورت التي انتقدت نوع العقلانية المرتبطة بحركة الحداثة، حيث تحوّل العقل إلى عقل "أداتي"، يفكّر في الوسائل أكثر من تفكيره في الغايات الأكبر.
أسير في الشارع، عندما أضطر للخروج لقضاء بعض الضرورات، مرتدياً كمّامتي، متحسّساً المسافة التي تفصلني عن الآخرين. المصافحة التي كانت زهرةً طبيعية في نسيج وجودنا اليومي، أصبحت مثل "زهرة ملغومة"، وحتى الابتسامة، لغة التواصل البشري العريقة، باتت تتوارى خلف الكمّامات، خجلةً من أن تظهر أيضاً.
إلى عهد قريب، كنّا في العالم العربي قليلي الاهتمام بكل ما يجري من متغيّرات ومخاطر من هذا النوع، بحكم انشغالاتنا المستمرّة بمشاكلنا الاجتماعية والسياسية المزمنة، ولأنَّ هذه الأخطار نفسَها كانت تبدو بعيدة. تغيُّرات المناخ، التي كانت تُمثّل الخطر الأكبر قبل ظهور كورونا، مع كلّ ما تمثّله من مخاطر على وجود البشر، كانت أيضاً تبدو أكثر بعداً وكأنها من شأن عالَم آخر، رغم أنها لو كشّرت عن أنيابها ذات يوم، فستشمل كلّ المعمورة. أسلحة الدمار الشامل كذلك، والتي كانت البشرية فعلاً على وشك الانزلاق في هوّتها لا سيما أيام الأزمة الكوبية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، والتي منعها في اللحظة الأخيرة قرار فردي لضابط قرّر أن ما يراه من صواريخ على الشاشة ناجم عن خطأ تقني.
مخاطر مجتمع المجازفة لا تنبع من الطبيعة والمجتمعات بصورة طبيعية كما كانت في السابق، بل مِن تدخُّل الإنسان المحموم في بيئته، الساعي وراء الربح وتسخيره الطبيعة بعيداً عن الرؤية الأشمل. وها هي الطبيعة اليوم توجّه إحدى الصفعات إلى البشر، وكأنها تصرخ في وجوههم: "لقد أنذرتكم كثيراً...أما كفى؟!".
ومن يدري، فلعلّ كورونا، إذا ما نجحت محاولات السيطرة عليه والتصدّي له بعلاج ناجع، قد لا يكون التهديد الأخطر، مقارنةً بتغيُّرات مناخية باتت بوادرها تعلن عن نفسها بصوت عالٍ منذ مدّة، كما هو الحال مع الحرائق غير المسبوقة التي جرت في أستراليا قبيل اندلاع أزمة الوباء، وقبل ذلك الأعاصير والحرائق غير المسبوقة التي ضربت الولايات المتّحدة. ومن يدري أيضاً، فلربما يظهر فيروس جديد أكثر استعصاء أمام العلاج، سواء أكان ظهوره عرضياً، أو مقصوداً، أو ربما حتى من جهود فردية لعالم مجنون يريد نهاية العالم، حيث توفّر له ترابطية العالم البيئة الملائمة لذلك.
والمفارقة الأُخرى، أنه في الوقت الذي تنشغل فيه مجتمعاتنا العربية بمخاضات التغيير وأسئلة الديمقراطية والاستبداد والفساد وضرورات التحديث وفتح الآفاق أمام شعوبها، فإن حركة التقدُّم التقني العالمي نفسها في ظلّ الرأسمالية وصلت إلى نقطة الإنذارات الجادّة المتعلّقة بوجود البشر أنفسهم.
حضارة أحادية الجانب، "إنسان ذو بُعد واحد"، بُعد تكنولوجيا الاستهلاك الذي يتضخّم مثل ثقب أسود كبير يضع كلّ الأبعاد الأُخرى في مداره. والقلق، مرض العصر، لم يعُدْ نفسياً فقط، ولا قلَقاً بمعنى الانشغال بأسئلة الوجود - كما كان - بل قلقاً على الوجود نفسه، بمعنى قلق القدرة على البقاء على قيد الحياة.
تُرى أيّ عالَم سيظهر بعد هذه الأزمة، أو أزمات أُخرى جديدة ربما؟ يصعب التكهُّن بذلك، فتلك مقامرة أُخرى قد تتيح مراجعة جذرية لكل ما يجري، أو ترمي البشر في غياب مجهول يعيدهم قروناً إلى الوراء بعد أن يفنى قسم كبير منهم. ونأمل بالطبع أن تكون المراجعة لا الانتكاس الشامل، هو الدرس الذي يخرج من فكَّي الأزمات، مع أنَّ البشر علّمونا عبر تاريخهم، أنهم قلّما يستفيدون من دروس الماضي.
في حواره عن مستقبل البشر، في المناظرة التي ينقلها كتاب "هل أفضل أيام البشر قادمة؟"، يشير ألان دو بوتون إلى ما يسمّيه "الجوزة الخطّاءة"، كناية عن الدماغ البشري الذي يشبه شكل الجوزة من جهة، ولا يستفيد من تجارب آلاف السنين من جهة أُخرى. بل يذهب أبعد من ذلك، إلى حد تصوُّر أنّ الأمل قد يكون معقوداً على جنس جديد يظهر من الجنس الحالي، كائنات تستطيع أن تكون أكثر عقلانية، لن نكون سوى أسلافها البائدين.
على أية حال، ها أنا أعود إلى البيت، أستبدل الملابس التي خرجتُ بها، أضع الحذاء بعيداً، أغسل يديَّ لمدّة لا تقلّ عن عشرين ثانية... عشرون ثانية... لا أقلّ! فأن تكون المدّة أقصر هي مجازفة أخرى أيضاً، من المجازفات الكثيرة التي باتت تتخلّل كل حركاتنا وسكناتنا.
* كاتب ومترجم عراقي من مواليد بغداد عام 1962، حاصل على البكالوريوس في الهندسة المعمارية عام 1986. صدر له قرابة 18 كتاباً بين التأليف والترجمة في مجالات الشعر والفكر والفلسفة؛ من بينها: "الفلسفات الآسيوية" (2013) لجون كولر، و"العالم كتصّور" (2015)؛ وهو الكتاب الأول من "العالم كإرادة وتصوّر" لآرتور شوبنهاور، و"كيركجارد: فيلسوف الإيمان في زمن العقل" (2018) لباترك غاردنر.