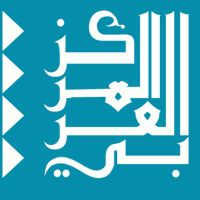24 أكتوبر 2024
احتجاجات تونس.. جدل الأسباب والمسؤولية
تونسيون يحتجون في العاصمة ضد ارتفاع الأسعار (9/1/2018/الأناضول)
شهدت مناطق مختلفة من تونس مواجهاتٍ بين قوى الأمن ومتظاهرين، أغلبهم من فئة الشباب، تزامنًا مع الذكرى السابعة للثورة التونسية. انطلقت الاحتجاجات على خلفية الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة، وصدّقها مجلس النواب، ضمن موازنة 2018، والتي تفرض ضرائب جديدة، ورفعًا في أسعار المحروقات والخدمات والسلع الاستهلاكية. وتطورت الحركة الاحتجاجية التي بدأت بتظاهرةٍ صغيرةٍ وسط العاصمة، لتتحول إلى مواجهات ضارية مع قوى الأمن، وأعمال حرق وتخريب ونهب لمقار إدارية وأمنية وفضاءات تجارية، في أكثر من مدينة.
أزمة هيكلية
بعد سبع سنوات من الثورة، لا يزال الوضع الاقتصادي والمعيشي في تونس يراوح مكانه، ولم تفلح الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة في الحد من البطالة، وكبح جماح التضخم والمديونية وعجز الميزان التجاري، ووقف تدهور قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية. وعلى الرغم من عودة الإنتاج إلى قطاع الفوسفات الذي ظل معطلًا عدة سنوات، وارتفاع معدلات السياحة التي كانت قد تأثرت سلبيًا بالهجمات الإرهابية التي استهدفت فنادق ومتاحف، فإن ذلك لم ينعكس، إيجابيًا، على الوضع الاجتماعي والمعيشي. وبالتوازي مع ذلك، ظلت الاحتجاجات، ذات البعد الاجتماعي والمطلبي، تتواتر وتتمدد من منطقة إلى أخرى، وتتصاعد دوريًا، في ديسمبر/ كانون الأول، ويناير/ كانون الثاني. وهذان الشهران مشحونان برمزية خاصة في دورات الاحتجاج التي عرفتها تونس، منذ انتفاضة الخبز 1984، وصولًا إلى الثورة سنة 2011، وما تلاها.
ويذهب معظم المختصين بدراسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي التونسي إلى أن الوضع الصعب الذي تمر به البلاد هو نتيجة طبيعية للخيارات الكبرى التي انتهجتها السلطات منذ عقدين ونصف، على الأقل، وأن النهج الاقتصادي والسياسي الذي أدى إلى الاختناقات التي مهدت للثورة لا يزال متواصلًا، مع فروق في التفاصيل. ويتصف هذا النهج، في عمومه، باستسهال اللجوء إلى الاستدانة، والانحياز إلى اقتصاد السوق من دون ضوابط إدارية وتشريعية ورقابية، وضعف الشفافية والنزاهة، واستشراء الفساد وعدم اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة نشاط "لوبيات" التهريب والاقتصاد الموازي، وضعف الاستثمار والبنى التحتية في الدواخل والأطراف. وفي حين تمكّن نظام ما قبل الثورة من السيطرة على المشهد، طوال سنوات، عبر القبضة الأمنية والتحكّم في تدفق المعلومات، فإن أجواء ما بعد الثورة، وما شهدته من تراجع لسطوة أجهزة الأمن، وحرية تدفق المعلومات وتعددية سياسية، وارتفاع توقعات الشعب التونسي في الوقت ذاته، تضافرت في تصعيد المطالب والاحتجاجات.
من الاحتجاج إلى الفوضى
انطلقت الأحداث الحالية بتوزيع منشورات تدعو إلى التحرك لإسقاط الإجراءات الضريبية التي تضمنتها الموازنة الجديدة، بالتوازي مع تظاهر مجموعات شبابية محدودة العدد، أغلبها من
أنصار الاتحاد العام لطلبة تونس (ذو توجه يساري)، في الشارع الرئيس وسط العاصمة، في إطار حملةٍ أطلق عليها منظمّوها شعار "فاش نستنّاو؟" (ماذا ننتظر؟)، فقد أضيف إلى المطالب الاجتماعية مطلب بإطلاق سراح الناشطين المعتقلين على خلفية توزيع المنشورات. لم تمر سوى ساعات معدودة حتى انطلقت تحركات ليلية في أحياء في العاصمة والمدن الداخلية، على غرار القصرين وقفصة وباجة وقبلّي.
ومع اتساع رقعة الأحداث وانطلاق التحركات الليلية، اختلفت هوية الفئات الفاعلة فيها، كما اختلفت طبيعة الاحتجاج، وغابت أي شعارات أو مطالب معلنة؛ فعلى مستوى الفئة المحتجة، مثّل الشباب العاطل عن العمل وغير المؤطر والمراهقون وحتى الأطفال أغلبية الفاعلين في الاحتجاجات الليلية، في حين كان الطلبة وناشطو بعض الأحزاب اليسارية عماد التحركات التي انطلقت وسط العاصمة. كما شهدت التحركات تحولًا في طبيعتها من الاحتجاج السلمي الذي ميز البدايات إلى أعمال عنف وحرق وسطو، شملت المقارّ الأمنية والمصالح الإدارية والفضاءات التجارية. وبعدما رفعت التحركات الأولى شعاراتٍ محدّدة تتمحور حول رفض الإجراءات الاقتصادية المعلنة في موازنة 2018 وتحمّل الائتلاف الحاكم مسؤولية الواقع المعيشي الصعب، لم تفصح التحركات الليلية وأعمال العنف عن أي مطالب، ولم ترفع أي شعارات.
من المسؤول؟
تجاهل الإعلام التونسي، الرسمي والخاص، الأحداث، في اليومين الأول والثاني. ومع تواصلها وتصاعدها وتمددها إلى مناطق متفرقة من البلاد، بدأت النشرات الإخبارية ومنابر الحوار في تغطية ما يجري، واستضافة المسؤولين الحكوميين والأمنيين وممثلي الأطراف السياسية والحزبية. ومن متابعة ردّات فعل الأطراف السياسية المعلنة، يمكن تصنيفها إلى ثلاثة مواقف رئيسة: الأول، ردة الفعل المعارضة للائتلاف الحاكم في كل حال، بغضّ النظر عن سياساته، وهو موقفٌ يدعم التحركات من دون تحفظ، ويدعو إلى تصعيدها من دون التعليق على أعمال العنف التي ترافقها أو نقدها، وتمثل هذا الموقف أساسًا الجبهة الشعبية (ائتلاف حزبي يساري قومي). والموقف الثاني يعترف بصعوبة الوضع الاجتماعي والمعيشي وبالحق في الاحتجاج السلمي، ويندد بالتحركات الليلية، وأعمال العنف التي ترافقها، وتتبناه حركة النهضة وحركة نداء تونس (المشاركتان في الائتلاف الحاكم) والتيار الديمقراطي وأحزاب أخرى، مع اختلافات في التفاصيل بين حزب وآخر. أما الموقف الثالث، فيلفّه بعض الغموض بسبب انتهازية
تصريحاته التي تراوح بين التنديد، في الآن نفسه، بالحكومة وبالمتظاهرين، والتذكير بالحق في التظاهر والدعوة إلى التصدّي للعنف، وتأكيد أن قانون المالية الحالي هو السبب في ما يجري، وتمثله حركة مشروع تونس المنشقة عن حركة نداء تونس، التي تريد الاستفادة من الأزمة.
لم يتوقف التجاذب وتحميل المسؤوليات عند البيانات الحزبية والتصريحات الصحفية، بل وصلا إلى مداولات البرلمان، حيث تبادل نواب الجبهة الشعبية ونواب حركة النهضة المسؤولية عما يجري. واتهمت الجبهة الشعبية حركة النهضة والائتلاف الحاكم بتصديق الموازنة المثيرة للجدل، في حين اتهم نواب النهضة الجبهة بالموافقة على الموازنة نفسها، ثم الاعتراض عليها في الشارع، وممارسة الابتزاز السياسي. أما رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزير الفلاحة سمير بالطيب، فقد وجّها أصابع الاتهام، صراحةً، إلى الجبهة الشعبية، بالتحريض على الفوضى والعنف. ويُعد تصريح الشاهد وبالطيب تحولًا في الخطاب السياسي الرسمي؛ إذ يتحاشى المسؤولون الحكوميون التونسيون، منذ الثورة، توجيه اتهاماتٍ صريحةٍ إلى أطراف حزبية محدّدة، وذكرها بالاسم، وتحميلها المسؤولية المباشرة عن الحركات الاحتجاجية المتتالية التي شهدتها البلاد.
خريطة الاحتجاجات
انطلقت الاحتجاجات الليلية العنيفة من مدينة طبربة (30 كيلومترًا غرب العاصمة)؛ فقد شهدت المنطقة مواجهاتٍ عنيفةً بين قوى الأمن والمحتجين، قبل أن تنتقل، في الليالي الموالية، إلى أحياء التضامن والجبل الأحمر والكبّارية وابن خلدون، في الضاحية الغربية للعاصمة، وإلى أحياء جبل الجلود وحمّام الأنف والمدينة الجديدة، في الضاحية الجنوبية، وهي أحياء أغلب سكانها من الطبقات ذات الدخل المحدود. أما في الدواخل، فقد شهدت مناطق من ولايات القصرين وقفصة وباجة وقبلّي مواجهات عنيفة بين قوى الأمن والمتظاهرين. في حين ظل وسط العاصمة والضاحية الشمالية ومدن الجنوب الشرقي ومدن الساحل ومدينة صفاقس (المدينة الثانية بعد العاصمة، من حيث عدد السكان)، مناطق هادئة نسبيًا، باستثناء وقفات احتجاجية محدودة من حيث العدد.
تشير خريطة الاحتجاجات إلى أن العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية قامت بأدوار نسبية في تصعيدها في بعض المناطق وخفوتها في مناطق أخرى؛ ففي وسط العاصمة، حيث تتركز معظم الوزارات والإدارات والمؤسسات المصرفية، ظل زخم الاحتجاجات السلمية ضعيفًا ومقتصرًا على مجموعات محدودة العدد من الناشطين. وحرصت السلطات المعنية على إبداء قدر كبير من التشدد الأمني، يصعب معه خروج أي احتجاجات عن السيطرة وتحوّلها إلى أعمال عنف وتخريب. أما في الأحياء الغربية والجنوبية للعاصمة وولايات القصرين وباجة وقفصة وقبلّي، حيث ترتفع نسب البطالة، ويتعمق التهميش الاجتماعي والاقتصادي، فقد اتسمت الاحتجاجات بمنسوبٍ عالٍ من العنف، وتواترت مشاهد نهب محال تجارية وحرق مؤسسات أمنية.
على خلاف الأحياء الطرفية في العاصمة وبعض الدواخل، ظلت منطقة الساحل (ولايات سوسة والمنستير والمهدية) هادئة، عدا تحرّكات محدودة في الأحياء الطرفية لمدينة سوسة. وتعدّ
منطقة الساحل، خصوصا مدنها الرئيسة، من المناطق التي شهدت تطورًا نسبيًا في الاستثمار والبنية التحتية، على امتداد العقود الأخيرة، مقارنةً بالدواخل، وقد حاز فيها حزب نداء تونس والرئيس الباجي قائد السبسي أغلب أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية سنة 2014. وعلى غرار الساحل، ظل الهدوء سيد الموقف في مناطق الجنوب الشرقي (ولايات تطاوين ومدنين وقابس) وولاية صفاقس. ويبدو أن الحضور القوي لحركة النهضة، المشاركة في الائتلاف الحاكم، ومحدودية حضور الأحزاب اليسارية، في الجنوب الشرقي، حالَا دون تمدّد الاحتجاجات إليها. وكانت الحركة قد حصدت أعلى نسبة تصويت لمصلحتها في هذه الولايات سنة 2014. أما ولاية صفاقس، فتتميز بحضور فاعل، نسبيًا، لحركة النهضة، وبكثافة النسيج الصناعي والحرفي، ما ساهم في إيجاد حركية اقتصادية واجتماعية عرفت بها الولاية منذ أمد بعيد. وعلى الرغم من أن المدينة شهدت مسيرات ضخمة، خلال ثورة 2011، فقد تميزت بالهدوء في السنوات التالية.
تساؤلات عن الأدوار الإقليمية
تُعدّ مسألة العلاقة بين ما يجري في تونس من تحولات، منذ 2011، والسياقات الإقليمية والدولية، من المسلمات التي يذهب إليها مراقبون كثيرون، إذ تُجرى مقارنات بما آلت إليه الأوضاع في عدد من بلدان الربيع العربي؛ مصر وليبيا واليمن وسورية خصوصًا، بفعل التدخل الإقليمي وأدواته المحلية، والمحاولات التي جرت لاستنساخ السيناريوهات ذاتها، في تونس، من دون تحقيق اختراقٍ حاسم، على الرغم من الضخ المالي والإعلامي الكبير الذي كُشفت بعض تفاصيله، خلال انتخابات 2014، لترجيح كفة الأطراف المحسوبة على الثورة المضادة.
وتأتي الأحداث أخيرا بعد أسابيع قليلة من تفجر أزمة العلاقات بين تونس والإمارات العربية المتحدة على خلفية القرار الإماراتي الذي منع التونسيات من السفر على متن الخطوط الإماراتية، وبعد ثلاث سنوات من الجفاء، المعلن حينًا والمكتوم أحيانًا أخرى بين البلدين بسبب قبول حركة نداء تونس تشكيل ائتلاف حكومي تشارك فيه حركة النهضة، وانفتاح الدبلوماسية التونسية، والرئيس السبسي، على جميع الأفرقاء الليبيين، بما يخالف الدور الإماراتي المنحاز، بقوة، إلى معسكر اللواء خليفة حفتر. ويضاف إلى ذلك ما سُجل، خلال الأحداث، من تغطيةٍ مكثفةٍ ومنحازة، أمّنتها القنوات الفضائية الإماراتية، وحضور مراسليها في المناطق المتوترة، في أثناء المواجهات، في فواصل بث مباشر. كما تجدر الإشارة، في السياق ذاته، إلى زيارة محمد دحلان تونس، ولقائه بعدد من السياسيين، وما أعقبها من انسحاب حزب آفاق تونس من الائتلاف الحكومي، وظهور مطالب من داخل حركة نداء تونس لفك الائتلاف مع حركة النهضة.
ما بعد الاحتجاجات
تبدو وتيرة الاحتجاجات الليلية العنيفة في انحسار، مقارنةً بأيامها الأولى؛ فقد عاد الهدوء إلى أغلب المناطق التي شهدت مواجهاتٍ وأعمال حرق ونهب وتخريب. وبالتوازي مع ذلك، بدأ الخطاب السياسي المساند للاحتجاجات من دون تحفظ يستدرك أمره. وعلى المستوى الأمني، تسلم الجيش مهمة تأمين الإدارات والمرافق الحيوية في عدد من المناطق، بعد انسحاب قوى الأمن إثر المواجهات التي خاضتها ضد المحتجين، وهو إجراء اعتادته السلطات التونسية، منذ الثورة، في المناسبات المشابهة للأحداث الأخيرة، للتخفيف من فرص الاحتكاك بين الشباب وقوى الأمن، مؤقتًا، إلى حين عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه، إذ يستبعد استخدام الجيش في التصدّي للاحتجاج ذي البعد الاجتماعي، أو إقحامه في التفصيل الأمني الداخلي اليومي، عملًا بالتقاليد التي حكمته عقودا، وتحاشيًا لأي تداعيات غير محسوبة قد تنجم عن هذا الإجراء.
ومهما يكن الحيز الزمني الذي ستأخذه الأحداث، والتي بدأ زخمها في التراجع، فلا يُنتظر أن تؤدي إلى نتائج من شأنها إحداث تغيير جذري في المشهد السياسي، أو الملفين الاقتصادي والاجتماعي؛ فالأحداث الأخيرة ليست الأولى من نوعها، وإن كانت الأكثر إثارةً للجدل بشأن مدى انخراط أطراف سياسية داخلية فيها، وكذلك قوى إقليمية معروفة بعدائها التحول الديمقراطي. أما بخصوص المشهد السياسي الداخلي، فينتظر أن تبقى موازين القوى على ما هي عليه، وتظل التجاذبات قائمة، حتى إن سرّعت الأحداث رحيل حكومة يوسف الشاهد، أو بعض أعضائها في الحد الأدنى، وهو احتمال قائم منذ أشهر ولا علاقة سببية بينه وبين ما يجري الآن، غير أن الأحداث الراهنة قد تمنح الساعين إلى دفع الشاهد إلى الرحيل أوراقًا جديدة، بعد تحميله وزر ما وصلت إليه البلاد.
أزمة هيكلية
بعد سبع سنوات من الثورة، لا يزال الوضع الاقتصادي والمعيشي في تونس يراوح مكانه، ولم تفلح الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة في الحد من البطالة، وكبح جماح التضخم والمديونية وعجز الميزان التجاري، ووقف تدهور قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية. وعلى الرغم من عودة الإنتاج إلى قطاع الفوسفات الذي ظل معطلًا عدة سنوات، وارتفاع معدلات السياحة التي كانت قد تأثرت سلبيًا بالهجمات الإرهابية التي استهدفت فنادق ومتاحف، فإن ذلك لم ينعكس، إيجابيًا، على الوضع الاجتماعي والمعيشي. وبالتوازي مع ذلك، ظلت الاحتجاجات، ذات البعد الاجتماعي والمطلبي، تتواتر وتتمدد من منطقة إلى أخرى، وتتصاعد دوريًا، في ديسمبر/ كانون الأول، ويناير/ كانون الثاني. وهذان الشهران مشحونان برمزية خاصة في دورات الاحتجاج التي عرفتها تونس، منذ انتفاضة الخبز 1984، وصولًا إلى الثورة سنة 2011، وما تلاها.
ويذهب معظم المختصين بدراسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي التونسي إلى أن الوضع الصعب الذي تمر به البلاد هو نتيجة طبيعية للخيارات الكبرى التي انتهجتها السلطات منذ عقدين ونصف، على الأقل، وأن النهج الاقتصادي والسياسي الذي أدى إلى الاختناقات التي مهدت للثورة لا يزال متواصلًا، مع فروق في التفاصيل. ويتصف هذا النهج، في عمومه، باستسهال اللجوء إلى الاستدانة، والانحياز إلى اقتصاد السوق من دون ضوابط إدارية وتشريعية ورقابية، وضعف الشفافية والنزاهة، واستشراء الفساد وعدم اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة نشاط "لوبيات" التهريب والاقتصاد الموازي، وضعف الاستثمار والبنى التحتية في الدواخل والأطراف. وفي حين تمكّن نظام ما قبل الثورة من السيطرة على المشهد، طوال سنوات، عبر القبضة الأمنية والتحكّم في تدفق المعلومات، فإن أجواء ما بعد الثورة، وما شهدته من تراجع لسطوة أجهزة الأمن، وحرية تدفق المعلومات وتعددية سياسية، وارتفاع توقعات الشعب التونسي في الوقت ذاته، تضافرت في تصعيد المطالب والاحتجاجات.
من الاحتجاج إلى الفوضى
انطلقت الأحداث الحالية بتوزيع منشورات تدعو إلى التحرك لإسقاط الإجراءات الضريبية التي تضمنتها الموازنة الجديدة، بالتوازي مع تظاهر مجموعات شبابية محدودة العدد، أغلبها من
ومع اتساع رقعة الأحداث وانطلاق التحركات الليلية، اختلفت هوية الفئات الفاعلة فيها، كما اختلفت طبيعة الاحتجاج، وغابت أي شعارات أو مطالب معلنة؛ فعلى مستوى الفئة المحتجة، مثّل الشباب العاطل عن العمل وغير المؤطر والمراهقون وحتى الأطفال أغلبية الفاعلين في الاحتجاجات الليلية، في حين كان الطلبة وناشطو بعض الأحزاب اليسارية عماد التحركات التي انطلقت وسط العاصمة. كما شهدت التحركات تحولًا في طبيعتها من الاحتجاج السلمي الذي ميز البدايات إلى أعمال عنف وحرق وسطو، شملت المقارّ الأمنية والمصالح الإدارية والفضاءات التجارية. وبعدما رفعت التحركات الأولى شعاراتٍ محدّدة تتمحور حول رفض الإجراءات الاقتصادية المعلنة في موازنة 2018 وتحمّل الائتلاف الحاكم مسؤولية الواقع المعيشي الصعب، لم تفصح التحركات الليلية وأعمال العنف عن أي مطالب، ولم ترفع أي شعارات.
من المسؤول؟
تجاهل الإعلام التونسي، الرسمي والخاص، الأحداث، في اليومين الأول والثاني. ومع تواصلها وتصاعدها وتمددها إلى مناطق متفرقة من البلاد، بدأت النشرات الإخبارية ومنابر الحوار في تغطية ما يجري، واستضافة المسؤولين الحكوميين والأمنيين وممثلي الأطراف السياسية والحزبية. ومن متابعة ردّات فعل الأطراف السياسية المعلنة، يمكن تصنيفها إلى ثلاثة مواقف رئيسة: الأول، ردة الفعل المعارضة للائتلاف الحاكم في كل حال، بغضّ النظر عن سياساته، وهو موقفٌ يدعم التحركات من دون تحفظ، ويدعو إلى تصعيدها من دون التعليق على أعمال العنف التي ترافقها أو نقدها، وتمثل هذا الموقف أساسًا الجبهة الشعبية (ائتلاف حزبي يساري قومي). والموقف الثاني يعترف بصعوبة الوضع الاجتماعي والمعيشي وبالحق في الاحتجاج السلمي، ويندد بالتحركات الليلية، وأعمال العنف التي ترافقها، وتتبناه حركة النهضة وحركة نداء تونس (المشاركتان في الائتلاف الحاكم) والتيار الديمقراطي وأحزاب أخرى، مع اختلافات في التفاصيل بين حزب وآخر. أما الموقف الثالث، فيلفّه بعض الغموض بسبب انتهازية
لم يتوقف التجاذب وتحميل المسؤوليات عند البيانات الحزبية والتصريحات الصحفية، بل وصلا إلى مداولات البرلمان، حيث تبادل نواب الجبهة الشعبية ونواب حركة النهضة المسؤولية عما يجري. واتهمت الجبهة الشعبية حركة النهضة والائتلاف الحاكم بتصديق الموازنة المثيرة للجدل، في حين اتهم نواب النهضة الجبهة بالموافقة على الموازنة نفسها، ثم الاعتراض عليها في الشارع، وممارسة الابتزاز السياسي. أما رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزير الفلاحة سمير بالطيب، فقد وجّها أصابع الاتهام، صراحةً، إلى الجبهة الشعبية، بالتحريض على الفوضى والعنف. ويُعد تصريح الشاهد وبالطيب تحولًا في الخطاب السياسي الرسمي؛ إذ يتحاشى المسؤولون الحكوميون التونسيون، منذ الثورة، توجيه اتهاماتٍ صريحةٍ إلى أطراف حزبية محدّدة، وذكرها بالاسم، وتحميلها المسؤولية المباشرة عن الحركات الاحتجاجية المتتالية التي شهدتها البلاد.
خريطة الاحتجاجات
انطلقت الاحتجاجات الليلية العنيفة من مدينة طبربة (30 كيلومترًا غرب العاصمة)؛ فقد شهدت المنطقة مواجهاتٍ عنيفةً بين قوى الأمن والمحتجين، قبل أن تنتقل، في الليالي الموالية، إلى أحياء التضامن والجبل الأحمر والكبّارية وابن خلدون، في الضاحية الغربية للعاصمة، وإلى أحياء جبل الجلود وحمّام الأنف والمدينة الجديدة، في الضاحية الجنوبية، وهي أحياء أغلب سكانها من الطبقات ذات الدخل المحدود. أما في الدواخل، فقد شهدت مناطق من ولايات القصرين وقفصة وباجة وقبلّي مواجهات عنيفة بين قوى الأمن والمتظاهرين. في حين ظل وسط العاصمة والضاحية الشمالية ومدن الجنوب الشرقي ومدن الساحل ومدينة صفاقس (المدينة الثانية بعد العاصمة، من حيث عدد السكان)، مناطق هادئة نسبيًا، باستثناء وقفات احتجاجية محدودة من حيث العدد.
تشير خريطة الاحتجاجات إلى أن العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية قامت بأدوار نسبية في تصعيدها في بعض المناطق وخفوتها في مناطق أخرى؛ ففي وسط العاصمة، حيث تتركز معظم الوزارات والإدارات والمؤسسات المصرفية، ظل زخم الاحتجاجات السلمية ضعيفًا ومقتصرًا على مجموعات محدودة العدد من الناشطين. وحرصت السلطات المعنية على إبداء قدر كبير من التشدد الأمني، يصعب معه خروج أي احتجاجات عن السيطرة وتحوّلها إلى أعمال عنف وتخريب. أما في الأحياء الغربية والجنوبية للعاصمة وولايات القصرين وباجة وقفصة وقبلّي، حيث ترتفع نسب البطالة، ويتعمق التهميش الاجتماعي والاقتصادي، فقد اتسمت الاحتجاجات بمنسوبٍ عالٍ من العنف، وتواترت مشاهد نهب محال تجارية وحرق مؤسسات أمنية.
على خلاف الأحياء الطرفية في العاصمة وبعض الدواخل، ظلت منطقة الساحل (ولايات سوسة والمنستير والمهدية) هادئة، عدا تحرّكات محدودة في الأحياء الطرفية لمدينة سوسة. وتعدّ
تساؤلات عن الأدوار الإقليمية
تُعدّ مسألة العلاقة بين ما يجري في تونس من تحولات، منذ 2011، والسياقات الإقليمية والدولية، من المسلمات التي يذهب إليها مراقبون كثيرون، إذ تُجرى مقارنات بما آلت إليه الأوضاع في عدد من بلدان الربيع العربي؛ مصر وليبيا واليمن وسورية خصوصًا، بفعل التدخل الإقليمي وأدواته المحلية، والمحاولات التي جرت لاستنساخ السيناريوهات ذاتها، في تونس، من دون تحقيق اختراقٍ حاسم، على الرغم من الضخ المالي والإعلامي الكبير الذي كُشفت بعض تفاصيله، خلال انتخابات 2014، لترجيح كفة الأطراف المحسوبة على الثورة المضادة.
وتأتي الأحداث أخيرا بعد أسابيع قليلة من تفجر أزمة العلاقات بين تونس والإمارات العربية المتحدة على خلفية القرار الإماراتي الذي منع التونسيات من السفر على متن الخطوط الإماراتية، وبعد ثلاث سنوات من الجفاء، المعلن حينًا والمكتوم أحيانًا أخرى بين البلدين بسبب قبول حركة نداء تونس تشكيل ائتلاف حكومي تشارك فيه حركة النهضة، وانفتاح الدبلوماسية التونسية، والرئيس السبسي، على جميع الأفرقاء الليبيين، بما يخالف الدور الإماراتي المنحاز، بقوة، إلى معسكر اللواء خليفة حفتر. ويضاف إلى ذلك ما سُجل، خلال الأحداث، من تغطيةٍ مكثفةٍ ومنحازة، أمّنتها القنوات الفضائية الإماراتية، وحضور مراسليها في المناطق المتوترة، في أثناء المواجهات، في فواصل بث مباشر. كما تجدر الإشارة، في السياق ذاته، إلى زيارة محمد دحلان تونس، ولقائه بعدد من السياسيين، وما أعقبها من انسحاب حزب آفاق تونس من الائتلاف الحكومي، وظهور مطالب من داخل حركة نداء تونس لفك الائتلاف مع حركة النهضة.
ما بعد الاحتجاجات
تبدو وتيرة الاحتجاجات الليلية العنيفة في انحسار، مقارنةً بأيامها الأولى؛ فقد عاد الهدوء إلى أغلب المناطق التي شهدت مواجهاتٍ وأعمال حرق ونهب وتخريب. وبالتوازي مع ذلك، بدأ الخطاب السياسي المساند للاحتجاجات من دون تحفظ يستدرك أمره. وعلى المستوى الأمني، تسلم الجيش مهمة تأمين الإدارات والمرافق الحيوية في عدد من المناطق، بعد انسحاب قوى الأمن إثر المواجهات التي خاضتها ضد المحتجين، وهو إجراء اعتادته السلطات التونسية، منذ الثورة، في المناسبات المشابهة للأحداث الأخيرة، للتخفيف من فرص الاحتكاك بين الشباب وقوى الأمن، مؤقتًا، إلى حين عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه، إذ يستبعد استخدام الجيش في التصدّي للاحتجاج ذي البعد الاجتماعي، أو إقحامه في التفصيل الأمني الداخلي اليومي، عملًا بالتقاليد التي حكمته عقودا، وتحاشيًا لأي تداعيات غير محسوبة قد تنجم عن هذا الإجراء.
ومهما يكن الحيز الزمني الذي ستأخذه الأحداث، والتي بدأ زخمها في التراجع، فلا يُنتظر أن تؤدي إلى نتائج من شأنها إحداث تغيير جذري في المشهد السياسي، أو الملفين الاقتصادي والاجتماعي؛ فالأحداث الأخيرة ليست الأولى من نوعها، وإن كانت الأكثر إثارةً للجدل بشأن مدى انخراط أطراف سياسية داخلية فيها، وكذلك قوى إقليمية معروفة بعدائها التحول الديمقراطي. أما بخصوص المشهد السياسي الداخلي، فينتظر أن تبقى موازين القوى على ما هي عليه، وتظل التجاذبات قائمة، حتى إن سرّعت الأحداث رحيل حكومة يوسف الشاهد، أو بعض أعضائها في الحد الأدنى، وهو احتمال قائم منذ أشهر ولا علاقة سببية بينه وبين ما يجري الآن، غير أن الأحداث الراهنة قد تمنح الساعين إلى دفع الشاهد إلى الرحيل أوراقًا جديدة، بعد تحميله وزر ما وصلت إليه البلاد.