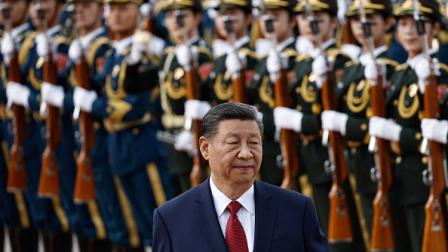سجّل الأردن، العام الماضي، رقماً قياسياً في عدد حالات الانتحار، بلغ 177 حالة، بواقع حالة انتحار كل ثلاثة أيام، في ارتفاع واضح عن العام الذي سبقه، والذي سجل فيه وقوع 113 حالة، فيما سجل عام 2014 وقوع 100 حالة انتحار. يكفي الارتفاع المضطرد لأعداد المنتحرين لإثارة حالة من الذعر لدى الباحثين والجهات المعنية، والتوقف أمامها طويلاً لدراسة الأسباب الكامنة وراء ارتفاع أعداد المنتحرين، خصوصاً بعد أن أظهرت المؤشرات الأولية للعام الحالي أن عدد المنتحرين مرشح للارتفاع.
يسهل على الجهات المعنية ربط ارتفاع أعداد المنتحرين بالعلاقة الطردية المتناسبة مع الزيادة السكانية. ويسهل أيضاً إحالتها إلى ضعف الوازع الديني كما يفسر رجال الدين. وكذلك ليس من الصعب تفسيرها في سياق التفكك الأسري، وتراجع الروابط الاجتماعية، وأحياناً غياب أو ضعف الرعاية النفسية. كذلك، ليس من التجني وضعها في سياق تردي الأوضاع الاقتصادية للمواطنين الذين ينسحبون يومياً إلى ما دون خط الفقر، بفعل السياسات الاقتصادية الرسمية.
جميع تلك الأسباب تبدو منطقية، لكنها لا تقدم تفسيراً علمياً يمكن صانع القرار من اتخاذ إجراءات، أو وضع سياسات، تكبح جنون ما يمكن اعتباره ظاهرة باتت تتشكل. حتى الآن، تتعامل الجهات الرسمية مع حالات الانتحار كأرقام صماء، وتواصل تقديم مبررات غير منطقية لتفسير ارتفاعها، من دون أن تقدم على تنفيذ دراسة علمية تفسرها، وتقف على حقيقة دوافع المنتحرين بغية تطويقها، أو الحد من ارتفاع معدلاتها. سلوك لا يمكن تفسيره إلا بأنه هروب من لحظة الحقيقة.
نهاية الأسبوع الماضي، وفي غضون 24 ساعة، وقعت ثلاث حالات انتحار منفصلة، بقيت أسبابها ودوافعها غامضة. وقبل أيام انتحر موظف بإحراق نفسه احتجاجاً على أوضاعه الاقتصادية الصعبة، من دون أن تكشف التحقيقات الرسمية التي أجريت تلك الأسباب، بل طوي ملف حياة إنسان وكأنه لم يكن أصلاً. على نحو متزايد، يلاقي المنتحرون تعاطفاً شعبياً يبرر لهم ما أقدموا عليه، وذلك خلافاً لمشاعر سلبية كان يحملها الأردنيون سابقاً تجاه المنتحرين، الذين كانوا يودعون بالاحتقار ويرمون بأقذع الأوصاف، وهو ما يحتاج أيضاً إلى تفسير.