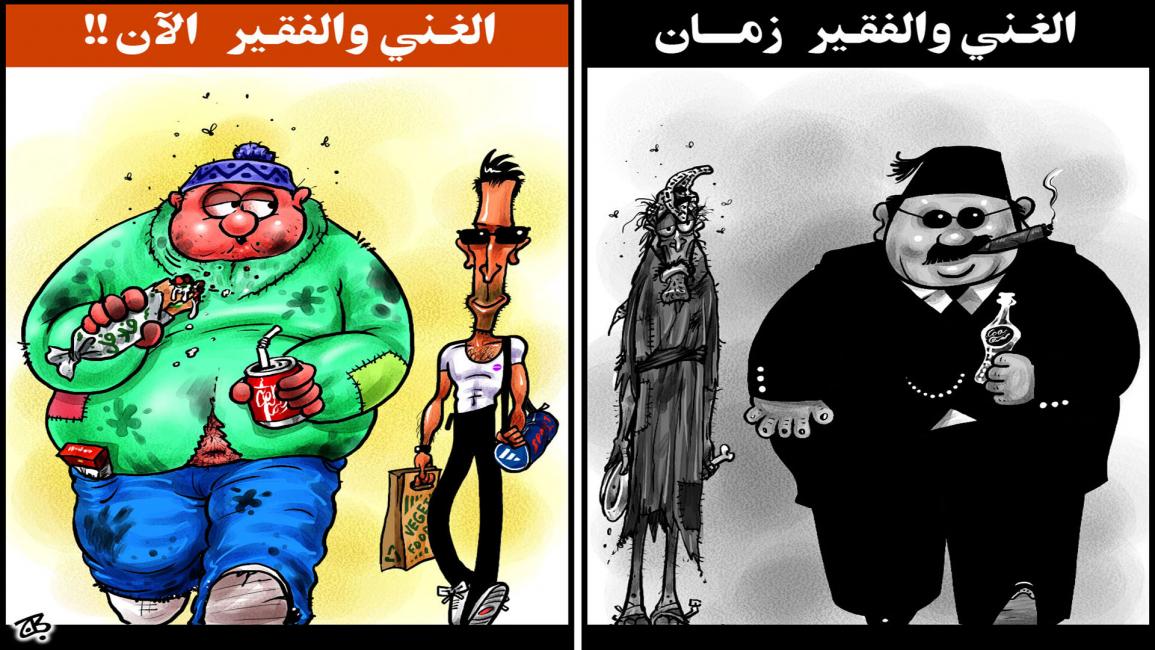27 سبتمبر 2018
التغول المالي في الرأسمالية ووضع الدولة
يؤسّس الطابع المالي الذي بات يحكم الرأسمالية وضعاً جديداً للدولة، بحيث تصبح السلطة شكلاً ليس إلا. ووفق المتعارف عليه، فإن الدولة أداة طبقةٍ للسيطرة وتحقيق مصالحها، حيث تصبح القوى القهرية (الجيش والأمن والشرطة) أدواتٍ بيدها، من أجل إخضاع المجتمع، وفرض النهب والاستغلال من خلال مجمل القوانين التي تصدرها باسم الدولة، وتنفذها بيروقراطيتها. وفي هذه الوضعية، تتشكل "بنية" للدولة، من موظفين تعيّنهم السلطة. كل هؤلاء هم بيروقراطية الدولة التي تعيلهم، لكي ينفذوا أوامر السلطة التي هي سلطة الطبقة المسيطرة. وبهذا، ينشط الرأسمال في الاقتصاد محمياً بسلطة الدولة وأدواتها القمعية. كل هؤلاء هم الدولة، أي الجيش والأمن والشرطة والمؤسسات التي تشكل "كتبة" الدولة وبيروقراطييها. وعناصرها موظفون لدى الدولة، هي التي تدفع لهم أجرهم، بالضبط لكي يخدموا مصالح الطبقة المسيطرة. والدولة تسدّد لهم من الضرائب التي تتحصّل عليها من الشعب.
هذا هو الوضع في الدولة الرأسمالية منذ نشوئها، والذي كان يجعل الدولة "أداة حكم طبقي". وهو الوضع الذي حكم الرأسمالية في مرحلتها التنافسية (القرن التاسع عشر)، ومرحلتها الاحتكارية (القرن العشرون). حيث كانت الصناعة (ثم الزراعة) وسيلة الإنتاج الأساسية التي يذهب التراكم الرأسمالي نحو التوظيف فيها. لكن، أفضى التراكم المالي الهائل الناتج عن فيض الأرباح التي تتحقق إلى حاجةٍ لمنافذ استثمارية، تتجاوز كل أشكال الاستثمار السابقة، بعد أن أصبح "الاقتصاد الحقيقي" مشبعاً، بحيث لا إمكانية لاستثمارٍ زائدٍ فيه، بعد أن أصبح الإنتاج فائضاً عن المقدرة المجتمعية التي تتحدّد بسعة السوق من جهة، وبالقدرة الشرائية من جهة أخرى.
ذهب التراكم المالي الذي نتج عن الزراعة، ووقع بيد التجار، مع نشوء الصناعة، إلى التوظيف في الصناعة، بعد أن أصبحت مشروعاً مثمراً، لكنه استمر بالتوظيف في التجارة والزراعة، وإنْ بشكلٍ يتوافق مع الطابع الجديد للاقتصاد الذي أوجدته الصناعة. وتوسع في الخدمات، وفي الاستثمار في المواد الأولية، والتصدير إلى الأطراف (البلدان المتخلفة). وهذه هي العملية التي حكمت الرأسمالية قرنين تقريباً، لكن فيض الأرباح من جهة، وتشبّع السوق في كل هذه المجالات، وتصاعد المنافسة التي كانت تفضي إلى نشوء أزمة الكساد من جهة أخرى، فرض أن يبحث المال المتراكم في البنوك عن مجالاتٍ جديدة أوسَع من مجالاتٍ كانت هامشية، هي الديون والمشتقات المالية وأسواق الأسهم والمضاربات على السلع. وهي السياسة التي فرضتها أزمة سبعينات القرن العشرين، وأدت إلى "انحراف" التوظيف نحو أشكال قديمة/ جديدة، هي التوظيف المالي، أي التوظيف في المال من خلال أشكالٍ شتى، منها المضاربة، ومنها الديون، وأيضاً اختراع المشتقات المالية.
لكن، يظهر الآن، أن ذلك كله ليس كافياً، فالتراكم المالي يتصاعد بشكل سريع، نتيجة أن الأشكال الجديدة للتوظيف تحقق أرباحاً أعلى بكثير من التوظيف في "الاقتصاد الحقيقي". وبالتالي، إذا كان التوظيف في هذه القطاعات الجديدة هو الحلّ للتراكم المتحقق في الاقتصاد الحقيقي، حيث شهد الاقتصاد الصناعي حالتي فيض الإنتاج وفيض الأرباح، فإنه يعمّق الأزمة، فيدفع إلى البحث عن مجالات استثمار جديدة. لقد فرض فيض الأرباح التي تحقّقت في الاقتصاد الحقيقي، وبات مستحيلاً توظيفها فيه، كما كان في السابق، إلى التوظيف في أشكالٍ مالية، أشرت إليها للتو، بمعنى أن التوظيف خرج عن الاقتصاد الحقيقي، انحرف عن التوظيف في الاقتصاد الحقيقي، نحو القطاع المالي الذي بات وسيلة جذبٍ لاستثمار أرقام متزايدة من المال، باتت أضخم من الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي. لكن، لا بد من أن نلاحظ أن هذا التوظيف كان يضخّم الأرباح التي تضاعفت عما هو في الاقتصاد الحقيقي بشكل كبير، الأمر الذي أعاد إنتاج المشكلة مضخمةً، حيث بات هناك تراكم مالي هائل، يبحث عن توظيف، هو أكبر مما كان سابقاً. وإذا كان سابقاً قد جرى "اختراع" أشكال توظيف "وهمية"، مثل المشتقات المالية، لا نعرف ما هي الأشكال الوهمية التي يمكن أن يجري اختراعها، لتوظيف المال الجديد المتراكم، والذي يتراكم بتسارعٍ نتيجة الشكل سابق الذكر في التوظيف.
ما يظهر من سياساتٍ اقتصادية، تُفرض عادة على الأطراف باسم صندوق النقد الدولي المتحكّم به من الطغم المالية، هو توسيع عمليات الخصخصة، لكي تطال كل شيء يمكن أن يدرّ ربحاً. وصلت عملية الخصخصة إلى كل الخدمات التي كانت تعتبر من واجبات الدولة التي تجني الضرائب من أجل تحقيقها، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والمواصلات والماء والكهرباء. بدأت الخصخصة بإنهاء دور الدولة الاقتصادي بوصفها مستثمراً، حيث بيع "القطاع العام"، أي المصانع والشركات التابعة له، وبات الاقتصاد ملكاً للرأسمال الخاص، المحلي والدولي. انتقلت هذه العملية، بعدئذٍ، إلى مجالات التعليم والصحة والماء والكهرباء والغاز، والمواصلات، في دولٍ كثيرة، وهي تزحف إلى الدول التي لم يتحقق ذلك كله فيها، فتشهد الأطراف موجة لبرلةٍ جديدةٍ، تكمل ما بدأ مع سياسة الخصخصة منذ سبعينات القرن العشرين. وكما لم تقد أزمة جنوب شرق آسيا سنة 1997 وامتداداتها إلى وقف عملية الخصخصة وتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، فإن الثورات العربية لم تؤدِ أيضاً إلى وقف هذه العملية، بل إن مجمل السياسات الاقتصادية التي مورست، بعد امتصاص الصدمة، تمثلت في "تعميق" الخصخصة، وتوسيعها لكي تشمل القطاعات الخدمية والبنية التحتية.
أيضاً، سيظهر أن ذلك لا يبدو كافياً، فالتراكم المالي في ازديادٍ متسارع، على الرغم من تصاعد دور البورصات، وتوسيع المديونية، والتوسع في المشتقات المالية. بالضبط، لأن هذا التوظيف يضخم من عملية التراكم المالي، ويسرّع في المركزة، ليكون هناك بضع أشخاص يملكون ما يملكه نصف العالم. وتتمركز الشركات، بحيث تنحصر المنافسة في عدد محدود منها في كل فرع من فروع الاقتصاد. وتصبح الأموال المتراكمة في البنوك، أو المتداولة يومياً، بمئات التريليونات، أو حتى آلافها، التي هي بحاجة الى مجالات توظيف.
ما يظهر أن مسار التوظيف المالي سوف يصل إلى أجهزة الدولة، بعد أن تكون كل مجالات الاقتصاد والبنية التحتية قد خُصخصت، وفي مسار "اختراع" أشكالٍ جديدة من "المشتقات المالية". أصبحت بعض الدول تميل إلى خصخصة بعض القطاعات الأمنية (الشركات الأمنية)، وحتى العسكرية (الجيش)، وأيضاً بعض الإدارات. وذلك كله تحت عنوان "تخفيف العبء" على الدولة. لكن، يمكن أن نعتبر هذه مقدمةً لمسار جديد، يكمل خصخصة التعليم والصحة والبنية التحتية، سوف يوصل إلى أن تكون الدولة بلا أجهزةٍ وبيروقراطية. حيث سيكون الاتجاه نحو خصخصة وزارة الداخلية، بحيث توكل مهمات الشرطة لشركة خاصة، والجيش لشركةٍ أخرى، والأمن لشركة ثالثة (وربما كل هذه لشركةٍ واحدة). وكذلك ستوكل بيروقراطية الدولة (الدواوين) لشركةٍ، أو عدة شركات خاصة، بحيث تقوم هي بالإدارة في مختلف المجالات. وهذا يشمل القضاء الذي سوف يخضع اختيار القضاة لامتحان شركة خاصة. وأيضاً ستكون مؤسسات الدولة مؤجرةً من شركة عقارية، وسوف تصبح دائرة جني الضرائب من نصيب شركة خاصة، كذلك الجمارك. من ثم، لا يكون للدولة مدخول سوى هذه. وهي تُدفع للشركات التي توظفها الدولة، للقيام بمهامها المختلفة. بمعنى أن كل "أدوات" الدولة التي تحكم بها لمصلحة طبقةٍ ستصبح استثماراً خاصاً للطبقة نفسها. لكن، هذه المرة مشروعاً ربحياً، وليس "خدمة" للشعب الذي يدفع الضرائب من أجل ذلك.
في هذه الوضعية، سوف تصبح الدولة بلا "أدوات"، حيث تصبح المؤسسات التمثيلية (البرلمان) والتنفيذية (الوزارة)، والرئاسة، كلها تمارس نشاطها بموظفين تابعين لشركةٍ خاصة، وبمقرّات مستأجرة، وتتحدّد مهمتها في إقرار القوانين والإملاءات التي تفرضها الشركات الخاصة، والتي ستكون مصالحها أوسع من التوظيف في مؤسسات الدولة هذه. تصبح الدولة شكلاً ليس أكثر، ولا تعود أداة سيطرة طبقةٍ باتت هي أصلاً مسيطرةً على الدولة مباشرة، بل شكلاً سياسياً نافلاً، مظهراً فقط. وستكون الضرائب التي تفرض على الشعب، وأسعار الخدمات المختلفة التي كانت تقدمها الدولة بمبالغ رمزية، هي ما يسدّد "حقوق" الشركات التي باتت تستثمر مؤسسات الدولة كاستثمار خاص. وتصبح الشركات المستثمِرة هي التي تدفع أجور أعضاء البرلمان والوزراء والرئيس الذين سيكونون من "رجال الأعمال" انفسهم الذين يؤجرون "الدولة" مؤسساتها، ويقومون بكل خدماتها. هنا، يصبح التماهي واضحاً بين السياسة والاقتصاد، بين الرأسماليين وممثلي الدولة، ويصبح الربح أساس العلاقات، والاقتصاد هو المهيمن مباشرةً بعد أن كان "في الخفاء" يلعب دور "المحدِّد".
في هذه الوضعية، يتغوّل الاقتصادي مقصياً السياسي، أو محولاً إياه إلى شكلٍ ليس إلا. بالتالي، لا تعود السلطة أداة طبقةٍ، بل تصبح بيد الرأسمال مباشرة، وتكون "السلطة" الشكل الذي يبرّر ذلك. هي "المحلل" لكل سياسات الرأسمال، من دون حاجةٍ إلى شكل يظهر وكأنه يمثل "الشأن العام"، ويدافع عن "المصالح العامة". تظهر الدولة على حقيقتها أداة الرأسمال، وليس معبّراً عن "المصالح العامة".
هذا هو الوضع في الدولة الرأسمالية منذ نشوئها، والذي كان يجعل الدولة "أداة حكم طبقي". وهو الوضع الذي حكم الرأسمالية في مرحلتها التنافسية (القرن التاسع عشر)، ومرحلتها الاحتكارية (القرن العشرون). حيث كانت الصناعة (ثم الزراعة) وسيلة الإنتاج الأساسية التي يذهب التراكم الرأسمالي نحو التوظيف فيها. لكن، أفضى التراكم المالي الهائل الناتج عن فيض الأرباح التي تتحقق إلى حاجةٍ لمنافذ استثمارية، تتجاوز كل أشكال الاستثمار السابقة، بعد أن أصبح "الاقتصاد الحقيقي" مشبعاً، بحيث لا إمكانية لاستثمارٍ زائدٍ فيه، بعد أن أصبح الإنتاج فائضاً عن المقدرة المجتمعية التي تتحدّد بسعة السوق من جهة، وبالقدرة الشرائية من جهة أخرى.
ذهب التراكم المالي الذي نتج عن الزراعة، ووقع بيد التجار، مع نشوء الصناعة، إلى التوظيف في الصناعة، بعد أن أصبحت مشروعاً مثمراً، لكنه استمر بالتوظيف في التجارة والزراعة، وإنْ بشكلٍ يتوافق مع الطابع الجديد للاقتصاد الذي أوجدته الصناعة. وتوسع في الخدمات، وفي الاستثمار في المواد الأولية، والتصدير إلى الأطراف (البلدان المتخلفة). وهذه هي العملية التي حكمت الرأسمالية قرنين تقريباً، لكن فيض الأرباح من جهة، وتشبّع السوق في كل هذه المجالات، وتصاعد المنافسة التي كانت تفضي إلى نشوء أزمة الكساد من جهة أخرى، فرض أن يبحث المال المتراكم في البنوك عن مجالاتٍ جديدة أوسَع من مجالاتٍ كانت هامشية، هي الديون والمشتقات المالية وأسواق الأسهم والمضاربات على السلع. وهي السياسة التي فرضتها أزمة سبعينات القرن العشرين، وأدت إلى "انحراف" التوظيف نحو أشكال قديمة/ جديدة، هي التوظيف المالي، أي التوظيف في المال من خلال أشكالٍ شتى، منها المضاربة، ومنها الديون، وأيضاً اختراع المشتقات المالية.
لكن، يظهر الآن، أن ذلك كله ليس كافياً، فالتراكم المالي يتصاعد بشكل سريع، نتيجة أن الأشكال الجديدة للتوظيف تحقق أرباحاً أعلى بكثير من التوظيف في "الاقتصاد الحقيقي". وبالتالي، إذا كان التوظيف في هذه القطاعات الجديدة هو الحلّ للتراكم المتحقق في الاقتصاد الحقيقي، حيث شهد الاقتصاد الصناعي حالتي فيض الإنتاج وفيض الأرباح، فإنه يعمّق الأزمة، فيدفع إلى البحث عن مجالات استثمار جديدة. لقد فرض فيض الأرباح التي تحقّقت في الاقتصاد الحقيقي، وبات مستحيلاً توظيفها فيه، كما كان في السابق، إلى التوظيف في أشكالٍ مالية، أشرت إليها للتو، بمعنى أن التوظيف خرج عن الاقتصاد الحقيقي، انحرف عن التوظيف في الاقتصاد الحقيقي، نحو القطاع المالي الذي بات وسيلة جذبٍ لاستثمار أرقام متزايدة من المال، باتت أضخم من الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي. لكن، لا بد من أن نلاحظ أن هذا التوظيف كان يضخّم الأرباح التي تضاعفت عما هو في الاقتصاد الحقيقي بشكل كبير، الأمر الذي أعاد إنتاج المشكلة مضخمةً، حيث بات هناك تراكم مالي هائل، يبحث عن توظيف، هو أكبر مما كان سابقاً. وإذا كان سابقاً قد جرى "اختراع" أشكال توظيف "وهمية"، مثل المشتقات المالية، لا نعرف ما هي الأشكال الوهمية التي يمكن أن يجري اختراعها، لتوظيف المال الجديد المتراكم، والذي يتراكم بتسارعٍ نتيجة الشكل سابق الذكر في التوظيف.
ما يظهر من سياساتٍ اقتصادية، تُفرض عادة على الأطراف باسم صندوق النقد الدولي المتحكّم به من الطغم المالية، هو توسيع عمليات الخصخصة، لكي تطال كل شيء يمكن أن يدرّ ربحاً. وصلت عملية الخصخصة إلى كل الخدمات التي كانت تعتبر من واجبات الدولة التي تجني الضرائب من أجل تحقيقها، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والمواصلات والماء والكهرباء. بدأت الخصخصة بإنهاء دور الدولة الاقتصادي بوصفها مستثمراً، حيث بيع "القطاع العام"، أي المصانع والشركات التابعة له، وبات الاقتصاد ملكاً للرأسمال الخاص، المحلي والدولي. انتقلت هذه العملية، بعدئذٍ، إلى مجالات التعليم والصحة والماء والكهرباء والغاز، والمواصلات، في دولٍ كثيرة، وهي تزحف إلى الدول التي لم يتحقق ذلك كله فيها، فتشهد الأطراف موجة لبرلةٍ جديدةٍ، تكمل ما بدأ مع سياسة الخصخصة منذ سبعينات القرن العشرين. وكما لم تقد أزمة جنوب شرق آسيا سنة 1997 وامتداداتها إلى وقف عملية الخصخصة وتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، فإن الثورات العربية لم تؤدِ أيضاً إلى وقف هذه العملية، بل إن مجمل السياسات الاقتصادية التي مورست، بعد امتصاص الصدمة، تمثلت في "تعميق" الخصخصة، وتوسيعها لكي تشمل القطاعات الخدمية والبنية التحتية.
أيضاً، سيظهر أن ذلك لا يبدو كافياً، فالتراكم المالي في ازديادٍ متسارع، على الرغم من تصاعد دور البورصات، وتوسيع المديونية، والتوسع في المشتقات المالية. بالضبط، لأن هذا التوظيف يضخم من عملية التراكم المالي، ويسرّع في المركزة، ليكون هناك بضع أشخاص يملكون ما يملكه نصف العالم. وتتمركز الشركات، بحيث تنحصر المنافسة في عدد محدود منها في كل فرع من فروع الاقتصاد. وتصبح الأموال المتراكمة في البنوك، أو المتداولة يومياً، بمئات التريليونات، أو حتى آلافها، التي هي بحاجة الى مجالات توظيف.
ما يظهر أن مسار التوظيف المالي سوف يصل إلى أجهزة الدولة، بعد أن تكون كل مجالات الاقتصاد والبنية التحتية قد خُصخصت، وفي مسار "اختراع" أشكالٍ جديدة من "المشتقات المالية". أصبحت بعض الدول تميل إلى خصخصة بعض القطاعات الأمنية (الشركات الأمنية)، وحتى العسكرية (الجيش)، وأيضاً بعض الإدارات. وذلك كله تحت عنوان "تخفيف العبء" على الدولة. لكن، يمكن أن نعتبر هذه مقدمةً لمسار جديد، يكمل خصخصة التعليم والصحة والبنية التحتية، سوف يوصل إلى أن تكون الدولة بلا أجهزةٍ وبيروقراطية. حيث سيكون الاتجاه نحو خصخصة وزارة الداخلية، بحيث توكل مهمات الشرطة لشركة خاصة، والجيش لشركةٍ أخرى، والأمن لشركة ثالثة (وربما كل هذه لشركةٍ واحدة). وكذلك ستوكل بيروقراطية الدولة (الدواوين) لشركةٍ، أو عدة شركات خاصة، بحيث تقوم هي بالإدارة في مختلف المجالات. وهذا يشمل القضاء الذي سوف يخضع اختيار القضاة لامتحان شركة خاصة. وأيضاً ستكون مؤسسات الدولة مؤجرةً من شركة عقارية، وسوف تصبح دائرة جني الضرائب من نصيب شركة خاصة، كذلك الجمارك. من ثم، لا يكون للدولة مدخول سوى هذه. وهي تُدفع للشركات التي توظفها الدولة، للقيام بمهامها المختلفة. بمعنى أن كل "أدوات" الدولة التي تحكم بها لمصلحة طبقةٍ ستصبح استثماراً خاصاً للطبقة نفسها. لكن، هذه المرة مشروعاً ربحياً، وليس "خدمة" للشعب الذي يدفع الضرائب من أجل ذلك.
في هذه الوضعية، سوف تصبح الدولة بلا "أدوات"، حيث تصبح المؤسسات التمثيلية (البرلمان) والتنفيذية (الوزارة)، والرئاسة، كلها تمارس نشاطها بموظفين تابعين لشركةٍ خاصة، وبمقرّات مستأجرة، وتتحدّد مهمتها في إقرار القوانين والإملاءات التي تفرضها الشركات الخاصة، والتي ستكون مصالحها أوسع من التوظيف في مؤسسات الدولة هذه. تصبح الدولة شكلاً ليس أكثر، ولا تعود أداة سيطرة طبقةٍ باتت هي أصلاً مسيطرةً على الدولة مباشرة، بل شكلاً سياسياً نافلاً، مظهراً فقط. وستكون الضرائب التي تفرض على الشعب، وأسعار الخدمات المختلفة التي كانت تقدمها الدولة بمبالغ رمزية، هي ما يسدّد "حقوق" الشركات التي باتت تستثمر مؤسسات الدولة كاستثمار خاص. وتصبح الشركات المستثمِرة هي التي تدفع أجور أعضاء البرلمان والوزراء والرئيس الذين سيكونون من "رجال الأعمال" انفسهم الذين يؤجرون "الدولة" مؤسساتها، ويقومون بكل خدماتها. هنا، يصبح التماهي واضحاً بين السياسة والاقتصاد، بين الرأسماليين وممثلي الدولة، ويصبح الربح أساس العلاقات، والاقتصاد هو المهيمن مباشرةً بعد أن كان "في الخفاء" يلعب دور "المحدِّد".
في هذه الوضعية، يتغوّل الاقتصادي مقصياً السياسي، أو محولاً إياه إلى شكلٍ ليس إلا. بالتالي، لا تعود السلطة أداة طبقةٍ، بل تصبح بيد الرأسمال مباشرة، وتكون "السلطة" الشكل الذي يبرّر ذلك. هي "المحلل" لكل سياسات الرأسمال، من دون حاجةٍ إلى شكل يظهر وكأنه يمثل "الشأن العام"، ويدافع عن "المصالح العامة". تظهر الدولة على حقيقتها أداة الرأسمال، وليس معبّراً عن "المصالح العامة".