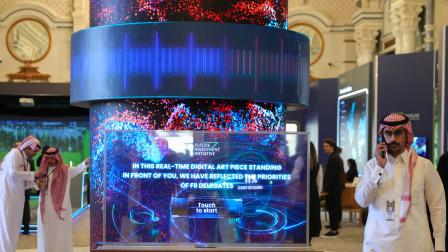هنالك علاقة طردية بين نسبة البطالة وارتفاع درجة الفساد(غيتي)
تدرس جامعات عالمية مادة القانون والحوكمة ضمن إطار واحد، فالحوكمة أو الـ (Governance) تعني بكل تطبيقاتها الجانب المتعلق بتنفيذ القانون. وفي عالمنا الذي بات يرى، في النظري والعملي، تقارباً في الزمان، وشرطاً للنجاح في الجانب العملي، بحيث أصبح الفصل بينهما أمراً قليل النفع والفائدة.
وتتخذ الحوكمة في التطبيق مضامين متعددة، أولها الفصل الواضح بين الإدارة والملكية في الشركات العامة، وتحييد التعيينات والترفيعات والترقيات عن كل ما يؤثر فيها سوى الكفاءة والقدرة على الاضطلاع بالمهام المنوطة بالوظيفة.
وهكذا نستثني من هذا الأمر صلة القرابة، والواسطة والعشائرية، أو التمييز بين الناس على أساس المذهب، أو العقيدة، أو اللون، أو الأصل أو غيرها من أدوات التمييز الممارسة في الحياة.
ومن مضامين الحوكمة كذلك الشفافية، بحيث تكون الشروط والمتطلبات واضحة، محدّدة، وتاركة القليل الأقل للاجتهاد الشخصي، أو التقدير الذاتي لصاحب القرار، إلا فيما يتفق عليه من معايير تؤخذ عبر لجان محايدة، مثل الذكاء الاجتماعي، قوة الشخصية، وغيرها من ملكات وصفات شخصية وعاطفية.
وقد طور العالم معايير للمقارنة بين الدول، فمنظمة الشفافية الدولية تصدر قائمة بالدول، حسب انتشار الفساد فيها. وتأتي عادة دول الخليج الصغيرة في مراكز متقدمة بين دول العالم، ومراكز أولى بين الدول العربية.
وهنالك علاقة طردية إلى حد كبير بين نسبة البطالة في دولة ما وارتفاع درجة الفساد في الدول، حيث تكثر أساليب الضغط على المسؤولين عند التعيين أو الترقية، وتروج بين الباحثين عن وظائف أو الطامحين إلى مراكز أعلى، أو وظائف أفضل دخلاً، مقولة "ليس المهم ما تعرف، ولكن المهم من تعرف".
وبهذا القول الشائع، حتى في الدول الغربية، نجد منظومة الكفاءة والقدرة في الدرجة الثانية، ونظام الواسطة في الدرجة الأولى.
اقــرأ أيضاً
وبحسب ما يذكره أحد مدراء المخابرات أيام الرئيس الروماني، نيكولاي تشاوتشسكو (1965 ـ 1989)، واسم هذا المدير أيون باسيبا، أن قائمة التعيينات الأخيرة كانت ترسل إلى مدير المخابرات، ليختار منها ما تظهر البيانات والملفات أنه الأفضل. ولكن باسيبا الذي جندته وكالة الاستخبارات الأميركية (سي.آي. إيه) طلب منه آنذاك، دليلا على تعاونه، أن يختار الشخص الأسوأ في القائمة ليرشحه للمنصب العالي المرغوب ملؤه.
وقد أدى هذا مع الزمن إلى تراجع الأداء الحكومي، وإلى تعيين الأقل كفاءة على كل المستويات والدرجات في الإدارة العامة، ما ساهم في تدهور النظام لمّا دارت عليه الدوائر.
وبموجب نظرية العالم الاقتصادي والاجتماعي الأميركي، جوزيف سبينغلر، فإن المجتمعات التي تبنى على نظام الكوتا، أو تلك التي تتجزأ إلى مجموعات، يتحيز أفراد كل منها لبعضهم بعضا، فإن أصحاب الكفاءات المحدودة سوف يسيطرون على الإدارة، ويطردون الكفاءات الجيدة إلى الخارج.
ولا يكتفي سبينغلر بهذا، بل يقول إن المجتمعات التي تكثر فيها الطوائف الدينية، والذين لا يتزوجون إلا من داخل الطائفة، ستكثر بينهم العنوسة بين النساء خصوصا، والرجال بشكل أقل. وفي الأردن، كانت الطوائف المسيحية لا تتزوج إلا من بعضها بعضا، فكثرت العنوسة، والسبب أن تصغير قاعدة الاختيار يجعل التماهي بين الأزواج أصعب وأندر.
أما الشباب فيتزوجون من دول أخرى، والبنات يكبرن ويعنّسن. ولذلك تداعى رجال الدين المسيحي إلى فتح باب الزواج بين الطوائف، ما قلل من نسبة العنوسة بشكل كبير.
ولهذا، فإن حجم الكلفة الناجمة عن التمييز كبير جداً ويصعب قياسه، وأول مشكلة له أنه يجعل ولاء الموظف ليس لصاحب العمل، أو للمؤسسة التي يعمل بها، وإنما للشخص أو الجهة التي توسطت له في التعيين. ورداً للجميل، فإن الموظف قليلا ما يرفض طلباً ممن توسط له، لكي يساعده على الفوز بعطاء، أو يسرّب له معلومات، أو يحابيه في الخدمة على حساب الصالح العام.
وبالتدريج، يصبح الموظف المعين بالواسطة أقرب إلى التساهل في تطبيق القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، ويتساهل في التغاضي عنها، خصوصا إذا كانت الرقابة وآليات التدقيق ضعيفة التطبيق، أو أن القائمين بها غير أكفياء. وتنتقل المراعاة إلى الأقارب والأصحاب وإلى الأغراب مقابل هدايا أو منافع مادية. وحتى يضمن كل قابل للهدايا سلامته من التساؤل، يبدأ بالتنسيق مع زملاء آخرين يرتكبون الخطأ نفسه.
وهكذا يصبح هنالك مع الوقت عصابة تتكافل وتتعاون على الفساد، ما يصعب من مهمة الكشف عنها أو متابعتها. وللفساد ديناميكية خاصة به، فهو سرعان ما ينتشر بين الدوائر، ويوسع حلقته. ولهذه الحلقات بالطبع أدواتها، مثل الإيقاع بالبريئين من غير المتعاونين.
ويصل بهم الأمر أحياناً إلى حد القتل، وبث المعلومات المسمومة والكاذبة، وحتى حرق المخازن التي يسرقون منها للتستر على جرائمهم، كما أشيع عن حرق دار الأوبرا وقصر محمد علي في القاهرة قبل سنوات كثيرة.
وينطوي الفساد في العطاءات واللوازم على كلفة اجتماعية عالية، فهو قد يؤدي إلى مخالفة المواصفات، واستخدام مواد أقل جودةً، وتغيير المطلوب بحجج واهية. وقد قمت بدراسةٍ عن كلفة الفساد في العطاءات الحكومية، فوجدت أن كلفة كل دينار (1.41 دولار) يدفع رشوة حوالي سبعة دنانير على مدى عمر البناء.
ولا تقف الكلفة عند هذا الحد، بل إن الأسوأ هو انتشار الاعتقاد بين سواد الناس أن إنجاز معاملاتهم في الدوائر العامة لا يتم إلا بعد دفع الرشوة، سواء كانت معاملة صغيرة، أو معاملة كبيرة.
وهكذا تصبح الرشوة قائمةً على حساب الخزينة العامة، فالمرتشي يدل الراشي على الوسائل، لتقليل الرسوم والضرائب التي يدفعها، أو يقلل من تقدير قيمة السلع والممتلكات التي تدفع ضريبتها كنسبة من القيمة، أو أنه يسمح للبائع بعدم تسجيل الصفقة.
وهكذا يصبح للفساد كلف عالية تدفع الحكومات إلى الاقتراض، وإلى زيادة الرسوم والضرائب. لذا فالحوكمة والقانون صنوان لا ينفصلان، وأحدهما متمم للآخر، أو أن كل واحد منهما يشكل وجه العملة الآخر.
وتتخذ الحوكمة في التطبيق مضامين متعددة، أولها الفصل الواضح بين الإدارة والملكية في الشركات العامة، وتحييد التعيينات والترفيعات والترقيات عن كل ما يؤثر فيها سوى الكفاءة والقدرة على الاضطلاع بالمهام المنوطة بالوظيفة.
وهكذا نستثني من هذا الأمر صلة القرابة، والواسطة والعشائرية، أو التمييز بين الناس على أساس المذهب، أو العقيدة، أو اللون، أو الأصل أو غيرها من أدوات التمييز الممارسة في الحياة.
ومن مضامين الحوكمة كذلك الشفافية، بحيث تكون الشروط والمتطلبات واضحة، محدّدة، وتاركة القليل الأقل للاجتهاد الشخصي، أو التقدير الذاتي لصاحب القرار، إلا فيما يتفق عليه من معايير تؤخذ عبر لجان محايدة، مثل الذكاء الاجتماعي، قوة الشخصية، وغيرها من ملكات وصفات شخصية وعاطفية.
وقد طور العالم معايير للمقارنة بين الدول، فمنظمة الشفافية الدولية تصدر قائمة بالدول، حسب انتشار الفساد فيها. وتأتي عادة دول الخليج الصغيرة في مراكز متقدمة بين دول العالم، ومراكز أولى بين الدول العربية.
وهنالك علاقة طردية إلى حد كبير بين نسبة البطالة في دولة ما وارتفاع درجة الفساد في الدول، حيث تكثر أساليب الضغط على المسؤولين عند التعيين أو الترقية، وتروج بين الباحثين عن وظائف أو الطامحين إلى مراكز أعلى، أو وظائف أفضل دخلاً، مقولة "ليس المهم ما تعرف، ولكن المهم من تعرف".
وبهذا القول الشائع، حتى في الدول الغربية، نجد منظومة الكفاءة والقدرة في الدرجة الثانية، ونظام الواسطة في الدرجة الأولى.
وقد أدى هذا مع الزمن إلى تراجع الأداء الحكومي، وإلى تعيين الأقل كفاءة على كل المستويات والدرجات في الإدارة العامة، ما ساهم في تدهور النظام لمّا دارت عليه الدوائر.
وبموجب نظرية العالم الاقتصادي والاجتماعي الأميركي، جوزيف سبينغلر، فإن المجتمعات التي تبنى على نظام الكوتا، أو تلك التي تتجزأ إلى مجموعات، يتحيز أفراد كل منها لبعضهم بعضا، فإن أصحاب الكفاءات المحدودة سوف يسيطرون على الإدارة، ويطردون الكفاءات الجيدة إلى الخارج.
ولا يكتفي سبينغلر بهذا، بل يقول إن المجتمعات التي تكثر فيها الطوائف الدينية، والذين لا يتزوجون إلا من داخل الطائفة، ستكثر بينهم العنوسة بين النساء خصوصا، والرجال بشكل أقل. وفي الأردن، كانت الطوائف المسيحية لا تتزوج إلا من بعضها بعضا، فكثرت العنوسة، والسبب أن تصغير قاعدة الاختيار يجعل التماهي بين الأزواج أصعب وأندر.
أما الشباب فيتزوجون من دول أخرى، والبنات يكبرن ويعنّسن. ولذلك تداعى رجال الدين المسيحي إلى فتح باب الزواج بين الطوائف، ما قلل من نسبة العنوسة بشكل كبير.
ولهذا، فإن حجم الكلفة الناجمة عن التمييز كبير جداً ويصعب قياسه، وأول مشكلة له أنه يجعل ولاء الموظف ليس لصاحب العمل، أو للمؤسسة التي يعمل بها، وإنما للشخص أو الجهة التي توسطت له في التعيين. ورداً للجميل، فإن الموظف قليلا ما يرفض طلباً ممن توسط له، لكي يساعده على الفوز بعطاء، أو يسرّب له معلومات، أو يحابيه في الخدمة على حساب الصالح العام.
وبالتدريج، يصبح الموظف المعين بالواسطة أقرب إلى التساهل في تطبيق القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، ويتساهل في التغاضي عنها، خصوصا إذا كانت الرقابة وآليات التدقيق ضعيفة التطبيق، أو أن القائمين بها غير أكفياء. وتنتقل المراعاة إلى الأقارب والأصحاب وإلى الأغراب مقابل هدايا أو منافع مادية. وحتى يضمن كل قابل للهدايا سلامته من التساؤل، يبدأ بالتنسيق مع زملاء آخرين يرتكبون الخطأ نفسه.
وهكذا يصبح هنالك مع الوقت عصابة تتكافل وتتعاون على الفساد، ما يصعب من مهمة الكشف عنها أو متابعتها. وللفساد ديناميكية خاصة به، فهو سرعان ما ينتشر بين الدوائر، ويوسع حلقته. ولهذه الحلقات بالطبع أدواتها، مثل الإيقاع بالبريئين من غير المتعاونين.
ويصل بهم الأمر أحياناً إلى حد القتل، وبث المعلومات المسمومة والكاذبة، وحتى حرق المخازن التي يسرقون منها للتستر على جرائمهم، كما أشيع عن حرق دار الأوبرا وقصر محمد علي في القاهرة قبل سنوات كثيرة.
وينطوي الفساد في العطاءات واللوازم على كلفة اجتماعية عالية، فهو قد يؤدي إلى مخالفة المواصفات، واستخدام مواد أقل جودةً، وتغيير المطلوب بحجج واهية. وقد قمت بدراسةٍ عن كلفة الفساد في العطاءات الحكومية، فوجدت أن كلفة كل دينار (1.41 دولار) يدفع رشوة حوالي سبعة دنانير على مدى عمر البناء.
ولا تقف الكلفة عند هذا الحد، بل إن الأسوأ هو انتشار الاعتقاد بين سواد الناس أن إنجاز معاملاتهم في الدوائر العامة لا يتم إلا بعد دفع الرشوة، سواء كانت معاملة صغيرة، أو معاملة كبيرة.
وهكذا تصبح الرشوة قائمةً على حساب الخزينة العامة، فالمرتشي يدل الراشي على الوسائل، لتقليل الرسوم والضرائب التي يدفعها، أو يقلل من تقدير قيمة السلع والممتلكات التي تدفع ضريبتها كنسبة من القيمة، أو أنه يسمح للبائع بعدم تسجيل الصفقة.
وهكذا يصبح للفساد كلف عالية تدفع الحكومات إلى الاقتراض، وإلى زيادة الرسوم والضرائب. لذا فالحوكمة والقانون صنوان لا ينفصلان، وأحدهما متمم للآخر، أو أن كل واحد منهما يشكل وجه العملة الآخر.