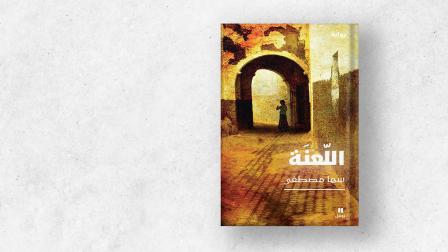جاءت عهود في القرن الماضي، كانت واعدة بمتغيّرات عظيمة تشمل نتائجها المنطقة العربية، عمِل فيها الأدب بتوجيهات تقدّمية رعاها "اتحاد الكتّاب العرب"، الابن البار للأنظمة الاشتراكية، كانت الضامن لتحرّر الأدب ونهضة الجماهير المسحوقة. للأسف لم ينل الأدب والعمّال والفلاحّون شيئاً من خيرات المتغيّرات، ليس من شدّة تسارعها، فهي لم تثمر خيراً، بل أثمرت دكتاتوريات.
واظب الاتحاد على التمسّك بالثوابت، فالمهامّ كانت واضحة، العمل على تحقيق الدولة الاشتراكية حسب طبعتها الاستبدادية، فلم تجد وسلية إلاّ بعطب الأدب، أما الجماهير المسحوقة فلبثت مسحوقة. المهامّ التي أصابت الاتحاد بالطاعة إلى حدّ الشلل، بثّت فيه النشاط بالدعوة إلى الوحدة، الرافعة التي ستدفع الأمة العربية إلى الانطلاق في طريق التقدّم.
أظهر الاتحاد صلابته، فالهدف لا يشوبه خلل ولا ضعف، ما دام سيتحقّق بالمؤتمرات الأدبية، لا بالمؤامرات العسكرية. وإذا كانت المؤتمرات قد عملت بلا جدوى على الوحدة، فالمؤامرات هي التي نجحت في تمزيقها. منذئذ اعتُمد الأدب عنصراً لفظياً في توحيد كلمة العرب.
أضاف الاتحاد شعار الحرية إلى الوحدة المفروغ منها، ولم يساير السياسيين أصحاب الشعار الثلاثي (وحدة حرية اشتراكية) خشية الوقوع في الكذب، فالأنظمة لا تطيق الحريات بأنواعها، وعَدَتْ ولم تفِ بوعودها، والهزائم التي تكبّدتها انقلبت إلى انتصارات، رغم أنها خسرت أراضيَ إضافية لصالح العدو الصهيوني.
أهداف الاتحاد طالما أنها أدبية، لا تسمح له بالتنازل عن قضية الحرية، وكانت محدّدة بتحرّر الشعب الفلسطيني، من دونها لن يجد الأدب ما يعمل عليه. تشبّث بها لأسباب نفسية أيضاً، كانت شفاء من الشعور بالذنب من قضية يعيش عليها طوال نصف قرن، وانتفع منها شعراً ونثراً، تنظيراً ونقداً، مؤتمرات وندوات، مهرجانات وسفريات.
إلى أن جاءت عهود تحلّل فيها الاتحاد من تزمّته، وتبخّرت اللائحة المتشنجة حتى من فلسطين، عدا التطبيع، ورقة التوت الأخيرة. فغضّ النظر عن الجنس والدين، بالتخفّف من ملاحقتهما بالمنع ومقصّ الرقيب، فسمح بما لا يُمكن السماح به من قبل، فالجنس يرفع النظام إلى مصاف الدول العلمانية المتقدّمة حضارياً. أما الدين فباتباع خطّة رشيدة، فمن طرف تُبنى المساجد، ومن طرف آخر يُقمع المتدينون. لماذا؟ النظام يهتمّ بالتوازن، فكان الحكَم بينهما، ومن يشذّ عن هذه المعادلة المثالية، نصيبه الزجّ في السجون مع حرية التصرّف بجثّته تعذيباً وشنقاً ودفناً.
جدّد الاتحاد ثوابته، وأصبح معقلاً لصناعة الأدب طبقاً لمواصفات غامضة، لكنها واضحة بالنسبة إلى القائمين عليه، لا أدباء خارجه، ولا آلية أخرى لتقييم أو لانتشار أو تقدير أي عمل إلاّ له وحده. في رحلة الاتحاد الأخيرة، أصبحت الحظوة لأدب المقاومة والممانعة، مما صنّف الأدباء إلى موالين ومعارضين. أسهمت بتصدير أدباء عملاء لأنظمة عميلة، مع ضمان العمالة الأبدية لأنظمة تتأبّد. أما الأدب فإلى جحيم الصمت، هناك يموت أو يحيا.